دور التصوف في بناء وتطوير الحضارات

مقدمة
واجه التيار الصوفي في بعض الحضارات محاولات للقمع من خلال اتهام أتباعه بالخمول، الكسل، وانعدام الفاعلية، بالإضافة إلى تأثيرهم السلبي على مجتمعاتهم. لم تقتصر هذه الانتقادات على التصوف في الحضارات الأخرى، بل شملت أيضًا الحضارة العربية الإسلامية. ومع ذلك، يُعتبر التصوف ركيزة أساسية في الحضارة الإسلامية، حيث أسهم بشكل بارز في جوانب متعددة، بما في ذلك الاجتماعية، السياسية، العلمية، الأدبية، والفنية، وحتى في المجال المعماري، إذ يبرز تأثيره بوضوح في الزخارف والهندسة المعمارية للمقرات، الزوايا، والأضرحة.
بناءً على ذلك، تهدف هذه الورقة البحثية بعنوان: دور التصوف في بناء وتطوير الحضارات إلى تفنيد الفكرة القائلة بعدم وجود إسهام للتصوف في بناء الحضارات، من خلال عرض الأدوار المهمة التي قام بها شيوخ الزوايا وأتباع الطرق الصوفية، الذين استلهموا نهجهم من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لتعزيز بناء الحضارات عمومًا، والحضارة العربية الإسلامية خصوصًا، وفق منهج التصوف الإسلامي السني. تركز الورقة على الإجابة عن عدة أسئلة رئيسية، منها:
- ما معنى التصوف، الحضارة، العولمة، والحداثة؟
- ما هي مجالات إسهام التصوف في بناء الحضارة العربية الإسلامية؟
- كيف ساهم التصوف في مواجهة التحديات المعاصرة؟
- هل كانت مواقف الناس تجاه إسهام التصوف متجانسة أم متباينة؟
1. مفاهيم أساسية في البحث:(توضيحات وتبديدات)
1.1. توضيح مفهوم التصوف:
- في اللغة العربية:
كلمة التصوف وصوفية مشتقة من كلمة الصوف، وذلك لأن الصوف كان الزي السائد بين الزهاد في العصور القديمة[1]، أما عن اشتقاق كلمة الصوفية، فقد يكون من الصفاء، لأن التصوف قائم على التصفية الروحية، أو من الصفة بمعنى الاتصاف بالكمالات الروحية، أو ربما من أهل الصفة في المسجد النبوي، حيث يتشبه الصوفية بأهل الصفة في الانقطاع والتوجه نحو الله. وقد يكون أيضًا من الصوف كما أُشير سابقًا، حيث كان الصوف لباسهم تواضعًا وزهدًا في الدنيا، لأن الأنبياء كانوا يرتدون الصوف. ويرى ابن عجيبة الحسني(1747_1809م) أن هذا الاشتقاق هو الأقرب من حيث اللغة والأوضح في النسبة، إذ يُقال تصوّف عندما يلبس الشخص الصوف، كما يُقال تقمّص عندما يلبس القميص، وتُشتق النسبة منه فيُقال صوفي[2].
- في اللغة الفرنسية:
مصطلح(Mysticisme, Mystique) يقابل مفهوم الصوفية، وله عدة تعريفات. يُفهم أحيانًا على أنه معرفة تعتمد على ترتيب للحقائق فوق الطبيعة، والتي لا يمكن الوصول إليها عبر الإدراك التقليدي، بل من خلال تجارب تؤدي إلى معرفة عقلانية، كما يُعرّف بأنه حالة نفسية تميز الأفراد الذين يشعرون بأنهم على اتصال مباشر مع الله. وبصيغة أخرى، يمكن القول إنه إيمان أو معرفة تتعارض مع العقل، حيث يرفض الاعتماد على الذكاء والملاحظة، ويرتكز على الإحساس والخيال[3]. والمفهوم هنا يرتكز بشكل عام على كونه نوعًا من التأمل العميق أو التبصر الروحي الخاص بالفرد، حيث يسعى الشخص إلى الوصول إلى حالة من الفهم الداخلي أو العلاقة الروحية الخاصة، التي تتجاوز الإدراك العقلي والعقلاني التقليدي.
3.1.1. في الاصطلاح:
يرى خليل أحمد خليل (1942م- ) إن التصوف هو طريقة روحية دينية أو مذهب فلسفي يقوم على فكرة أن المعرفة تتحقق من خلال اتصال مباشر بين الروح والمطلق، دون الحاجة إلى الاعتماد على العقل العملي. أما الصوفية فهي مذهب ديني يهدف إلى تحقيق اتحاد بين الإنسان وخالقه، وذلك من خلال التأمل، والتوحد، والشعور بالوجود، وصولًا إلى الفناء[4]. وينطلق محمود يعقوبي(1931-2020م) من إن التصوف موقف معرفي يعتقد فيه الشخص أن حقيقة الوجود يمكن أن تنكشف له بشكل مباشر عبر الحدس، بشرط أن يتخلى عن الطريق العقلي الذي لا يصل إلى تلك الحقيقة. ويضيف أن التصوف قد يكون أيضًا سلوكًا أخلاقيًا نابعًا من هذا الموقف المعرفي، يدفع صاحبه إلى الزهد في كل شيء باستثناء الحقيقة التي انكشفت له[5]. فحين اعتبر معروف الكرخي (ت815م) أن التصوف عبارة عن السعي نحو الحقيقة الروحية، مع التخلي عن الأمور التي تؤدي إلى الضرر أو الألم للآخرين، وذلك من خلال حياة زهد وتركيز على القيم الأخلاقية والروحانية[6]، وقد انتشرت كلمة الصوفي في العالم الإسلامي بعد أن قالها أبو هشام الكوفي (ت 156ه/15م).
ومن المواضيع التي أثارت جدلًا بين الباحثين هو أصل التصوف: هل يعود جذوره إلى الهندوسية، المسيحية، أو ربما هو رد فعل للعقلية الآرية ضد الإسلام وثقافته في فارس؟ أم أنه امتداد للفلسفة اليونانية؟ أم أنه نشأ من صميم البيئة العربية الإسلامية؟ في هذا السياق، يرى الأستاذ عميراوي أن التصوف الإسلامي قد يكون مشتقًا من الكلمة اليونانية(Théosophie) التي تعني حكمة الإله[7]، بينما يؤكد المتصوفة المسلمون أن التصوف مستند إلى الكتاب والسنة، وقائم على اتباع نهج الأنبياء الأصفياء.
وعلى العموم، يُعرف التصوف بأنه علم يُرشد إلى كيفية السير نحو حضرة ملك الملوك، ويسعى إلى تنقية النفوس من الرذائل وتزيينها بأنواع الفضائل. كما يُفسَّر بأنه غياب الخلق في مشاهدة الحق، مع العودة إلى التمسك بالأثر. وعليه يُقال إن التصوف يبدأ بالعلم، يتوسطه العمل، وينتهي بالموهبة الإلهية.
2.1. توضيح مفهوم الحضارة:
- في اللغة العربية:
تشمل كلمة حضارة عدة معانٍ، من أبرزها الاستقرار في الحضر. والحضر والحضرة هما نقيض البادية، وتشيران إلى المدن والقرى والأرياف، وسُميت بذلك لأن أهلها يعيشون في المراكز الحضرية والمساكن الثابتة. أما الحاضرة، والحاضر، فيدلان على القبيلة الكبيرة، أو المجتمع[8].
- في اللغة الانجليزية:
كلمة(Civilisation) تعادل مصطلح الحضارة، حيث كانت في البداية تشير إلى المدينة بمعناها الطبيعي، ثم تطور استخدامها لتشير إلى مفهوم الحضارة بمعناه الأوسع[9]، وبعض الباحثين يربطون الحضارة بالمفهوم المدني أو المتعلق بالمدينة وسكانها، حيث تُعتبر الحياة الحضرية مرتبطة بالمدن[10].
- في الاصطلاح:
لا يوجد تعريف واحد للحضارة، حيث تختلف التعاريف باختلاف المجالات العلمية والفكرية. ومن بين التعاريف المهمة: عرّف الفيلسوف الفرنسي أندريه لالاند André Lalande(1876-1963م) الحضارة بأنها مجموعة من الظواهر الاجتماعية المعقدة ذات طبيعة قابلة للتوارث، وتتميز بطابع ديني، جمالي، فني، تقني أو علمي، وتنتشر بين أجزاء متعددة في مجتمع واسع، أو بين مجتمعات مترابطة، مثل: الحضارة الصينية، الحضارة المتوسطية[11].
أما الباحث المصري إبراهيم مدكور (1902-1996م)فقد رأى أن الحضارة هي نقيض البداوة، وتتميز بالتحضر، وهي مرحلة متقدمة في التطور الإنساني[12]. ومن ناحية أخرى، يرى المفكر الجزائري مالك بن نبي (1905-1973م) أن الحضارة لا تقابل البداوة كما يعتقد كثير من المفكرين، بل يراها إطارًا يضمن للإنسان الحماية من الهمجية. وفقًا له، الحضارة ليست مرادفة للمدينة، بل هي مجموعة من الشروط الأخلاقية والمادية التي تمكّن المجتمع من تقديم الدعم اللازم لأفراده في كل مرحلة من مراحل حياتهم، من الطفولة إلى الشيخوخة[13].
3.1. توضيح مفهوم العولمة:
1.3,1. في اللغة الفرنسية:
(Mondialisation) هو المصطلح الذي يعادل العولمة، حيث يرى هوبرت فيدرين(HubertVedrine) (1947م- ) أن العولمة ليست فكرة بقدر ما هي حقائق تقنية فرضت نفسها على المشهد العالمي. وفي هذا السياق، أثارت قلقاً واسعاً، خصوصاً لدى الدول والمؤسسات الخاصة. فهي ظاهرة تؤثر تحديداً على اقتصاد السوق والاستهلاك، إلى جانب اقتصاد تحويل العملات وإدارة الاستثمارات[14].
2.3.1. في الاصطلاح:
عرّف سمير أمين (1931-2018م) العولمة بأنها عملية تفاعل اقتصادي متبادل بين الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة، وتوسيع التبادل التجاري بين الشمال والجنوب، حيث يُنظر إلى الجنوب كسوق مهمة[15].
أما عزمي بشارة (1956م- ) فيرى أن العولمة هي سيطرة قوانين التبادل العالمي، التي تفرضها المراكز الصناعية الكبرى، على احتياجات الاقتصاد المحلي[16].
4.1. توضيح مفهوم الحداثة:
1.4.1. في اللغة الفرنسية:
(Modernisation-Moderne–Modernité) هو المقابل لمصطلح حديث أو حداثة، حيث تشير الحداثة إلى الحضور، أو الزمن الراهن. فهي تعبر عن حركة متواصلة للتغيير، سواء في التحديث أو التقدم الاجتماعي، وتدل على مسار اجتماعي يعكس التحول نحو العقلانية والعلمانية. الحداثة تمثل قطيعة معرفية وعلمية مع التراث التقليدي، مثل قطيعة أوروبا مع تعاليم الكنيسة وانفتاحها على العلوم اليونانية والعربية، التي عبر عنها ديكارت René Descartes (1596-1650م) بقوله الشهير: «أنا أفكر»، والذي يرمز إلى ميلاد الفرد الحر في القرن السادس عشر. وتعد الحداثة عكس الأصالة وما يرتبط بها من توجهات أصولية وحركات رجعية[17].
1.4.1. في الاصطلاح:
الحديث والمحدث يُشيران إلى كل جديد لم يكن معروفًا أو شائعًا من قبل، بينما يُفهم التحديث على أنه التخلي عن الوسائل القديمة نظرًا لقصورها واستبدالها بوسائل أكثر تطورًا في المجال التقني. أما في المجال الثقافي، فإن التحديث يعني التخلي عن الأفكار القديمة التي أصبحت غير صالحة، واستبدالها بالمعارف الحديثة والمتقدمة، وهو ما يُعرف بالعصرنة[18].
2. أبعاد إسهام التصوف في تطور الحضارة العربية الإسلامية:
تشير القراءة الأولية لتاريخ التصوف السني إلى أهمية دوره في حياة الفرد والمجتمع، من خلال إسهامات ملموسة في مجالات متعددة أهمها:
- الإسهام العلمي للتصوف: (حاجة المعرفة إلى الإلهام الروحي)
تُعد الزوايا في العالم العربي الإسلامي، وخاصة في الجزائر، مركزًا للعلم والثقافة العربية الإسلامية. فهي بمثابة مدارس وملاجئ وبيوت للعمل الخيري، حيث تخصصت في تحفيظ القرآن الكريم وتعليم العلوم اللغوية والشرعية والتاريخية الضرورية. وفي جنوب الجزائر، لعبت الزوايا دورًا مهمًا في نشر الإسلام واللغة العربية حتى في الدول المجاورة جنوب الصحراء، كما خرّجت العلماء والفقهاء وحفظة القرآن الكريم. بفضل هذه الأدوار، يُنسب إليها الفضل في الحفاظ على اللغة العربية وعلومها والثقافة الإسلامية من الاندثار خلال فترة الاحتلال الطويلة للجزائر (1830-1962م([19].
يرى بول مارتي Paul Marty( 1882- 1938م) أن الشيخ سيدي مختار الكنتي (1727_1811م) كان شيخًا شديد الورع، ومثقفًا من الطراز الأول، ورجل سياسة. لقد لعب دورًا بالغ الأهمية في الحياة الصحراوية (1700-1811م) خلال تلك الفترة، وكان مصلحًا إسلاميًا حقيقيًا. بفضله، ازدهرت الحركة العلمية في بلاد التكرور والأزواد في القرن الثامن عشر، وانتشر السلام بفضل جهوده. تولى الزعامة السياسية والعلمية، وأذعنت له جميع قبائل الأزواد بفضل سمعته الواسعة. كما أعاد للطريقة الصوفية القادرية مجدها[20].
2.2.الإسهام السياسي والتاريخي للتصوف: (أهمية الروحانية في منظومة الحكم)
يتضح اهتمام رجال التصوف ومشايخهم بالسياسة من خلال كتابات مؤثرة، مثل: (التبر المسبوك في نصيحة الملوك) لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي (1058- 1111م)، و(الذهب المسبوك في نصيحة الملوك) لأبي عبد الله محمد الحميدي(1029-1095م)، و(التدابير الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية) لمحي الدين بن عربي(1165-1240م)، و(سراج الملوك) لأبي بكر الطرطوشي (1059-1127م). وسنقتصر هنا على تناول كتاب (التبر المسبوك في نصيحة الملوك) الذي ألفه الإمام الغزالي بناءً على طلب السلطان محمد بن ملك شاه السلجوقي (451-520هـ). من خلال هذا الكتاب، يعبر الغزالي عن رؤيته للسلوك السياسي من منظور صوفي، حيث يوضح فيه أن الغاية هي الحفاظ على الإيمان وتعزيزه بالطاعة. على سبيل المثال، يخاطب السلطان قائلًا:«أعلم أيها السلطان أن كل ما كان في قلب الإنسان من معرفة واعتقاد فذلك أصل الإيمان، وما كان جاريًا على أعضائه السبعة من الطاعة والعدل فذلك فرع الإيمان، فإذا كان الفرع ذاويًا ذابلًا دلّ على ضعف الأصل، فإنه لا يثبت عند الموت، وعمل البدن عنوان إيمان القلب»[21].هذا بالنسبة للأعمال التي لها خصوصية بمهاهم السياسي.
كما يحدد الغزالي نوعين من الأعمال المرتبطة بالإيمان السياسي: الأول يتضمن الأعمال التي تربط السلطان بالله، مثل الصلاة والصوم، والثاني يتعلق بالعلاقة مع الرعية، مثل العدل والكف عن الظلم. ويشير إلى أن الخطر الأكبر على الملوك هو الظلم، حيث يقول: «لا يتجاوز به عنك على كل حال يوم القيامة، وخطره عظيم، ولا يسلم من هذا الخطر أحد من الملوك إلا ملك عمل بالعدل والإنصاف، ليعلم كيف يطلب العدل والإنصاف يوم القيامة»[22]
يقدم الغزالي أصول العدل التي يجب على السلطان اتباعها لضمان حسن الختام، مثل ضرورة لقاء العلماء الأخيار، متابعة أعوانه ومنعهم من الظلم، الحرص على القناعة، واستعمال الرفق. باختصار، يركز الغزالي على إصلاح السلطان من خلال رعاية الإيمان والعدل.
كما قدمت الزاوية إسهامًا كبيرًا في النهضة العلمية والإصلاحية في مختلف أنحاء العالم العربي الإسلامي، وخاصة في الجزائر. فقد أنجبت نخبة من العلماء الذين عادوا إلى قراهم وأوطانهم لنشر العلم والمعرفة. أسس هؤلاء العلماء زوايا، مدارس، وكتاتيب قرآنية، وأحيوا المساجد، وساهموا في مقاومة حركة التبشير الصليبية التي اشتدت في تلك الفترة. ومن الأمثلة على ذلك زاوية سيدي عبد الرحمن اليلولي في جبال جرجرة شمالًا، وزاوية الشيخ سيدي محمد بن الكبير(1911-2000م) جنوبًا. الأولى أصبحت ملاذًا للثوار والمجاهدين خلال حرب التحرير، ما دفع الاحتلال الفرنسي إلى تدميرها وإحراق مخطوطاتها وإيقاف نشاطها العلمي والثقافي عام 1957[23]. أما الزاوية الثانية، فقد دعمت المجاهدين وساهمت في تعزيز روح الثقة والانتصار والثبات بينهم، وحثتهم على الصبر وتحمل المشاق. فقد كان الشيخ سيدي محمد بن الكبير يستقبل موفدي المجاهدين ويقدم لهم الطعام. وكان منزله في أدرار ملاذًا لكل المجاهدين الذين قدموا إلى المنطقة، حيث كانوا ضيوفًا عند الشيخ طوال فترة إقامتهم بالولاية. وغالبية الوافدين كانوا من الولايتين السادسة والخامسة. بالإضافة إلى ذلك، شغل الشيخ منصب عضو في مجلس شورى المجاهدين، مما يعكس دوره البارز في دعم حركة التحري[24].
خلاصة القول عبت الزوايا الصوفية دورًا بارزًا في دعم المقاومة على مختلف الأصعدة الدينية، الاجتماعية، والسياسية. فقد ساهمت في حل النزاعات بين القبائل وتعزيز التآلف بينها، بالإضافة إلى تزويد الناس بالمعارف الدينية. كما كانت ملجأً للعجزة والمحرومين، مما يعكس دورها الشامل في خدمة المجتمع والمقاومة.
2.2. الإسهام الأخلاقي للتصوف: (حاجة الفرد والمجتمع إلى القيم الصوفية)
يُعد التصوف مصدر أمان للفرد والمجتمع في مواجهة التيارات المادية التي اجتاحت العصر الحديث والمعاصر، والتي ساهمت في الانحدار الأخلاقي والانجراف وراء الملذات. التصوف، باعتباره علمًا يتعامل مع النفس الإنسانية، يعمل على تهذيبها من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس المطمئنة. وهو يساهم في علاج أمراض القلوب مثل: الحسد، والكبر، والرياء، ويبدلها بمشاعر إيجابية مثل: التواضع، والإخلاص، مصداقًا لقوله : ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾[25].
يُعتبر التصوف علاجًا للجمود الذي أصاب المجتمع الإسلامي، حيث يقول النبي :» إن في الجسد مُضْغَة، إذا صَلُحَت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب»[26].والعلم الذي يعالج القلب هو التصوف. في هذا السياق، يذكر محمد زكي إبراهيم أن التصوف يركز على الدعوة، والجهاد، والخلق، والزهد، وهي مكونات التقوى التي تشكل مقام الإحسان في الإسلام[27].قال : ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾[28].
وخلاصة القول، التصوف يحقق التوازن بين الجانبين المادي والروحي للإنسان، ويعبر بصدق عن حركة التغيير التي مرت بها البشرية عبر التاريخ، حيث يصفه لويس ماسينيون Louis Massignon( 1883- 1962م) بأنه الأخلاق الدينية ومعاني العبادة[29].
كان لشيوخ الطرق الصوفية دورٌ مهمٌ في تعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام بين القبائل والدول المختلفة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، ما قام به الشيخ سيدي مختار الكنتي، الذي شهد عصره نزاعات شديدة بين قبائل كنته، وإدوا الحاج، وتجكانت، وأولاد سباع، وإدوعيش. فقد تجلت جهوده في التفاوض مع محمد الخير، أمير قبائل الهقار، حيث نجح في ضمان استعادة قبيلة كنته ممتلكاتها التي كانت قد استولت عليها عشائر الهقار الطارقية[30].
3. الإسهام الصوفي في مواجهة التحديات المعاصرة:
1.3. التصوف في ظل الحداثة وما بعد الحداثة:
يشكل مفهوم الإنسان محورًا هامًا في الخطابات الفلسفية الحديثة وما بعد الحديثة، مما أدى إلى ظهور عدة ثنائيات تتناول هذا المفهوم، مثل: (الإنسان والديمقراطية)، (الإنسان والتقنية)، حتى وصلنا إلى مفهوم موت الإنسان أو نهاية الإنسان في الفلسفة المعاصرة. هذه الأزمة أثارت جدلًا واسعًا بين الفلاسفة والمفكرين حول كيفية الخروج منها. وقد أجمعت العديد من الأصوات على أن التصوف يمثل الحل الوحيد لأزمة الإنسان المجهول، وذلك بتحويله إلى إنسان معلوم يُفهم طريق إصلاح حاله ومستقبله. أما فيما يتعلق بالأسرة في ظل الحداثة وما بعدها، فقد تسببت الحداثة الغربية في انهيار أخلاقي، حيث انفصلت الأسرة عن القيم التقليدية التي كانت مستندة إلى الدين، مما أدى إلى ظهور مشكلات اجتماعية. يوضح "عبد السلام" أن الحداثة لم تتوقف عند حدود التعقيل الضيق لعالم الأشياء، بل امتدت لتشمل علم الأحياء الإنساني والعلاقات الأسرية[31].
ويدور النقد حول أن الحداثة الغربية فصلت الأخلاق عن الدين، حيث سعى المفكرون إلى تحرير الأخلاق من سلطة المعتقدات الدينية، وهو ما أثر سلبًا على القيم الأسرية[32].
يمكن اعتبار التصوف أكثر فهماً للحداثة، فقد نجحت الطرق الصوفية في تناول أسئلة الحداثة الإنسانية والكونية والإلهية بعمق ووعي. العديد من الباحثين يتناولون اليوم مسألة مواكبة التصوف للحداثة وما بعدها، حيث يشيرون إلى: نقد العقل والحد من السلطة المطلقة للعلم: التصوف لا يستبعد أية أداة معرفية، ويمنح الإلهام والكشف أهمية أكبر في السعي إلى اليقين، مع التركيز على توحيد الإنسان مع الإلهي.عودة إلى القيم الأخلاقية والجمالية؛ لأن التصوف يعتمد على منظومة من القيم الروحية والأخلاقية، وهو ما يجعله مصدرًا لا ينضب لهذه القيم[33].
قدم طه عبد الرحمن، في كتابه سؤال الأخلاق: مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية، نقدًا صوفيًا للحداثة. يركز عبد الرحمن على ضرورة دوام الاشتغال بالله للوصول إلى العقلانية المؤيدة بأحكام الشريعة، والتي تمكن الإنسان من تجاوز العقلانية المجردة[34].
ويبرز كذلك أهمية التجربة الصوفية كطريقة للتخلص من زيف الحضارة الحديثة، ويعتبر أن الربط بين الأخلاق والدين هو السبيل لهدم أصول الحداثة[35].
خلاصة القول، إن الأزمة التي يعيشها الإنسان المعاصر تعود إلى ابتعاده عن القيم الروحية والدينية، وارتباطه بالقيم العقلية المادية. سعى الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن إلى تجديد العقل الغربي من خلال ربطه بالقيم الروحية الإسلامية، محاولًا إثبات أن النهضة الحقيقية لا يمكن تحقيقها إلا في إطار التشريع الإسلامي. التصوف كفلسفة تربوية عملية: التصوف كفلسفة تربوية عالج مشكلات إنسان الحداثة وقد يتمكن من معالجة التحديات التي يواجهها إنسان ما بعد الحداثة. الباحث الفرنسي المسلم إريك جفروا Éric Geoffroy(1956م- )، في كتابه الإسلام سيكون روحياً أو لن يكون، قدّم التصوف كمشروع كامل لإحياء علوم الإسلام وتجديد التدين من خلال الاجتهاد الروحي بدلاً من الاجتهاد الفقهي المحدود. ويرى أن التصوف يمثل نموذجًا ملائمًا لحقبة ما بعد الحداثة، حيث يعزز القيم الروحية التي تدعم حقوق الإنسان وحرية المرأة وتفتح الإسلام على العالم[36].
يؤكد جفروا أن التصوف يقدم تصورًا عقلانيًا أكثر دقة من العقلانية الفلسفية، ولكن تم تجاهل هذه الإمكانات بسبب اختزال التصوف في الجانب الجمالي أو التجربة الروحية الفردية بدلاً من رؤيته كمنظومة فلسفية كاملة[37].
2.3. التصوف في عصر العولمة وما بعد العولمة:
يعتبر التصوف مساهمة حضارية عميقة قدمها حكماء التصوف العرفانيون الأوائل على مر العصور، حيث يعزز فهماً أعمق لدور الإنسان في تحقيق التوازن بين المادة والروح. في عصر العولمة، حيث طغت المادة على الروح، يقدم التصوف بديلاً يتمحور حول الحياة بكل جوانبها، في مقابل العولمة التي تركز على القوانين التي يضعها الإنسان لتفسير الحياة، وذلك بالتوجه إلى ما وراء الحواس وتجاوز المعرفة المادية المحدودة التي سادت في عصر العولمة ومابعدها[38].
4. إسهام التصوف بين النقد والتأييد:
1.4. التصوف بين التيار المعارض والتيار المؤيد:
1.1.4. التيار المعارض للتصوف:
لم يكن التصوف دائمًا محل قبول في المجتمع الإسلامي، حيث وجد تيار من الفقهاء والمفكرين الذين عارضوا بعض مظاهر التصوف وانتقدوه بشدة. من بين هؤلاء ابن تيمية (1263-1328م) ومحمد البشير الإبراهيمي (1889-1965م). فابن تيمية كان من المعارضين لفكرة (خاتم الأولياء) التي تبناها بعض شيوخ التصوف، حيث رأى أن هذا المفهوم موهوم ويعتمد على ادعاءات لا أساس لها. وقد انتقد الطوائف التي تبنت هذه الفكرة واعتبرها مبتدعة[39].
وفي السياق ذاته محمد البشير الإبراهيمي انتقد التصوف بشدة، معتبرًا أن الطرق الصوفية كانت سببًا في تفشي الابتداع في الدين، وضلال العقيدة، وانتشار الجهل بين المسلمين. ورأى أن الطرق الصوفية ساهمت في إفساد المجتمع الجزائري وشكلت عائقًا أمام أي إصلاح في الحياة العامة[40].
لكن رغم انتقاداته اللاذعة، يجب التأكيد على أن المقصود في كلامه هو الطرق المبتدعة التي انحرفت عن التصوف الإسلامي الأصيل. انتقادات أخرى للتصوف: بعض المعارضين للتصوف يرون أن فكر أقطاب التصوف كابن عربي والحلاج (858-922م) وغيرهم يحتوي على جوانب مخالفة لما جاء به النبي وصحابته، ويعتقدون أن منهج الاستدلال عند المتصوفة يختلف عن منهج أهل السنة والجماعة. كما ينتقد هؤلاء اعتماد الصوفية على العلم اللدني والمنامات والكشوفات، معتبرين أن هذه الممارسات تبتعد عن الإسلام الصحيح وتفتح الباب أمام الخرافات والشركيات[41].
كما استدل المعارضون بقصة الخضر ونبي الله موسى في القرآن الكريم لتوضيح مفهوم العلم اللدني، لكنهم شككوا في صحة ادعاءات الصوفية بامتلاكهم لهذا العلم.
وخلاصةالقول أن التصوف كان دائمًا موضوعًا للجدل بين مؤيديه ومعارضيه. التيار الرافض للتصوف ينظر إليه على أنه مصدر للخرافات والبدع، بينما التيار المدافع يعتبره جوهرًا روحيًا يعزز التوازن بين الروح والمادة، ويقدم حلولًا لأزمات العصر الحديث، بما في ذلك تلك التي ظهرت مع العولمة وما بعدها.
2.1.4. التيار المؤيد للتصوف:
يرى أن التصوف، كغيره من الجماعات البشرية في المجتمع الإسلامي، تأثر بحالة الجمود التي أصابت الثقافة الإسلامية بشكل عام. ومع ذلك، كانت بعض الطرق الصوفية قادرة على تجديد نفسها، مثل الطريقة الشاذلية، النقشبندية، الخلواتية، والطريقة التيجانية التي أسسها الشيخ أحمد التيجاني(1737-1815م) عام 1815م. على الرغم من أن بعض الجماعات الصوفية عانت من التصلب خلال القرن التاسع عشر مع موجة الحداثة الأوروبية التي حملت معها قيم العلمنة والدنيوية، فإن هناك طرق صوفية أخرى استطاعت التكيف والإصلاح[42]، ومن الأدلة على أهمية التصوف والزوايا:
- يُعتبر أن الزاوية ليست مجرد مؤسسة دينية بل مدرسة حياة متكاملة. فهي أماكن مخصصة للتعليم الديني والتربية الروحانية، والعلاج من الأمراض، ودمج المنبوذين في المجتمع، بالإضافة إلى نشر إسلام السلام والانفتاح على الآخر، وثقافة الترحاب والضيافة والوساطة الاجتماعية[43]. هذه الوظائف الإيجابية لا يمكن إنكارها، ومن عارضها دفع الثمن، مثل الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين (1932-1978م) الذي اضطهد المتصوفة في السبعينيات وأغلق الزوايا. ومع ذلك، سُرعان ما أدرك الجزائريون الآثار السلبية لهذا القرار، حيث ساهم في تدهور الأوضاع وظهور الإرهاب الأصولي الذي اجتاح البلاد في التسعينيات، نتيجة ضعف الحركة الصوفية وتقوية الحركات الأصولية المتشدد[44].
زيدان ميربوط يشير إلى أن البلدان التي حاربت التصوف، مثل الجزائر، تركيا، مصر، وتونس، قد دفعت ثمناً باهظاً لهذا القرار، إذ ساعدت بشكل مباشر أو غير مباشر على تعزيز الحركات الأصولية الراديكالية. في المقابل، البلدان التي لم تحارب التصوف ودمجته في المجتمع المدني، مثل بلدان غرب أفريقيا، تنزانيا، والمغرب، كانت أقل تضررًا حتى الآن.
- كما كانت الزوايا مراكز للجهاد والمقاومة:فمن المعروف أن بداية المقاومة ضد الاستعمار وُلدت في الزوايا والطرق الصوفية، مثل الطريقة القادرية التي ارتبط بها الأمير عبد القادر(1808-1883م)، وكذلك الشيخ محمد المقراني (1815-1871م) والشيخ محمد أمزيان بن علي الحداد (1789-1873م) من الطريقة الرحمانية. ورغم أن الطرق الصوفية لم تدخل في مواجهة مباشرة مع الاستعمار، إلا أن معظمها كان ضد الوجود الفرنسي في الجزائر[45].
- زاوية الشيخ كمستشفى للأمراض الروحية:تُعتبر زاوية الشيخ بمثابة مستشفى للأمراض الروحية، حيث تُعنى بتطهير القلوب والنفوس. يرى عبد الباري (1963م- ) إن حضرة الشيخ تتميز بالتربية والتهذيب، مع التركيز على الجوانب الظاهرة والباطنة. فالشيخ يتمتع بقدرة فائقة على تهذيب النفس وإصلاحها من خلال منهج علمي راسخ، مما يجعل الطريق واضحاً أمام السالكين دون تعقيد أو خطر. كما أن الصوفية أخذت على عاتقها محاربة أعداء الإسلام من الظلمة والمستعمرين.
وكانت لها دور بارز في نشر الإسلام في مناطق نائية، إذ يُذكر أنها كانت القوة التي أدخلت الإسلام إلى أعماق أفريقيا بفضل جهودها[46].
5. خاتمـة:
من خلال ما سبق، نستنتج أن التصوف لم يكن عزلاً عن الحياة كما يُظن، بل كان مصدر قوة للبناء الحضاري. فالتصوف يعزز مقاومة الانهزامية والتواكل، ويشجع على الجهاد ضد الشيطان والرقي بالقيم الإنسانية في سبيل البحث عن الحق سبحانه وتعالى. يرى المتصوفة أن بناء الحضارة يبدأ من بناء الجانب الأخلاقي في الإنسان، حيث يسهم المتصوف في إصلاح البشرية بنشر صفاء الأخلاق وتنوير دروب الحياة. فهو لا يقيم الوجود الإنساني بناءً على المعطيات المادية فقط، بل يعتمد على المعرفة الروحية التي تأتي من الذوق والكشف، مما يجعله متحرراً من قيود العالم المادي نحو عالم الحقيقة واليقين الأزلي. إن دعوة المتصوفة إلى بناء الحضارة تستند إلى العلم والمعرفة، بالإضافة إلى الأخلاق. ويتفرد منهج التصوف في تحصيل المعرفة بتحريرها من قيود الجسد والماديات، والاعتماد على الحدس الروحي المطلق. لم يخرج المتصوف عن مقاصد الوجود الثلاثة: الخلافة، والتعمير، والعبادة، بعيداً عن الإفساد وحب التملك والسيطرة. فالوجود الحقيقي للحق، وبناء الحضارة يرتكز على المعرفة المستمدة من التصوف أخلاقاً وسلوكاً. إلى جانب العلم والأخلاق، يُعد الفن والأدب من العناصر الأساسية لبناء الحضارة، حيث يتميز المتصوف بذوق رفيع ينعكس في التفوق في مختلف الفنون.
الصوفي المعتدل يسعى إلى تحقيق توازن بين المتطلبات المادية والروحية، مع إعطاء الريادة للروح الإنسانية التي تقترن بالعقل الحكيم في مواجهة الرغبات النفسية وضبطها. هذا التوجه يمثل قمة السلم الإنساني نحو الكمال. فالفلسفة الصوفية تعتبر رؤية مستقبلية تهدف إلى تشكيل النموذج الأمثل للإنسان الكامل، مستندة إلى أرضية معرفية شاملة توازن بين الجوانب المعنوية والروحية والمادية للإنسان. من هنا، بدأت العلوم الإنسانية المتنوعة مثل علم النفس، الاجتماع، السياسة، الإدارة، وحتى الفيزياء الكونية تستفيد من التراث المعرفي الصوفي. هذا النهج يبلور مفهوم الإنسان العالمي الطامح إلى تحقيق توازن روحي ومادي، مقارنةً بمفهوم الإنسان العولمي الذي يركز على الجوانب المادية فقط. لذا، يُطلب تعاون بين الغرب التقني والشرق الروحي لتحقيق بناء الإنسان الكامل كما يُصوره التصوف. من هذا المنطلق، يتجاوز التصوف القيود القومية والعرقية والدينية، ليُركز على الإنسان كفرد له خصوصية إنسانية خاصة. فالإنسان هو المخلوق الذي يمكنه تمثيل الصورة الإلهية، لأنه خليفة الله على الأرض. وفقاً لهذا الفهم، ليس هناك تفضيل لشعب على آخر، أو لشخص على شخص، إلا بالتقوى، والتي تعني تجاوز السلبيات والتغلب عليها. إذن، التصوف من خلال مصادره الميتافيزيقية ورؤيته العرفانية يقدم لنا رؤية متكاملة عن الإنسان وحقيقته وعلاقته بالآخرين. هذه الرؤية تتجاوز عنف الحداثة المعولمة التي انبثقت من نظرة مادية ضيقة للإنسان، وتقدم بديلًا يقوم على لا عنف ما بعد الحداثة، والتي تنبثق من نظرة شمولية وغير محدودة للإنسان. في هذه الرؤية، يتكامل الجانب المادي مع الروحي، لتقدم هذه الفلسفة رؤية لعصر ما بعد الحداثة. بينما تميزت الحداثة بالعقلانية المفرطة، فإن التصوف يعترف بأن للعقل حدودًا، وأن الحقيقة لا حدود لها. ولهذا، يقترح التصوف أدوات معرفية تتجاوز العقل، تمكن الإنسان من الوصول إلى الحقيقة والعيش بها بكليته.
البحث في حقيقة الإنسان الجوهرية وحقيقة الحياة يتجاوز الانتماءات الأرضية الضيقة ليصل إلى الانتماء للحقيقة الوجودية الكونية المفتوحة، وهي حقيقة لا تعرف الخوف من أي تهديد خارجي لاندثار الذات أو الهوية، لأن كل الأجزاء متصلة بالكل في العمق. لا توجد حواجز ظاهرية مثل العرق، الطائفة، أو الدين تفصل الناس عن بعضهم البعض، إلا عندما يسعى البعض للهيمنة أو استغلال الآخرين، مما يؤدي إلى انفصالهم عن حقيقتهم الإنسانية وتشويهها من خلال الأنانية وتضخيم الذات الطامعة.من هذا المنطلق، يصبح الحديث عن التربية الصوفية وأثرها في العصر الراهن أمرًا ملحًا. الحاجة إلى هذه التربية ضرورة لأنها تُمكن الإنسان من السير في طريق الهداية، وتدفعه نحو السمو الأخلاقي، والرقي إلى مراتب السالكين. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف يمكننا تحقيق هذا الهدف؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قائمة المراجع:
- القرآن الكريم، برواية حفص عن عاصم.
- بالعربية:
- إبراهيم مدكور، المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية، دط، مصر، 1983.
- أحمد خليل خليل، معجم المصطلحات الفلسفية، دار الفكر اللبناني، دط، بيروت، 1995.
- إريك يونس جفروا، المستقبل الروحاني للإسلام، ترجمة هشام صالح، ومراجعة أسامة نبيل، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 1916.
- تقي الدين محمد ابن تيمية، الإيمان، تخريج الألباني، الجزء1، المكتب الإسلامي، ط11، عمان، 1996.
- جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج1، دار الكتاب اللبناني، دط، بيروت، 1982.
- أبو حامد الغزالي ،التبر المسبوك في نصيحة الملوك، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، 1988.
- حميدة عميراوي، بحوث تاريخية، دار البعث، دط، قسنطينة، 2001.
- خالد عبد الوهاب، حوار مع الباحث الأكاديمي الدكتور خميستي، في ضرورة تجديد العلوم الدينية والتواصل مع ثقافة العصر، عن الموقع الإلكتروني: https://www.mominoun.com/articles/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8، 2/6/2022.
- سعد خميستي، أبحاث في الفلسفة الإسلامية، دار الهدى، دط، الجزائر، 2002.
- سعيد عبد العظيم، ومحمد جميل غازي، الصوفية الوجه الآخر، دار الإيمان للطبع والنشر والتوزيع، دط، الإسكندرية، دس.
- سمير أمين، تحديات العولمة، مجلة شؤون الأوسط، عدد 71، نيسان 1998.
- السيد ولد أباه، الاجتهاد الروحي وما بعد الحداثة، عن الموقع الإلكتروني:https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/55015، 4/3/2022.
- الشيخ مولاي التهامي، الإشراق الكبير في ذكر جملة من فضائل ومآثر ومواقف وكرامات الشيخ سيدي محمد بن الكبير رحمه الله ورضى الله عنه، المؤسسة الوطنية للاتصال النشر والإشهار، طبع وحدة رويبة، الجزائر، 2002.
- الصديق حاج أحمد آل المغيلي، من أعلام التراث الكنتي المخطوط الشيخ محمد بادي الكنتي حياته وآثاره، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، 2007.
- طه جابر العلواني، الخصوصية والعالمي في الفكر الإسلامي، دار الهادي، دط، بيروت، 1424.
- عبد الحميد عرفان، نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، دار الجيل، ط1، بيروت، 1993.
- عبد الرحمان الوكيل، هذه هي الصوفية، دار الكتب العلمية، ط3، بيروت، 1979.
- عبد الرحمن طه، روح الحداثة، المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية، المركز الثقافي العربي، ط2، الدر البيضاء، المغرب.
- عبد الرزاق قسوم، إشكالية الحضارة في فكر مالك بن نبي، مجلة الموافقات، المعهد العالي لأصول الدين، الخروبة، (الجزائر)، العدد الثالث، جوان 1994.
- عبد السلام بوزبرة، طه عبد الرحمن ونقد الحداثة، جداول للنشر والتوزيع، ط1، لبنان، 2011.
- عبد اللطيف كمال، النقد الصوفي للحداثة، قراءة في كتاب سؤال الأخلاق لطه عبد الرحمن، مجلة العلوم الإنسانية، 2007.
- عبود شلتاع، الثقافة الإسلامية من التغريب والتأصيل، دار الهادي، دط، بيروت، 1422.
- عزمي بشارة، إسرائيل والعولمة، مجلة فكر ونقد، عدد7، أذار 1998.
- لالاند أندريه، موسوعة لالاند الفلسفية، منشورات أحمد عويدات، ط2، بيروت، باريس، 2001.
- ماسينيون عبد الرزاق مصطفى،التصوف، مكتبة المدرسة طباعة، نشر، توزيع، بيروت، 1984.
- محمد البشير الإبراهيمي، الطرق الصوفية، مكتبة الغرباء الأثرية، ط1، الجزائر، 2008.
- محمد زكي إبراهيم، أبجدية التصوف الإسلامي بعض ما له وما عليه، مؤسسة إحياء التراث الصوفي، ط5، القاهرة، دس.
- محمود يعقوبي، معجم الفلسفة وأهم المصطلحات وأشهر الأعلام، دار الميزان، ط2، الجزائر، 1998.
- محمود يعقوبي، معجم الفلسفة، أهم المصطلحات وأشهر الأعلام، دار الميزان، ط2، الجزائر، 1998.
- ابن منظور ، لسان العرب، دار المعارف، ط1، القاهرة، 1981.
- مؤلف مجهول، التصوف الإسلامي ودوره في بناء إنسان المستقبل، محاضرة ألقيت في مهرجان غوتنبرغ للثقافة السويد، 2004، عن الموقع الإلكتروني:https://shabaalkhatmia.yoo7.com/t982-topic#2021،6/2/2022.
- بالأجنبية:
- Gérard, Durozoi; André, Roussel, Dictionnaire de philosophie, Imprime en France I.M.E, Nathan, 2003.
- Hubert, Vedrine, Mondialisation et pensée unique. In "la méditerranée a l'heure de la mondialisation", cahiers de la fonation abderrahim bouabid, N27, 1997.
-[2]الحسني ابن عجيبة، مصطلحات التصوف، مكتبة مدبولي، القاهرة، دط، 1999، ص3. ينظر أيضًا الفاخور ي حنا وخليل الجر، تاريخ الفلسفة العربية، دار الجيل، دط، بيروت، 1993، ص 283.
[3]-Gérard, Durozoi; André, Roussel, Dictionnaire de philosophie, Imprime en France I.M.E, Nathan, 2003, p267.
[4]- أحمد خليل خليل، معجم المصطلحات الفلسفية، دط، دار الفكر اللبناني، بيروت، 1995، ص103.
[5]- محمود يعقوبي، معجم الفلسفة، أهم المصطلحات وأشهر الأعلام، ط2، دار الميزان، الجزائر، 1998، ص88.
[7]- حميدة عميراوي، بحوث تاريخية، دار البعث، دط، قسنطينة، 2001، ص60.
-[8]ابن منظور، لسان العرب، ط1، دار المعارف، القاهرة، 1981، ص907. ينظر أيضًأ: جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج1، دط، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1982، ص475.
[10]- طه جابر العلواني، الخصوصية والعالمي في الفكر الإسلامي، دار الهادي، دط، بيروت، 1424، ص14.
[11]- لالاند أندريه، موسوعة لالاند الفلسفية، ط2، منشورات أحمد عويدات، بيروت، باريس، 2001، ص14.
[13]- عبد الرزاق قسوم، "إشكالية الحضارة في فكر مالك بن نبي"، مجلة الموافقات، المعهد العالي لأصول الدين، الخروبة، (الجزائر)، العدد الثالث، جوان 1994، ص292.
[14] -Hubert, Vedrine, Mondialisation et pensée unique. In " la méditerranée a l'heure de la mondialisation", cahiers de la fonation abderrahim bouabid, N27, 1997.
[15]- يراجع: سمير أمين، "تحديات العولمة"، مجلة شؤون الأوسط، عدد 71، نيسان 1998.
[16]- يراجع:عزمي بشارة، "إسرائيل والعولمة"، مجلة فكر ونقد، عدد7، أذار 1998.
[17]- أحمد خليل خليل، مرجع سبق ذكره، ص ص62-63.
[18]- محمود يعقوبي، مرجع سبق ذكره، ص88.
[19]- عبد العزيز الشهبي، الزوايا والصوفية والعزابة والاحتلال الفرنسي في الجزائر، دار الغرب للنشر والتوزيع، دط، وهران، 2007، ص47.
-[20] الصديق حاج أحمد آل المغيلي، من أعلام التراث الكنتي المخطوط الشيخ محمد بادي الكنتي حياته وآثاره، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، 2007، ص ص26،27
[21]- أبو حامد الغزالي، التبر المسبوك في نصيحة الملوك، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، 1988، ص14.
[22]- نفسه، ص14.
[23]- عبد العزيز الشهبي، مرجع سبق ذكره، ص
[24]- الشيخ مولاي التهامي، الإشراق الكبير في ذكر جملة من فضائل ومآثر ومواقف وكرامات الشيخ سيدي محمد بن الكبير رحمه الله ورضى الله عنه، المؤسسة الوطنية للاتصال النشر والإشهار، طبع وحدة رويبة، الجزائر، 2002، ص32.
[25]- القرآن الكريم،سورة الشمس، الآية (7-10).
[26]- يراجع: تقي الدين محمد ابن تيمية، الإيمان، تخريج الألباني، الجزء1، المكتب الإسلامي، ط11، عمان، 1996.
[27]- محمد زكي إبراهيم، أبجدية التصوف الإسلامي بعض ما له وما عليه، مؤسسة إحياء التراث الصوفي، ط5، القاهرة، دس، ص14.
[28]- القرآن الكريم، سورة آل عمران، الآية 79.
[29]- ماسينيون عبد الرزاق مصطفى، التصوف، مكتبة المدرسة طباعة، نشر، توزيع، بيروت، 1984، ص66.
[30]- الصديق حاج أحمد آل المغيلي، مرجع سبق ذكره، ص ص 26،27.
[31]- عبد السلام بوزبرة، طه عبد الرحمن ونقد الحداثة، جداول للنشر والتوزيع، ط1، لبنان، 2011، ص188.
[32]- عبد الرحمن طه، روح الحداثة، المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية، المركز الثقافي العربي، ط2، الدر البيضاء، المغرب، ص100.
[33]- خالد عبد الوهاب، حوار مع الباحث الأكاديمي الدكتور خميستي، في ضرورة تجديد العلوم الدينية والتواصل مع ثقافة العصر، عن الموقع الإلكتروني:
[34]- عبد اللطيف كمال،النقد الصوفي للحداثة، قراءة في كتاب سؤال الأخلاق لطه عبد الرحمن، مجلة العلوم الإنسانية، 2007، الصفحات (348-339).
[35]- عبد اللطيف كمال، مرجع سبق ذكره، ص(348-339).
[36]- عبد الحميد عرفان،نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، دار الجيل، ط1، بيروت، 1993، ص160.
[37]- السيد ولد أباه، الاجتهاد الروحي وما بعد الحداثة، عن الموقع الإلكتروني:
https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/55015، 4/3/2022.
[38]- مؤلف مجهول، التصوف الإسلامي ودوره في بناء إنسان المستقبل، محاضرة ألقيت في مهرجان غوتنبرغ للثقافة السويد، 2004، عن الموقع الإلكتروني:
[39]- عبد الرحمان الوكيل، هذه هي الصوفية، دار الكتب العلمية، ط3، بيروت، 1979، ص130.
[40]- محمد البشير الإبراهيمي، الطرق الصوفية، مكتبة الغرباء الأثرية، ط1، الجزائر، 2008، ص51.
[41]- سعيد عبد العظيم، ومحمد جميل غازي، الصوفية الوجه الآخر، دار الإيمان للطبع والنشر والتوزيع، دط، الإسكندرية، دس، ص8.
[42]- إريك يونس جفروا، المستقبل الروحاني للإسلام، ترجمة هشام صالح ومراجعة أسامة نبيل، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 1916، ص223.
[43]- نفسه، ص224.
[44]- نفسه، ص ص 224، و225.
[45]- إريك يونس جفروا ، مرجع سبق ذكره، ص ص 224، و225.
[46]- سعيد عبد العظيم، ومحمد جميل غازي، مرجع سبق ذكره،ص 163.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة:
- قدمت هاته الورقة البحثية ضمن أعمال المؤتمر الأول الموسوم ب: زوايا العلم والتصوف وأثرها في إصلاح الفرد والتنمية المجتمعية (الزاوية الرقانية وامتداداتها في أفريقيا أنموذجًا). المنعقد بتاريخ: 29و30 أفريل 2025.
- المؤتمر من تنظيم: المدرسة القرآنية الداخلية الشيخ سيدي مولاي عبد الله الرقاني -رحمه الله- للتعليم القرآني وعلوم الدين بزاوية الرقاني/ بالتنسيق مع: جامعة برج بوعريريج وجامعة الجزائر1 وجامعة الجزائر 2 وجامعة بشار وجامعة غرداية...

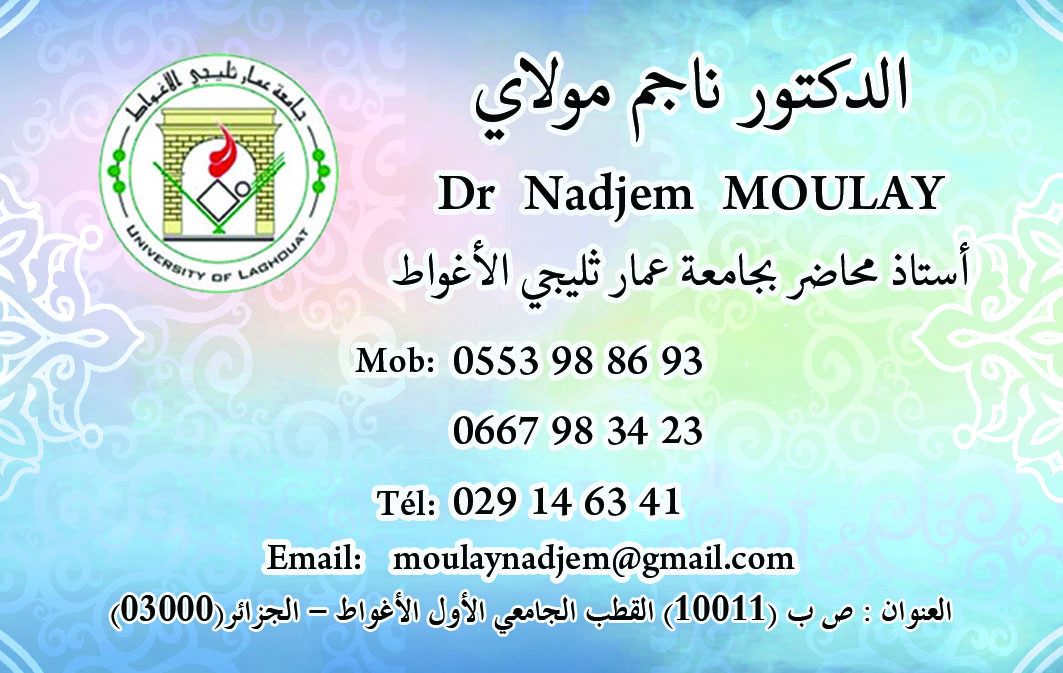
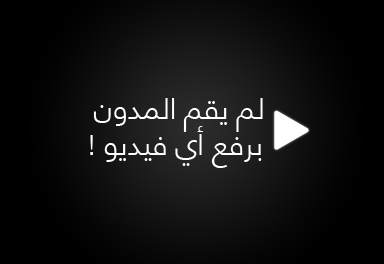

التعليقات (0)