فهمي هويدي : الدولة الديمقراطية اولا

الدولة الديمقراطية قبل المدنية أو الدينية
فهمي هويدي
أرأيت كيف استدرج الناس في مصر إلى الجدل حول المفاضلة بين الدولة المدنية والدولة الدينية، في حين أننا لم نخط خطوة تذكر باتجاه تأسيس الدولة الديمقراطية.
(1)
هي “موضة” الموسم إن شئت الدقة، أن يتنافس نفر من المثقفين على مديح الدولة المدنية وهجاء الدولة الدينية وأن تروج وسائل الإعلام لذلك الجدل، الأمر الذي دفع كثيرين إلى الركض وراءهم ومحاولة الترجيح بين الكفتين، لذلك لم يكن غريبا أن تتعدد الندوات، التي تعقد لهذا الغرض، وكنت واحدا من “ضحايا” هذه الموضة، حيث لم يتسع وقتي هذا الشهر لأكثر من المشاركة في ندوتين، إحداهما في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والثانية بكلية الطب في جامعة عين شمس.
وما كان للناس أن ينشغلوا بهذا الموضوع لولا كثافة الضخ الإعلامي، الذي تناول الموضوع، ونقل البلبلة والحيرة إلى قطاعات عريضة في المجتمع. ذلك أنه في غيبة رؤية واضحة لترتيب أولويات المرحلة، فإن المثقفين المهيمنين على منابر الإعلام باتوا يفرضون اهتمامهم وحساباتهم على الرأي العام، بل أصبحت ضغوطهم تؤثر أيضا في القرارات التي تتخذ، بحيث بدا بعضها مستجيبا للضجيج والضغوط الإعلامية أكثر من استجابته للمصالح الوطنية العليا.
الموضوع ليس جديدا، رغم أن المصطلح مستحدث في الخطاب العربي. فالثقافة العربية عرفت الأنشطة الأهلية والجمعيات الخيرية، وكان نظام “الوقف” هو الصيغة التاريخية التي ابتكرها المسلمون للتقرب إلى الله من خلال المشاركة في بناء مجتمعاتهم وإعمار الأرض، وقد اقتبسها الغربيون ونقلوها عن الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر.
ورغم أن فكرة المجتمع المدني ظهرت في أوروبا في القرن الثامن عشر، وكانت موضوعا للمناقشة بين الفلاسفة والمفكرين، فإن المصطلح تم تداوله في مصر والعالم العربي منذ ثلاثة عقود تقريبا، برز خلالها الحديث عن منظمات المجتمع المدني، التي كانت قد نمت وتعاظم دورها في المجتمعات الغربية، وهو أمر لا يخلو من مفارقة، لأن الغربيين نقلوا عنا فكرة الوقف في القرن الثامن عشر، ثم استوردنا نحن منهم مصطلح المجتمع المدني في القرن العشرين.
في الثمانينيات حين برز مصطلح المجتمع المدني في وسائل الإعلام. أثار ذلك انتباه الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، فاستفسر عنه قائلا: إنه يعرف المجتمع المكي والمجتمع المدني الذي يميز أهل مكة والمدينة في الحجاز. ويعرف أيضا المجتمع المدني، الذي يعد نقيضا لذلك الذي يحكمه العسكر. كما يعرف المجتمع المدني المشتق من المدينة بمعنى الحضر، وهو متميز عن المجتمع القروي أو الريفي، ثم سألني: هل المجتمع المدني الذي يتحدثون عنه يندرج تحت أي من التصنيفات؟
(2)
ليس الشيخ الغزالي وحده الذي التبس عليه الأمر. لأنني من خلال الندوات التي حضرتها متحدثا أو مستمعا أدركت أن المصطلحين (الدولة الدينية والمدنية) بحاجة إلى تحرير، وإن الالتباس واقع فيهما إلى حد كبير، وهو ما دفعني إلى الرجوع إلى ما أمكن الوصول إليه من مراجع ودراسات حول الموضوع. كما أنني قمت في الوقت ذاته بتجميع القصاصات والمقالات التي تناولته في الصحف على الأقل.
الكلام في تعريف الدولة الدينية كان التوافق حوله أكبر. ذلك أنه لم يخالف أحد في أنها الدولة التي يدّعي القائمون عليها أن بقاءهم اختيار من الله وأنهم يمثلون إرادته سبحانه وتعالى، وبالتالي فإنهم لا ينطقون عن الهوى، ولكنهم مفوضون عن الله، لذلك فإن كلامهم لا يرد، وعصيانه لا يعد خروجا عن الطاعة فحسب، ولكنه يعد خروجا من الملة وتحديا لإرادة الله، النموذج الذي يضرب به المثل في هذا الصدد هو ممارسات الكنيسة التي سنعرض لبعضها بعد قليل.
في الدولة المدنية الوضع مختلف، فالقائمون عليها يختارهم الناس. ومصير البلد لا يقرره فرد. لأن كل الناس فيه سواء، يتمتعون بحق المواطنة الذي يقرر لهم المساواة في الحقوق والواجبات. والبلد تديره وتقرر مصيره المؤسسات التي ينتخبها المجتمع. أما رأس الدولة فكلامه يؤخذ منه ويرد، وهو قابل للمراجعة والمساءلة.
ومن الفلاسفة من يتحدث عن بعد أخلاقي للدولة المدنية، إذ يرون أنها لا تقوم فقط بقيام المؤسسات وتحقيق المساواة بين المواطنين، بل تقوم أيضا بتحقيق الرقي في السلوك الاجتماعي، الذي بمقتضاه تسود قيم وأخلاق المدن التي يفترض أنها الأكثر تهذيبا. وفي الوقت ذاته فإن الدولة المدنية لا تأبه بالمرجعيات ولا تتدخل في عقائد الناس وأفكارهم. إذ لا تهم مرجعيتك التي تنطلق منها، ولكن الأهم هو أداؤك واحترامك للنظام العام والقانون. وهي ليست نقيضا للدين ولا تستبعده، بل تحتوي المؤسسات الدينية وغير الدينية، وتفتح ذراعيها لإسهام الجميع في تحقيق المقاصد العليا للمجتمع.
(3)
هل عرفت الخبرة العربية والإسلامية الدولة الدينية بالمعنى المتقدم، وهل يمكن أن يكون لها وجود في زماننا؟ ــ ردي على هذا السؤال أنه منذ انقطاع الوحي عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يجرؤ أحد من حكام المسلمين على ادعاء أنه مفوض من الله. وقد اعتبر الإمام محمد عبده فيما نشر له أوائل القرن الماضي أن قلب السلطة الدينية والإتيان عليها من أساسها بمثابة أصل من أصول الإسلام. وقال إن الإسلام: هدم بناء تلك السلطة ومحا أثرها، حتى لم يبق لها عند الجمهور من أهله اسم ولا رسم. وإنه: ليس لمسلم مهما علا كعبه في الإسلام، ومهما انحطت منزلته فيه إلا حق النصيحة والإرشاد. مضيفا أن الخليفة عند المسلمين ليس بالمعصوم ولا هو مهبط الوحي. إذ الأمة هي التي تنصبه، وهي صاحبة الحق في السيطرة عليه، وهي التي تخلعه متى رأت ذلك من مصلحتها، فهو حاكم مدني من جميع الوجوه.
وأضاف الأستاذ الإمام في رده على فرح أنطون صاحب مطبوعة “الجامعة” أنه: لا يجوز لصحيح النظر أن يخلط الخليفة عند المسلمين بما يسميه الإفرنج (ثيوكراتيك) أي سلطان إلهي. فإن ذلك عندهم هو الذي ينفرد بتلقي الشريعة عن الله، وله في رقاب الناس حق الطاعة.. وهكذا كانت سلطة الكنيسة في العصور الوسطى، ولا تزال تدعي الحق في هذه السلطة. وكان من أعمال التمدن الحديث الفصل بين السلطة الدينية والسلطة المدنية.
وهو يدلل على نفوذ السلطة الدينية في التجربة الغربية، بمنشور أصدره البابا في سنة 1864 لعن فيه كل من يقول بجواز خضوع الكنيسة لسلطة مدنية أو جواز أن يفسر أحد شيئا من الكتب المقدسة على خلاف ما ترى الكنيسة أو يعتقد أن الشخص حر فيما يعتقد. وفي منشور له سنة 1868 قال إن المؤمنين يجب أن يفدوا نفوذ الكنيسة بأرواحهم وأموالهم، وعليهم أن ينزلوا لها عن آرائهم وأفكارهم.
وبعد ذلك بثلاث سنوات (في سنة 1871) وقع نزاع بين حكومة بروسيا والبابا بشأن أستاذ بإحدى الكليات رأى رأيا لا يروق للحزب الكاثوليكي، فحرمه البابا وطلب من الحكومة عزله، إلا أن حكومة بسمارك نصرت مدنية القرن التاسع عشر على سلطان الكنيسة، وأبقت على الأستاذ، وجعلت التعليم تحت السلطة المدنية (د. محمد عمارة ــ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ــ جـ3).
الخلاصة أن الدولة الدينية تجربة غربية بالأساس قدمت الكنيسة نموذجا لها في العصور الوسطى. وليس لها مثيل في خبرة المجتمعات الإسلامية، وليس صحيحا ما يدعيه البعض من أن النظام الذي قام في إيران بعد ثورة 1979 الإسلامية يعد نموذجا للدولة الدينية بمفهومها التقليدي، ذلك أنها رغم التزامها النسبي بالتعاليم الإسلامية، فإن النظام هناك ليست له قداسة من أي نوع.
فرأس الدولة (المرشد أو القائد) لم يدع أنه يحكم باسم الله أو مفوض منه، ومعارضوه لم يطعن أحد في دينهم، ولم يكفرهم أحد. حتى “مجاهدي خلق” الذين أشهروا السلاح في وجه النظام ولا يزالون يدعون إلى إسقاطه بالقوة فإنهم اتهموا فقط بأنهم “منافقون”، ولم يخرجهم أحد من الملة. وللعلم فإن صلاحيات المرشد هناك فيما يوصف بأنه دولة دينية كانت أقل من صلاحيات الرئيس السابق مبارك (في دستور عام 1971). ذلك أن الأول لا يملك حق حل البرلمان المنتخب من الشعب، في حين أن مبارك كان مخولا ذلك.
(4)
عندي أكثر من ملاحظة على الإلحاح على المقابلة بين الدولتين الدينية والمدنية وهي:
أن استدعاء فكرة الدولة الدينية التي اندثرت في الغرب ولم يكن لها وجود في الخبرة الإسلامية يستدعي أكثر من سؤال، أحد تلك الأسئلة ينصب على الدافع إلى ذلك، والثاني يتعلق بإمكانية تحقيقه على أرض الواقع. ذلك أنه في زماننا يتعذر على أي سلطة أو شخص أن يدعي أنه مفوض من الله أو يتحرك باسمه. وفي أسوأ المفروض وأبعده فإنه لو فعل ذلك فلن يجد من يصدقه أو يمشي وراءه.
أن الذين فاضلوا بين الصيغتين لترجيح كفة الدولة المدنية لم ينشغلوا بمسألة الديمقراطية، التي يمكن أن تغيب في الحالتين. وهو ما يعطي انطباعا قويا بأن إصرارهم على طمس أي هوية دينية -إسلامية تحديدا- بدا أقوى من حرصهم على تأسيس الدولة الديمقراطية، وللعلم فإن كل المستبدين في العالم العربي يباشرون سلطانهم ويرتكبون جرائمهم في ظل دول مدنية وبعضها موغل في مدنيته.
أن استحالة إقامة الدولة الدينية مع استمرار هجائها والتنفير منها، وكيل المدائح للدولة المدنية، لا يمكن تفسيره إلا بأن المراد به التنفير والتخويف مما هو منسوب إلى الدين، خصوصا في ظل الصعود الإعلامي للتيارات الإسلامية في المجتمع المصري بعد ثورة 25 يناير. وإذا صح ذلك فإن الجدل الراهن حول الدولتين يصبح في حقيقته جزءا من التعبئة التي تمهد للحملة الانتخابية المقبلة، في شهر سبتمبر/أيلول.
أن أعلى الأصوات في هجاء ما هو ديني وترجيح ما هو مدني لأشخاص لهم سجل مشهود في الدفاع عن العلمانية والدعوة إلى تهميش دور الدين. الأمر الذي يدل على أنه بعدما أصبح مصطلح العلمانية سيئ السمعة ومرفوضا من جانب المجتمع، فإن المبشرين به أصبحوا لا يجرؤون على الكشف عن هويتهم الحقيقية، وقرروا جميعا أن يختبئوا وراء قناع المجتمع المدني.
يؤيد النقطة السابقة أن الذين دأبوا على هجاء الدولة الدينية تحدثوا عن الإسلام بلغة المستشرقين. فقد انطلقوا من أنه ينفي الآخر ويقمعه، رغم سجله المشهود في احتواء الجميع باختلاف مللهم ونحلهم. كما أنهم تجاهلوا تماما الخبرة المدنية العريضة في التجربة الإسلامية، التي حققت نجاحات كبيرة على مدار التاريخ ممثلة في الأوقاف التي ظلت تؤدي دور الرافعة للمجتمع الإسلامي، ولا تزال تؤدي دورها الحيوي حتى الآن في المجتمع التركي.
إن الإلحاح على إقصاء الإسلام بحجة مدنية الدولة لا يعيد إنتاج خطاب النظام الإقصائي السابق فحسب، ولكنه يشكل تحديا بل عدوانا صارخا على إرادة الأغلبية الساحقة من المصريين، الأمر الذي قد تكون له عواقبه الوخيمة على الاستقرار والسلم الأهليين.
إنني أخشى من استمرار إشغال الناس بجدل مشكوك في براءته ومقاصده حول الدولة الدينية والدولة المدنية، فنبدد طاقتنا ونضيع وقتنا، وننشغل عن إقامة الدولة الديمقراطية، التي هي المشكلة وهي الحل.








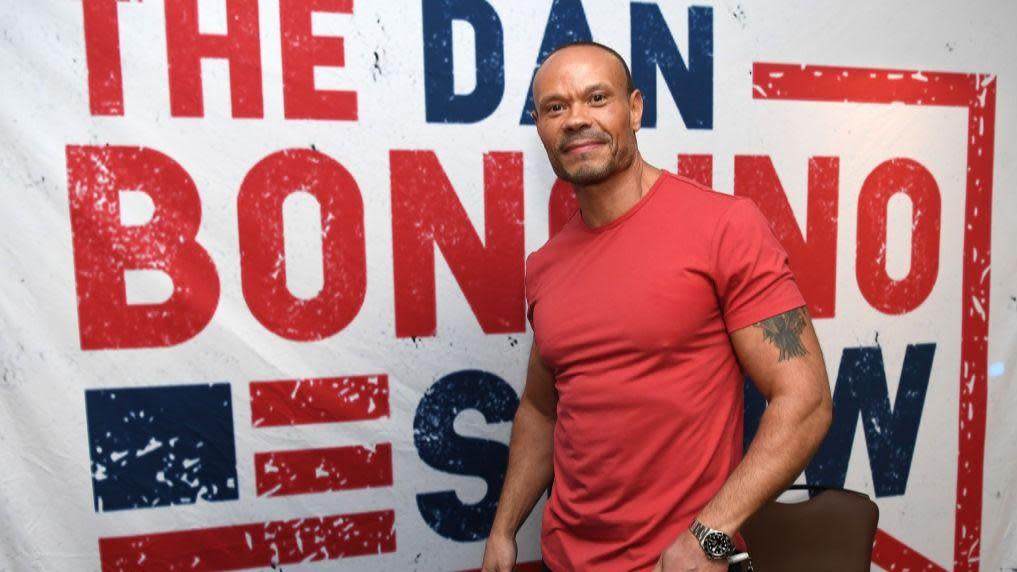











التعليقات (0)