وجوه أخرى لـ "العراق الجديد"(3)

الترييف من المؤسسات إلى القناعات
بقلم/ ممدوح الشيخ
mmshikh@hotmail.com
يشكل الترييف حزمة قيم وممارسات وقناعات ورموز؛ بدءا من تقديس الأرض ووصفها بأنها "عِرض"، وتحويلها من مجال لنشاط اقتصادي، كأي معطى مادي آخر، لمصدر للقيم. وتشمل الحزمة أيضا شيوع جرائم الشرف، وانتشار العنف الاجتماعي، وكراهية الإجراءات، وقلة الاكتراث بالزمن وربط المواعيد بالظواهر الطبيعية لا بساعة محددة "آخر النهار ـ بعد الظهر ـ ليلا -...."، مرورا بالانحياز إلى "ثقافة الاعتزاز" على حساب "ثقافة الإنجاز"، حيث المكانة مصدرها الأصل الذي ينحدر منه الإنسان وليس ما هو قابل للكسب. ويتضمن الترييف أيضا ميلا إلى "الثقافة الشفاهية"، وفي نهاية المطاف ينجم عن "الترييف" روح قدرية شاملة مصدرها طبيعة الزراعة كنشاط يعتمد على أقل قدر من الجهد، حيث تتحول البذرة لنبات مثمر دون تدخل يذكر من الفلاح.
والترييف كحالة اجتماعية ثقافية، يطرح أسئلة عديدة في مقدمتها التراتبية بين أشكال الاجتماع الإنساني وما إذا كان الإسلام منحازاً لأي منها؟
الباحث الأردني إبراهيم غرايبة يرى أن المجتمعات والحضارات تتجه في مسارها العام إلى التمدن، فالمدن كانت مركز الحكم والثقافة والرسالات السماوية أيضا، ويعتبر ترييف المدن والسلطة والثقافة العربية معاكسا للاتجاه المفترض لتطور الحياة العامة والسياسية، وربما يكون من أسباب فشل التنمية والإصلاح والمشاركة السياسية والعامة .
وتجمع الناس حول المكان في عقد اجتماعي أهم خطوات ومقتضيات التحضر، فالمدن مركز العمل العام والاجتماعي والحضاري والإبداع، ويقتضي ذلك بالضرورة انتماء الإنسان منتميا لمدينة أو تجمع حضري، فالرعاة والصيادون لا يمكن أن يؤسسوا أعمالا ومشاريع وبرامج اجتماعية وثقافية. والفكرة الجامعة للناس حول المكان أساس الدول والحضارات والعمل العام؛ لأنها تنشئ مصالح وتشريعات وثقافة منظمة للإدارة والحياة السياسية والثقافية مستمدة من تفاعل الناس مع المكان، وتعاقدهم على الأمن والعدل وتحقيق المصالح والاحتياجات وفق تفاعلهم مع المكان وليس ما تقتضيه بيئة الإنتاج والحماية الأخرى المنتمية للريف أو البادية.
وإقامة مجتمع إسلامي كانت أساس الدعوة الإسلامية، وسميت يثرب "المدينة" في دلالة رمزية مهمة على أن الإسلام يطبق أساسا في مدينة، فالرسالة لا تنجح ولا يصح أن تكون ابتداء في القرى الصغيرة والمراعي والتجمعات المحدودة، وكان الرسول ينهى من ينتقل للمدينة من البدو عن العودة، ليبني مجتمعاً مدينياً.
وأحكام الإسلام تؤسس لسلوك مديني متحضر يستوعب المكان الذي يجمع الناس، كالاستئذان عند دخول البيوت، والنهي عن رفع الصوت، والتجمل والتطيب والنظافة، وإشهار الزواج،.. ..والذوق العام، وغير ذلك مما ينشئ عادات وتقاليد وثقافة مكانية مدينية ومجتمعية.
والمواطنة والجنسية عقد والتزام بين طرفين: الدولة والمواطن، وتقتضي الانتماء والمشاركة وأداء الواجبات، والمواطنة ليست عرقا أو إثنية، بل تقوم على المكان، فمواطنو الدولة يتجمعون حول فكرة جامعة للدولة تقوم على أساس المواطنة والالتزام نحوها والتمتع بالحقوق والفرص التي تتيحها، فالانتماء يقوم أساساً على المكان، والمواطنة والجنسية علاقة اجتماعية تنشأ مع المكان.
والتمدن كضرورة ليس ترفا، بل ضرورة يقتضيها نشوء المدن، فلا يمكن إقامة جامعات وبرلمانات وشركات ومصانع دون ثقافة مدينية لإدارتها وتنظيمها. والكارثة في منطقتنا هي استخدام الأدوات والمناهج الريفية لإدارة دول ومؤسسات ومجتمعات مدنية كبرى، فإذا كانت الثقافة الريفية أو البدوية تكونها تجمعات صغيرة قائمة على نمط معين من الإنتاج والانتماء والحماية، فلا يمكن تصور كيف ستنظم هذه الثقافة تجمعات سكانية ومهنية وسياسية كبرى ومعقدة لا يربطها ببعضها ما يربط المجموعات الصغيرة من السكان المتشاركين في النسب والمصاهرة والعمل والحياة.
ودائما ترتبط ظواهر: الديكتاتورية وتسلط العسكر وحكم الفرد بغياب أو تهميش الطبقة الوسطى (مهنيين، برجوازيين، مثقفين.. ..) ممن يحملون خصائص المدينة، وبتسلط العصبيات الريفية والقبلية على الحكم والإدارة والأحزاب والجماعات. وهناك من يعتبر البدونة "أي إعادة إنتاج البداوة" الوجه الآخر للترييف، حيث كلاهما يمثل المرحلة السابقة على "المدينة".
وبزوال النظام البعثي في العراق ظهر سيل دراسات عن المجتمع كنموذج للنتائج السلبية للترييف والبدونة، فأهم حصاد لحكم البعث أن الثقافة الاجتماعية للشعب العراقي (وهو واقع يمكن تعميمه عربياً بدرجات متفاوتة) أصبحت مزيجا من البداوة والحضارة. والعراقي مزدوج الشخصية تتصارع فيه قيم البدوية والحضارية، ومع الزمن كان "الحضاري" يتزايد على حساب البدوي. وبسبب تقديس البداوة زحفت ثقافة الصحراء والريف على المدينة. فمعظم قادة البعث من خلفية ريفية وعشائر بدوية، وهم أحيوا القيم البدوية وقلدوا حياة البدو في حياتهم اليومية.
ومن ناحية التنظيم الاجتماعي تم إحياء القبلية والأحكام العشائرية في حل المنازعات بين الناس فأعطيت صلاحيات واسعة لشيوخ العشائر، وتحول الشعب العراقي لاتحاد قبلي بين هذه العشائر، وبذلك تم إعادة المجتمع العراقي للبداوة على حساب الحضارة.
ومنذ الانقلاب على الملكية هناك صراع بين "التمدين" و"الترييف" وهو بالتالي كان انتصارا للريف على المدينة. وهو كان بداية استئثار عصبية ريفية بالسلطة. وهذه الظاهرة لم تتمكن الأيديولوجيا من إخفائها عن عين الناظر إلا قليلا. فاحتلت الثقافة الريفية المشهد السياسي العراقي وتحولت المدينة لساحة لسلطة ريفية تحمل معها عصبياتها وولاءاتها التقليدية وقيمها أيضا، فيما تعرضت النخب السياسية المدينية لضربات موجعة أفقدتها جلّ مقومات البقاء.
ولم يكن غريبا إنتاج بنية تحتية في السلوك السياسي تعتبر مؤسسات المجتمع المدني عدوا محتملا دائما تجب مراقبته والسيطرة المستمرة عليه، فحيازة الحقيقة هو ميراث ريفي بجدارة. وفي هذا الوضع، لم تعد ثمة حدود دستورية واضحة تقيّد اعتباطية قرارات القائد "الملهم" و"الفارس" ذي الأصل الريفي.





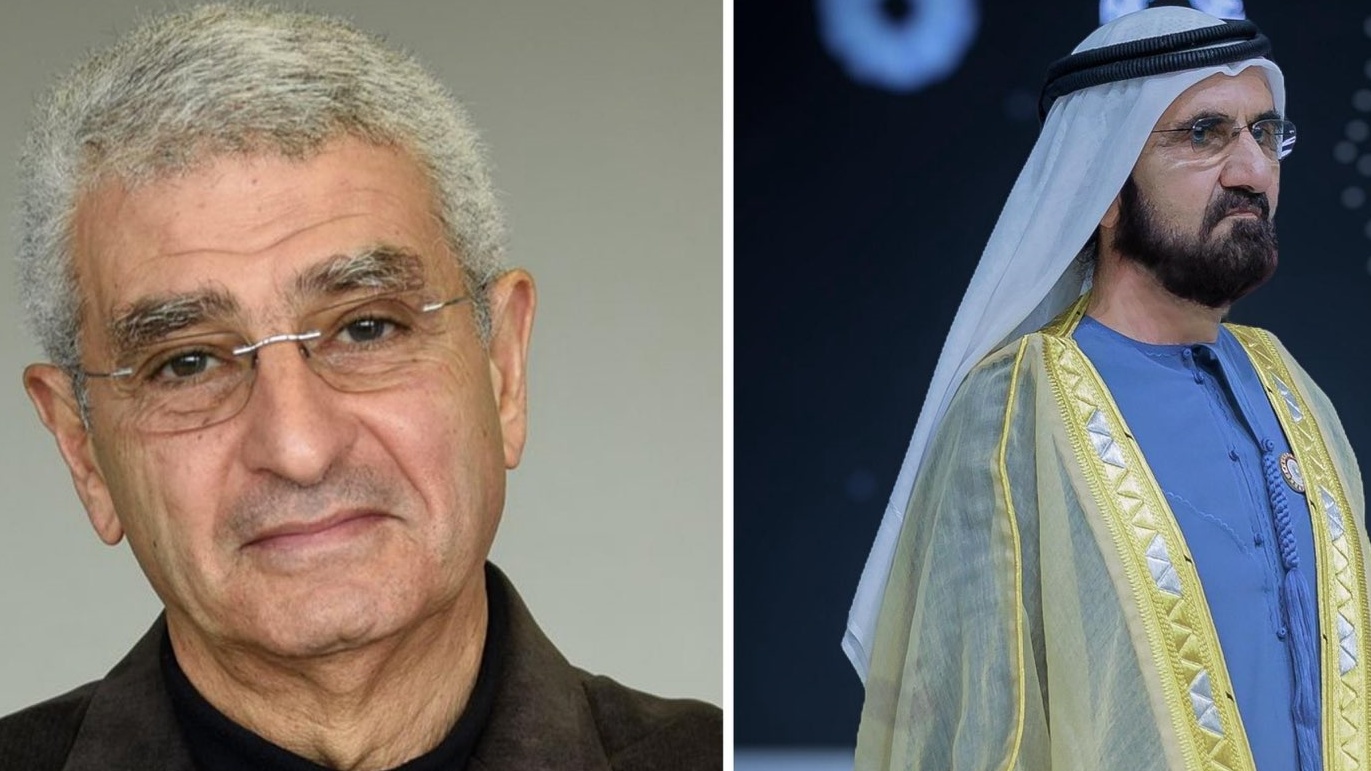





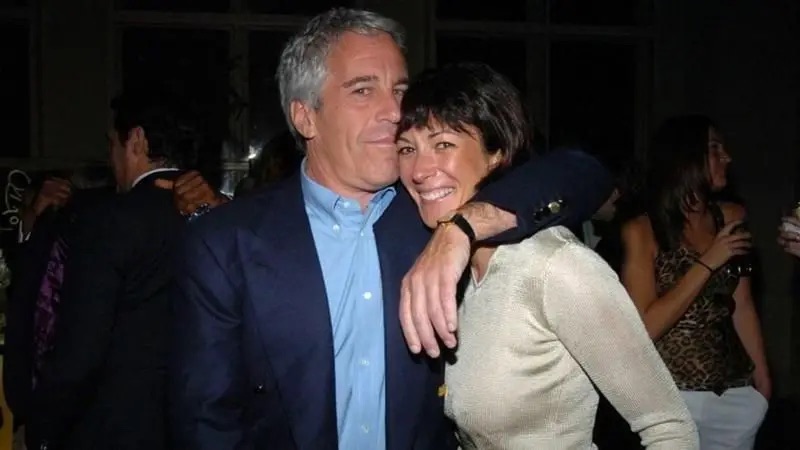





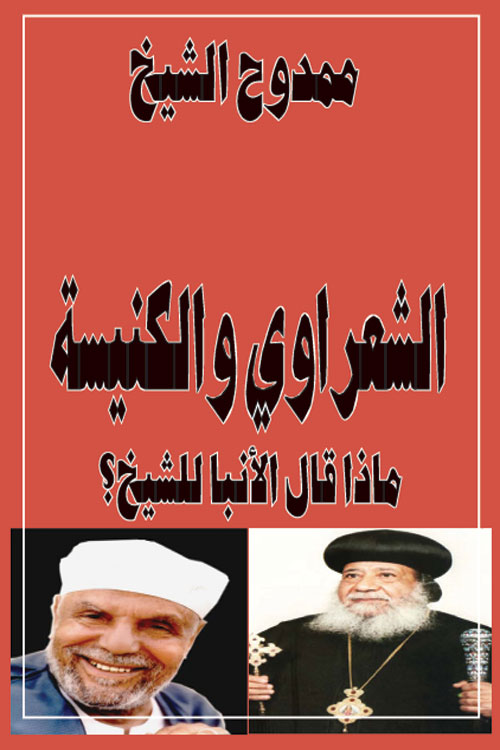
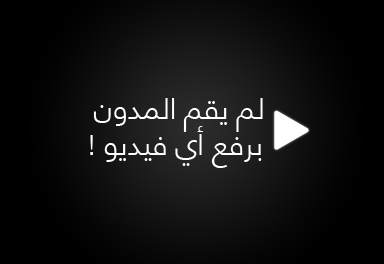

التعليقات (0)