وجوه أخرى لـ "العراق الجديد"(1)

بقلم/ ممدوح الشيخ
"العراق الجديد" تعبير محبب إلى نفسي لأنه يذكرني دائما بأن صفحة مظلمة طويت وأن تضحيات كبيرة بذلت لتخرج هذا البلد العظيم بشعوبه العريقة من قبضة "دولة المنظمة السرية" التي مارست أبشع تنكيل بحق الناس والتاريخ والمكان. وفي حقيقة الأمر فإن زوال نظام البعث لم يكن مجرد إحلال لشكل من أشكال التنظيم السياسي محل آخر، فالتنظيم السياسي هو في الحقيقة قمة هرم قاعدته حزمة من الاختيارات الثقافية. ويعد غياب الاهتمام بالمدخل الثقافي للتغيير في الثقافات المشرقية عموما أحد أخطر نقاط ضعفها، فالاهتمام الأكبر هو بالأشياء والمفاهيم المادية، ولذا كانت الانقلابات السمة المميزة لما يقرب من قرن من لتخبط السياسي في منطقتنا.
ومع تجذر النزوع المادي أصبح هناك قناعة بأن الموارد الطبيعية عموما أهم من الإنسان، وتبع هذا توجه آخر أقرب للخطيئة، هو القناعة بأن الشعوب ليسوا سوى حراس للأرض التي هي "المقدس الأكبر"، ومن هذا السبيل اعتبر صدام حسين نفسه – في المقام الأول – حارسا للبوابة الشرقية، ومع استمرار الإلحاح على الفكرة توارت الأسئلة المتصلة بالناس حقوقهم، وكأن هذا البلد العظيم مجرد ساحة لتنفيذ المهمة المقدسة: "حماية البوابة الشرقية"، وفي مفارقة تاريخية كبيرة، وبتعبير ربما بدا صادما، كان صدام حسين – بسبب قناعاته – ينظر للعراق على أنه "أرض بلا شعب"!
وعندما تتوارى الثقافة في خلفية المشهد وتحل محلها السياسة – لا كمساحة للمفاوضة والمواءمة بل كميدان صراع استئصالي – لا يكون هناك مكان إلا لـ "المهيب الركن". وعندئذ يحل "التغيير" محل "التغير"، ورغم أن الفرق بين اللفظين من ناحية الإملاء (الشكل) حرف واحد، إلا أن ما بينهما من ناحية المعنى (المضمون) فرق كبير. فالتغير تحول تلقائي وفق قوانين داخلية يمكن القول إنها "سنن كونية" لو تركت المجتمعات البشرية فستنتقل وفقاً لها من طور إلى آخر من أطوار التحول الاجتماعي.
أما التغيير فعمل مخطط سلفاً – وبتعبير أوضح انقلابي – لتحقيق غايات محددة مسبقاً، وقد ارتبط مفهوم التغيير أولا بظهور "الدولة القومية" كشكل للتنظيم السياسي. لكن ميلاد هذه الدولة أدى، أيضا، لميلاد ظاهرة أخرى هي النزوع المتزايد إلى التحكم في العوامل الحاكمة لعملية "التغير" ليحل محلها "التغيير".
ومن أهم نماذج هذا النزوع ما يرويه الأكاديمي الأمريكي والتر ج .أونج في كتابه "الشفاهية والكتابية"، يقول حرفيا: "ليس ثمة من عمل يتناول التفكير الإجرائي أكثر فائدة للدراسة الراهنة من كتاب أ .ر .لوريا " التطور المعرفي: أسسه الثقافية والاجتماعية"، "فبناءً على إيحاء من عالم النفس السوفيتي الفذ ليف فيجوتسكي، قام لوريا ببحث ميداني واسع على أشخاص أميين "أي شفاهيين" وأشخاص كتابيين إلى حد ما في المناطق البعيدة من أوزبكستان وقيرغيزيا في الاتحاد السوفييتي" ، "ولم ينشر كتاب لوريا في طبعته الروسية الأصلية إلا.. ..بعد أن اكتمل البحث باثنتين وأربعين سنة". والعبارة الأخيرة من كلام أونج هي الأكثر أهمية فلماذا تخفي السلطات السوفيتية بحثاً كهذا لمدة أكثر من أربعين عاما؟ إنه على الأرجح النزوع إلى السيطرة على التغير الاجتماعي، وبخاصة أن البحث الذي يؤكد أونج أهميته من المؤكد أنه كشف عن مفاتيح مهمة في "التغير الاجتماعي".
وقد شهد منطقتنا خلال النصف الثاني من القرن العشرين تحولا لفت نظر الباحثين كانت سمته الرئيسية موجة واسعة من الترييف للمدن العربية، وما يلفت الانتباه في هذه الموجة أنها اقترنت بتولي نخب التحرر الوطني الحكم عقب رحيل الاستعمار. وبينما كان الاتجاه في كثير من تجارب الاجتماع الإنساني في الشرق والغرب التحول من سكنى الريف إلى سكنى المدن فإن الاتجاه في كثير من الدول العربية كان "ترييف" المدن.
والترييف يتعدى كونه مظهراً اجتماعياً ليكون منظومة متكاملة من المفاهيم والرموز والميول النفسية، ومن الناحية السياسية كان الترييف انقطاعاً في مسيرة تأسيس "دولة المؤسسات" التي تقترن فكرة إنشائها بالحياة في المدينة مقابل سيادة العلاقات القرابية والطبقية في الريف، فكانت نتيجة الترييف سيطرة قيم قروية على المؤسسات!
ومفهوم "المؤسسة" يقترن بمفاهيم ويحمل في جوهره منطقاً محدداً، وفلسفة وملامح خاصة أهمها : الموضوعية، والتعددية، وتحييد المشاعر، وحرية تداول المعلومات، واعتبار الموظف رصيداً إنسانياً ومهنياً. وقد كان الإجماع عليها في الواقع والممارسة في الدولة الحديثة ودراستها في العلوم الاجتماعية تعبيراًً عما يمكن أن نطلق عليه "الديمقراطية الإدارية"، حيث تتراجع مركزية دور الشخص ـ الملهم القابض على زمام الأمور المنفرد وحده بالقرار ـ لتحل محله المؤسسة التي تخضع لقواعد إدارية معروفة سلفاً، ويعرفها الجميع، ويخضعون لسلطانها في إطار من الشرعية القانونية.
والمؤسسة ولدت في مجتمع عرف قيمة الفرد ككيان مستقل، وإذا تحقق كيان الفرد تأتي نشأة المؤسسة تعبيرا عن تحقق مكانته. وللأسف فإن معظم مجتمعاتنا لم يستقر فيها مفهوم الفردية بعد ربما لأنه لم يستقر بالمعنى الحقيقي مفهوم "المدينة" كتعبير لتطور اجتماعي وعلاقات حديثة جديدة تختلف عن علاقات القبيلة أو القرية، فما هو قائم الآن شكل مدني خارجي في بعض الحواضر الكبرى، تسوده علاقات ذات صبغة ريفية. والريف لا يعرف الفرد مستقلاً بل دوماً منتسباً، وبالتالي فإن الفرد والمؤسسة لم يولدا بعد في منطقتنا.
وللحديث بقية





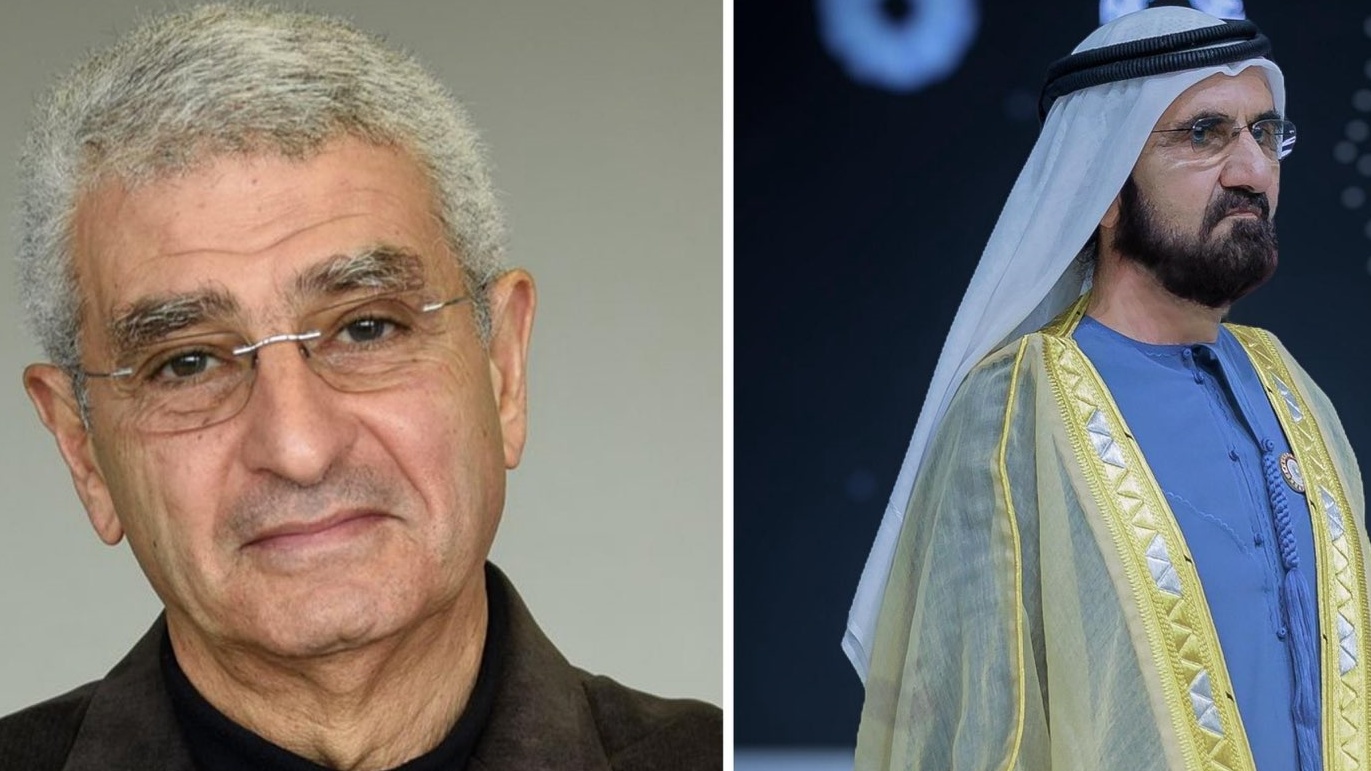





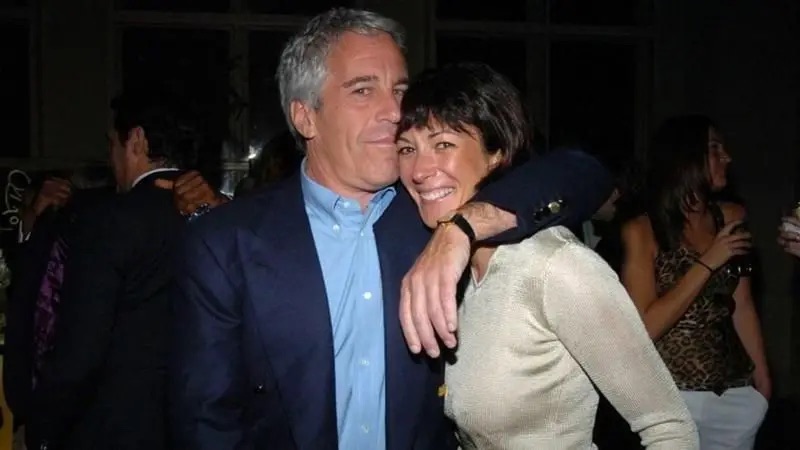





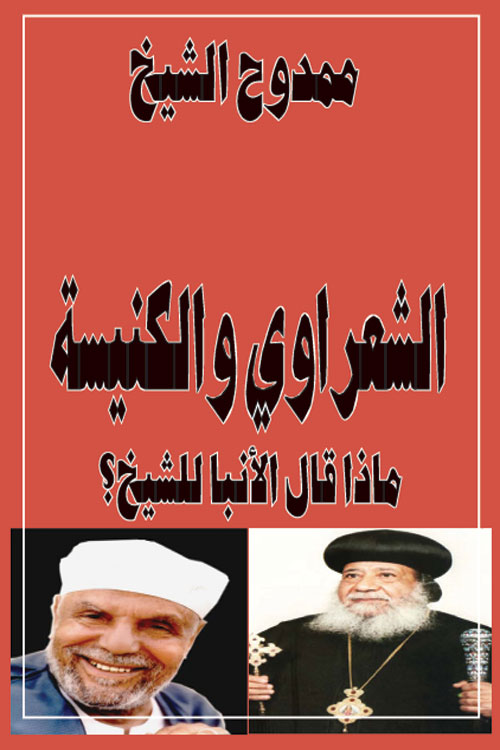
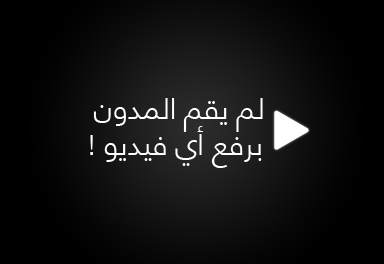

التعليقات (0)