هل نحن سطحيون بالفعل ؟ مالاتعرفه عن الانترنت ؟؟

هل نحن سطحيون بالفعل ؟
الجمعة ، 27 أغسطس ، 2010
م
الكاتب : فهد الحازمي |
هل قلقت ذات يوم من حاجتك الملحة لزيارة قوقل لأنك لم تستطع ان تتذكر معلومة معينة ؟ هل تساءلت ذات يوم عن سر رغبتك المتجددة في فتح إيميلك، وزيارة حسابك في تويتر ورؤية تحديثات صفحتك على الفيس بوك، أو حتى زيارة قارئ خلاصاتك بدلاً من قراءة كتاب رائع أو الاستمتاع بوقتك بين أسرتك وأصدقائك؟ وهل فعلاً استطعت أن تبتعد عن هذه التحديثات لفترة طويلة ؟ هل تشعر بالخسارة والفقدان حينما تبتعد عن الانترنت لأن مواداً رائعة وروابط جيدة وسواليف جميلة قد فاتتك ؟ هل قررت امتلاك إحدى الجوالات الذكية حتى تتمكن من متابعة الانترنت عبر جوالك ؟ .. حسناً إن سببت لك هذه الأسئلة بعض القلق والارتباك فأنت لست سوى فرد واحد في عالم كبير من مدمني الانترنت -الذي أنتمي له-.
في الأيام القليلة الماضية شدني سؤال تأثير الانترنت والتقنية الحديثة (ثورة الجوالات الكفية والأجهزة اللوحية) على تفكيرنا، وعقولنا، وأسلوب تعاملنا مع المعلومات استقبالاً ومعالجة. طرأ علي هذا التساؤل بعد ملاحظتي لنفسي ومراقبة سلوك عقلي في التعامل مع بعض الحوادث والمستجدات التي أجدني فيها مائلاً إلى التسطيح والبساطة، فأشعل في داخي الحماس لأبدأ البحث عن الجواب، فلما بدأت بالقراءة في ذات الموضوع وجدت هذا القلق من التأثيرات السلبية للانترنت موجوداً عند قطاع عريض من متابعي ومستخدمي الانترنت. وقد كُتبت فيه كتب عديدة وأُجريت عدة دراسات وأبحاث من جامعات عريقة كلها تعزز هذا القلق وتؤكده، حيث تواتر الحديث الجاد في الآونة الأخيرة عن التأثيرات السلبية للتكنولوجيا على عقولنا. ويقدم نيكولاس كار في كتابه “السطحية : ماذا يفعل الانترنت في عقولنا؟ “ – والذي كان امتداداً لمقالته التي نشرها عام 2008م في مجلة “الأطلسي” بعنوان “هل يجعلنا قوقل أغبياء؟”- رؤية مفزعة لتأثير الانترنت على عقولنا وأذهاننا داعماً إياها بتجربة شخصية، بالإضافة إلى كتب أخرى تعرضت لذات الموضوع ككتاب “أنت لست بأداة” للمؤلف جارين لينير وغيرها من ردود الفعل. مما استدعاني أن أعمم تجربتي وأشارككم بما توصلت إليه من نتائج وأفكار.
من اختراع الأحرف الأبجدية، إلى اختراع الساعات وآلة الطباعة، غيرت كل وسيلة حديثة أساسية بشكل جذري طريقة تفكير البشر، في الوقت الذي يصر فيه جميع البشر على الاعتقاد بأنهم يسيطرون على الأدوات التي يخترعونها ويستخدمونها. والوسائل الرقمية التي نستخدمها اليوم ليست بدعاً من تلك الوسائل، وهاهي قد بدأت بتغيير بنيتنا الدماغية.. كما يقول نيكولاس كار.
لقد اعتبرت الانترنت في السابق مجرد وسيلة سواء للتعليم أو الترفيه أو ما سوى ذلك. في الواقع، وما نريد أن نثبته خلال هذه الورقة هو أن الانترنت لم تعد وسيلة نستخدمها -فحسب- بل إنها أصبحت تمارس تأثيراً بالغاً على تفكيرنا، وأعادت برمجة عقولنا بحيث تصبح متلائمة مع سلوكياتنا الجديدة في عصر الانترنت. حيث اتخذ هذا التأثير -فيما سنتطرق له في هذه الورقة- ثلاثة مسارات : تأثير على عقولنا بوصفها أوعية للمعلومات والمهارات، التأثير على أسلوب تلقينا ومعالجتنا للمعلومات، والتأثير على أسلوب إنتاج هذه المعلومات والتفاعل معها.
الأعراض
الإنترنت يؤثر على عقولنا. أو بدقة أكثر، سلوكياتنا اليومية على الانترنت هي التي تمارس هذا التأثير. وهي تمارسه عبر تعزيز نماذج ذهنية محددة، من خلالها نتعامل مع العالم الخارجي. وقبل أن نوضح كيف تمارس هذه السلوكيات هذا التأثير، لنتحدث قليلا عن هذه السلوكيات. يمكن أن نقول أن هناك ملمحين رئيسيين يشكلان أساس سلوكنا اليومي على الانترنت، هما : ضعف التركيز، والبقاء في السطح.
بالنسبة إلى ضعف التركيز، فبالكاد أستطيع إكمال قراءة مقالة طويلة دفعة واحدة من دون أدنى أي تشتيت، وهو الأمر الذي لم يكن يحدث من قبل حينما أقرأ الكتب الورقية. بل إن تركيزي سريعاً ما ينفذ بعد صفحات أو حتى فقرات قليلة، لأعود إلى عالمي الخاص، فإما أن أطالع تحديثات “الفيس بوك” ، أو تحديثات “تويتر” أو موقع اليوتيوب -أو أي نشاط آخر- وأقضي معها قليلاً من الوقت قبل أن أعود لمواصلة القراءة. يصف نيكولاس كار هذا بقوله (فكنت سابقا أسترخي حينما أنغمس في قراءة كتاب أو مقال طويل، ليتعلق ذهني بحبكة درامية أو بحوار فكري. ونادرا ما أعيش تلك اللحظات مع ذهني الآن، بل ينجرف تركيزي بعد صفحة أو صفحتين، وأتململ لأبحث عن شيئا آخر لأقوم به، وأشعر دائما الحاجة لسحب عقلي المشاكس للنص، وأصبحت القراءة العميقة نضال مرهق). لقد فقدت مقدرتي على الصبر في القراءة، حيث -وبشكل حاد- تقلصت المدة التي أستطيع التركيز فيها. ولذا، ويوماً بعد يوم، تزداد صعوبة هضم المواد الطويلة والثقيلة. فكلما ازداد استهلاكي للانترنت، كلما ازداد الجهد الذي أبذله حتى أبقى مركزاً في قراءة الكتب والمقالات الطويلة، ولهذا تفسير سنتعرض له لاحقاً. ونتيجة لكل هذا، تحول أغلب استهلاكي المعلوماتي إلى معلومات صغيرة، خفيفة، سريعة، ملونة، بما يتناسب مع طبيعة قدراتي الذهنية في تلقي المعلومات ومعالجتها، والتي تحولت بفعل الانترنت كما سنثبت هذا لاحقاً.
وأما بالنسبة للمشكلة الأخرى -والتي قد ترتبط بضعف التركيز-، فهي فقدان المقدرة على الدخول في العمق، حيث أشعر بأني أبقى دائماً وأبداً على السطح. سطح كل شيء من معلومات أو أخبار أو مقالات. فالمتعة والإثارة والفائدة موجودة في كل مكان على الشبكة، لكنها -كما يصف المدون علاء المكتوم- في كل اتجاه أيضاً، فإن كنت تلاحق كل شيء فإنك لن تمسك بشيء أبداً.
دخول الموجة الحديثة من الهواتف الذكية -بالإضافة إلى أسعار الانترنت المنافسة-، عزز من ملامح سلوكياتنا اليومية على الانترنت، فطبيعة عرض المحتوى بهذه الهواتف، لا تسمح إلا بالمعلومات الصغيرة الخفيفة السريعة الملونة والتي تشتت تركيزك في كل وقت ومكان. وهذه المعلومات -بطبيعة الحال- ستأتيك من كل حدب وصوب ومجال وفن، بما يعزز من بقائك على السطح أكثر وأكثر. ونتيجة لهذه الموجة الحديثة من الهواتف الذكية -بما تحمله من ميزات تقنية مغرية- ، لم يعد التهرب من متابعة التحديثات أمراً سهلاً. حيث زادت دوافع الاستمرار في متابعة الشبكات الاجتماعية، فالرغبة في متابعة جديد الأخبار والروبط من أصدقائك ومعارفك -وبتكلفة لا تذكر- يشعرك بجو الألفة وتواصل الرابطة. وبالإضافة إلى ذلك هناك شعور الوهمي بالإنجاز والعطاء، هذا الشعور ينبع من مجموعة ردود أفعال لا قيمة لها، كالتعليقات على “حالة” في الفيس بوك، أو إعادة بث التحديثات في موقع تويتر “ريتويت” بحيث تشكل مشاعر إيجابية تدفع للمزيد من التفاعل والمتابعة.
وأستأذنك عزيزي القارئ لكي أشرح قليلاً لماذا أسميها بـ (الضغوط السائلة). فهذه الضغوط أسميها سائلة لأن المرور من خلالها بدون خسارة سهل وإلى حد كبير، كماهو الحال حينما تمرر أصبعك في الماء. ونشعر بذلك حينما تمر ظروف شخصية، يقل فيها الإلحاح النفسي لمتابعة هذه التحديثات بشكل كبير حيث تستطيع أن تمضي يومك من غير أن تشعر بالرغبة في متابعة التحديثات، وهكذا يتملكك شعور بأنه يمكنك أن تقضي حياتك بعيداً عنها من غير أن تشعر بالخسارة والفقدان، بما يجعل مشاعر الخسارة والفقدان وهمية أكثر من كونها حقيقية. بالإضافة إلى ذلك، فطبيعة التحديثات المختلفة والمتنوعة على الرغم من شعورنا بوجودها إلا أنه من الصعب الإمساك بها والخروج بغنيمة قيمة منها، كمن يحاول أن يجمع ماء الحنفية (الصنبور) في كوب واحد، إذ مهما طالت مدة احتفاظ الكوب بالماء، لابد أن يسفح الماء من فوق الكوب لوجود كميات أخرى من المياه.. وهكذا تستمر التحديثات بالتدفق وتمضي من غير أن تخرج منها بشيء طويل الأمد.
كل الملامح والملاحظات التي ذكرناها إلى الآن -وإلى حد ما- تنبع من طبيعة الانترنت الجديدة (ويب تو) بمافيها الشبكات الاجتماعية، فتحديثاتها تمتاز -كما يعدد المدون علاء المكتوم- بثلاثة أمور: أولاً، أنها قصيرة وسريعة وملائمة لإيقاع العصر. وثانياً، أنها تصل لحظياً للمستخدم وتعمل على مدار الساعة، وتصل في أي مكان (عن طريق الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية). وثالثاً، أن المستخدم يتحكم في طبيعتها بحيث تلائم مزاجه وذوقه الشخصي..فهذه الثلاث ميزات تجعلك أمام بحر من الاهتمامات المختلفة (سواء كانت شخصية أو موضوعية) وأمام خيوط جديدة لا تنتهي في كل اهتمام، فتظل تلاحق كل شيء في ذات الوقت بذات الطريقة، وهذا ما يشتت التركيز، ويعزز بقاءنا في السطح دائماً.
ما وراء الأعراض
ذكرنا أن السلوكيات اليومية على الانترنت بملامحها هي الأساس الذي يُحجم تأثير الانترنت على عقولنا ، فمن خلالها ستتعزز النماذج الذهنية التي نتفاعل من خلالها مع العالم الخارجي. فالسؤال المطروح الآن هو ماهي طبيعة تأثير تلك النماذج الذهنية على علاقتنا بالعالم الخارجي ؟ بصيغة أخرى، ماهو أثر السلوكيات اليومية على الانترنت على عقولنا وتفكيرنا ؟
قد يشكك البعض من أثر الوسائل الحديثة التي يستعملها الناس على عقولهم ونمط حياتهم بشكل عام، وبالتالي لن يكون لهذه الورقة أي معنى. ولكي نفند هذا التشكيك، فلنأخذ لمحة عن تأثير وسيلة واحدة من الوسائل الحديثة على عقول البشر، وهي الساعة. “دانيال بيل” يخبرنا عما يسميه بـ (التقنيات الثقافية intellectual technologies) وهي الأدوات التي تمتد بتأثيرها عبر وعينا العقلي، ولن يتوقف أثرها على استخدامنا لها فحسب. حيث يرى دانيال أننا وبشكل حتمي نسير في طريق تبنيها وإسقاط طريقة عملها على عقولنا. فالساعة ذات العقارب، والتي جاءت في القرن الرابع عشر ميلادي، تقدم أوضح مثال على ذلك حيث بدأ الناس آنذاك بإضفاء طريقة عملها وتبنيها في عقولهم وسلوكهم اليومي، أعني ما يتعلق بتقسيم الزمان إلى دقائق وثواني محددة. ولك أن تتخيل ماذا لو لم يتم اختراع الساعة.
إجابة على سؤال التأثير الخطير ، سأقوم باستعراض هذا التأثير -مستعيناً بعدد من الأبحاث والدراسات- مجيباً على ثلاثة أسئلة رئيسية : ماهو أثر الانترنت في عقولنا كأوعية للاحتفاظ بالمعلومات والمهارات ؟ ما أثره على عقولنا كأدوات لاستقبال المعلومات ومعالجتها؟ ما أثره على طريقة إنتاج هذه المعلومات ؟
“مهارات لغوية معدومة، صعوبة في التركيز، ضعف التحصيل المعرفي، هذا هو ما يصل به الشاب الأمريكي إلى الجامعة حسب إحصاءات خطيرة ومقلقة تؤكد مزاعم الخوف المنتشرة بين أساتذة الجامعات الأمريكيين”. هذا -بتصرف بسيط- ما يستنتجه البرفسور (مارك بيورلين) في كتابه “الجيل الأغبى: كيف يجعل العصر الرقمي من الشباب الأمريكي أغبياء ويعرض مستقبلنا للخطر” والمنشور بعام 2008، وذلك حسب ما نقله البروفسور (توماس بينتون) في مقالته (في الغباء).
وفي دراسة ضخمة أخرى -يشير إليها د. عمار بكار- تتعلق بالعلاقة بين التكنولوجيا والقدرات الذهنية، حيث تقول هذه الدراسة -التي شارك فيها نصف مليون طفل في المرحلة المتوسطة- بأن وجود الانترنت السريع في المنازل واستخدامه المكثف، له علاقة عكسية واضحة بأداء الطلاب في المدارس ، خاصة في المواد التي تتطلب قدرات ذهنية مثل الرياضيات. والأمر الذي خرجت به هذه الدراسة هو أنه كلما ارتبط المنزل بالتكنولوجيا بشكل أكبر، كلما قلت قدرات الطلاب الدراسية!
لا أستطيع أن أعلق على ما ورد أعلاه حيث لم أطلع على تفاصيل تلك الدراسات، لكن فيما يبدو أن تلك الدراسات تتحدث عن مستوى مكثف من الاستخدام الغير مفيد للانترنت -كما يفعل مدمنو الشبكات الاجتماعية- بما يفقدهم المهارات اللغوية والعقلية التي تُنمى خارج أسوار الانترنت، بما يضعف من التحصيل المعرفي والقدرات الذهنية. أو بالأحرى، يضعف أذهاننا كأوعية قادرة على استيعاب المعلومات والمهارات بشكل كامل.
والآن، نأتي إلى السؤال الآخر وهو عن أثر الانترنت على سلوكنا في استقبال المعلومات ومعالجتها. ونحن هنا أمام إشكالين سنتعرض لهما على التوالي: الأول هو في تحليل عمل أذهاننا أثناء القراءة على الانترنت وأثرها في تفكيرنا، والثاني هو في علاقة هذه القراءة بأسلوب تلقينا للمعلومات.
بالنسبة لتحليل عمل أذهاننا أثناء القراءة على الانترنت، فقد ذكرنا في موضع سابق بأن التركيز الطويل في القراءة يزداد صعوبة مع زيادة الاستخدام اليومي للانترنت. واحدة من ضمن التفسيرات لهذه الظاهرة، هو أن هذا عائد إلى انشغال ذهن متصفح الانترنت بصناعة قرارات كثيرة بشكل سريع وعشوائي.. النقر على هذا الرابط، الاستماع إلى ذاك المقطع، الرد على فلان، زيارة الموقع الفلاني … وهكذا. واتخاذ القرارات هذه يتم تحت ضغط عاملي السرعة والعشوائية، بحيث تتهاوى في ذات الوقت القدرة على تقييم أغلب المعلومات والمواد التي نستقبلها من الانترنت، لنصبح مستهلكين سطحيين مهووسين بالأشكال، غير مبالين بقيمة تلك المعلومات. وهذا خلاف الأمر الذي يحصل مع قارئ الكتاب والذي يبقى صافي الذهن منهمكاً في استخلاص المهم أثناء قراءته (ولا يوجد ما يشغله غير ذلك).
في ظل هذا التفسير، هل نحن قادرون على القراءة العميقة، وبالتالي قادرون على التفكير ومعالجة المعلومات بشكل عميق؟ هذا ما تحاول الإجابة عنه السيدة ماريانا وولف، والتي تقول -بتصرف- “نحن لسنا ما نقرأ، بل نحن كيف نقرأ”. وولف تخشى من نمط القراءة على الانترنت والذي يضع معياري الآنية والكفاءة قبل كل شيء، وهذا ما يضعف من قدرتنا على على القراءة العميقة، ذلك النمط الذي ظهر مع الآلة الطابعة. فحينما نقرأ على الانترنت، نميل إلى أن نترجم ما نقرؤه لأذهاننا فحسب (decoders of information)، بما يعني أن قدرتنا على تحويل ما نقرؤه إلى مادة ثرية مندمجة في روابطنا العقلية تظل محدودة جداً. خلاف الأمر الذي يحصل حينما نقرأ كتاباً بعمق وبدون تشتيت. وتضيف وولف “القراءة العميقة لا يمكن ان تنفصل عن التفكير العميق” .. وهذا يعطينا صورة واضحة عن مدى قدرتنا على استقبال ومعالجة المعلومات.
الفقرتين السابقتين، في الواقع كنا قد أشرنا إلى طرف منها حينما تحدثنا عن مسألة كثرة التحديثات -والتي ستتطلب منك الكثير من القرارات- بما يجعلك باقياً على السطح، من غير امتلاك القدرة على تقييم المعلومات، فضلاً عن الدخول في العمق. وهذا ما يجعل العملية الآنية الدائمة للدماغ هي في ترجمة المواد المعروضة للعقل دون خوض في تفكير عميق حولها، ليس لأننا (إلى حد ما) غير قادرين على التعمق، بل لأن التفكير العميق سيؤخر من عملية متابعة التحديثات الأخرى واللحاق بالركب!
بالنسبة لعلاقة هذا اللون من القراءة بأسلوب تلقينا للمعلومات ومعالجتها، فهذا التأثير على عقولنا جعلنا نتوق لأن نستقبل كل المعلومات كما يعطينا إياها الإنترنت، أو كما نستقبلها منه. معلومات سريعة تأتينا بطريقة سريعة، وتتدفق باستمرار.. تماماً كما أشرت في الأعراض في بداية الورقة قائلاً “تحول أغلب استهلاكي المعلوماتي إلى معلومات صغيرة، خفيفة، سريعة، ملونة”. وهكذا نصبح مثل متزلج يتزلج على سطح بحر المعرفة بشكل “يبدو مثيراً”… بعد أن اعتاد على الغوص في ذات البحر!
ونحن -كمستخدمين عاديين- لسنا الوحيدين الذين تغيرت طريقة تلقيهم للمعلومات، بل حتى الباحثين في أروقة الجامعات تغيرت أساليبهم في التعامل مع المعلومات متأثرة بالانترنت. وحين نشير إلى الباحثين، فنحن نتوقع منهجاً أكاديمياً محدداً وطقوساً علمية واضحة! لكن الواقع يثبت خلاف ذلك.. ففي دراسة لجامعة كلية لندن عن عادات البحث على الانترنت، وقد استغرقت خمس سنوات، حيث قام العلماء -عن طريق بيانات الدخول في الكمبيوتر computer logs – باختبار عادات الباحثين الذين يزورون موقعي بحوث مشهورين، الأول تابع للمكتبة البريطانية، والثاني للجمعية التعليمية البريطانية، حيث يوجد الكثير من المقالات والكتب الالكترونية والمصادر الأخرى المكتوبة. اكتشفوا أن نشاط الزائرين لهذين الموقعين أشبه ب” نشاط القراءة المسحية للموقع a form of skimming activity” متنقلين بين مصدر وآخر، ونادراً ما يعودون لمصدر ما مرة أخرى. في العادة لا يقرؤون أكثر من صفحة أو صفحتين قبل أن يغادروا إلى موقع آخر. في بعض الأحيان يحفظون المقالات في الأجهزة، لكن لاتوجد براهين على أنهم عادوا إليها وقرؤوها. كتب القائمون على هذه الدراسة مانصه : (إنه من الواضح أن المستخدمين لا يقرؤون في الانترنت كما يقرؤون قراءة تقليدية، وبكل تأكيد هناك إشارات على أشكال جديدة من القراءة تنشأ مع ظاهرة التصفح السطحي للعناوين وفهرس المحتويات ومواجز البحوث لتحقيق انجازات وهمية عاجلة. إنه في الغالب كما يبدو أنهم يلجؤون للانترنت لكي يتجنبوا القراءة بالشكل التقليدي) .
وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على مدى سطوة النماذج الذهنية التي عززتها سلوكيات الانترنت، حتى على التقاليد العلمية الراسخة، بما يجعل مهمة إصلاحها تبدو محفوفة بالكثير من المتاعب.
السؤال الثالث كان عن طريقة إنتاج المعلومات والتفاعل معها، وأثر الانترنت فيها. فللانترنت أثر في تعزيز التفكير الجمعي والاستجابة له، فقد أجريت دراسة من قبل المعهد الأمريكي الوطني للاضطرابات العصبية والسكتات الدماغية يقول بأن تعددية المهام multi-tasking في الانترنت تجعل الناس أكثر اعتماداً على الأفكار والحلول المتاحة على الطاولة للنقاش، بدلاً من أن يخوضوا التحدي ويبتكروا طرق تفكير جديدة. والسبب كما يبدو هو ما كررناه سابقاً، حيث أن تعددية المهام تشتت التركيز بما يضعف المقدرة على التعمق وابتكار أفكار جديدة. كما أن جامعة شيكاغو أجرت دراسة أظهرت أن الأوراق والبحوث الأكاديمية بدأت تشير إلى مصادر ورقية أقل، بعد أن توفرت المنشورات على الانترنت.
وهكذا، نكون خلصنا إلى استعراض ملامح موجزة عبر دراسات وإشارات إلى أثر الانترنت في عقولنا كأوعية لحفظ المعلومات، وأثره في تلقي المعلومات ومعالجتها، وأثره في الإنتاج، والتفاعل مع هذه المعلومات.
وماذا عن العرب والخليجيين ؟
لكي أتعرف على توجهات المستخدمين من حولي، طرحت عبر حسابي في تويتر والفيس بوك رابطاً لاستفتاء عن أثر الانترنت، وقد كان فيه مجموعة من الأسئلة السريعة والمباشرة، والأجوبة متعددة الاختيار لتسهيل مهمة الاختيار المباشر وزيادة عدد المشاركين فيه، وكانت نتائج إجاباته على النحو التالي : في السؤال الأول الذي يقول “كم ساعة تقضيها على الانترنت يومياً ؟” أجاب 43? بأكثر من ست ساعات وأيضاً 43? بما بين ثلاث إلى ست ساعات، و 13? أجابوا بما بين ساعة إلى ثلاث ساعات. وصفر بالمئة أجابوا بأقل من ساعة! بما يعني أن النتائج التالية، كلها مأخوذة من مجموعة مدمني الانترنت. وأما السؤال الثاني القائل “ هل تستطيع التركيز لفترة طويلة على قراءة كتاب/مقال بدون تشتيت أو انقطاع ؟” فقد أجاب 16? بنعم، و 35? أجابوا بلا، و49? أجابوا بإلى حد ما. وأما السؤال الثالث “في العادة، بأي طريقة تقرأ في الانترنت ؟” فأجاب 75? بقراءة مسحية والمتبقي وهو 25? أجابوا بقراءة متأنية. وأما السؤال الرابع حول البحث في قوقل حول معلومة معينة، حيث يفضل 49? أن يأخذوا طرف المعلومة مباشرة من خلال النتائج ومتى ما وجدوا ما يريدون ينهون عملية البحث. فيما اختار البقية (51?) الخيار الثاني حيث يبحثون عن أمور أخرى متعلقة تعينهم على الفهم بشكل أعمق، مثل تاريخ المعلومة ودراسات عنها وتنبؤات مستقبلية بها، وأي متعلقات عنها.. وأما السؤال الخامس الذي يقول “وددت أن تتعرف على موضوع حاز على اهتمامك، وجدت أنه في اليوتيوب في فيلم وثائقي، ونفس المحتوى في الويكيبيديا في مقالة، فماذا تفضل؟” حيث اختار مشاهدة الفيلم في اليوتيوب (51?) واختار قراءة المقالة في الويكيبيديا (49?) . أما السؤال السادس فقد اختار 75? الاشتراك بمواقع قليلة لكي يحصلوا على معلومات غنية وثرية ونوعية وفيما اختار البقية (25?) الاشتراك بمواقع كثيرة لمعرفة أكبر قدر ممكن من المعلومات والأخبار. وأخيراً، السؤال السابع والذي يقول “أثناء إجابتك على النموذج أعلاه، هل شعرت برغبة في الانتهاء منه بأسرع وقت ممكن ؟” حيث قال بنعم 44? ، وقال بلا 56?. كان مجموع المشاركين هو 202 مشارك، في خلال ساعتين من نشر رابط الاستفتاء.
ماهي الدلائل التي يمكن أن يحملها لنا هذا الاستفتاء السريع؟ لا يوجد بون شاسع بين افتراضاتنا وبين نتائج الاستفتاء، حيث يؤكد 16? فقط أنهم يستطيعون التركيز لفترة طويلة في قراءة كتاب أو مقالة، فيما يعترف الباقون (84?) بتأثير التشتيت والانقطاع حينما يركزون طويلاً. وكذلك يؤكد الأغلبية (75?) أن نشاط القراءة في الانترنت هو قراءة مسحية، وليست متأنية، وهذه تبدو نتيجة طبيعية في ضوء السؤال الأول. فالتركيز لفترة طويلة يعني -بشكل ما- المقدرة على القراءة المتأنية. السؤالين الرابع والخامس جميع إجاباتهم كانت تقريباً بالمناصفة، وهذ قد يدل على اختلاف التوجهات بخصوص التعامل مع المعلومات ولم تكن الإجابات على النحو الذي افترضناه في هذه الورقة بشكل حرفي، لكنها في المقابل ليست بعيدة عن تلك الافترضات. السؤال السابع، كانت النتيجة أيضاً أقرب للمناصفة بحيث لا نرى فرقاً كافياً لكي نطلق حكماً أو نخرج بنتيجة.
نظرة أخرى
هناك دلائل حديثة جداً تشير إلى تحول في التعاطي مع المعلومات على الوجه الذي ذكرناه سابقا، وقد تبشر بلون جديد في هذا المجال. وحتى نمتلك فكرة عن سياق هذا التحول، نشير إلى مقارنة سريعة. وهي أننا في السابق كنا محاطين بعدد قليل من المصادر والتقنيات من كتب وصحف ومجلات وقنوات. بالإضافة إلى وجود نوع من عدم المقدرة على الوصول لكافة المعلومات المتاحة في موضوع محدد لعدم وجود التقنيات الضرورية، بما يجعل طبيعة تناول المواضيع تميل إلى العمق (في ظل محدودية الأفكار المتاحة). أما اليوم، صار حولنا عدد كبير من المصادر والتقنيات، و امتلكنا القدرة على الوصول لمعلومات فوق حاجتنا لكل المواضيع من حولنا، بما يجعل طبيعة تناول الأفكار تميل إلى السطحية، ولم يعد بالإمكان تناولها بذات العمق سابقاً وإلا فسنبقى محاطين بمعلومات قديمة لم تعد ذات قيمة. ففي ظل هذه المقارنة، وفي ظل زيادة تدفق المحتوى الرقمي من تطبيقات الحاسب إلى الأجهزة اليدوية (آي باد، كندل،… ) وفي ظل احتلال تطبيقات الكتب في القارئات اليدوية أعلى التطبيقات تحميلاً في متجر آبل، وفي ظل الزيادة المطردة لمبيعات الكتب الالكترونية لدرجة تجاوزها مبيعات الكتب الورقية في سوق أمازون -كما أعلنت أمازون- ، يبدو أننا مقبلين على تحول في علاقتنا بالمعلومات وبطريقة تلقيها. صحيح أنه لم تتضح حتى الآن معالم هذه العلاقة لحداثة هذه التقنيات، لكن الدلائل الأولى تشير إلى وجود مقدار هائل من المعلومات، ومقدار كبير من التقنيات والوسائل، بما يعني أننا ربما سنكون أمام أنموذج جديد وأسلوب حديث يدمج بين المعلومات والوسائل لكي نصبح أمام طريقة غير تقليدية لعرض المعلومات، وحينها أقول “ربما” نكون قادرين -بعض الشيء- على التعمق في المعلومات وتناولها بشكل أفضل مما نفعله حالياً في الانترنت. وهذا ما يؤكده خبر النيويورك تايمز حيث يؤكد إصدار سايمن آند شيوستر ( Simon & Schuster ) ما يسمونه “voobs” أي دمجاً بين “video + books” وهو كتاب مدعم بعروض فيديو وأشكال جديدة تتجاوز الكتب التقليدية، والتي عبارة عن مجموعة كلمات مرصوصة. قد تبدو هذه التقنيات لن تفيد إلا مع أنواع محددة من الكتب كالموسوعات المعرفية والكتب العلمية والتعليمية، نظراً لطبيعة محتواها ، لكن لن تستطيع أن تفيد في الروايات أو في الكتب الفكرية مثلاً، لأن النصوص حق للمؤلف.
على كل حال، ليس سؤال مدى إفادة هذه التقنيات هو الأهم، بل السؤال الحقيقي المطروح أمامنا هو هل ستتجاوز هذه التقنيات الجديدة مشكلات الانترنت لتجعلنا أقل تشتيتاً وأكثر تركيزاً وهل ستحد من السيل الهادر من التحديثات الذي يسبقنا حيث نذهب ؟ أم أنها مجرد تقنيات سطحية لا يمكن أن تتجاوز عمق المشكلة التي تعرضنا لها في السطور السابقة فتقدم جميع وسائل التشتيت تحت مسمى دعم الشبكات الاجتماعية ؟
سننتظر، ونرى.
.













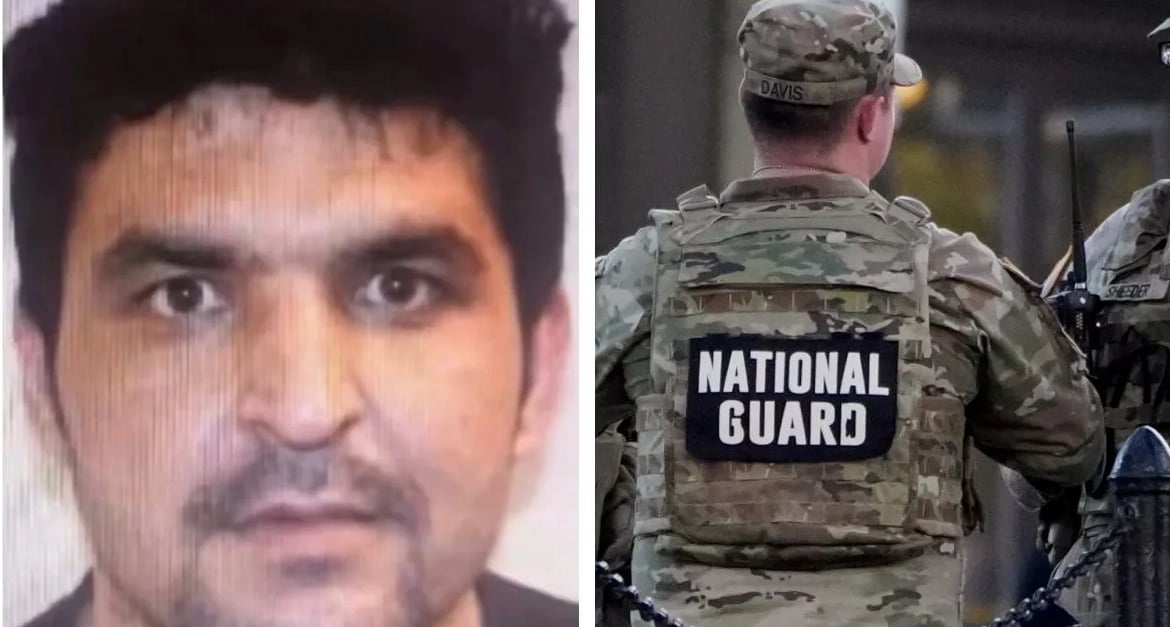
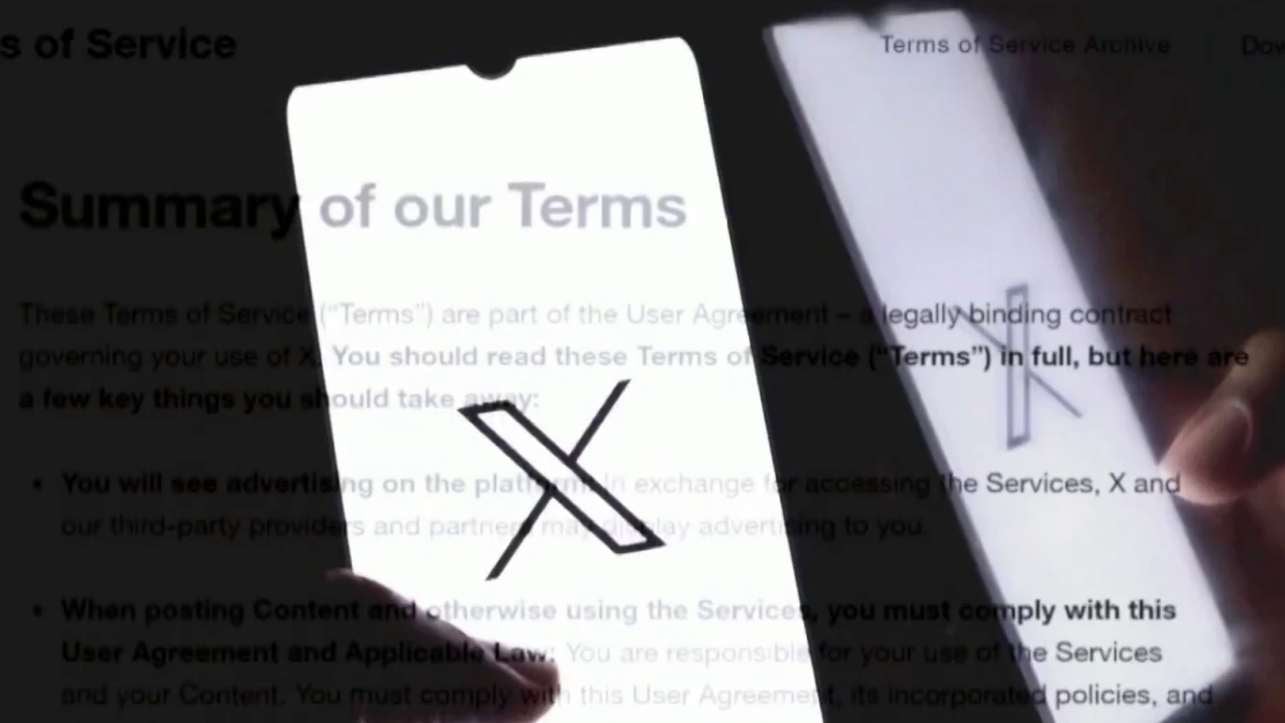


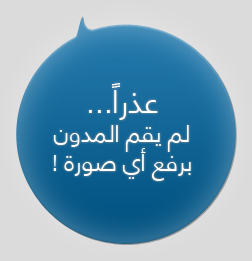
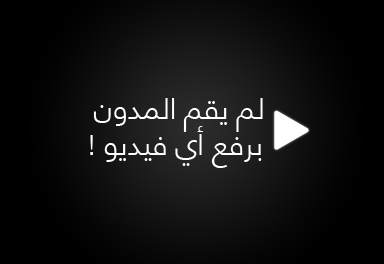

التعليقات (0)