نقد الشعر بين الأستذة والموهبة

نقد الشعر بين الأستذة والموهبة
كرم الله شغيت
يتفق الكثير من الدارسين على إن البداية الحقيقة لنشوء النقد هو ما يصدر من المتكلم نتيجة التأثير الحاصل في نفسه لحظة القراءة أو السماع، وقد عد هذا النوع من النقد انطباعيا، ففي بعضه كان لا يصدر إلا عن حالة خاصة منسجمة مع غرض شخصي، وفي ذلك الغرض ما فيه. وفي مراحل متقدمة أخذ الناقد يقف طويلا عند النص لقراءته واستجلاء مزاياه بالاستعانة بما حوله مما لدى الأديب نفسه وبيئته وظروفه وبما لدى الناقد من ثقافة وعلم واطلاع ونفاذ صبر وتأمل، ومما لا شك فيه أن الناقد يحتكم إلى الكم المعرفي الذي تولد لديه عبر خبرة القراءة وهي في حقيقتها لا تخرج عن شكلين الأول لا يكون للفرد فيه دخل في توجيهه وهو ما نسميه بالدراسة المنهجية، التي يتأطر فيها عقله وخياله وينمو فيها إحساسه وأدوات التصور لديه ويتعمق تحليله ويتنوع تعبيره، والثاني غالبا ما تحكمه الصدفة وتوجهه الميول الشخصية. كما يحتكم الناقد إلى ذائقته والتي تشكل الدافع الأول في شروعه باختيار النص واكتشاف الباعث الإبداعي في لاوعي الشاعر وتقديمه بشكل نظري وإثبات الصيغة القانونية التي تقف وراءه، وهذا هو الهدف الأول من أهداف النقد في سعيه لتقييم المنجز لوضعه في مكانته التي يستحقها بين أقرانه.
وبوجود هذا الاختلاف في النشأة المعرفية للنقاد والأدباء برزت إلى السطح عقدة الأكاديمي والموهوب، ولهاث كل منهما للوصول إلى ما عند غريمه، وهي ظاهرة لم تختص بنوع واحد من الفنون. وإذا كان من السهل على الأديب أن يحرز موقعا أكاديميا مرموقا فإن الموهبة لا زالت عصية على الكثير من الأكاديميين، على إنه لا يمكن أن ننكر وجود من تربع على عرش الاثنين.
وإذا اعتبرنا أن الأكاديمي متسلح بعلمه وهو لا يتحدث إلا بلسان محيط بجوانب موضوعه، فأنه لا يبتعد كثيرا عن الطرق التي تعلمها في دراسته مطبقا لنظريات من يعدهم مثله الأعلى، ونحن إذ نتحدث عن الأكاديمي ليس لأنه الوريث الشرعي لأسلافه من النقاد فحسب؛ بل لأنه أفضل من يعول عليه في الأخذ بيد الفنون المتنوعة ليعبر بها إلى الضفة الأخرى حيث يجلس المتلقي البسيط الذي يفتقر إلى أسلحة الأكاديمي العلمية أنفة الذكر.
والذي دفعني إلى كتابة هذا الموضوع هو ما ينشر في الصحف من نقد للشعر يتصدره اسم لامع ولقب أكاديمي كبير يغري بالتهام النص وليس قراءته فقط، فانتسابه إلى شخص ذي مؤهل علمي عالٍ ينبئ عن غنى محتواه وتنوع أطروحاته، وقد لفت نظري في مقال ينتمي إلى هذا النوع أن كاتبه بدأه بزخة كثيفة استعرض بها سعة اطلاعه وجاء بأقوال لأسماء من شرق الأرض وغربها ليدخل بها إلى حديثه الذي يكاد لا يخلو سطر منه من مصطلح غير معرّب، فوجدت نفسي أبحث عن الرابط بين النص وعلوم مثل الجيولوجي و الطوبولوجي و النوستولوجي و الانثروبولوجي والأركيولوجي والساسيولوجي و الفينومينولوجي والسبميزم ، والتي يرتبك لسماعها طلبة الفرع العلمي، ناهيك عن طلبة الفرع الأدبي ، إذن كيف بقارئ ليس له حظ من المعرفة جذبه إلى قراءة تلك المقالة اسم الشاعر الذي يحبه. أما السؤال الذي لا مناص منه فهو هل يخدم هذا النوع من المقالات النصوص التي تتحدث عنها؟ وأين يقع الحد المبدئي الفاصل بين الطريقة العلمية ووجهات النظر المثالية؟ فالطريقة الموازية للعلم أو المستندة إليه شيء والعلم الذي يعتمد على العقل و المنطق شيء آخر. فلم يكن من الشعراء من ينظر لعمله الشعري قبل أن ترى قصيدته النور وإنما جاء النقاد ومن خلال قراءتهم لنصوصهم الشعرية، فنظروا لأعمالهم فأوجدوا لهم منهجا نقديا في التناول والبحث، في الوقت الذي أوقع انسياق بعض الشعراء الشباب مع التنظير لأعمالهم في منزلق الغموض المفتعل والإغراب المصطنع في تراكيبهم اللفظية. يقابل ذلك إصرار النقاد الأكاديميين منهم خاصة على حشد كم ملفت للنظر من المصطلحات الأجنبية في مقالاتهم ربما يكون منشؤها استعراضيا كما أسلفت أو للتدليل على موسوعية كاتبه، وقد عللها أحد الشعراء في رده عليهم بالروح المتعالية التي تورثها الشهادات العليا عند بعض أصحابها. فالغاية من النقد زيادة على ما ذكرته في البداية ردم الهوة التي حصلت بين الشعر وجمهوره وهنا تظهر الحاجة إلى نصوص نقدية ترتقي إلى مصاف الشعر الذي تشتغل عليه وتضيف إليه ما ينقصه، وتمسح عنه ما لحقه من غبار لاعتبارات تخص كاتبه ومتلقيه معا. وبظهور نصوص مثل التي نتحدث عنها يظهر فيها الكاتب هو البطل بدلا من أن ينسب ذلك إلى الشاعر نفسه ملقيا الضوء على نفسه لا على منقوده، ممارسا دور الأستاذية والتنظير من خلال وضعه معاني تلك المصطلحات بين قوسين، لا يتحقق أي من الأهداف التي ذكرناها، فإقحام مصطلحات مثل التي ذكرتها تفترض موسوعية القارئ وإلا فهي تنظر إليه نظرة متعالية وتنحاز إلى قارئ نخبوي.
إن الأكاديمي مطلوب منه بما حباه الله من معرفة أن ينير النص ويكشف جوانبه ليضع اللبنة الأساس في تواصل القارئ معه، وتدريب ذائقته على استكشاف العلاقات الداخلية فيه، بالأدوات البسيطة التي يمتلكها القارئ العادي، لا بأدواته هو، وبهذا يكون عونا له من غير أن يثقل كاهله فينصرف ذهنه إلى البحث عن ما تعنيه تلك المصطلحات، ويكرس جهده وحواسه في إعادة بناء النص كي يولد من جديد في وعيه، وحين يصل القارئ بمساعدة الناقد إلى يقين بأن ما يقرأه مطابق لواقعه يكون الأخير قد أسهم في إلغاء الفجوة بين الشعر والحياة ، فالتكافؤ الثقافي كان ولا يزال عنصرا مهما بين طرفي أي تجربة إبداعية والطرف السلبي(بمعنى المستقبـِل) فيها دائما هو القارئ رغم قيامه بجهد فاعل في تفهم أبعادها تبعا لخلفيته الثقافية. ولا يتحقق التكافؤ المنشود حين يصر كل من الطرفين على الجلوس متربعا على عرشه، ويصبح حال القارئ كحال الأعرابي الذي وقف على مجلس الأخفش فسمع كلام أهله في النحو وما يدخل معه، فحار وعجب وأطرق ووسوس، فقال الأخفش (ما تسمع يا أخا العرب ؟) قال:( أراكم تتكلمون بكلامنا في كلامنا بما ليس من كلامنا).
وبالعودة إلى عقدة الأكاديمي والموهوب نجد الأول يرى نفسه مخولا باستعمال الطرق العلمية في التحليل والاستقراء، فإذا ما استعملها غيره عدها حذلـقة عديمة الجدوى تقتل النص وترهقه. وقد قرأت عرضا قام به أكاديمي لكتاب من تأليف ناقد غير أكاديمي فرأيته يمتدحه كما نمتدح الأطفال بل راح يكيل إليه عبارات العطف والحنان ويقول أنه قد انتفع أو حاول أن ينتفع بما قرأه من تنظير، وأنه يرجع في نقده إلى الذوق فيستشيره والى الثقافة يعتمد عليها، ويؤكد التهمة التي توجه إلى غير الأكاديميين مصدرا فتواه بنفيها عنه، معترفا في نهاية المطاف بأن طريقته في النقد تنفع المتلقي وتفتح أمامه السبيل ليدخل عالم الشعر وغابته الكثيفة.
وقد عاب عدد من الأكاديميين الافتعال في النصوص النقدية وعلى رأسهم الدكتور علي جواد الطاهر فهو يقول في أحد لقاءاته: إن كتابة جافة يطغى عليها التعليم ويثقلها التعليل والتحليل والأحكام القاطعة وآثار القواعد ومدارس الآخرين، قد يأتي فيها النقد صحيحا غير أن صحته تعرض جافة ثقيلة وكأنها اقتطعت من كتاب مدرسي، ففيها قال فلان وقال فلان وفيها 1،2،3 ...و آ.ب.جـ. وفيها يموت الناقد والمبدع معاً بنظرية لغيره استعارها قسرا.
إن المطلوب من الناقد أن يعمل على معالجة النص بمسؤولية تجعل تجربة الآخرين تجربته الذاتية، كي تجذب القارئ إليها وتغريه بمتابعة القراءة، وتعطي مقالته حظا من البقاء غير مرتبط ببقاء النص.














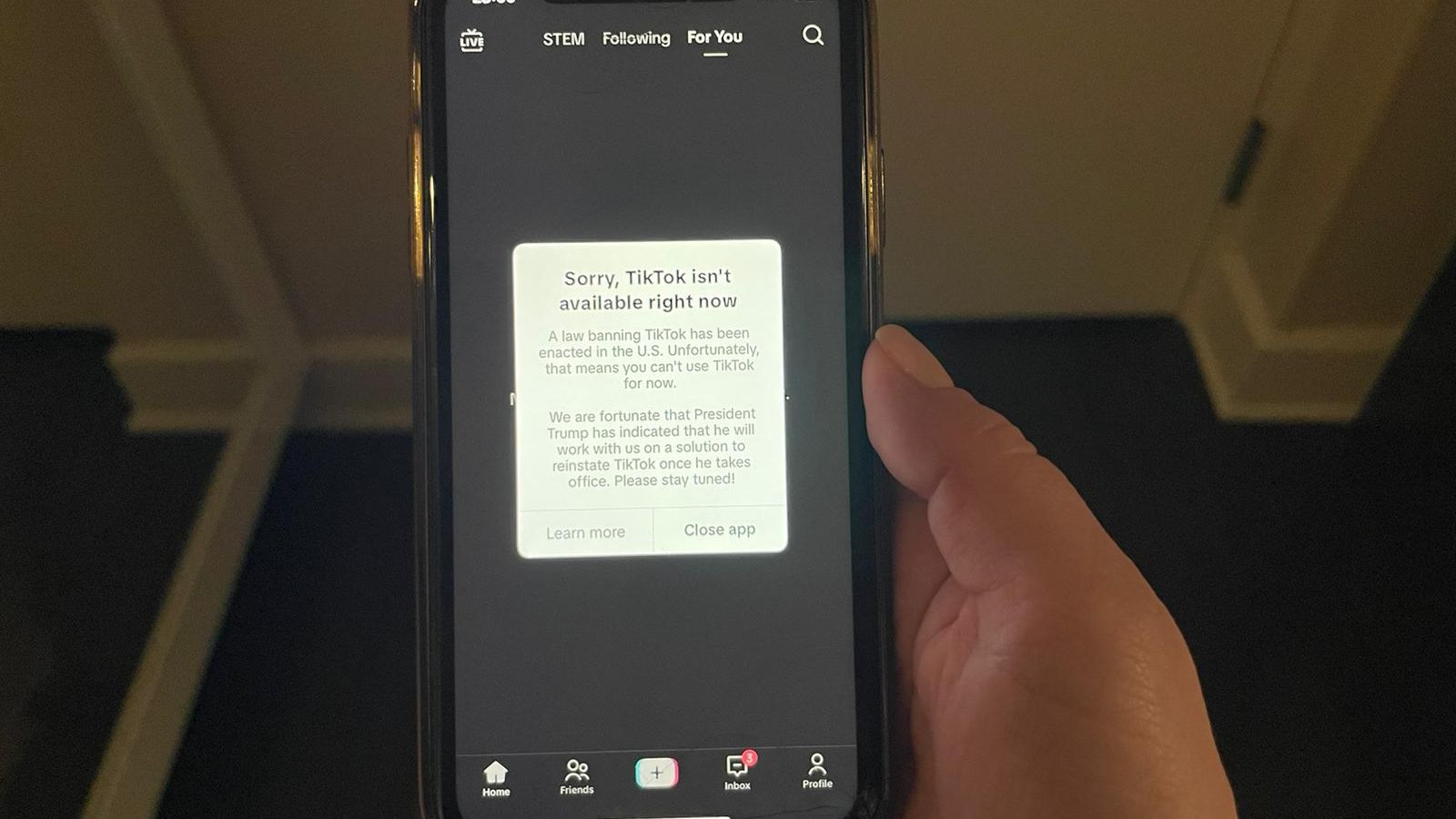





التعليقات (0)