موت المؤلف

يقول رولان بارت : إن موت المؤلف هو الشرط الوحيد لولادة القراءة الفاعلة المنتجة. ذلك أن المؤلف بتأكيده لحضوره الطاغي على النص يؤشكل القراءة لا لتبدو حيزا للاختلاف ومعرضا للتباين وحقلا للتعارض والتضاد ، ولكن لتقول ما يريد ان يقوله المؤلف .
فهل من الممكن أن تكون هذه العبارة وهذا المفهوم منسجمين أو متسقين مع كتبة الاناجيل الأربعة ومع بولس الرسول في رسائله؟ وكيفية تعاملهم مع النص باعتباره فضاء لغويّاً متعدد الدلالات؟ حتى أصبح النصّ الديني مكاناً لحرب القراءات أو التأويلات بين الفرق المسيحية المختلفة . دعونا نسقط مقولة بارت صاحب المدرسة التفكيكية على منهجية الجدل المسيحي في بناء المعنى .
، وهنا يحضرني التاريخ المسيحي أو يتجسد بجميع تجلياته المذهبية وفرقه المتناحرة والمشتتة معرفيا، والتي انطلقت من بنية النصّ ذاته ومن احتمالات دلالاته وأوجه تحولاته ، هذا النصّ ذو البنية الأسطوريّة بحسب ما ذكرناه وأكدنا عليه وأثبتناه في دراساتنا السابقة، مليء بالإحالات الخارجية التي تمثّلت على سبيل مغاير ، في صور عديدة مثل عملية الصلب والأقانييم الثلاثة والكفارة أو ما يعرف بالفداء أقدّم مثالاً واحداً يدل على إشكالية الاختلاف في عملية إنتاج الدلالة لمعنى الفداء ، اذ يمكن ان يختلق المؤلف من خلال البنية اللغوية ابعادا طقسية يوظفها لتضليل القارئ بعد أن يدفع به الى اعماق الصور الخالية من اية معاني سوى ما يريده المؤلف. لاحظ كيف يتم اختصار الدلالات النهائية على صدقية الغاية في بعد الفداء. وهنا يضل المؤلف يضغط على وعي القارئ حتى يسلبه ارادته في التفكير. أو على الأقل في التصور المنهجي لهذا المفهوم . إن تحول المعنى من الصيغة المباشرة الى الصيغة الممكنة هو لعبة نصية يمكن القبض عليها بسهولة ، وهذا ما حاولت أن أكشفه للقارئ بصياغة بسيطة يستطيع فهمها .
من هنا أعيد طرح السؤال الذي اجترحته بدءاً حول الإشكال الديني المسيحي ونظرية موت المؤلف، اذ لم يعد لهذا الكاتب المقدس وجود جدلي معرفي يستنطق الحقيقة بمفهومها النسبي هاذا ما سوف نلاحظه ، لأن القارئ هو الذي يحدد مستوى الدلالات ومضامينها الفكرية، وما إذا كان بالإمكان استثمارها في قراءة النصّ الديني بعيدا عن الأسقاطات المؤدلجة من الكتبة ، فمما لا شكّ فيه أن النصّ الأنجيلي هو نصّ لغويّ كاي نص قبل أي شي آخر،. اللغة بحسب دي سوسير هي مجموعة الإمكانات التعبيرية التواصلية والمخزون الذهنيّ لمجموع هذه الإمكانات، وما النصّ الإنجيلي إلا ( خطاب ) ينبثق من هذا النظام، كغيره من الخطابات التي هي تجلٍ من تجليات هذا النظام، أقصد هنا التعامل التوصيليّ للخطاب ، وغيرها من أشكال التعبير اللغويّ … كالكتابة على سبيل المثال .... وهنا أعيد طرح السؤال السابق مباشر. وهو إذا ما كان بالإمكان القول بموت الرب على خشبة الصليب و بهذا التحديد السابق، أي موت المؤلف بمعنى أن الرب هو الذي كتب الأنجيل ، وأجدني هنا مظطرا لأن اعيد سرد التصور مرّة أخرى، لتخرج لي ذات النتيجة في قراءة النصّ الأنجيلي، إلا إن الإشكال هو من صميم العنوان الذي يثير حساسية المتلقّي الديني المسيحي ، أي إنّ مقولة موت الرب المؤلف وحساسية العبارة حين تستخدم في قراءة النص الأنجيلي ، وتضاربها مع مقولات تيولوجية عقديّة، لا مع مفهوم النظرية ذاتها، هو أساس الإشكال التي تثيره النظرية في الدين المسيحي ، لأن التقسيم وفق منهجية التضاد على مستوى الخطاب، وفي ظل إمكانية موت المؤلف نظريا، لا يمكن قبول هذه الإمكانية المعرفية إلا مع الأعتراف بمضمون الخلخلة للمعنى المراد توضيفة وفق بنى التصور الديني . ومن هنا نلاحظ مدى الخلط لصيغ التصور في ذهنية كتبة الأناجيل والتناقض الذي وقعوا به في سرد الحادثة الواحدة مما يشي حتما بمدى التلاعبات الممارسة في الخطاب من كل مؤلف على مدى إمكانية تصوره الذهني .
متى يفهم أولاء اللاهوتيون أن المعنى ليس جوهرا مكنونا، أو مفهوما محضا، أو قصدا متعاليا يعبر عنه بالأدوات اللفظية اللغوية . فللملفوظات أثرها في إنتاج المعنى وتوليد الدلالة ، وللنص سلطته مقابل ما أراده المؤلف، وما راح يقصده ، ذلك أن الكاتب عندما يعبر عن مراده للمعنى، لا يقطف المعاني البكر أو يلتقط الدلالات الأولى البريئه . وإنما يستخدم اللغة التي هي كناية عن توظيفات مجازية، وتراكمات دلالية تاريخية، خاصة اذا ما تعلق الأمر بالدين الذي يحرف معنى المعنى وينتهكه ويفظ بكارته بشكل سافر . نلاحظ هنا كذلك أن هذا الخطاب عادة ما يمارس تلاعباته من خلال منهجية التعريف، والتعريف نوع من التأويل، الذي يحيل بدوره الى تأويل آخر، ومن هنا يستمر التداخل المقيت بين المعنى المصاغ بقصد، وبين وعي المؤمن . وهكذا يظل المؤمن يبحث عن المعنى المحض في سلسلة التأويلات تلك التي لا تنتهي، حتى يضيع تماما في فضاء هذا الدين، ويصبح اسيرا له، ومن هنا مشكلة اولاء الذين لا نستطيع أن نجد لهم عذرا غير أنهم جهلة لا يستخدمون عقولهم في الفهم والتفكر والتدبر .
إذا أردنا مقاربة المعنى ، سواء من جهة العلامة أو من جهة الدلالة . لا نصل أو يستحيل أن نصل الى ماهيات ثابته ، ولا نقبض على هويات متطابقة . بل ما نقع عليه هنا وقائع خطابية مستقلة عن إرادة المؤلف ، وهي بنى تحتاج الى تفكيك علاقاتها للكشف عن لا معناها وفك رموزها ، مما يعني أن النص لا ينفك عن حلوليته في جسده الذي هو نصه .
إذن لسنا إزاء معان مفارقة في هذا الدين العجيب الذي يسعى الى تجسيد المطلق من خلال النص على شكل بشري، أي أن الله صار بشرا، حتى نسأل ماذا حل بهذا المعنى ؟ بل نحن إزاء منطوق بشري هو عبارة عن رسائل تحتاج الى من يجيب عنها باستمرار وكل جواب يفتح امكانية جديدة، مما يجعل المعنى الذي نبحث عنه ينحل في سلاسل متلاحقة من الرسائل، أو في شبكات معقدة من التأويلات، خذ مثلا مشكلة الأقانيم الثلاثة، لا أحد يسطيع أن يستنطق معناها، ولذلك يظل السؤال دائرا في فلكه يبحث عن معناه ولا يجده، وهذا مراد المؤلف الذي صاغ هذا النص . وأنا لا اعتقد أن مؤلفي الأناجيل كانت لديهم القدرة الفكرية والذهنية اللغوية على صياغة هذه النص بهذا الأسلوب الإشكالي وإنما نقلوا بشكل ذكي الصياغة الإفلوطونية المحدثة ووظفوها هنا ثم اسبغوا عليها التعالي الذي أخذ يتعمق بشكل كبير مع ممارسة الشعائر والطقوس ثم احيطت هذه النصوص بالتفسيرات الرمزية . هذا ما نشاهده في نص الرؤيا الملحمية في إنجيل يوحنا على الخصوص . والذي تقاطع بشكل فج مع اية إمكانية للتواصل مع معنى محدد يحيل إليه النص .
المعنى يختلف عن نفسه باختلاف فهمه أو تحليله الى مستوياته ، ولعله يختلف عن نفسه بقدر ما يتكشف عبر النقد والتفكيك عن محنته ومأزقه . أعني تعذر القبض عن معنى المعنى . ولو كان هناك معنى واحد لمعنى واحد يمكن إدراكه بصورة متواطئة لتوقف الكلام على الأشياء وإمكانية تصوراتها . والحال هنا أنه لا شيئ يمكن تعريفه بصورة نهائية، بل كل تعريف هو اختزال للمعنى . عندما نقول الرب هو يسوع . نفتح فضاء مرعبا لتدمير المعنى . بصيغة أنه لا يمكن للتعبير المنطوقي اللغوي أن يوجد مقابلا للمعنى على نحو محدد ذلك أن هذا اليسوع هو بشر كان يتحرك وفق الأناجيل في زمان ومكان محددين على الأرض، فكيف نقبض على علة المعنى . أي لماذا حدث ما حدث . تجيب الأناجيل .. حتى يكفر عن خطيئة آدم . ولكن لماذا يكفر الرب عن خطيئة مخلوق خلقه . ؟ وهو الذي أعطاه أسباب خطيئتة ؟ ... وهنا نجد مع تداعي الأسئلة السطحية هذه كيف يضيع المعنى في نسق خطابي مباشر لا ينفك عن التبدل والتغير ، ثم نجد أنفسنا أمام حقول للقراءات متضاربة ومتضادة لا تمتلك أدنى واقعية فكرية .
تبلورت نظرية موت المؤلف مع الطرح البنيويّ، بالرغم من أن النقاش حول هذا المفهوم قد ابتدأ منذ النقد الجديد على يد الشكلانية الروسيّة، لكن هذه المدرسة قامت باستبعاد دور المؤلف وبتحييده عن النصّ، إلا إن البنيوية هي من قالت بموته تماماً، غارزة آخر مسمار في نعش المؤلف، تحديداً مع رولان بارت، وهذا الطرح يعتبر محاولة راديكالية لإقصاء سلطة المؤلف في إنتاج الدلالة وهيمنته على النّص، هذه الهيمنة التي امتدّت طوال فترة النّص الكلاسيكيّ، وتفاقمت لحدّ ديكتاتوريّة الدلالة وحقيقتها المنتجة في فترة النصّ السيادة المطلقة للنص الديني حتى أصبحت فعالية القارئ لا تتمّ إلا بمحاولة اقتناص ما يريد أن يقوله المؤلف، فيما يكتب وينتج من نصوص، إلا إن المدارس التي أعقبت تلك المرحلة قد فطنت إلى أن عملية القراءة تتكوّن من ثلاثة محاور، هي : المؤلف والنّص والقارئ، فقامت هذه المدارس بالتركيز على عنصر النّص وتدريجياً أصبحت عملية القراءة متطرّفة في إعطاء القارئ كامل السلطة في عملية التأويل والقراءة، وبالتالي في إنتاج الدلالة، بما يتجاوز أحياناً بنية النص ذاته الى التواري الكامل للمؤلف …
و يعتبر المؤلف بهذا الطرح منتجاً للنّص فقط، لا منتجاً لدلالاته ، فالقارئ يشتغل في عملية القراءة على نصّ لغويّ، ويتعامل مع كيفية عمل الإشارات داخل فضائها وبنيتها النصيّة وإدراك العلاقات الخفيّة بين هذه الإشارات، هذا النصّ يعتبر مخزوناً مكثّفاً من الإحالات الخارجيّة لمرجعيات تتجاوز فضاء الوقائع اللغوية، كما أن بنية التصوّر التي تحيلنا للقول بأن الرموز اللغوية تتكوّن دلالاتها من الشيء الخارجي، أي الإحالات للمرجعيات الخارجية، إضافة للصورة الذهنيّة التي ينسجها القارئ حول الرموز اللغوية المقروءة، مما يجعل دور المؤلف وهيمنته على النصّ معدوماً في عملية إنتاج الدلالة…
يحضرني في هذا السياق المثال الذي قدّمه الناقد الإنجليزيّ إمسون في كتابه ( سبعة أنماط من الغموض ) حيث قال عبارة بسيطة وناقش عملية إنتاج الدلالة استناداً على هذه العبارة، وأوضح قبل كل شيء أن العبارة التي قدّمها خالية من الغموض الدلالي والنحويّ والتركيبيّ والمجازي ، هذه العبارة هي ” القطة البنّية تجلس على السجادة الحمراء “، حيث قال بأنّ عملية إنتاج الدلالة للقرّاء ستكون مغايرة، فمنهم من سيركّز على أن القطة بنية اللون، ومنهم من سيركّز على الجلوس، بينما سيركّز آخرون على أن السجادة حمراء اللون، وأردف قائلا : بأن عملية إنتاج الدلالة في جميع الحالات صحيحة. ولا يمكن تخطئة القارئ بغضّ النظر عن قصدية المؤلّف من هذه العبارة… و هذه الدلالات التي أنتجت بناء على العبارة كانت إنتاجاً سلبيّا لا منتجاً، إذ لم تنتج عملية القراءة فعالية التأويل، فلو ترك القارئ للتأويل الفعالية التامّة لتوفّر لنا عدد من الدلالات بما قد تستدعيه القطّة من دلالات جنسيّة اجتماعية، وما تستدعيه السجادة الحمراء من دلالات سياسية أو دينية، دون أن يغيب عن ذهننا وضوح العبارة وقصرها…...
ولنا عودة ....














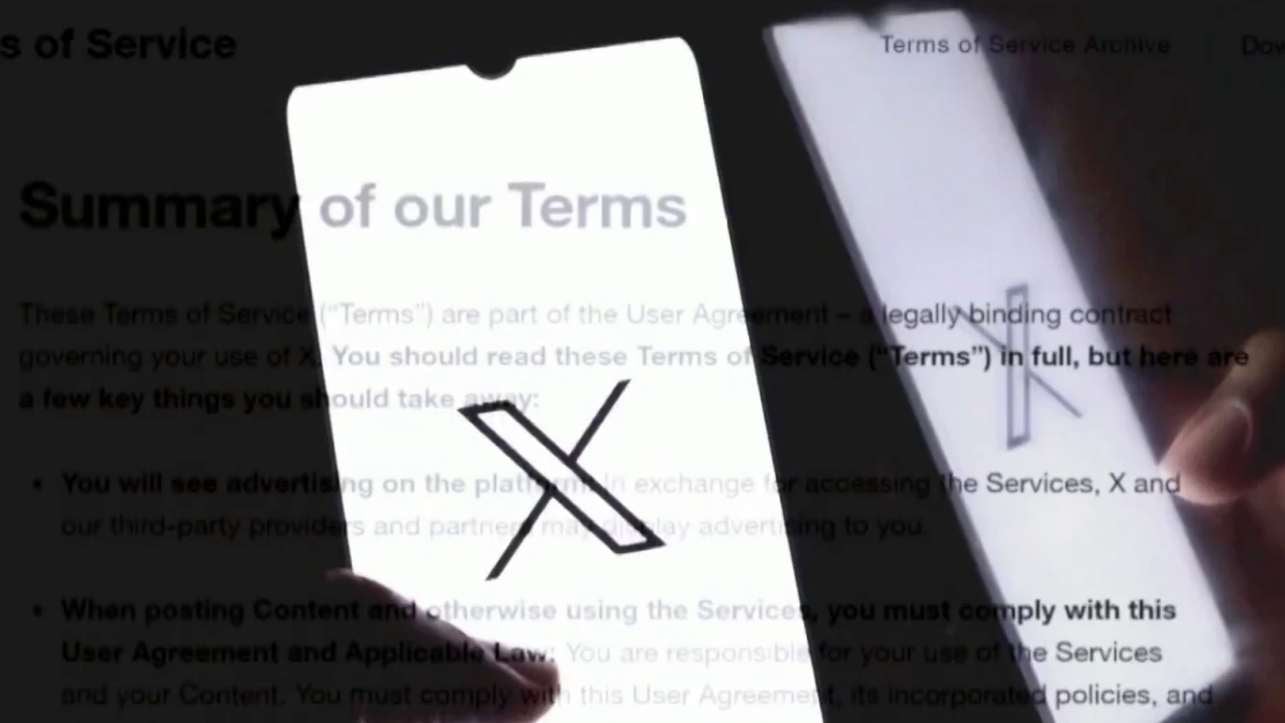





التعليقات (0)