مقدمة كتابي الجديد: البحرُ يقرأ طالعي

قصة هذه التجربة
ـ كيف تكتبين للحبّ في أزمنة الدمار؟
كنتُ ومازلتُ اُواجه هذا السؤال أينما ذهبت. وكنت ومازلتُ أردّ عليه بكل طاقة قلبي وقلمي على الدفاع، ربما بسبب إحساسٍ غامض بأن السؤال يُضمرُ بين طيّاته تهمةً يكون عليّ دائماً أن أدرأها عن نفسي.
وغالباً ما أتساءلُ: هل جرّب من يطرح عليّ ذلك السؤال أن يعقد صفقةَ حياته مع الموت؟ وهل جرّب معنى أن يكون صديقاً حميماً له؟ وأن يقاسمه الفطور وقهوة الصباح وأرق الليالي مروراً بكل تفاصيل اليوم التي جرّدتها الحروبُ من إنسانيتها طوال عقود من العيش في العراق؟
ومع هذا فثمة وطأةٌ أقلّ ثقلاً من سواها, وثمة موتٌ أكثرُ نُبلاً. أما الموت الجماعيّ والدمار الشامل والإنهيار والانقلابات السياسية والاجتماعية والنفسية، فإنها قد تقود الى خرَسٍ فكريّ وشللٍ في الأصابع وتبلّدٍ في المشاعر قد يفوقُ كلّ إحتمال أو وصف، وقد تعجزُ عن إستيعابه أعتى شطحات الخيال.
وهكذا كانت حالتي وأنا في بغداد ذات خريفٍ من عام 2003، أنا التي لم أكن قد تركتُ العراق الا لماماً منذ أن ولدتني امي حتى ما بعد ذلك التاريخ بما يزيد على العامين، وشاء قدري أن أكون، مثل ملايين غيري، شاهدة عيانٍ بإمتياز على كل ماحلّ ببلدي.
وفي ذلك الخريف تحديداً، كان قد ملأني إحساس جازم بأن الشعر قد هجرَني وهجرته الى الأبد. كنت أراه متربعاً فوق عرشه في مكانٍ ناءٍ بعيد كل البعد عما يدور، ولا يمكنه بأيّ حالٍ أن يستوعب بعضاً من بعض ما يحدث. كان يسمو في عليائه متفرجاً عند منطقةٍ موغلة في تَرَفِها، ولا قِبَلَ لي بالوصول اليها حتى في حلمي، وكأن ما جرى ويجري بدا أكبر من الشعر، أو أن الشعر بدا سماوياً في وقتٍ كانت بشاعته لا تصلح الا لأفلام الرعب، او لنشرات أخبار دامية يقتاتُ عليها المتفرجون، فيمصمصون شفاههم ويمضغون حسرتهم علينا.. نحن! نحن الذين كنا نعيش في قلب فلم الرعب دون أن يكون لنا أدنى ذنب!
..
وذات صباح من ذلك الخريف، جاءتني اختي بان، وهي مهندسة معمارية وفنانة تشكيلية وكنا نسكن مع اسرتينا الصغيرتين آنذاك في بيتين متلاصقين جميلين تحيطهما الحدائق وأحواض الورد. فاجأتني اختي وبين يديها لوحة زرقاء وهي تقول بفرح: أخيراً رَسَمْت!
كانت بان تشاطرني أحاسيس الذهول والإنسحاب، وكان الموت قد أخذ مكانه المعتاد بيننا بصفته جزءاً لا محيدَ عنه من تفاصيل حياتنا اليومية، وبصفته فرداً من أفراد عائلتنا وركناً أساسياً من أركان البيت. وكان الخوضُ في تفاصيل الدمار قد غدا سمةً تصبغُ أيامنا برتابتها المميتة. ناهيك عن فكرة الخروج من البيت التي كانت قد بدأت تتضاءل شيئاً فشيئاً، فالخطر في كل مكان. ومع كلّ هذا فقد إستطاعَتْ هي أن تحفرَ بأظافر إبداعها كوّةً في تلك الظلمة.
نظرتُ الى اللوحة؛ كانت زرقاءَ حدّ البوح، ولا تجسّدُ أكثر من صورة لامرأةٍ ورجل.. آدم وحواء! تأمّلتُها بصمتٍ طويل.. ولم أعد أدري من أي مغارةٍ منسيةٍ إنبجس دمعي نقياً سخيناً، فبلّل روحي وغسل الجوانح من ألمها، وداعب بدفئه معانٍ انسانية سحيقة كنتُ قد نسيتها في داخلي.
ترتبك بان فتقول ممازحة: لقد إعتدنا أن نبكي تأثراً بقصيدة نسمعها منك في امسية شعرية، ولم افكر مرة بما يمكن أن يكون شعورك أزاء من يبكي! ولكن ياإلهي! أن أرسم لوحة ويبكي الجمهور؟ لا.. هذا شعور جديد عليّ! .. لماذا تبكين؟
واجيب: لأنها رائعة! ولأنني سعيدة بك جداً لأنك إستطعتِ أن ترسمي، أما أنا فلم أعد أستطيع أن أكتب! ارجوك.. دعيني اُعلّقها هنا أمامي.. اريدها معي ولو ليلة واحدة.
وكان أن تبقى اللوحة أمامي طوال ذلك اليوم، تكلّمني وتحاكيني وأنا أروح وأجيء في البيت، وأخوض في تفاصيل يومٍ من كهرباءٍ مقطوع، وماءٍ متقطّع ونشراتِ أخبارٍ دموية وأصوات إنفجاراتٍ أو إطلاقاتٍ نارية عابرةٍ في خارجٍ لا يكفّ يشهر وجودهُ رغم أنف الإنسحاب، بينما تشخص أمامي حواء بزرقتها الفيروزية وآدمها، وتحدّثني عن عالم آخر تماماً: عالم بكرٍ إنسانيّ نقي أنيق.
وإذ باتت اللوحة عندي تلك الليلة، لم أشعر الا وخيوط الفجر تداعب جفوني وأنا بعدُ متيقّظة أكتب وأكتب! فقد أيقَظَتْ تلك اللوحة أربعة قصائد بدتْ وكأنها كانت مخبوءةً في مجاهل روحي فإنبجستْ مثلما إنبجس الدمع.
وقلت في نفسي بفرح: لا بأس.. مازلت أمتلك شيئاً من الشعر!
وبعد يومين جاءتني بان قائلة: لوحة اُخرى! فضحكتُ وقلت: مابالك ياعزيزتي؟ هذه أول مرة في حياتي أكتب شعراً بسبب لوحة.. هل تظنين بأن الأمر سهل؟ تعتقدين انه من الممكن لي أن أعود واُسطر القصائد من جديد فقط لأنك إستطعتِ أن ترسمي؟ لا أظن.. لقد غادرني الشعر وغادرته.. ولم يكن ما حدث قبل يومين سوى انفعال لحظي، أو حاجة لشيء من الجمال.
ولكنها علّقَتْ اللوحة وقالت: سنرى!
وأيضاً باتت اللوحة عندي في تلك الليلة، وأيضاً.. ولدهشتي.. كتَبْت!
..
وحتى تلك اللحظة، بدا لنا الأمر وكأنه مزحة، فلا هي كانت مقتنعة تماماً بما رسَمتْ ولا كنت أنا اصدّق بأن ماكتبته يمكن ان يكون شعراً. ورغم انني كنتُ معجبة بعملها وكانت هي معجبة بكتابتي، الا اننا كنا معاً نجد الامر أشبه بمحاولة لإستعادة شيء مفقود، او انه أشبه بالإحماء الذي يسبقُ بدء العمل.
وبعد أيام، وإذ كنتُ منهمكة في إنجاز عملٍ يوميّ روتيني، جاءتْ بان وقالتْ بإحباط: رسمتُ لوحة فاشلة جداً.
وقلت: ومن أين لكِ بأنها فاشلة؟
فقالتْ: أنا أجدها فاشلة!
فقلتُ بإصرار: هاتها لنرى.
رفضَتْ أول الأمر، وأمام إصراري، عادت لتطلعني على اللوحة سِراعاً وتمضي. ولم تكن أكثر من نظرة عابرة إلتقطتها من تلك اللوحة "التي قالت عنها فاشلة"، حتى إستحال كل شيء حولي الى شعر! وراحت الكلمات والصور تنهمر ببالي دون هوادةٍ وأنا لا أقوى على صد سيلها الجارف، حتى تركتُ عملي اليوميّ "الأرضيّ" على حاله وهرعتُ الى ورقتي، وراح القلم ينوب عني بفعل الكتابة!
..
ومنذ ذلك اليوم، وهي ترسم وأنا أكتب. كنا نبيتُ الليل كلٌ على حدة، ونصحو صباحاً – إذا نمنا – لتأتي إحدانا الاخرى بلوحة أو بقصيدة. ولم يعد مهماً أن أنتظر ما ترسم ولا مهماً أن تنتظر هي تأثير لوحتها على قلمي، راحت الألوان تحاكي المفردات بشكلٍ بدا مذهلاً متطابقاً في كثير من المرات؛ كأنْ أكتب القصيدة وأذهب لأقرأها لها فأجد لوحة مُعلّقة في بيتها تحاكي تفاصيل قصيدتي!
واستمرّتْ التجربة ثلاثة أشهر تقريباً، أنجزَتْ فيها بان ما يمكن أن تقيم به معرضاً كاملاً، وأنجزتُ أنا مجموعة شعرية كاملة. وفكرنا أن نؤطّر اللوحات مثلما نؤطّر القصائد، وأن نفتتح المعرض باُمسية شعرية!
لكن وطأة الموت كانت أثقلَ بكثير من أيّ فكرةٍ خلاّقة أو ابداع، ولم يكن بإمكاننا أن ننفّذَ هذا "الترف" في خضم مهرجانات الدم اليومية والصباحات المفخخة والمساءات الناسفة! كان اللون الأحمر المعفّر بالتراب في الخارج هو سيد المواقف كلها، بينما كنا أنا وهي نحاول أن ننأى بأحزاننا لنلعب بالماء على شواطئ مفترضة، ونطرطشُ زرقتَنا بطفولة بدَتْ خارج الزمن والمكان.
فوُئِدَ المشروع في مهده، ولم يرَ النور. وبعد سلسلة طويلة من الأحداث والكوارث تركنا العراق أنا وهي كلٌ الى بلد، افترقنا، مثلما إفترقَتْ ملايين الاُسر العراقية. وبقيَتْ اللوحات طيّ الحقائب، والقصائدُ في دفاترها القديمة تشكو ضيق الوقتِ وضيق الافق.
..
ولكن هاهي الآن بين أيدكم، ربما مارسنا عليها أنا وبان بعض التعديلات الفنية الطفيفة، وحذفنا منها او أضعنا ربما شيئاً من تفاصيلها الصغيرة، لكن المتن هو هو. وهي تجربتنا المشتركة الاولى التي قد نستطيع بها ان نجيب على ذلك السؤال المكرور: كيف نكتب او نرسم للحب في أزمنة الدمار؟
ولي اُضيف أيضاً: حينما نجلس وجهاً لوجه مع الموت، نجد أنفسنا مرغمين على التشبّثِ بالحياة، ونجد أنفسنا ونحن نحدّثهُ عن طفولتنا وعشقنا وابداعنا. وحينما نكون وجهاً لوجه مع القبح، نجد أنفسنا نتشبّثُ بالجمال والإبداع والرهافة. وحينما نواجه الشر والألم والعنف واليأس، فلابد لنا من لمسة خير او نسمة عافية أو شيء من التسامح والأمل. وحين نكون وجهاً لوجه مع الحرب، نجدُ إنسانيتنا وهي تستفزّ حمائمها وتطلقها للفضاء الرحب وهي تحلمُ بالبحرِ وبالإبحار.
هذه هي تجربتنا المتواضعة، وإن هي إلا محاولة لزرعِ وردة وسط حقلٍ من الألغام.
ريم قيس كبّة
القاهرة 3/5/2009
مقدمة كتابي الجديد: البحر يقرأ طالعي.. قصائد: ريم قيس كبة... لوحات: بان قيس كبة... وقد صدر مؤخراً في القاهرة عن دار مركز المحروسة للنشر.


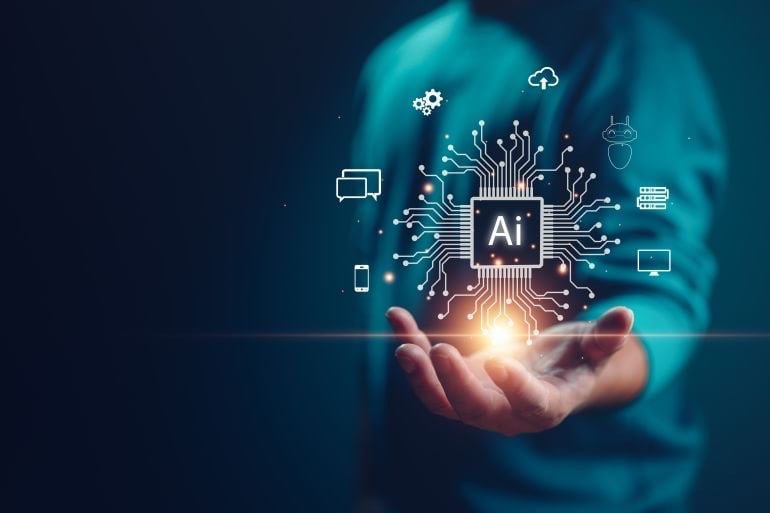

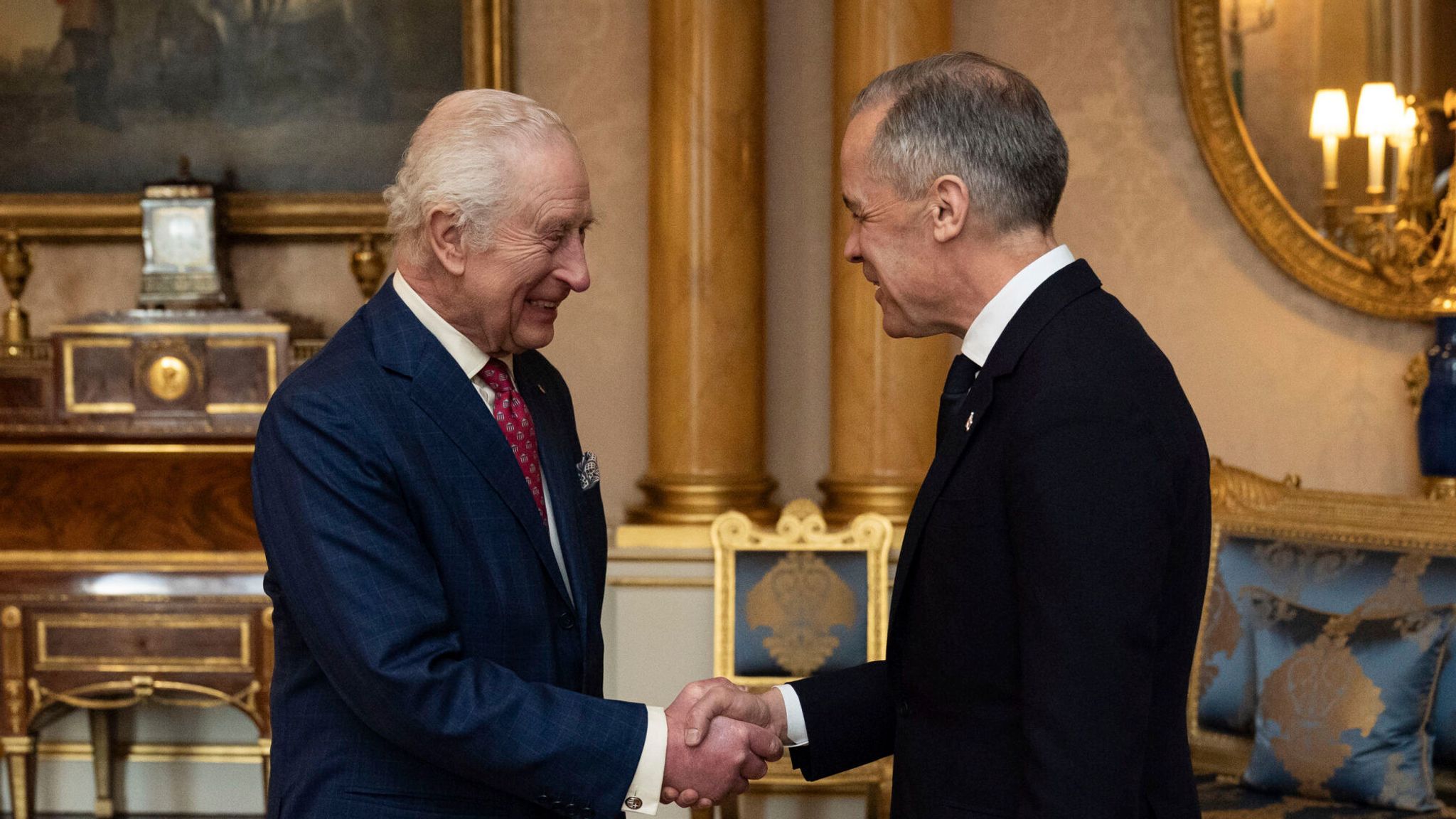
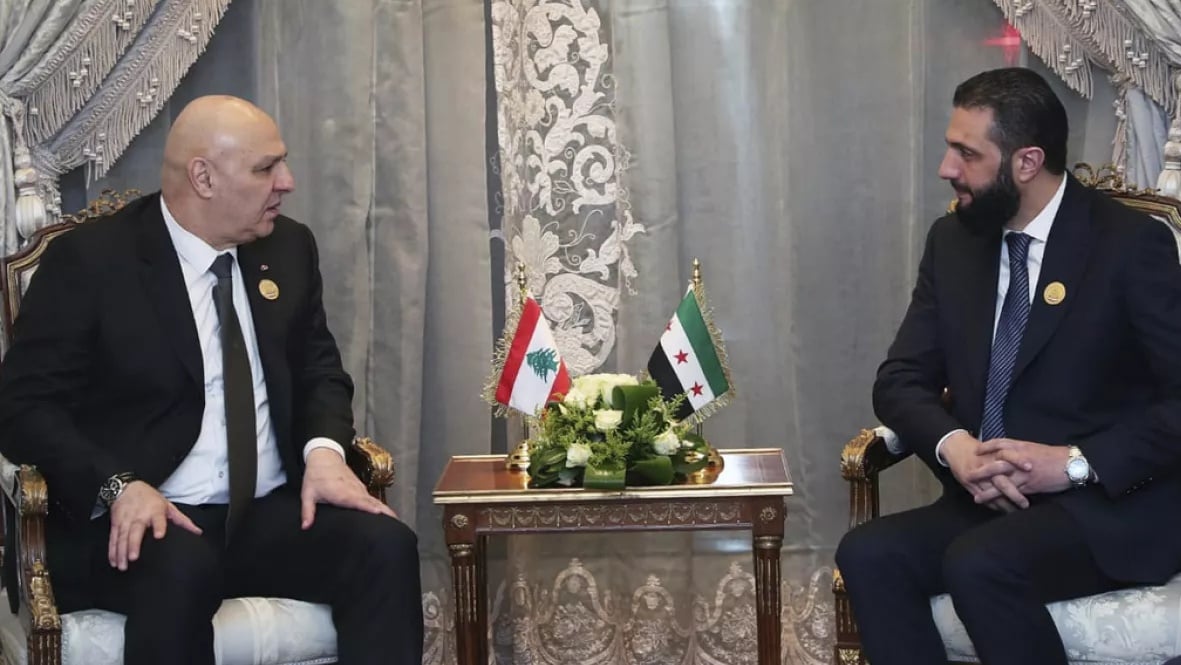














التعليقات (0)