ما بعد الإنسان

لا اذكر من قال هذه العبارة البسيطة في ناقشه عملية إنتاج الدلالة .. عبارة قدّمها خالية من الغموض الدلالي والنحويّ والتركيبيّ والمجازي والشعري ، العبارة هي : القطة البنّية تجلس على السجادة الحمراء ، حيث قال بأنّ عملية إنتاج الدلالة للقرّاء ستكون مغايرة، فمنهم من سيركّز على أن القطة بنية اللون، ومنهم من سيركّز على الجلوس، بينما سيركّز آخرون على أن السجادة حمراء اللون، وأردف قائلا : بأن عملية إنتاج الدلالة في جميع الحالات صحيحة. ولا يمكن تخطئة القارئ بغضّ النظر عن قصدية المؤلّف من هذه العبارة… و هذه الدلالات التي أنتجت بناء على العبارة كانت إنتاجاً سلبيّا لا منتجاً، إذ لم تنتج عملية القراءة فعالية التأويل، فلو ترك القارئ للتأويل لتوفّر لنا عدد من الدلالات بما قد تستدعيه القطّة من دلالات جنسيّة اجتماعية، وما تستدعيه السجادة الحمراء من دلالات سياسية أو دينية، دون أن يغيب عن ذهننا وضوح العبارة وقصرها .. قائل العبارة قالها فقط ثم رحل ولا يعنينا حضوره او ما هو الذي أراد أن يقوله .. هنا يأتي دور المتلقي الذي يقوم بعملية التأويل التي تتعدد بتعدد المتلقين .. القارئ هو الذي يصوغ الدلالة النهائية على النص فهو الذي يخلق النص في فضاءه الدلالي الجديد وتعدد مساحة الدلالة بقدرة القارئ على التحليل ونوعية ثقافته هنا يتوارى المؤلف وراء نصه ويظل حاله كذلك الى أن يغيب ويتلاشى تماما ....
ونجد هذا التغييب ينعكس أيضا على مستوى نظريات الأدب، إذ ارتفعت دعوات إلى موت المؤلف كما هو الحال مع نظرية النص التي قدمها رولان بارت، والمناداة بتحرير الرواية على سبيل المثال من نمطها التقليدي القائم على نظام الشخصيات إلى رواية حركية مبنية على أساس اللغة وبلبنات الألفاظ حيث لا تحضر الشخوص التي هيمنت كما هو الحال في الفضاء الروائي الكلاسيكي. كما تم تغييب الأحداث والزمن والمكان والخط السردى وطغت الفكرة في قالبا متشظي بحيث يظل كل قارئ لديه الحرية الكاملة في خلق دلالاته أو تصوراته عن النص الذي يمتاز أحيانا بنمط من التشعير ولا أقول الشعرية أي عملية تشعير النص الروائي بحث ينفتح على فضاءات لم تخلق بعد ودائما بطريقة التحريك الموسيفي للكلمة والعبارة واستدعاء الصوت بديلا عن البنية السردية .. وهذا تماما ما حدث لقصيد مابعد الحداثة وللفن والمسرح والنقد الموجه الى كافة هذه الحقول اذ راح النقد الحديث يتوضع داخل اطار الدلالة وامكانية تفكيكها بشكل مستمر وابتعد عن التأويل الذي ساد فيما قبل البنيوية
إن ظهور البنيوية واكتمالها بوصفها نظرية في الأدب، قد وضع العلاقة بين المؤلف والعمل موضع شك ونقد. فإذا نظرنا إلى البنيوية كمحتوى وليس منهجا تحليليا فقط، فإن هناك بنى قبلية تكون على الدوام تحت تصرف المؤلف ينهل منها على المستويين الواعي واللاواعي. وهذه البنى هي التي تشكل العمل الأدبي أكثر مما يشكله المؤلف. إن هذه البنى لا يستطيع أي مؤلف الفكاك منها. إنها تلازمه كظله في أثناء الكتابة. ونحن بالطبع ميالون إلى عد البنيوية محتوى أكثر من كونها أنموذجا قسريا يروم إدخال الخطاب في قوالب معدة سلفا أو حشره في بنى خارجة عنه، بل إن هذه البنى هي بالتأكيد محايثة للخطاب وتدخل في جوهر تركيبه.
وهكذا، فإن كل نص يوجد ويتكون داخل شبكة من النصوص الأخرى التي تحيط به. إنه يحيلنا إلى خطابات أخر ويندمج في حقل واسع من الخطابات، ويستند إلى ما كان قد قيل سابقا، كل ذلك من خلال البنى الجزئية التي تشكل الخطاب؛ وداخل هذا السياق البنيوي يغيب المؤلف. ولا تعود علاقة المؤلف بالنص تتجلى إلا في فرادة غيابه.
كل هذه التيارات السابقة قدمت بالتأكيد المبررات الكافية لموت المؤلف، ولكن اللسانيات الحديثة جاءت أخيرا لكي تقدم أداة تحليلية فاعلة من أجل تدمير المؤلف. فقد أوضحت لنا اللسانيات بشكل جلي أن التعبير في جملته إنما هو صيرورة فارغة تعمل بشكل مستقل دونما حاجة إلى ذوات المتخاطبين. فقد باتت اللغة تنتج المعنى بشكل تلقائي دونما حاجة إلى تدخل ذات المؤلف.
وهكذا أصبح ابتعاد المؤلف ابتعادا حقيقيا وظل يتضاءل حتى أصبح كتمثال صغير بشع . وأصبح النص يصنع من الآن فصاعدا ويقرأ بطريقة تجعل المؤلف غائبا على كافة المستويات.
أصبح النص فضاء لأبعاد ما متعددة تتزاوج فيها كتابات مختلفة وتتنازع من دون أن يكون أي منها أصليا أو مرجعيا، فالنص هو نسيج لأقوال ناتجة عن ألف بؤرة من بؤر الثقافة. إن الكاتب لا يستطيع إلا أن يحاكي حركة سابقة له على الدوام من دون أن تكون هذه الحركة أصلية وذات معنى الا في ذاكرته أي أنها ليست خلقا وفرادة .
وبالعودة إلى ساحة النقد، فإن موت المؤلف كان له أثر مماثل لما حدث في ساحة الإبداع. فالنقد الكلاسيكي كان يقوم على أسطورة فك رموز العمل الإبداعي منطلقا من نسبة النص إلى المؤلف مما يستتبع القول بمدلول محدد ونهائي وإغلاق الكتابة.
وهذا التوجه ملائما تماما للنقد الكلاسيكي الذي يسعى دائما إلى الكشف عن أقانيم المؤلف (المجتمع، التاريخ، النفس، الحرية) خلف ستار العمل الأدبي، وعندما يوفق النقد في الربط المنشود بين المؤلف وأقانيمه خلف ستار العمل الأدبي، يكون النقد قد حقق انتصارا، ولكن زعزعة المؤلف أدت أيضا إلى زعزعة النقد (وهذه نتيجة متوقعة)، لأن النقد الكلاسيكي كان دائما يستمد سلطته ومشروعيته من سلطة المؤلف. فالنقد الكلاسيكي لا يعترف بإنسان داخل النص سوى الإنسان الذي يؤلف ولا يهتم بالإنسان القارئ ولم يعترف بوجوده، وبعد موت المؤلف تنتقل اللعبة إلى ساحة القارئ.
إن النقد الألسني لم يعد يبحث عن أقانيم المؤلف كما في السابق. لأنه ببساطة لم يعد بحاجة إلى ذلك، إذ إن الخطاب يشي بكل الظروف التي رافقت تشكله. إنه يعكف على الاستدلال عن ذاته بذاته دونما حاجة إلى البحث عنها خارج الخطاب، والخطاب يتقمص كل حيثيات نشوئه، وهذا بالطبع يعفينا من أي بحث عن مبررات للخطاب من خارجه، فالمبدأ الأساسي في النقد الألسني ينطلق من مبدأ المحايثة، وهو دراسة النسق اللغوي في ذاته من دون العودة إلى تاريخه ولا إلى علاقته بأقانيم المؤلف، لم يعد كل ذلك لازما.
وعلى سبيل آخر إن الدعوات إلى تخليص الرواية كلياً من مفهوم الشخصية ومفهوم السرد والتاريخ ..الخ ! هو تصور يندرج في السياق الموغل في استبعاد الذات الإنسانية وتهميشها أو زحزحتها من مركزيتها الطاغية .. .
ومع هذا النفي المتعدد للكائن الإنساني والذي حصل مع سيكولوجية فرويد وتحليلات رولان بارت وميشيل فوكو وديردا وجويس وغيرهم ، يغدو السؤال عن معنى ودلالة الإنسان في الفكر المعاصر، فكر ما بعد الحداثة، سؤالاً ملحاً وضرورياً يفتح لنا أفقاً جديداً للتفكير النقدي هنا تكمن الخطورة في هذا الفكر .
فقد حدث انقلابا هائلا في دلالة الإنسان ومركزه حيث استبعدت فاعلية الذات، وأصبح ينظر إليها كذات تابعة مشروطة بمحددات خارجة عن إرادتها خارجة عن كينونتها التي ركزت عليها الفلسفات الوضعية والمثالية والعلموية والدينية على السواء ..
وليست الغاية هنا التوسع في المبررات التي أدت بفكر ما بعد الحداثة إلى إعلان موت الإنسان، فهذا يصلح أن يكون مبحثا مستقلا .. أرجو أن تعود الى فوكو .. في جانيولوجيا المعرفة .. وغياب الأنسان وموت المؤلف لرولان بارت ...
الذات الإنسانية التي هي مركز الكون لم تعد مقبولة في فكر ما بعد الحداثة الذي دمر كل المرجعيات والمطلقات وأحال الفكر إلى مسطح معرفي تندلق عليه المعارف بلا مرجعيات ولا عمق ولا اتجاه. إذ تصبح الذات الإنسانية في هذا المسطح ليست أكثر من ثنية أو انعطافة بلا اتجاه ولا عمق أو بالتعبير السوسيري تحول الفكر إلى انسيكلوبيديا معرفية بلا مرجعيات. وهكذا أصبحت الذات الإنسانية يوتوبيا زائدة يجب التخلص منها.
فإذا كان الإنسان يختفي أو يتلاشى في أفق الفكر الحديث، فإن مفهوم المؤلف والذات الواعية يختفيان هما أيضا لدى تحليل الخطابات. لقد كان شيئا لازما في العصور السابقة نسبة كتاب ما أو اكتشاف ما لصاحبه، إذ كان ذلك يعد علامة على صحته أو صحة المعلومات الواردة فيه. وكان الكلام يمتلك قيمته العلمية بمجرد عزوه أو نسبته إلى مؤلف ما. لكننا نلاحظ أن نسبة العمل إلى مؤلفه اختفت من ساحة الخطاب تماما وهذه نقلة بمستوى كافة الممكنات .
التفكيك نقلة في العمق
ليس التفكيك مجرد تقنية وإنما منحنى فكري يخترق النصوص الفلسفية ويرمي الى ما يحجبه الخطاب ويستبعده فيما هو يقوله ، أي تعرية آلياته في توليد المعنى ، أو إجراءاته في إنتاج الحقيقة، أو ممارسته في إخفاء سلطته وحقيقته ، كما يتعدى التفكيك النصوص الى سواها، فيعمد الى خلخلة الأبنية والممارسات وتفكيك الأنظمة الأجتماعية والسياسية والأخلاقية، للكشف عن مدى التلاعبات الكامنة وراء الأنساق التي تشكل الأسس التي تقوم عليها هذه الأبنية ، وقد ادى كل ذلك الى تحطيم النموذج الذي يصوغ الحقيقة و يحتكر الطريق إليها، والحقيقة اصبحت أشبه ما تكون بالصناعة التي ينجزها الفرد والمجتمع، ولم تعد هناك حقيقة متعالية . سواء بالمفهوم الفلسفي أو الديني، لقد تم تحطيم العقل الذي أنتج الفلسفة كما تم تحطيم اللاهوت الذي أنتج الدين .. وبتحطيم الذات العارفة لم يبق إلا نموذج ولكل نموذج قيمته النسبية القياسية على مستوى الغياب فقط ، ولكل قيمة حقيقتها فقط من خلال مستوى النظر ومستوى القياس ..الخ . لقد اخترق التفكيك الحواجز المنصوبة في ميادين المعرفة ومجالات الفكر، وهنا أصبحنا أمام ثورة معرفية قلبت كافة اليقنيات والمسلمات رأسا على عقب .
وللأسف الشديد ان الفكر العربي المعاصر المسجون في أطره الدينية التقليدية الما قبل عقلية لم ولن يتعرف أو يستبطن هذه الثورة الكبرى في المدى المنظور ، وأرجو أن تقرأ كتابي المرايا المحدبة والمرايا المقعرة التي صدرا عن سلسلة عالم المعرفة كشاهدي على استراتيجية الرفض التي يعاني منها هذا الفكر ... أشير الى هذين الكتابين للأهمية البالغة التي اعطيت لهما ..
يمكن الحديث عن أهم المعطيات النقدية التي قدمها دريدا صاحب النقد التفكيكيّ من خلال النقاط الآتية :الاخــتلاف ، نقد التمركـز ،علم الكتابـة ، . أنّ هذ العناصر تحيل الى القول بأن كلّ شيء مؤقت في المشروع التفكيكـي ، لأنّ جميع التراكيب والبنى هي في حالة صيرورة دائمة ، وقد تأتى ذلك من انحطاط النموذج الإنساني أمام النص ، وإنكار التقاليد الإبداعية لولادة النتاج البشري ، وعدم الثقة بالحقيقة المطلقة ، وترجيع كلّ شيء إلى عدم ثبات ،
إنّ تلمس الحقيقة في التحليلات النصية في المشروع التفكيكي هو محال ، وهناك تفسيرات مختلفة للنصوص لكنها لا تستند إلى حقائق نهائية ، ودور التحليل في هذا المشروع هو تحريك تفسيرات متعددة في قراءة نص معين ، ووفقاً لذلك لا تمثل اللغة انعكاساً طبيعياً للعالم ، لأنّ بنية النص هي التي تنظم ترجمتنا الفورية للعالم ، وهي التي تخلق مجموعة تجاذبات تسهم في فهم الحقيقة التي تتصف في المشروع التفكيكي بأنّها نسبية .لقد اكتشف جاك ديردا أنّ تاريخ الفكر الغربي من مجموعة ثنائيات متعارضة ومتضادة ( الرجـل ـ المرأة ، الخير ـ الشر ، العقل ـ اللاعقل ، الخطاب ـ الكتابة ، … ) ويشكل الطرف الثاني نقـداً ، وجانباً سلبياً للطرف الأول دائما في نظام الثنائيات هذا مما يجعل المعرفة تدور بين المجالين ثم تجعل النص هو المحور الذي يحرك الحقيقة بالإتجاه الذي يريد حتى يتحول هذا النص الى نظام خطاب يصعب اختراقه
الاختلاف: يشير هذا المصطلح عند ديردا إلى السماح بتعدد التفسيرات انطلاقاً من وصف المعنى بالتمدد وبالاستفاضة والقابلية والرجوع المحوري ، وعدم الخضوع لحالةٍ مستقرةٍ ، ويبين الاختلاف تعدد منزلة النصية في إمكانيتها التي تزود القارئ بسيل من الاحتمالات الممكنة ، وهذا الأمر يدفع القارئ إلى العيش داخل النـص ، لاقتناص الدلالة المرادفة للمعنى . إنّ المعطيات السابقة تقود إلى أن يغدو كل معنى مؤجلاً بشكل لا نهائي ، وكل دال، يقود إلى غيره من أنظمة الدوال ، دون التمكن من الوقوف النهائي على معنى محدد ، وتغدو عملية التوالد للمعاني مستمرة انطلاقاً من اختلافاتها المتواصلة ، التي تبقى مؤجلة ضمن نظام الاختلاف ، وتظل محكومة بحركة حرّة لا تعرف الثبات والاستقرار ، وكل هذا يشحن الدوال ببدائل لا نهائية لها من المدلولات ، الأمر الذي يكشف أنّ هناك بناءاً وهدماً متواصلين من أجل بلوغ عتبة المعنى .
التمركز : يقول ديردا عن هذا المصطلح أنه إمكانية كبيرة لفحص منظومة الخطاب الفلسفي الغربيّ عبر قرونه الممتدة زمنياً ، والمكتسِبة لخصوصية معينة في كلّ لحظةٍ من لحظاتها ، بوصفها المراحل المتعاقبة للبناء التدريجي للفكر الأوربي الحديث ، ويكشف هذا المعطى في الوقت نفسه عن التأمل الفلسفي المتعالي ، ويعمل على تعريته ، وتمزيق أقنعته بوصفها رواسب حجبت صورة الحقيقة .
والحقيقة إنّ تقويض التمركز يؤدي إلى تحطيم كلّ المراكز ، وتفكيك أنظمتها بدءاً من مركز كلّ شيء وهو ( الإله ) وهو سبب مركزي لكل الأحداث ، مروراً بمركز الحقيقـة ، وانتهاءً بمركز العقلانية ، ومنتجها العقل
وتتحدد رؤية التفكيك لفلسفة الميتافيزيقا على أنّها نظام مركزيّ من ناحية أنّ كلّ وحدة من وحداتها يرجع إلى مركزية ( الإله ) ، أو ( الإنسان ) ، أو ( العقل ) ، وقد دخلت هذه المراكز الثلاثة في علاقة جدلية عبر مراحل تطورها إلى أن وصلت إلى التفكيك .
اتسمت المرحلة الأولى بكون ( الإله ) هو مركز كلّ شيء ، وهو الأصل لكلّ الموجودات ، ، وفي المرحلة الثانية تخلخلت مركزية الإله ، واعتقاد الإنسان أنّه يستطيع أن يتربع على عرش هذه المركزية ، وفي المرحلة الثالثة طردت العقلانية المركز ، وأصبح اللاوعي ، أو اللاعقلانية هو المركز وأصل الأشياء ، ووصلت المرحلة الأخيرة إلى الشواطئ التي خلخلة كل تلك المراكز ، بحيث أصبح لكل تركيبٍ ونصٍ مركزاً خاصاً به ، يمثل المَعين الأساس للمصدر النهائي للعقل .
وقد تركت كل مرحلة من تلك المراحل أثراً في التحليل التفكيكي ، فالأولى تتسم بسيادة السلطة البابوية وسريان الحكم الكنسي الذي مزّق حضور الإنسان ( لا حظ أن العالم العربي والاسلامي لا يزال سجين هذه المرحلة ) بإحالته المستمرة إلى الميتافيزيقا في كل تفاصيل حياته ومظاهره الاجتماعيـة ، أما المرحلة الثانية فتمثل ردّة الفعلٍ على سلطة الكنيسة ، وتسلّم لإمكانية التواصل والإبداع بعيداً عن الاستناد إلى حكم يوظفه رجال الدين طبقاً لرغباتهم ، ولمصالح الأحكام اللاهوتية غير المُقنِعة ، وفي المرحلة الثالثة لم يستطع الإنسان قيادة رغباته وتطلعاتـه ، بل لم تقدم له عقلانيته طوق نجاةٍ لأزماته المتكررة ، وهذا ما دفعه إلى اللامعقول ، واللاوعي ، أو ممارسة فعل الأضداد على طول سلوكياته ، وتمثل هذه المرحلة تصورات ما بعد الإنسان وتوصف بأنّها مرحلة تأليهٍ لقدرات الإنسان ، وتأرجحٍ بين تمثيل وظيفة النص ، وإلغاء النموذجية الفردية الإنسانية التي هي أصل في خلق النص
أنّ مهمة الاستراتيجية التفكيكية هي تفادي تسكين المتعارضات الثنائية ، فمن خلال اختلافها يتولد المعنى وقد مثلت هذه المهمة الخطوة الأولى في نقد التمركز ، لأنّ ولادة المعنى كانت محكومة بسلطة اللوجوس ، والدلالات المتأتية من خلال هذه السلطة هي دلالات ذات صفة منطقية وعقلية
إنّ هدم التمركز ، هو إعلان عن تدمير جميع الدلالات التي تجد مصدرها في دلالة اللوجوس ، وتفكيكها ، وتذويب رواسبها المتعاقبة ، انّ جميع التحديدات هي غير قابلة للفصل عن هيئة اللوجوس الذي يحط من قيمة الكتابة المنظور إليها بوصفها وساطة لتحقيق القصد ، ويقود من ثمّ إلى السقوط في المعنى و إلى تحطيم الأصل الثابت للمعنى بوصفه مصدراً ، وتقويضه وتحويل كل شيء إلى خطاب ، وتذويب الدلالة المركزية ، ومن خلال هذه العملية تتحول الكتابة إلى أهمية قصوى ، ويصبح الاهتمام بالكلام مضمحلاً ، ولا شك أنّ التمركز حول العقل في الفلسفة قد نهض على الاهتمام بالكلام على حساب الكتابة ، وقد فتح هذا التوجه مركزاً آخر هو التمركز حول الصوت .
وقد شكلت نقطة اللوجوس بحدّ ذاتها تشعباً دلالياً ، وتفرعاً إيحائياً ، نظراً لما تحمله من موروث فلسفي ولغوي ، المنطوق على حساب المكتوب ، تحيل مفردة اللوجوس التي تختص بقِوى التحكم بالكون إلى فضاءات ثلاثة : فضاء اللغة والتشكل اللساني ، فضاء الفكر والعمليات الذهنية ، فضاء الكون وتُشكل هذه الفضاءات المُعادل الحقيقي لمصدر العقلانية في الكون كلّه والتعالي ، إنّه قضية فكرية ، وفلسفيـة ، وطروحات معرفية أشبه ما تكون بمتاهةٍ سادت بنية الفكر الانساني . إنّ الجدلية القائمة بين المركز ، والتمركز هي جدلية بين فعل السلطة والتسلط ، أي أنّ المركز يمارس سياسته في تنشيط حركة الدلالة ، وترتيب الأنساق ، ويتيح خلق بدائل مستمرة في أنظمة مختلفة ، أما التمركز فيمارس تسلطه ونفوذه في الإحاطة ببعض مصادر إنتاج المعنى وتفعيله كالعقل ، والكتابة …الخ ، ويقود إلى تمحور الخطاب حول نموذج معين
إنّ هدم التمركز ، هو إعلان عن تدمير جميع الدلالات التي تجد مصدرها في دلالة اللوجوس ، وتفكيكها ، وتذويب رواسبها المتعاقبة ، انّ جميع التحديدات الميتافيزيقية الحقيقية هي غير قابلة للفصل عن اللوجوس الذي يحط من قيمة الكتابة منظور أنها وساطة لتحقيق القصد ، ويقود من ثمّ إلى السقوط في خارجية المعنى ثم إلى تحطيم ذلك الأصل الثابت للمعنى بوصفه مصدراً ، وتقويضه وتحويل كل شيء إلى خطاب ، وتذويب الدلالة المركزية ، ومن خلال هذه العملية تتحول الكتابة إلى أهمية قصوى ، ويصبح الاهتمام بالكلام مضمحلاً ، ولا شك أنّ التمركز حول العقل في الفلسفة الأوربية قد نهض على الاهتمام بالكلام على حساب الكتابة ، وقد فتح هذا التوجه مركزاً آخر هو التمركز حول الصوت.
وقد شكلت نقطة الكلمة بحدّ ذاتها تشعباً دلالياً ، وتفرعاً إيحائياً ، نظراً لما تحمله من موروث فلسفي ولغوي ثم راحت تشكل المعادل لمصدر العقلانية في الوجود الإنساني برمته
علم الكتابة: تعتبر الكتابة ذلك الفضاء الذي شكل مركزية من نوع خطير في سياق التحولات في مفاهييم الدلالة النهاية للنص ذلك أن القارئ عادة ما يخضع للصيغ النمطية التي تنصب في قوالبها النصوص . فيقع تحت التأثير المباشر والغير مباشر للكتابة على حساب الرأي المخالف الذي من الممكن أن يستعيد الوعي حال قراءة ما هو مكتوب ثم يحوله الى منطوق الى صوت يبلغ تأثيره على الذات مرما بعيد ر . فيتحول المنطوق بفعل التقادم الى ما يسمى بالخطاب الشفهي المتداول ثم يعود مرة أخرى الى تثبيته كتابيا لمارس دوره التاثيري من جديد ثم يتحول الى منطوق وهكذا تستمر لعبة الخطاب والكتابة الى ما لانهاية حتى تتوارى الحقيقة داخل نمطية النسق الكلامي والنسق الاجتماعي والتاريخي .
يمكن أن اذكرك بالوقفة النقدية الكانتية ذات لاأثر البالغ في مسار الفكر والثقافة الأوروبية ، حيث لم يعد العقل قابلا للتأليه والتقديس، بل استحال إلى مجرد أداة محدودة في إمكانها المعرفي. كانت لحظة كانت انحرافا في الاتجاه الصحيح مع كتابة نقد العقل الخاص ,, وكتابة نقد العقل العام ....بدأت مع كانت الأرهاصات الأولى الى نقد الثورة على العقل .. ثم جاء نيتشة فصب جام غضبه على العقل في صورته الارسطوطليسة التي ظلت تتحكم بصورة المعرفة الممكنة الى عصر قريب لم يعد العقل هذا وسيلة صحيحة للمعرفة عن أية معرفة ممكن أن يكشف العقل و تكون معرفة صادقة وصحية .. ولذلك بحث نيتشة عن جدلية أو قوانين العقل التي تودي الى اكتشاف أو تقرير معارفة ووجد أنها قوانين زائفة باطلة متهالكة تقوم على مبدأ التضاد والتناقض ومبدأ الثالث المرفوع وتسرب اللاعقلنية اليه وغير ذلك وعندما فحص هذه القوانين كتشف زيفها الذي يقوم على التلاعب اللغوي ... ومع التوسير بدأت تنهار السرديات الفلسفية الكبرى ومدارسها لقد تحطم العقل وانسحق الفلسفة تحت هذه الضربات التي لم تكن بالحسبان ومع فوكو ويوتار ورولان بارت وجاك ديردا واسماء لا تحضرني بدأت مرحلة الانهار او الزلزال العظيم الذي شمل كل شيء بداية من الأدب مرورا بالمجتمع وانتهاء بالنص ومؤلفه وقارئه .. ومع كل هذا الغليان أو البركان اختفى الانسان عن المسرح ... بختفاء وانهيار مكوناته الزائفة التي تشكلت عبر التاريخ
ولم تكن ما بعد الحداثة ممارسة نقدية محدودة بل كانت ثورة وانقلابا على فلسفة الحداثة بكل تجلياتها.وإذا كان المشروع الحداثي من حيث الأساس اعلا من شأن الذات الإنسانية وقدراتها العقلية، فإن ما بعد الحداثة كان ضربة موجهة بالضبط إلى هذا الأساس وتفكيكا له، أي نقض العقل ونفي الذات. أو قتل الانسان بقتل أفكاره وتصوراته














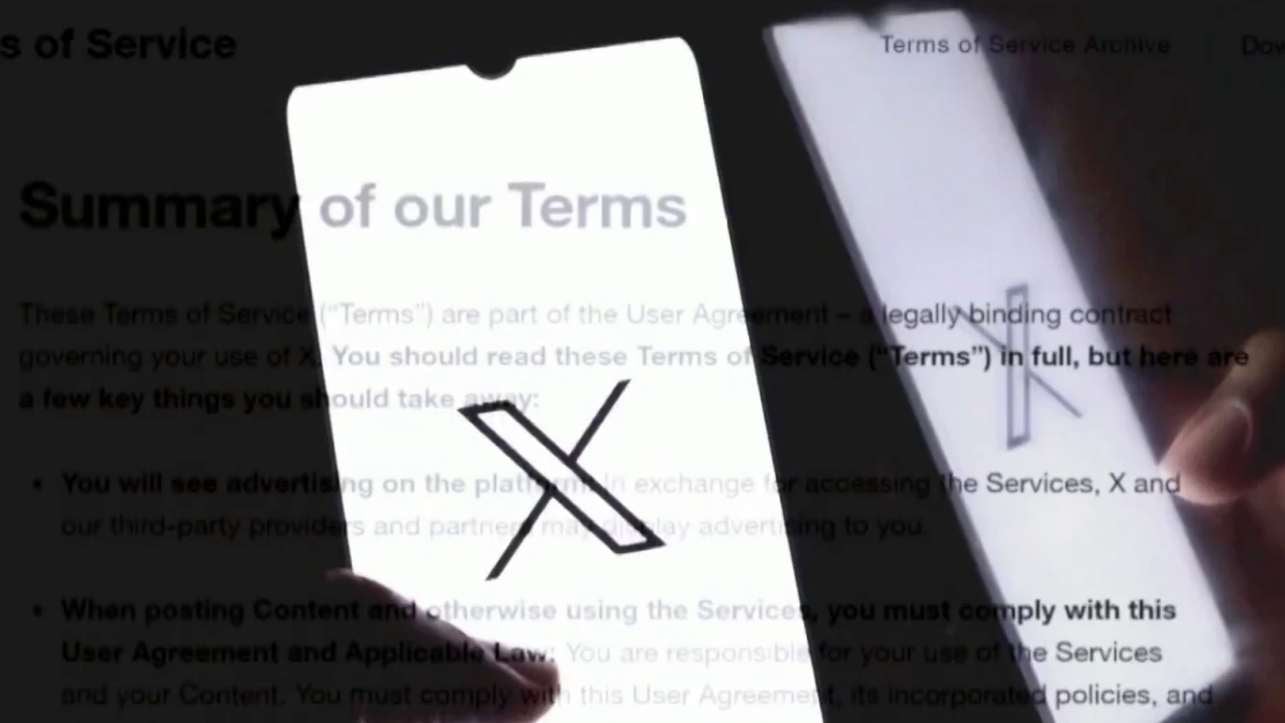





التعليقات (0)