مواضيع اليوم
ما الفرق بين مفهوم الجهاد و القتال

مصطلح الجهاد من المصطلحات التي عدت عليه العاديات، وجارت عليه النائبات، فأخرجته عن معناه الإسلامي الأصيل، وأبعدته عن كونه من خصائص منهج الإسلام إلى معان أبعدت النجعة عن فحواه، وحسرت عن مدلوله، مثلما حدث في غيره لكثير من مفاهيم الإسلام الأمر الذي أوجب العناية بمصطلح الجهاد واستجلاء معانيه اللغوية، ودلالته الشرعية غير أنه قبل الحديث عن تصحيح هذا المفهوم يتعين تقرير القواعد الآتية:
أولاً: أن السلم هو الأصل في البناء الفكري والسلوكي للمسلم.
وتلك حقيقة يعززها الاستقراء العام للشريعة في مقاصدها الكلية، وأحكامها الجزئية. التي تقرر أن السلام جزء من التركيب العقلي والنفسي للمسلم، بل هو جزء من خلقه الذي لقنه إياه الإسلام فكلمة الإسلام ذاتها مشتقة من نفس الجذر الذي اشتقت منه كلمات السِلم والسَلم والسلام والسلامة.
- فالسلام من أسماء الله الحسنى (الملك القدوس السلام المؤمن)([1])
- وسميت الجنة بدار السلام (لهم دار السلام عند ربهم) ([2])
- والسلام تحيته سبحانه لجميع رسله (وسلام على المرسلين) ([3])
- والسلام تحية الملائكة لأهل الجنة(والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ) ([4])
- والسلام تحية عباده الصالحين في الجنة (دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام) ([5])
- والسلام تحية المؤمنين لنبيهم عليه الصلاة والسلام (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)([6])
- والسلام تحية المؤمنين بعضهم لبعض (فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة) ([7])
وهكذا بين الله سبحانه وتعالى السلام في هدايته، وجعله تحية لأصفياء خلقه، وشعاراً لعباده المعترفين بفضله المؤمنين بحكمته، وقد تجسد ذلك في صورة التوجيهات العملية التي ساقها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته منها قوله عليه الصلاة والسلام(إن الله تعالى جمع السلام تحية لأمتنا وأمانا لأهل ذمتنا) ([8])وعن عبد الله بن عمر أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه أي الإسلام خير قال (تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف) ([9])
وفي الصحيح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم) ([10]) وهكذا تجتمع نصوص عديدة في الكتاب والسنة تسعى كلها إلى تكريس قيمة السلام في مجتمع المسلمين حتى ليكاد المسلم يلهج بالكلمة طيلة النهار في اللقاء والدخول والخروج على من عرف ومن لم يعرف.
ثانيا: السلام أساس التعايش مع المجتمع الإنساني :-
لقد تبدت عالمية الإسلام في قدرته على التعايش مع كل الجماعات البشرية غير المحاربة من نصارى ويهود، ملوك وفقراء، سود وبيض على مر الدهور والأيام بما شهد له العدو قبل الصديق وفق الموجهات التالية:
-
الاعتراف بأن الاختلاف بين بني البشر في الدين واقع بمشيئة الله تعالى فقد منح الله البشر الحرية والاختيار في أن يفعل ويدع وأن يؤمن أو يكفر(فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) ([11]).
-
الإيمان بوحدة الأصل الإنساني، والكرامة الآدمية انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى(ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا) ([12]) والرابطة الإنسانية بينهم قائمة شاءوا أم أبوا وهذه الرابطة تترتب عليها واجبات شرعية يتعين رعايتها والوفاء بها.
-
التعارف:لقوله سبحانه وتعالى (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) ([13])وكما ورد في الحديث (وأشهد ان العباد – كلهم- إخوة) ([14]) فالتعارف أساس دعا إليه القرآن وضرورة أملتها ظروف المشاركة في الدار أو الوطن بالتعبير العصري وإعمال لروح الأخوة الإنسانية بدلا من إهمالها أو التنكر لها.
-
التعايش:إذ أن حياة المتشاركين لا تقوم بغير تعايش سمح بيعاً وشراءً، قضاءً واقتضاءً ظعنا وإقامةً ، وتاريخ المسلمين حافل بصور التعامل الراقي مع غير المسلمين، وقد حدد الله سبحانه وتعالى أساس هذا التعايش بقوله(لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين)([15]) فغير المسلم إذا لم يبدأ بحرب، ولم يظاهر على إخراج فما من سبيل معه غير التعايش الجميل الملتزم بالبر، وهو جماع حسن الخلق، والقسط هو العدل والفضل والإحسان، وفي القسط على العدل زيادة معنى وفضل مراد.
-
التعاون: كثير من القضايا العامة تشكل قاسماً مشتركاً بين المسلمين وغيرهم ويمكن التعاون فيها كما أن الأخطار التي تتهددهم معاً ليست قليلة، ويمكن أن تشكل هذه القواسم المشتركة منطلقاً، للتعايش والتعاون وأهم هذه القواسم المشتركة ما يلي:
-
الإعلاء: من شأن القيم الإنسانية، والأخلاق الأساسية كالعدل والحرية والمساواة
-
مناصرة: المستضعفين في الأرض ومحاربة الظلم والطغيان.
-
الاستخدام الأمثل: لموارد البيئة وحسن التعامل معها.
-
تبادل المنافع: ورعاية المصالح والسعي لقيام شراكة إنسانية صحيحة ومعافاة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
ثالثاً : آفاق رحبة لمدلول الجهاد:
إنه لمن الإجحاف البين حصر معاني الجهاد ومضامينها في مباشرة القتال والقتل وامتشاق الحسام في وجه الخصوم فمفهوم الجهاد أوسع مدي ، وأكثر رحابة .
والمتأمل في الدلالة اللغوية والشرعية للجهاد في سبيل الله لا بد وأن ينتهي إلى أنه يشمل معاني عديدة متنوعة.
المعنى اللغوي:
الجهاد مصدر جاهد من الجَهْد والجُهْد وقيل الجَهْد: المشقة، والجُهْد: الطاقة تقول: أجهد جهدك وقال الليث:الجَهْد: ما جهد الإنسان من مرض أو أمر شاق فهو مجهود وقال ابن الأثير:بالفتح: المشقة وبالضم: الوسع والطاقة وقال الأزهري:الجَهْد:بلوغك غاية الأمر الذي لا تألو على الجهد فيه، وقال ابن عرفة:الجهد بالضم: الوسع والطاقة،والجهد بالفتح المبالغة والغاية والاجتهاد والتجاهد بذل الوسع والمجهود وحقيقة الجهاد :المبالغة واستفراغ الوسع في المدافعة باليد أو اللسان أو ما أطاق من شيء بينما القتال مشتق من القتل
كل مسلم مجاهد:
وعلى ذلك فإن كل مسلم يجب أن يكون مجاهدا وليس بالضرورة مقاتلا، إذ أن مجاهدة النفس والشيطان ،ومجاهدة المنكرات، ومجاهدة المشركين بالقلم واللسان والمال والسنان لا يتصور أن لا يكون للمسلم فيها نصيب بخلاف القتال الذي لا يتأتى إلا عندما تتهيأ أسبابه.
المعنى الاصطلاحي:
المستقصي لدلالة الجهاد الشرعية يجد أنها لصور متعددة، وصنوف متنوعة من بذل الجهد في سبيل نصرة الإسلام وليست مقصورة على صورة القتال ، فقد يكون:
- جهادا بالحجة والبيان فعندما بعث الله نبيه بالقرآن الكريم كان التوجيه الإلهي: (فلا تطع الكافرين، وجاهدهم به جهاداً كبيراً) ([16])أي جاهد المشركين بهذا القرآن.
- وجهادا للنفس ففي الحديث: (المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله)([17]).
- وصدعا بكلمة الحق ومنه قوله صلى الله عليه وسلم "أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر"([18]).
-وقد يكون جهادا بالمال ومنه وقوله صلى الله عليه وسلم "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم"([19])
- وكذلك يكون رعاية للأبوين: فعن عبد الله بن عمر قال : جاء رجل إلي النبي (صلي الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد ، فقال : أحي والداك ؟ قال : نعم قال : ففيهما فجاهد)([20]).
-وحج المرأة وعمرتها جهاد لا شوكة فيه كما صح بذلك الخبر
الجهاد في مأثور السلف:
- فقد عرف ابن عباس الجهاد بأنه : استفراغ الطاقة فيه ، ولا أن يخاف في الله لومه لائم.
- وجاء عن الحسن البصري أنه قال : إن الرجل ليجاهد وما ضرب يوماً من الدهر بسيف.
- وقال ابن المبارك: هو مجاهدة النفس والهوى
- وقال ابن تيمية: " الجهاد إما أن يكون بالقلب كالعزم عليه أو بالدعوة إلى الإسلام وشرائعه، أو بإقامة الحجة على المبطلِ، أو ببيان الحقِ، وإزالة الشبهة، أو بالرأي والتدبير فيما فيه نفع المسلمين أو بالقتال بنفسه"
- وذكر ابن القيم مراتب الجهاد:
-
جهاد النفس وهو أربع مراتب(1) جهادها على تعلم أمور الدين (2)وجهادها على العمل به بعد علمه(3) وجهادها على الدعوة إليه ببصيرة، وتعليمه من لا يعلمه،(4)و جهادها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله، وأذى الخلق.
-
جهاد الشيطان وله مرتبتان : جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات وجهاده على دفع ما يلقي إليه من الشهوات والإرادات الفاسدة
-
جهاد الكفار والمنافقين وله أربع مراتب:بالقلـب.واللسـان.والمـال واليـد.
-
جهاد أصحاب الظلم والعدوان، والبدع والمنكرات وله ثلاث مراتب: باليد إذا قدر المجاهد على ذلك فإن عجز انتقل إلى اللسان.فإن عجز جاهد بالقلب فهذه ثلاث عشرة مرتبة من الجهاد تبين على وجه التأكيد واليقين ان الجهاد ليس صورة واحدة أو حالة واحدة.([21])
من المفاهيم ذات العلاقة بمفهوم الجهاد:
الحرب: مفهوم الحرب في زماننا هذا أخذ أبعاداً أكبر من نشوب قتال بين دولة وأخرى أو بين مجموعة وأخرى فظهرت له مدلولات أخرى تمتد لتشمل الحرب الاقتصادية: التي من أسلحتها المقاطعة الاقتصادية وتجميد الأرصدة ونحوه.
الحرب الإعلامية: والتي من أسلحتها الانترنت والفضائيات والصحافة ونحوها.. من ضروب كحرب الدبلوماسية ـ والحرب الباردة ......إضافة إلى الحرب الاستباقية وغيرها.
الظهور والفتح:
إن الظهور والفتح لا يعنيان خوض المعارك وإعمال السيف في العدو فقط كما قد يتبادر للأذهان بل يمكن للمسلمين أن يفتحوا آفاقاً وأقطاراً فتحا سلمياً لا تراق فيه قطرة دم، فلا يشهرون سيفاً، ولا يطلقون طلقةً، ولا يعلنون حرباً، إنه (الفتح السلمي) الذي أصله الإسلام في صلح (الحديبية) المعروف والذي عقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش لإقامة هدنة بين الطرفين يكف كل منهما يده عن الآخر فسمى القرآن ذلك (فتحا مبينا) ونزلت في شأنه سورة الفتح وسأل بعض الصحابة الرسول الكريم:
أو فتحٌ هو يا رسول الله؟ قال:(إي والذي نفس محمد بيده إنه لفتح) إنه الفتح الحضاري الذي يدخل به الناس في دين الله أفواجا، فتح القلوب بالهداية، وفتح العقول بالفكر .
تعدد صور الجهاد في واقعنا المعاصر
ونخلص من تعدد صور الجهاد السابقة التي أشارت إليها الدلالات اللغوية والشرعية إلى عدم انحصاره في ميدان بعينه كما أن النظرة إلى الجهاد في واقعنا المعاصر يجب أن تكون متجددة على ميادينه التي اتسعت بتطور الزمن، وتسارع إيقاع الحياة، وبالنظر أيضا إلى ما يقتضيه حال المسلمين اليوم من وعي حضاري بطبيعة المعارك المعاصرة ومن ثم فإن من أهم أشكال الجهاد المعاصر:
(أ) الجهاد العلمي:
فالعالم من حولنا يشهد كل يوم تطورات علمية كبيرة بلغت حد اكتشاف خريطة الجينات البشرية، وهو لا يقل في أهميته عن غزو الفضاء، وهبوط الإنسان على سطح القمر، وهنا نتساءل: أين المسلمون من ذلك كله؟ أليسوا مطالبين دينيا بالكشف عن آيات الله في الكون وفى الإنسان؟ أين هم من هذا الرباط العلمي الدائم الذي هو جهاد حقيقي في سبيل الله؟
(ب) الجهاد الحضاري:
ويقصد به بذل الجهد من أجل صياغة مشروع حضاري إسلامي معاصر، يعبر عن رؤية شمولية لحاضر العالم الإسلامي، نتطلع بها إلى استشراف مستقبله، في ضوء الشهود الحضاري الرشيد بمتطلبات المرحلة وباحتياجاتها والتنبه الدقيق إلى وجوب معالجة المشكلات والقضايا التي تطرحها طبيعة الحياة بالعقل الحصيف، والتخطيط السليم والعلم النافع، والعمل المتقن.
(ج) الجهاد االروحي:
وذلك بإحياء الربانية الشفيفة ، وتجسيد القدوة الصالحة التي يكون التأثير فيها بدلالة الحال أبلغ من دلالة المقال ، بتزكية النفوس ، و صقل الأرواح ، وتهذيب الوجدان و التحلق في أفاق الرقائق و الحقائق ، و ارتقاءً في مدارج الإحسان .
(د) الجهاد الإعلامي:
من خلال تقديم المثل والقيم الإسلامية من خلال رؤية إعلامية ذات برامج هادفة، وقوالب جاذبة، ومناهج رشيدة، في ضوء الحفاظ على الثوابت الشرعية، والخصوصية الحضارية، مع الانفتاح الواعي على منجزات الحضارة الواعدة وكسبها المعرفي المتجدد، لنصون أجيالنا من الاستلاب الوافد الذي طغى على الفطرة فأفسدها وجنح بها عن استقامة الدين وهدايته.
(هـ) الجهاد الفكري :
بإحياء التجديد والاجتهاد الجماعي المؤسس الذي يجمع بين فقهاء الشرع، وخبراء الواقع لتقدم حلولاً ناجعة مرتبطة بالأصل ومتصلة بالعصر ، خروجاً بالأمة من حالة الجمود والتقليد والتفلت.
(و) الجهاد التنموي:
بذل الجهد من أجل تنمية مستدامة تفيد من تعدد الموارد الطبيعية، وتوفر الكفايات البشرية، والأرض الخصبة والموقع الجغرافي المتميز، لتحقيق الأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية والنهوض العلمي والتقني، وإزالة حالة الأمية، والتخلف، والجهل، والفقر، والمرض، فإذا استقلت الأمة بحاجتها من التكامل الاقتصادي كان ذلك عونا لها على استقلال قرارها من الارتهان والتبعية.
(ن) الجهاد السياسي:
للقيام بمقتضيات الحكم الرشيد القائم على التراضي، والبيعة الحرة، وبذل الشورى، وإقرار العدل، وكفالة الحقوق، والحريات، ورعاية ثوابت الأمة ومصالحها العليا، وتعزيز الشراكة الشعبية، والتزام المنهج السلمي قولاً وممارسة، وإحياء المصالحة الشاملة بين الأمة حكاماً ومحكومين، والوقوف في خندق واحد إزاء التحديات الماثلة.
رابعاً : أسباب مشروعية القتال في الإسلام:
القتال: مشتق من القتل وهو معنى مخصوص من معاني الجهاد .
أسباب القتال في الإسلام منحصرة في:
1. رد العدوان لقوله تعالى( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا) ([22])
2. القتال لمنع الفتنة في الدين (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) ([23])والفتنة هي مصادرة حرية الناس، واضطهادهم لأجل عقيدتهم، وإرغامهم على تغيير دينهم، كما حدث لأصحاب الأخدود، والقرآن يعتبر هذه الفتنة أكبر من القتل، وأشد من القتل، فمنع الفتنة مقصود أرفع من أن يكون مجرد هدف أرضي، ومبتغى أسمى من أن يكون مجرد مطلوب بشري، بل عبادة وطاعة وتوجه لله وحده لا يقصد به سواه .
3. القتال لنصرة المستضعفين في الأرض، لقوله تعالى (فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يقتل فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا)([24])
خامساً: القتال في الإسلام استثناء وليس أصلاً:
والقتال بهذه النظرة السامية لا يمثل أصلا وإنما جاء كحركة تحرير للإرادة الإنسانية من كل ضروب العبودية لبني البشر فقد حرم الإسلام القتال:
- لكونه مجرد إشباع للنزعات الذميمة، والرغبات الدنيئة.
- وأبطل الإسلام حروب العصبية العنصرية، مقررا أن الناس كلهم من أصل واحد.
- وأبطل حروب العصبية الدينية ( لا إكراه في الدين ) ([25]).
- ومنع حروب التشفي والانتقام للإساءات الأدبية( ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا) ([26]).
- وأنكر حروب التخريب والتدمير.
- واستنكر حروب التنافس بين الأمم في مجال الاستطالة والعلو والاستكبار في الأرض.
( ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة) ([27])
جاء الإسلام ليبطل كل هذا العدوان والعبث وليلغي كل هدف رخيص غير جدير بإراقة دماء هذا المخلوق المكرم
سادساً: أخلاقيات القتال في الإسلام:
إذا انعقدت الأسباب المشروعة لمطلوبات القتال فإن الإسلام أحاطه بقيمه النبيلة منها ما جاء في جاء النهي عن قتل النساء والصبيان والشيوخ والأجراء والفلاحين والرهبان والأحاديث في ذلك مستفيضة منها ما ورد:
- عن ابن عمر أنه قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان) ([28])
- وعن ابن أبي رباح رضي الله عنه قال:كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلا فقال انظر علام اجتمع هؤلاء فقال على امرأة قتيل فقال ما كانت هذه لتقاتل قال وعلى المقدمة خالد بن الوليد قال فبعث رجلا فقال :قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا) ([29])
- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان إذا بعث جيشا قال( انطلقوا باسم الله لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلا صغيراً ، ولا امرأة، ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين) ([30])
سابعاً: إشكاليات على طريق الفهم الصحيح للجهاد:
-
آية السيف
حيث ذكر بعض أهل العلم أنها نسخت كل الآيات السابقة ، وجعلت السيف هو الفيصل بين المسلمين وغيرهم ، ويجاب على هذا بأن آية السيف لم يتفق عليها ، فمن الناس من قال هي آية " وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة " وهذه ليس فيها نسخ بل فيها دعوة للمعاملة بالمثل، وقال آخرون هي آية " فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم " وهذه الآية نزلت في مشركي العرب الذين نكثوا العهود ولا دليل فيها على قتال من وفي بعده ، فقبل هذه الآية جاء قوله : " إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلي مدتهم " وبعدها جاء قوله " وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه " وقوله " فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم " . ومنهم من قال آية السيف " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " فهؤلاء وقفوا ضد الدعوة، وصدوا الدعاة وتآمروا على المسلمين فحق قتالهم وليس فيها دليل على قتال من لم يقاتل المسلمين أو يصد عن سبيل الله من الكفار.
-
حديث (بعثت بالسيف) ([31])
أما حديث "بعثت بالسيف-بين يدي الساعة- حتى يعبد الله وحده" فإنه ضعيف سندا ومتنا ، أما من ناحية السند: فمداره على عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وقد اختلف الأئمة في توثيقه، وتجريحه، والمجرحون له أكثر، وهم من أمثال الإمام أحمد الذي قال: أحاديثه مناكير، والإمام يحيي بن معين الذي ضعفه، والإمام النسائي وغيرهم.
وحتى الذين وثقوه: لم يوثقوه بإطلاق. بل منهم من قال: ليس به بأس،
وإذا غضضنا الطرف عن السند، ونظرنا في متن الحديث ومضمونه، وجدناه: مخالفاً مخالفة صريحة للقرآن، الذي لم يقرر في آية واحدة من آياته بأن الله بعث محمداً بالسيف، بل أرسله بالهدى ودين الحق، وبالبينات والشفاء والرحمة للعالمين وللمؤمنين.
وهذا ثابت بوضوح في القرآن المكي، وفي القرآن المدني، على سواء.
يقول تعالي في سورة الأنبياء، وهي مكية: ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) ([32])
ولو بعث الرسول بالسيف: لظهر ذلك طوال ثلاثة عشر عاماً، قضاها في مكة، وأصحابه يأتون إليه بين مضروب ومشجوج ومعتدى عليه، يستأذنونه في أن يدافعوا عن أنفسهم بالسلاح، فيقول لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. حتى هاجروا إلي المدينة، فأذن الله لهم: أن يدافعوا عن أنفسهم وحرماتهم ودعوتهم.
والخلاصة: أن هذا الحديث سواء نظرنا إلى إسناده أم نظرنا إلى متنه، فهو مرجوح في ضوء موازين العلم وقواعده الضابطة.
-
حديث (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله الله ...الحديث)
فإن شراح الحديث أفادوا بأنه ليس المقصود هنا بالناس كل الناس وإنما هم جماعة من البشر وهو المعنى المستخدم في بعض آيات القرآن كقوله (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا) وهو سياق يستحيل فيه عمليا أن تستقبل كلمة الناس باعتبارها كل خلق الله وثمة اتفاق بين جميع المسلمين على أن المراد بالناس في الحديث النبوي هم مشركو جزيرة العرب بوجه خاص لأن غيرهم من أهل الكتاب ومشركي غير العرب حكمهم يخالف ما جاء في الحديث.
-
حديث (من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو)
إذا كان المراد مجال التفكير الداخلي للإنسان، فإنه لابد لكل مسلم غيور أن يداعب خياله ذلك الحلم العظيم الذي يلهب المشاعر ويؤججها وهو أن يلقى ربه شهيدا مع النبيين والصديقين غير أن الحديث لا يدين كل مسلم لا يقاتل في سبيل الله الأمر الذي قد تشتم منه رائحة التحريض التي يحاول البعض اصطيادها من السياق؛ ولكنه يدين من لم يراوده خاطر الغزو حتى وإن لم يقاتل الأول يتهم إيمانه لأنه تقاعس عن النداء والثاني يتهم في إيمانه، لأنه بإسقاطه الأمر من وعيه كلية يبرهن أنه على غير استعداد للتضحية دفاعا عن عقيدته وذلك لا يعد تحريضا ولا تهييجا ولكنه نوع من التربية السامية التي تغرس في أعماق المسلم قيم الفداء والتضحية وبذل النفس والنفيس دفاعا عن دينه.
-
حديث الجنة تحت ظلال السيوف
فإن المقصود بالحديث هنا الحض على الآخرة وليس التحريض يقول العسقلاني: في شرحه"أفاد الحض على الجهاد والإخبار بالثواب عليه والحض على مقاربة العدو واستعمال السيوف والاجتماع حتى الزحف حتى تصير السيوف تظلل المقاتلين كما ان الحديث لم يقل إن السيف طريق وحيد للجنة ولكنه أفاد الحض على الآخرة، ثم إن الحديث قيل في مناسبة التعبئة لمعركة ولعلها الأحزاب ومثله حديث ( الجنة تحت أقدام الأمهات ) في إطار الحض على برِّهن، وقد علم أن أبواب الجنة ثمانية، ومنها باب الريان للصائمين لدلالة سعة رحمة الله تعالى، وتنوع أبواب الطاعات والصالحات .
-
غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم


















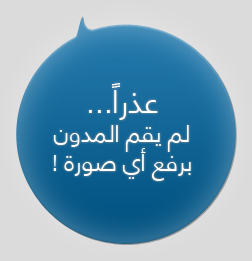
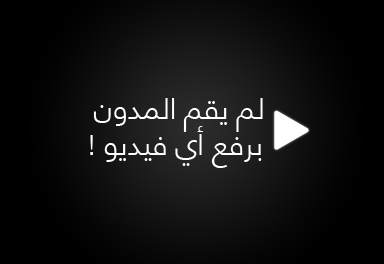

التعليقات (0)