ماذا لو لم يكن لدينا ذاكرة فأي الأوطان ستذكرنا ؟ .. مجرد ذاكرة سليطة..

سيدي السجّان .. سيدتي السجّانة ..
طاب سجنكما .. وطبتما ..
السجن النظربة أو النظرية السجن - حسبما اقترح صديق طلبتُ وده فجفا ..! - كيفما بدا العنوان .. لن يغيّر في المحتوى ..
أتيحت لي الفرصة أن أختبر نفسي بمعزل عن الأخرين ، حيث لا أقرباء ، ولا رقباء ، لا أصدقاء ، ولا أعداء حتى يتغصون عليك أو يغضبوك .
بدا البيت أشبه بعالم ينتابني كثيراً في أحلامي في الأونة الأخيرة ..أردتُ أن أجرّب أن أكون السجين والسجّان .. حيث يكون السجن اختياراً .. إذ تعبتُ من التنظير والمنظرين . دفعتني نفس تعيسة أن أختبرها فرضخت لتحريضها الذي بدأ مغرياً .
هاتفتُ صديقاً أثق في وعيه وفهمه ، شرحتُ له أن الأهل في سفر وأني في صدد ممارسة تجربة السجن الذاتي .. إستفهم ؟ .. فشرحتُ له أني بصدد حبس نفسي في غرفة لمدة عشرة أيام ، دون أن يكون في إمكاني استخدام الهاتف إلا بعد مضي المدة وألاّ يكون بجعبتي أي نوع من أنواع الدعم .. لا غذاء .. لا ماء ..لا سجائر .. لا كتب .. لا فراش ..فقط غرفة يسكنها الصمت ومحاطة بأربعة جدران صم ولا تحوي إلا البلاط.
طلبتُ من صديقي أن يحتفظ بمفتاح المنزل والغرفة بعد أن يقفل عليّ الغرفة من الخارج ، وألا يتخد أيّما تصرّف إلا بعد أن أهاتفه بعد انتهاء المدة ، وهي اللحظة التي أفتح فيها هاتفي المحمول .
كان الأمر بالنسبة لصديقي يبدو ضرباً من الحمق ، وأما لي فكان يبدو معرفةً جديدة واكتشافاً حقيقياً لنفسي . اطمئن صديقي - قسراً - حينما عرف اصراري ، وأرتاحت سريرته حينما عرف أن هناك وسيلة اتصال ستحدد الموقف . تم الإتفاق .. شكرته .. ودعا لي بالهداية ومزيد من العقل .
كانت الساعة بالضبط الرابعة عصراً ، حينما أصبحتُ وحدي داخل غرفة بدت كأنها غروب ليس بعده شروق .
كنتُ قد وفرّتُ كمية من الماء ، ووعائيين كبيرين لزوم الحاجات الفسيولوجية .. عدا ذلك كنتُ قد أخليت الغرفة من أي إضاءة قد ألجأ إليها في لحظة حرجة .
الأن يبدو المكان مناسباً للتجربة . في الساعات الأولى بدوتُ أكثر تماسكاً ، ثم ما لبثتُ إلا وأصُبتُ بإحساس الخجل والعار ، إذ بدأتُ أنظر لهاتفي المغلق وكأن نفسي تقول : أي حمق قادكَ إلى هذا التصرَف ..! أي حاجة جعلتكَ تجلدُني ..!
كان أجمل ماأنّس وحشتي هو صوت المؤذن الذي يذكرني بأني ما زلتُ صلباً .. إنه أذان المغرب ، والغرفة بدأت تتحول بعد أن امتزجت ألوان قزح ليبقى لون واحد أعتم الرؤية . الأن أصبحت طي النسيان ، وأصبح الرهان قيداً لي . أأستمر أم أتراجع .. ؟! بدت نفسي ضئيلة أمام هذا الإنهزام السريع ..! بدأ الصراع يلوّح من مسافات قريبة جداً ، وبدوت أقرب له مني . قررتُ في لحظة أن أتخلص من هذا العبء غير المُتوفع ، توسلتُ إلى كريم ظننتُه كذلك .. ولكنه أبى إلا أن يجعلني أغني له كي يمنَّ عليَ :
سرى ليلي سرى .. سرى ليلي
ألا وين الكرى .. سرى ليلي
واعدوني القمر .. إلى ظهر نوره ..
يرسلوا لي خبر .. أو خط أو صوره ..
واتركوا لي السهر .. والسهد في ليلي
واعدوني القمر .. مثل القمر خلي
إن وعدني ظهر .. وإن غاب يرسل لي
كيف خلي غدر ... وأهمل مراسيلي
واعدوني القمر ... واثر القمر ناسي
مثل خلي هجر ... يا قلبه القاسي
واعدوني القمر .. . واطفوا قناديلي
إستسغت الغناء ، وهذا الشجن القديم ، فرنت نفسي إلى حنين أخر ، فأستغثت بالذاكرة :
ما زلتُ أتذكر وصعب أن أنسى .. أأنسى تلك الغرفة الطينية الدافئة شتاءً رغم ضراوة الشتاء أنذاك ؟ ... التي لا أعرف مصدر دفئها ..!
أهي تلك الأنفاس التي تركت مساحات المنزل لتستوطن الزحام ؟
كنّا ننام في غرفة واحدة رغم أن في البيت غرف أخرى .. كان الترتيب كالتالي :
الفراش بمحاذاة الباب لأبي ، فأخي الأكبر ومن يليه فأنا .. فأمي ، فأختي الصغرى فالكبرى .. ولا أدري سراً لهذا الترتيب الذي دام سنيناً ..!
كانت الغرفة وخصوصاً في الشتاء الشديد تبدو وكأنها مدفأة تلتهم نوعاً من الحطب الأروستقراطي ..
أبنة الجيران - الفاتكة - ذات الخمسة عشر ربيعاً ، كانت أول أنثى تغتصب طفولتي .. الباب بالباب كما يقال ..وأنا أصغر من أن أفهم أو اُفهم ..
" الليلة نبي نتعلل عن جيراننا " ، هكذا أكدت أمي ..جيراننا وأبنتهم - المارقة - .. والساعة على وشك أن تجعل الصخب سكونا .. إنه موعد مسلسل " فارس بني عيّاد " ،ذلك المسلسل الذي يتسمّرُ أمامه كل الناس أنذاك ..فبمجرد أن يبدأ المسلسل وتلك الموسيقى التصويرية التي تدق في الأذان لتصبح فيما بعد صدى لا يُنسى .. بمجرد أن يحدث ذلك إلا وتجد الكل قيد العدم .. الجميع كانوا يكرهون " درغام " على ما أذكر .. ذاك الممثل اللبناني القدير - ميشيل ثابت <<<< يا عليه عيون كله شرّ .. كان يطارد بطل المسلسل " إحسان صادق " ليقتله .. ياه ! أي زمن ذاك الذي يتجلى فيه كل الناس .. الرجال والنساء ..الصغار والكبار .. لا وجود للنوايا السيئة .. لا وجود للمخاوف التي قد تُنتج أحاسيس مزدوجة كريهة .. أي زمن خسرناه ..!
دائماً ما أنام قبيل نهاية المسلسل .. أخرج من عالمهم لأدخل عالماً أخرا .. عالم الأحلام الصغيرة ..
أم جيراننا " خلوه لا تنكدون عليه .. خلوه ينام عندنا " .. هذا ما أكتشفه عندما أصحو في الغد .. أين أهلي ؟!
يالله ما أجمل ذلك الماضي !!
" خلوني " ، نعم دعوني أنام عندهم .. فليس أجمل من ذلك .. عادةً في الصيف ينام الجميع - أغلب الناس أنذاك - في " الطاية " ، إذ لا وجود للمكيفات عدا مرواح بدائية لا تفعل إلا النذر اليسير مقابل صيف لا يرحم .. إذ أشتد الصيف كان الناس يرشون شراشفهم بالماء ويعصروها حتى يتقوا لعنة لا يدرون من أين أتت .. طاية تحوي تسعة أشخاص كنت عاشرهم بين قمرين تشهد السماء لهما .. مارقتان لا مثيل لهما .. كنتُ أصحو عادةً في الليل لأجد نفسي في حضن لذيذ ، أو أجد من يساعدني على أن تتسلل يد صغيرة إلى عتبات فخذين بنعومة أحلامي .. كانت أنفاسها الزكية تقض طفولتي لتعيد حطامها بأبهى صورها .. أجد نفسي في الثلث الأخير من الليل وقد سكنت يدي الصغيرة مكان يشبه تفاحتين بينهما غصن رقيق .. دائماً ما كنتُ أسأل : لماذا يبدو فراش أبي فاتراً .. ؟! حتى عرفت السبب لاحقاً ..حينما اكتشفتُ لا تطاله " التماسيح " ..
أشعر وكأني في حلم لا ينتهي .. تمتد يدي لأتحسس إحدى التفاحتين .. تنتقل الأخرى وكأنها تريد أن تتأكد من حجم كل منهما ..
الغصن كان أكثر إغراءً حينما أحاول أن أعرف مقدار طوله ..فبالأصابع الصغيرة كنتُ " أشبره " صعوداً ونزولاً .. أكرر ذلك حتى يُهمس في أذني : يا ملعون توقف ..
بعد كل هذا الوقت ينتابني شعور حقيقي بأن روحي تصّعد إلى لذة لا أريدها أن تتوقف ..
لا أعرف كم من الوقت كنتُ أمضي مع تلك الشجيرة الأسرة .. ؟!
أصحو في الصباح الباكر لأرى وجهاً يبتسم للشروق : إنها شجيرتي المارقة ..
بدت الغرفة الأن أكثر ألفة .. مضت الساعات الثمان الأولى سريعة بسرعة إنتهاء شريط الذاكرة الماجن .. إنها الساعة الرابعة فجراً .. بدوتُ أكثر تعباً وأكثر ميلاً للنوم ..
نمتُ قليلاً إلى أن أُذن للفجر - الله أكبر - حتى خفت أن يصل إلى : الصلاة خير من النوم .. حكت نفسي : أي نوم تظنه أتياً ؟!
بعد الأذان - سيطر عليّ إحساس قوي أن أجرّب صوتي - لا أدري لمَ تذكرتُ هذه الأية " وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً " .. بكيتُ بإخلاص ..إي والله .. لا أعرف لمَ تطاردني صورة أبي .. ؟ ووجه وطن يشبه وجه طفل باك ..؟
هدأت نفس لعينة على إثر ضوء فريد في الإتساع والمعنى ..
في تلك اللحظات بدت لي تالا بعينيها الخضراوين وثغرها اللؤلؤي ، وتذكرتُ كيف تقول لي " بابا " : به به به به .. وكنتُ أرد ذلك بطريقة تفهمها وحدها لأسمع " كركرتها الإلهية " .. أحبوا الأطفال .. أحبوهم كما تحبوا أنفسكم .. إنهم منّة حقيقية ..
بدأتُ أتضور كل شيء .. الجوع .. العطش .. النيكوتين .. الأحباب والأصدقاء .. كان لدي هاجس وحيد وهو أن أمضي اليوم الأول من التجربة بنجاح ..
مضت ساعت لم أشعر بها .. سهلت عليّ البداية .. الأن أسمع " الله أكبر " فالظهر أقبل ..
صحوتُ على حلم يقول : أما زلت مستمراً في حماقتك ؟ .. لأجيب بجبن : أنّى لي أن أتراجع ؟
حسناً ..لا طعام ، لا ماء ، لا سجائر ، لا شيء .. ماأفعل إذن ؟
.. ولكنّها ملّت وكلّت .. فأي نوم هذا الذي يرضى بي .. ؟
عاد المؤذن ليؤنسَ وحشتي المبكرة ، حينما أذّن لصلاة العشاء ، وأنا دون عشاء ، وأمامي تسعة أيام ويزيد على هذه التجربة .
شعرتُ بالندم كثيراً لأني حرمتُ نفسي من القلم والورق والإضاءة - رغم أن الأخيرة قد لا أحتاجها نهاراً - ولكن هل أقبض على أحاسيس الليل نهاراً ؟! ..كنتُ أقول لربما ساعدني هذا الأمر على تمضية الوقت بتسجيل مشاعر حقيقية غير مزيَفة تنتابني وقد تنتابني في الأيام المقبلة - إن صمدت إرادتي - . الغرفة كانت مخنوقة وكنتُ أخنقها أكثر وأمامي جهاز التكييف الذي كان جزءاً من التجربة - لا لإستخدامه قبل إنتهاء الأجل - .. لم يسرّع الجوع ولا العطش بعد في جعلي أتأوه أو أتذمر ، إنما ذلك النداء الأخرق لإشعال سيجارة يفصلني عنها باب أخترتُ إغلاقه طوعاً .. أثرتُ أن أبحث عمّا يمنعني من أن تتسلل أصابعي إلى هاتفي ، أثرت ذلك وقررتُ أن أجد شريكاً لي في هذه التجربة .. كانت الذاكرة ..حاولت أن أختزل زمناً طويلاً قد ولّى لأسترجعُه في لحظات أشبه بأحلامنا ذات الثوان التي نظنها دهوراً حينما نحلم .
كأن الزمن يعود فعلاً .. وجدتُ نفسي أعود لعمر السادسة ، طفل يسكنه التطلّع دائماً إلى البحث عن " لماذا وكيف " ، ويسكن هو غداً بطئ .
في الصباح وككل يوم كانت أمي توقظني لأمر ماأحبته يوماً ، كانت السنة الأولى لي في المدرسة ، أصحو مقهوراً لأذهب للإغتسال وكأنه قادر على غسل وجعي ، لأعود إلى أمي من جديد وبيدها ثوب بطول ذاك الوجع . تُنهي إلباسي وتمشط شعري وتقول كعادتها : اذهب لأبيك - رحمه الله - ليعطكَ مصروفك " أربعة قروش " ، كانت توفر كأس شاي ونصف خبزة وجبنتين صغيرتين أبتاعهما من مقصف المدرسة ، وبعض الأحيان تُسرق تلك القروش من حقيبتي الحزينة ولم أكن أغضب لذلك ، فأنذاك كنا كلنا نسرق لنأكل .
أبي كان كل يوم يوصلني وأختي الصغرى إلى المدرسة بواسطة " سيكل " كان قد ابتكر صندوقاً كبيراً إلى حد ما ، وضعه في مؤخرة " السيكل " ، يتسع لطفل واحد فقط ، كانت مُدلّلَتُه من تحظى به ، أما أنا فكنتُ مُردفاً على " نعش السيكل " أمام أبي .
كالعادة ، تنزل أختي الصغرى أولاً إلى مدرستها ، ثم يستمر أبي بقيادة " السيكل " إلى مدرستي ليعود إلى عمله بصحبة أمله الذي توفى معه ، وهكذا يعود ليأخذنا بترتيب عكسي .
ما زلتُ أتذكر أختي الصغرى ، ذات الظفيرتان القصيرتان وكأن الزمن لم يسقها أماً لخمسة أطفال ، أكبرهم فتاة تذكرني دائماً بأختي ، عمرها خمسة عشر ربيعاً .. وكأن للأيام قدمين تكنولوجيتين تسابقان السابق ... ياالله ! ما أسرع ما تتكدس ذكرياتنا ويتأخر غدنا ..
لليوم ظهيرة وما أحقر السجن والسجّان !!










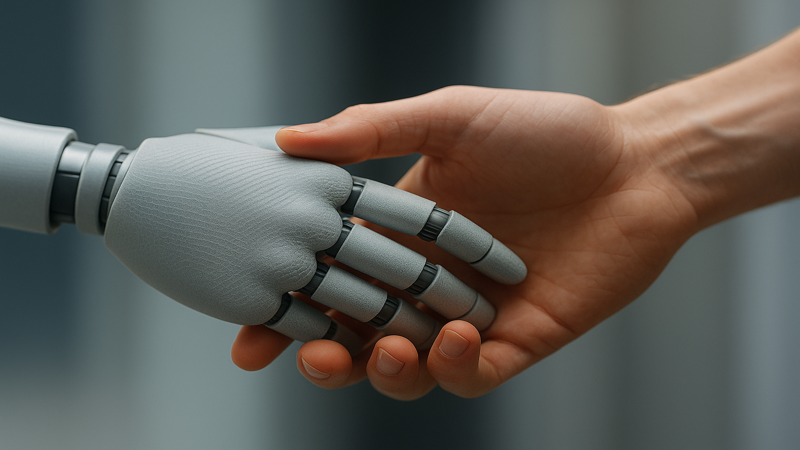









التعليقات (0)