كيف راح القرآن يشكل الاعتقاد

هذه الدراسة مهمة لأنها سوف تكشف لنا عن كيفية انبثاق الاعتقاد لأول مرة في التاريخ على الصعيد اللغوي والاجتماعي والنفسي، ثم كيف تجذر في النفوس وتغلغل فيها الى الدرجة التي راح يؤسس فيها الوعى الفردي والوعي الجماعي ،وهنا يفرض القرآن نفسه على هذا الصعيد كنقطة بداية ، ولكن الأولوية يجب أن تكون دراسة القرآن دراسة تاريخية لاهوتية، لأننا إذا ما أبتدأنا باللاهوت كما يفعل المسلم التقليدي إنتهى كل شيء، لأنه يزيل عن القرآن كل صبغة تاريخية، أي أن القرآن نص يعلو على كل زمان ومكان، وليس نص مرتبط بزمان ومكان معيين.
لابد أن نحرر النص المقدس بداية من كافة الاسقاطات العقلية التي اسقطت عليه لاحقا من قبل الأمة المفسرة ، وهي اسقاطات تراكمت فوق بعضها طيلة الأربعة قرون الأولى ، وذلك لا يتم إلا من خلال تحرير شروط القراءة النقدية للأفق التاريخي والمسار الزمني المتضمن نسق التلقي، أو التلقف للكلامات الأولى التي تلفظ بها محمد بشكل شفهي، أي قبل أن يتحول القرآن الى المدونة المغلقة التي ندعوها المصحف.
من حيث التسلسل الزمني يمكن القول بأن الحد الفاصل بين المرحلة السابقة على تشكل النص الرسمي المغلق ، والمرحلة اللاحقة على تشكله يمكن أن يحدد أو يرسم عن طريق التواريخ التالية :
المؤسسون الأربعة للمذاهب الفقهية السنية
ابو حنيفة ـ 150هـ
مالك بن أنس ـ 197 هـ
الشافعي ـ 204 هـ
ابن حنبل ـ 241 هـ
كتاب السيرة النبوية
ابن اسحاق ـ 150هـ
ابن هشام ـ 219 هـ
مؤلفو كتب الحديث الستة
البخاري ـ 256 هـ
مسلم ـ 261 هـ
ابن ماجة ـ 273 هـ
أبو داود الساجستاني ـ 279 هـ
الترمذي ـ 279 هـ
النسائي ـ 303هـ
الشهادات الإيمانية والعقائدية
عقيدة ابن بطة ـ 387هـ
عقيدة البربهاري ـ 329هـ
كتب التاريخ
تفسير الطبري ـ310 هـ
أما الشيعة الإمامية فلهم مدوناتهم نذكر منها:
الكافي للكليني ـ 329 هـ ، من لا يحضره الفقيه والعقيدة الإمامية ، لابن بابويه 381 هـ
ثم كتب ابو جعفر الطوسي ـ 460 هـ ، وكتب الشيخ المفيد ـ 413 هـ ، مؤلف كتاب الإرشاد ، ثم كتب الشريفين ـ الرضي 404 هـ والمرتضى 437هـ،
أما التواريخ القصوى فتتراوح بين ـ 767 ـ 1045 ـ . نلاحظ هنا وجود أسبقية زمنية سنية ، اي للفقهاء واللاهوتيين السنة، وتعود هذه الأسبقية الى علاقاتهم الوثيقة بالدولة الأموية ، ثم العباسية، وطبعا حاجات الدولتين ومطالبهما ، فالمذهب السني كان دائما مقربا من السلطة وفي ذات الوقت يخلع عليها المشروعية.
لقد حدد الغزالي الفقه بصفته قانون السياسة ، أي قانون السلوك الذي يتبعه كل مؤمن خاضع للمسؤلية الشرعية تجاه نفسه وعائلته ومجتمعه وطائفته، وأخيرا تجاه ربه ـ أي الإنسان المكلف ، ثم تلقى الفقه على سبيل الأولوية والأسبقية ذروة السيادة الروحية التي هي متمايزة عن ذروة السلطة من أجل أن يتكفل بمسؤولية الاستاذية العقائدية، أو مرتبة الاجتهاد والسيطرة على الاعتقاد الأرثوذكسي .
إن الذروة الروحية العليا مرتبطة بالخلافة الحاكمة فعليا ولكنها مستقلة عنها نظريا، وهي التي تقرر دمج أو رفض أي قبول أو نبذ المذاهب والحركات الفكرية الإسلامية كالمعتزلة، والمذهب الشيعي ، لقد نجح الشيعة الإماميون في فرض نصوصهم الخاصة مع تأخر زمني طفيف ، بالقياس الى السنة ، ثم أنتهى الأمر بالسلطة العقائدية السنية الى القبول بالاتجاه الصوفي المعتدل الذي يقبل بالاندماج داخل الأطر المحددة من قبل القرآن والسنة والاجماع ، وهي ثلاثة أصول حدد استخدامهما الصحيح من خلال علمين معياريين هما أصول الفقه الذي دشن مع رسالة الشافعي ، وأصول الدين الذي دشن مع الأشعري وأبي منصور البغدادي، ولكن اللحظة الحاسمة بالنسبة للتأليف ونشر النصوص الثانوية التي نصبت كأصل ثاني للذروة الإسلامية الخاصة بالهيبة الدينية العليا فتتموضع بين عامي 855 ـ 923 بالنسبة للسنة ، وبين عامي 940ـ 991 بالنسبة للشيعة الأماميين ، وأما الطبري فيمثل مرجعية أكثر أهمية وحسما من كل ما سبق لأنه يعتبر خاتمة المسار الذي أغلق به، ونقطة انطلاق لموقف معين للعقل، أو لنمط محدد في المعقولية والفهم ، أو لنظام معرفي خاص، وكلها أشياء استمرت في فرض نفسها حتى يومنا هذا بالنسبة لكل ما يمس الفكر الديني وتسيير شؤؤن الأعتقاد.
( هذا يعني أن الاعتقاد الإسلامي لم يتشكل دفعة واحدة منذ لحظة النبي محمد كما يتوهم المسلمون ، وإنما استغرق تشكيله أربعة قرون على الأقل من النقاشات والصراعات الحامية ، وبالتالي فهو عبارة عن محصلة لصيرورة تاريخية ، بطيئة ومعقدة ، ولكنه بعد أن تشكل أخذ يفرض نفسه كحقيقة مطلقة لا تناقش ولا تمس ، أخذ يخلع القدسية والتعالي على نفسه ويطمس تاريخيته. ولم يعد يسمح لأحد أن يكشف الغطاء عن كيفية تبلوره أو تشكله ، لأن حراس الأرثوذكسية الأشداء يخشون عندئذ من أن ينكشف الطابع التاريخي لاعتقادهم ونصوصهم التأسيسية ).
لنوضح هنا بشكل تفصيلي نقطة حاسمة أو أساسية، إن تأليف المدونات النصية المكتوبة ونشرها وتكريسها، أتاح للمسلمين تشكيل الذروة العليا للاعتقاد ، أي الذروة التي تعلو ولا يعلى عليها، أقصد الذروة التي يستمد منها جميع المؤمنين التحديدات أو الاحكام المقدسة الضرورية من أجل الاهتداء بها على الطريق والسلوك المثالي المستقيم، كما ويستمدون منها وسائل خلع الصلاحية على الاعتقاد وإعادة تنشيطه من جديد ، وهكذا تشكلت عبر الزمن استمرارية للساحة المعيارية الإسلامية ، وهي ساحة تشمل العبارات القرآنية ومراحل الحياة النموذجية أو المثالية للنبي ـ السيرة النبوية ـ ، ولأصحابه وبخاصة علي بالنسبة للشيعة ، ثم التعليم المتضمنة في الحديث النبوي ، ونلاحظ أن المؤمنين ( المسلمين ) يستشهدون في شتى حالات حياتهم اليومية ، وفي المناقشات العادية الجارية، بالآيات القرآنية والاحاديث النبوية ، هكذا بدون خطة محددة وكيفما اتفق ، إنهم يستشهدون بالآيات والأحاديث المكتوبة على هيئة قصص مصغرة، كما يستشهدون بمقاطع من حياة الشخصيات الرمزية الكبرى المدموجة داخل المدونة النصية الكبرى للاعتقاد الإسلامي ـ أي بأقوال الصحابة والأئمة والسلف الصالح ـ هذا يعني أن الاعتقاد المعاش من قبل المؤمنين يجهل التمييز الذي يقيمه الدارس المحلل سواء أكان مؤرخا أم عالم اجتماع أم عالم نفس ، بين القرآن بصفته سلسلة زمنية متعاقبة من التنصيص الشفهي ثم كنص رسمي مغلق من جهة / وبين النصوص الثانوية المبلورة من قبل الأمة المفسرة، لكي تدمج في المدونة النصية المثالية الكبرى ، والمنفتحة نسبيا للاعتقاد ، كل ما يبدو لهم وكأنه تجديد ، أو بدعة مفروضة عن طريق التطور التاريخي أو التعددية الاجتماعية ـ الثقافية للأقوام التي انتشر فيها الاسلام ، كان علم أصول الفقه قد قنن الشكلانية لهذا الدمج، أي دمج التاريخ الدنيوي في المدونة النصية الكبرى للاعتقاد ، حيث لاينبغي أن توجد إلا المعارف والسلوكيات الفردية والجماعية التي خلعت عليها المشروعية الإسلامية بشكل صحيح وموثوق، ونقصد بخلع المشروعية عليها إيجاد الباعث أو العلة القياسية التي تربط بينها وبين تحديدات كل المعاش البشري، الذي يقدم لكي يتصور ويدرك وكأنه إلهي ، وهذه هي الاحكام الشرعية. وهكذا أصبحت المدونات النصية الفقهية أي الكتب الفقهية عبارة عن مرجعيات إجبارية من أجل ممارسة العدالة أو القضاء في الدولة المؤمنة أو المجتمع المؤمن. ولهذا السبب فإنها تجيء لكي تقدم تأكيدا معقلنا لكل المدونة النصية الكبرى أو المثالية للاعتقاد. في الواقع أن هذه المدونة تشتغل أو تمارس دورها وكأنها وعاء لعمل جماعي متواصل من تشكيل الاعتقاد، وهذا الوعاء جامد من حيث عدد النصوص المتجمعة فيه، ولكنه يظل حيا وقادرا على الإنتاج الى ما لانهاية ، فيما يخص الاستخدامات الوجودية التي يتعرض لها المؤمنين الذين يعيدون تأويل معاشهم الدنيوي في اتجاه الطاعة للقانون الإلهي ، ويستخدمون من أجل ذلك تقنيات استدلالية للدمج ، أو بالأحرى لإلغاء التاريخية المحسوسة والدنيوية، من أجل توظيفها داخل إطار تاريخ النجاة في الدار الآخرة. هكذا نجد أنفسنا أمام أربع مدونات متمايزة من وجهة نظر الدارس : أي القرآن في وجهيه الشفهي والكتابي ، ثم الحديث في نسخه الثلاث السنية، الشيعية ، الخاريجية، وهو أيضا شفهي وكتابي ، ثم المدونات النصية الفقهية ، أي الكتب الفقهية والقضائية والتشريعية، ثم المدونة النصية الكبرى للاعتقاد . ولكن في الحياة اليومية المعاشة للمؤمنين نلاحظ أنه لا يوجد أي تمايز ينفصل ، وتمارس عملها بشكل متضافر ومتعاضد، بصفتها نظاما من المعايير والمرجعيات والتصورات التي ترسخ وحدة كل طائفة دينية كالبنيان المرصوص، اقصد ترسيخ وحدتها من خلال اعتقاد يعني في آن معا اعتبار كل العقائد والمضامين المسجلة كتابة والمحفوظة غالبا عن ظهر قلب بمثابة الصحيحة التي لا يعتريها شك، ثم اعتبار السلوك الذي يجسدها يوميا في حياة المؤمنين بمثابة السلوك العادل والصحيح أيضا ، فكل مؤمن يبرهن في تجربته اليومية على صلاحية هذه العقائد المعاشة أو المشهر بها أو المعترف بها ، ينبغي أن لا ينسى أن التسجيل الكتابي للنصوص لا يلغي أبدا العودة الى الاستخدامات الشفهية أثناء أداء الطقوس الشعائرية، أو المحادثات اليومية، أو الممارسة التعليمية والتربوية ، كيف يمكننا ضمن هذه الظروف أن نقوم بدراسة نقدية لكل مدونة نصية متمايزة دون أن ننتقص من الفعالية العلمية لما يمكن أن نسميه على غرار ما هو موجود في التراثات الدينية الأخرى ، بالتراث الإسلامي الحي ؟ أعتقد أن أن بإمكاننا تحاشي هذه العقبة المنهجية عن طريق المحافظة على مراوحة مستمرة بين المدونة النصية الشمولية للاعتقاد بالصيغة التي حددناها عليها آنفا، وبين المدونات النصية التي يغذيها وتؤبد طابعها الديني، أو روحها الديني الذي لا ينفصل عن الديناميكية أو الحيوية التاريخية لمجتمعات الكتاب المقدس. بعد أن تزودنا بكل هذه التحديدات الخاصة بالإطار التاريخي المفهومي ، نعود الى المدونة النصية التأسيسية التي ولدت كل النصوص الأخرى ، نعود الى القرآن بصفته مجموعة من العبارات الشفهية، إن التسجيل الكتابي لعدد غير محدود من الآيات في زمن النبي لا يغير في الأمر شيئا ، أقصد لا يغير شيئا في مسألة الصحة اللغوية البحتة لطريقة تشكيل المعنى في حالة التواصل الشفهي ، فالنبي تلفظ بالقرآن أولا بشكل شفهي أمام الصحابة قبل أن يسجل ما قاله كتابة ، وهناك فرق بين الحالة الشفهية للكلام والحالة الكتابية، إن المشكلة التي ينبغي أن يحلها كل تأويل علمي يقف أمام كلام شفهي أصبح نصا مكتوبا. هو بالضبط الاهتمام بدراسة الاختلافات الكائنة بين الحالة الشفهية التي ضاعت الى الأبد، وبين الحالة الكتابية للنص الذي كان له تاريخ شفهي قبل أن يسجل كتابة. لقد نوقشت هذه المسائل بإسهاب وتوسع من قبل علماء الألسنيات والانتربيولوجيا . إن التمييز الذي أقيمه بين ما قبل النص الرسمي المغلق، أي المصحف ، وما بعده لا علاقة له بمشاكل الصحة أو الموثوقية الخاصة بالمصحف العثماني، ولا علاقة له أيضا بمشاكل التضاد ذي الجوهر اللاهوتي بين الصحة الإلهية للعبارات الشفهية الأولى التي ينبغي علينا أن ننقذها بأي ثمن بصفتها تلك، وبين تدهور المعنى المتعالي لهذه الآيات بعد تدخل الكثير من المفسرين والمستهلكين لها ، سواء أكانوا مؤمنين أم غير مؤمنين ، في نهاية المطاف، فإن مشكلة المنشاء اللغوي في كلا النظامين الشفهي والكتابي يحيلنا الى مشكلة المكانة الفلسفية للمعنى الذي يتمايز عن آثار المعنى. وبالنسبة للآيات الأولى فإنه لا يمكننا أن نلجأ الى تفسير القرآن بالقرآن كما يقولون باعتبار هذه الطريقة الأكثر موثوقية من أجل شرحها وفهمها، وعندما أقول فيما بعد فإني أقصد بعد تشكيل النص الرسمي المغلق مع ترتيبه الاعتباطي للسور والآيات، إن القراءة التاريخية المحضة للقرآن تعيد لنا الظروف الواقعية لمعاصري النبي الذين قاموا بردود فعلهم على الآيات المتتالية ، ولكن ضمن تسلسل زمني ليس من السهل التوصل إليه أو التأكد منه . وبالتالي فيصعب علينا أن نكشف عن مراحل وآليات تشكل هذا الاعتقاد الذي كان في طور الانبثاق لأول مرة. أما القراءة اللاتاريخية ، حتى لو كانت غير لاهوتية، فإنها تسمح لنفسها بأن تنطلق من سورة الحجرات المرتبة برقم 49 في القرآن والتي تحتوي على تمييز واضح بين الإيمان / والاسلام ، فالإيمان يعني الاعتقاد المستبطن في القلب ، جاء في الآية السابعة من هذه السورة ( ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ) وأما كلمة الإسلام فإنها تعني شيئا آخر، يبدو أن سورة الحجرات المرتبة برقم 49 في القرآن هي تمثل في الواقع المرتبة رقم 114 ، وهذا ما كشفه المؤرخون الفللوجيون المحدثون الذين قاموا بترتيب زمن حقيقي لسور القرآن وآياته ( أنظر نولدكه وتلامذته) ، وبالتالي فإن السورة تحيلنا الى آخر فترة من فترات القرآن ، والى البلورة النهائية لمعنى كلا المفهومين الأساسيين ، مفهوم الإيمان ومفهوم الإسلام . وفي الحالة الراهنة للمناقشة لا يمكننا أن نقدم إلا بعض الملاحظات الإيحائية عن حصول تقدم ممكن فيما يخص تشكل الاعتقاد خلال العشرين سنة من عمر التبشير القرآني.
كان روبنسون قد تفحص ثلاثة ترتيبات لسور القرآن : الأول خاص بالنسخة المصرية النموذجية الرسمية لعام 1925 ، والثاني معتمد من شالي ، والثالث من نولدكة وهم الذين أكتشفوا الترتيب التاريخي الحقيقي لسور وآيات القرآن ، درس روبنسون موضعين أساسيين في النسخ الثلاث : موضوع النساء المرافقات للمؤمنين الذين يحظون بالجنة ، ثم الموضوع بالاسمين التاليين : الله ، والرحمن، وبعد أن درس الأمر عن كثب اكتشف أن الموضوع الأول يتكرر 12 مرة في القرآن . واكتشف أيضا أن بعض هذه المعاني تتحدث عن عذارى شابات ذوات صدور صلبة وأثداء متينة وعيون سوداء واسعة ، وأما بعضها الآخر فيتحدث عن أزواج مطهرة بكل بساطة ، واكتشف أن النسخة المصرية لا تتيح أن نلحظ أي تطور أو تغير في معالجة هذا الموضوع على مدار القرآن كله، وأما نسخة نولدكة فتكشف عن أن الوصف الأول يرد فقط في السور المكية، والوصف الثاني أي أزواج مطهرة فيرد في السور المدنية، وينطبق الشيء ذاته على كلمتي الله ، والرحمن، فالواقع أن كلمة رب ( أي السيد أو المولى ) لا ترد إلا في السور القرآنية الأولى أو المبكرة جدا ، وأما كلمة الرحمن والله فتردان بشكل متناوب ومتنافس في المرحلة المكية الثانية. وبعدئذ تفرض كلمة الله نفسها تدريجيا حتى تحذف كل ما عداها ، وذلك بصفتها المصدر الوحيد للاعتقاد والطاعة : أي الله بصفته الشخص الوحيد الذي يوجه إليه الاعتقاد والطاعة . إن احترام التسلسل الزمني أو الكنرولوجي للآيات القرآنية يتيح لنا أن نتعرف بشكل تاريخي دقيق على تلك المجادلة المتكررة ضد المعارضين العديدين ، وعلى المواقع الاجتماعية والسياسية للفئات الاجتماعية الموجودة على الساحة، وهكذا تمت بلورة أو إعادة بلورة المعجم اللغوي العربي السائد في العمق ، وذلك باتجاه المعنى الذي سصبح فيما بعد علم الاخلاق القرآنية . ولا تزال قوة هذه القيم أو جبروتها وتأثيرها على الفكر والسلوك تؤكد ذاتها حتى اليوم، وذلك على هيئة أشكال تاريخية واجتماعية ـ ثقافية ونفسية متنوعة ومتعددة، إن المعجم اللفظي المطبق على جماعات الفاعلين الموجودين على الساحة والمتنافسين والمتصارعين ، يعبر عن المنشأ الأول لدراما تاريخية، وينطبق على هذا الوضع ، اي وضع محمد في مكة وهو يجادل القرشيين ويحاول اقناعهم، نفس الخطة التي تنطبق على حكاية موجهة لتحفيف رغبة مشتهاة جدا ، فهناك من جهة الفاعلون المساعدون للبطل، وهناك من جهة أخرى الفاعلون المعارضون له، وبينهما تجري المعركة أو الدراما أو الحكاية حتى تنحل عقدتها ، ونلاحظ أن العبارات النصية المكية الأولى تحدد أولا وبعبارات رؤيوية استشرافية الهدف الأعظم للبحث والحالة التي ينبغي تغييرها وهذا الهدف يتمثل بكل بساطة بـ ( رب العالمين ) الذي كان آنذاك ( رب القبائل ) فقد راح الخطاب القرآني يستملكه تدريجيا بصفته شريكا متعاليا ، خلاقا ، فاعلا للخير، وحاميا للإنسان ، كما تتحدث الآيات القرآنية الأولى عن أمة المؤمنين الرشيدة أي ( الأمة ) . وهؤلاء المؤمنين مرتبطون شخصيا عن طريق ميثاق الطاعة بأوامر الرب الذي أصبح الله بعدئذ، وبمحمد بن عبد الله الذي أصبح فيما بعد رسول الله، وأما المعارضون لهذا البحث فانهم يشكلون فئة الكفار ،( أي الكنودين أو الكافرين بالنعمة أو الجاحدين لنعمة الله ). وفيما بعد سصبحون لا مخلصين أو مضادين للمؤمنين في المزدوجة المشهورة كافر/ مؤمن ، وهنا نجد أن تصرفات اللاإخلاص أو الخيانة سوف تتخذ كوسيلة لتبيان محاسن الإيمان الحقيقي ، الحارـ المجرد عن كل الحسابات والخاص بالمؤمنين، ثم هناك فئة المنافقين الذين يخفون موقفهم الحقيقي ويظهرون غير ما يبطنون، وهم ينضمون الى جماعة الأنصار أو المساعدون لغايات مصلحية أو لتحقيق منفعة شخصية. ثم هناك فئة العرب بحسب المعنى القرآني للكلمة ، أي عرب الصحراء الذين يرفضون صراحة أن ينضموا الى قضية الله ورسوله ، ويبدون بذلك أكثر أنواع الكفر غرورا وتبجحا ( الأعراب أشد كفرا ونفاقا ) ثم هناك فئة المشركين ، أي الذين يؤمنون بتعددية الآلهة ، وهو الدين العربي الذي كان سائدا قبل ظهور الإسلام ، والذي يتمثل كل المشروع القرآني في إعادة تحديده، وتغييره وتحويله، أو إعادة توجيهه في اتجاه ما سيصبح بعدئذ دين الإسلام، وهناك أخيرا فئة أهل الكتاب الذين استفادوا سابقا من نعمة الله وهداه، وكذلك نعمة أنبيائه وهداهم، ولكنهم يصرون على انكار آخر مبادره اتخذها الله لكي يعيد تنصيب الميثاق في حقيقته الأبدية هذا الميثاق الذي خانوه وحرفوه. ننتقل الآن الى جهة المساعدين أو الأنصار ، أي أنصار محمد ، نسجل أولا الملاحظة المهمة التالية: هي أن كلمة الصحابة لا ترد في القرآن . والواقع أن هذه الفئة أو المقولة سوف تشكل لاحقا وتمجد وتزين وتعظم ، وأما في القرآن فنجد مصطلح المهاجرين أي المعتنقين الأوائل والذين تخلوا عن عصبياتهم الدموية والعشائرية القديمة لكي يتبعوا محمد الى المدينة ، ونجد في القرآن أيضا فئة اولئك الذين آمنوا، وقد تميزهم عن أولئك الذين أظهروا اعتناقا ظاهريا أو سطحيا للإسلام، يمكن القول أن الخطاب القرآني يبرز الإعتقاد الجديد على مدار كل مراحل تطوره، وفي كل الظروف على هيئة عقدة مسرحية أو حبكة روائية ، وهذا الاعتقاد الجديد هو الذي سوف يحسم المصير الآتي والخلاص النهائي لكل القوى الفاعلة في الساحة ، أو المتصارعة في ذات الساحة ، فهم جميعا مدعوون أو منذرون ، بحسب الحالة، الى أن يصغوا الى الآيات البينات المقدمة لهم ، والى أن يفتحوا قلوبهم لها وأن يعقلوا الآيات والإشارات المقنعة والصريحة الدالة عليها، إن عرض الأمور على هيئة حبكة مسرحية يدل على الصراع الدامي الحاصل من خلال المواجهة ، كما يدل على النهاية غير المضمونة لهذا الصراع ، ( على الأقل ما قبل العودة الى مكة ) ، إنه يدل على المعركة الحاصلة بين الخير والشر ، بين الجهل والعلم ، بين الضلال والهدي الإلهي الذي ينتهي أخيرا بيوم الحساب الذي لا مفر منه ، والذي يحدد فيه الهلاك الأبدي أو النجاة الأبدية لكل نفس ، إن هذا العرض التحليلي للبنية الدلالية التي تقبع تحت كل العبارات النصية القرآنية لا ينبغي أن ينسينا ذلك التشكل التدريجي للاعتقاد بواسطة المسات البسيطة أو الإضافات ، أو التصحيحات ، وكل هذا قبل أن نتوصل الى الإعلانات القوية والظافرة والتمييزية ، والأمرية التعليمية أو الأرشادية لسورتي التوبة والمائدة، سوف نسجل هنا إحدى السمات الحاسمة للفضاء البلاغي والمعنوي للخطاب ، نلاحظ أن التحديدات الزمنية ، والمكانية والوقائعية الإحداثية ، وأسماء الأشخاص ، كلها تحاشاها الخطاب القرآني بسشكل منتظم وعلى طول الخط . ( إن مهارة الخطاب القرآني تكمن بالضبط في عدم ذكر الأشياء بأسمائها ، ولذلك يتخذ طابعا كونيا غير مرتبط بفترة محددة ومكان معين ، ولكي يصبح صالحا لكل زمان ومكان ) ، فجماعات المتنافسين أو المتحاربين حولت الى أبطال لدراما روحية . والأوضاع الاجتماعية والرهانات المحسوسة التي يدور الصراع حولها تم تساميها أو تصعيدها الى نماذج عليا السلوك والخيارات المتكررة التي تحسم حتما المصير النهائي لكل نفس ، أقصد لكل واقعة في مواجهة الإغراءات والإكراهات وعصبيات الحياة الدنيا ، كما أنها تواجه في ذات الوقت النظرة الصارمة والمستبطنة لإله شديد الحضور في الخطاب التأسيسي ، إله يعرض نفسه في كل مكان ، ويشهد على نفسه في كل مكان من هذا الخطاب ، وبشكل ملح ومتنوع الى أقصى الحدود . وهذا الحضور المهيمن لله في الخطاب القرآني سوف يشهد فيما بعد توسعات وتحولات تصعب الإحاطة بها .
كاتب أردني مقيم في نيوزلاندا














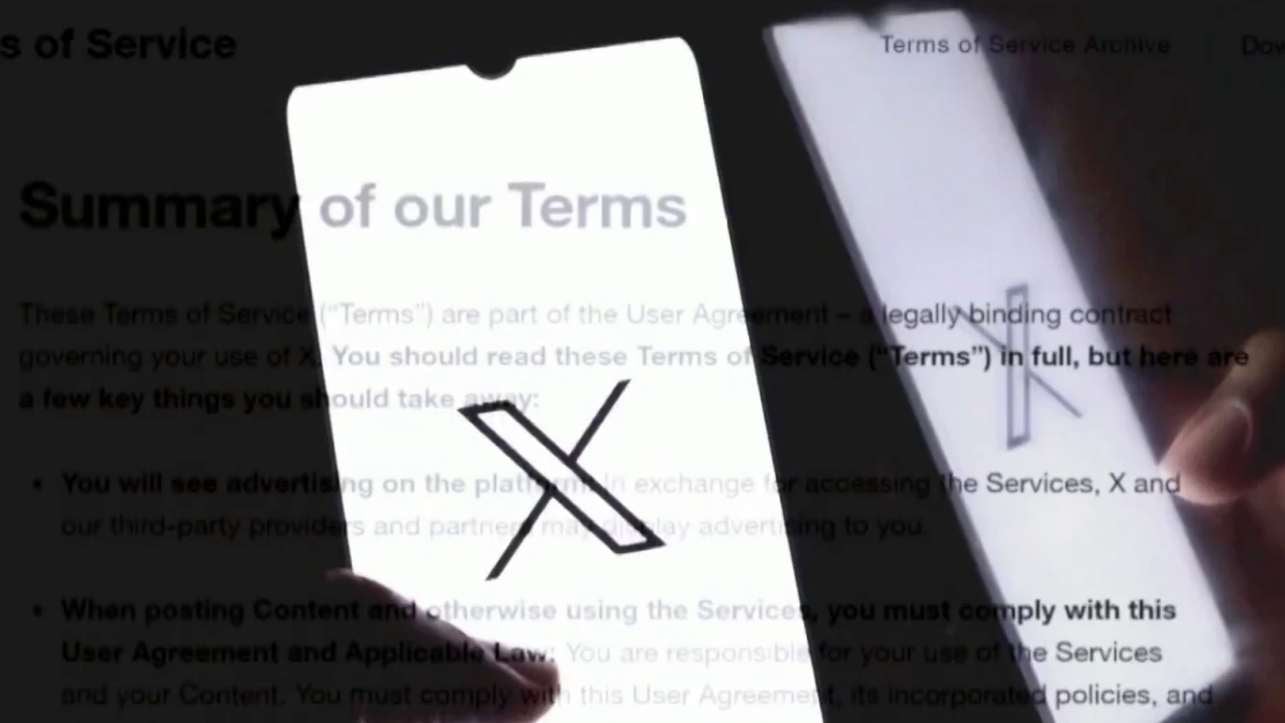





التعليقات (0)