قراءة متواضعة في تواضع الاصلاحات التعليمية

إن الحديث عن المنظومة التعليمية بالمغرب ورهانات إصلاحها يستدعي مساءلة واقعها الخاص بجميع الاسلاك خاصة السلك الابتدائي باعتباره قاعدة الهرم التعليمي وبذرته التي تفرض على الفاعلين كثيرا من العناية على مستوى التدبير السياسي والمادي و التربوي البيداغوجي.
إن المحتويات والمضامين المعرفية المبرمجة بالسلك الابتدائي تستهدف الاستجابة لحاجيات المتعلم النفسية والاجتماعية والعقلية والحركية التي تتكامل فيما بينها بشكل يحقق التوازن لشخصية الطفل,وهو ما يفرض من جهة تكامل المواد المدرسة فيما بينها ومن جهة أخرى العمل بالبيداغوجيات المعاصرة التي تجعل من التلميذ الفاعل الأساسي في الفعل التعليمي التعلمي.
ومن أجل أن تحقق المدرسة الابتدائية غاياتها ومراميها المنشودة لا بد لها من إصلاح آليات اشتغالها خاصة على مستوى التواصل البيداغوجي داخل الفصول الدراسية. وهو ما يفرض تجاوز البيداغوجيات الكلاسيكية واستبدالها بأخرى حديثة تستند في ممارستها لمقتضيات علوم التربية.ويتجلى الفرق بين النموذجين على مستوى الأجرأة فيما يلي:
البيداغوجيا الكلاسيكية ترتكن لاملاءات السلطة المجتمعية, وذلك من خلال القاعدتين الزجريتين التاليتين: "لكالها لمخزن هي لتكون" و "لكالها لمعلم هي لتكون",فكانت النتيجة مركزية المدرس/الحاكم و هامشية التلميذ/المحكوم, فهذا الشكل من البيداغوجيا يعلي من سلطوية المدرس فهو سيد المعرفة و مالكها, أما التلميذ فيعد علبة سوداء و ذات سلبية في عملية بناء المعارف.وضمن هذا التصور تكون العلاقة التربوية داخل الفصل يحكمها التأثير فقط (المدرس يوصل المعرفة للتلميذ و التلميذ يستقبل فقط ولا ينتج). وتتولد عن طبيعة هذا النظام البيداغوجي/الديكتاتوري ظواهر سلبية أهمها: العنف المدرسي , الهدر الدراسي , الخوف من المدرسة , ضعف جودة التربية و التعليم.
ومع انفتاح المغرب في عهد الحكم الجديد على قيم المواطنة وحقوق الانسان وحقوق الطفل ووعيا منه بأهمية تجويد (من الجودة) الفعل التربوي خدمة للمشروع الحداثي الشمولي, تبنى المغرب عدة مشاريع لإصلاح الحقل التربوي نصت على ضرورة العمل ببيداغوجيا الكفايات التي تتبنى شعارات التربية الحديثة وتتعامل مع الطفل باعتباره نواة و جوهر الفعل التربوي . فهو ذات عاقلة وحاسة ومالكة للمعرفة ومنتجة لها , لتكون بذلك العلاقة التربوية الصفية بين المدرس و التلميذ يحكمها التأثير و التأثر و تؤمن بمبدأ التبادل المعرفي بين الطرفين.
وسعيا منها نحو إصلاح الشأن التربوي , عملت الدولة على رفع مجموعة من التحديات و الرهانات ترجمتها في فصول الميثاق الوطني للتربية و التكوين الذي بشر ووعد بانجازات تاريخية ستبصم العشرية الأولى من القرن الواحد و العشرين.. فتفننت الوزارة الوصية و أحسنت اخراج مجموعة من الشعارات الرنانة رفعتها بحلول كل سنة دراسية جديدة نذكر من روائعها : الشراكة , السلوك المدني , الارتقاء بالجودة , التدريس بالكفايات,...إنها شعارات اشتغال مجموعة من المجالات التي تلتقي كلها في مجال المدرسة..إلا ا انه لقاء و التقاء غلب عليه طابع المفارقة للواقع بدلا من المحايثة المفتقدة, فتولدت بذلك نتائج كان وقعها على المنظومة التربوية كما يلي: تهشيش البنية التحتية الهشة أصلا , تفقير المردودية الفقيرة, تقليص الموارد البشرية المقلصة, تعزيز ظاهرة الاكتضاض في القاعات التي لم يبق من أبوابها و نوافذها إلا الإطار شاهدا على أنها كانت في زمن ما.وبفضل كل هذا احتل المغرب آخر الرتب في تصنيف الواقع التعليمي بالعالمين العربي و الإفريقي...ليتحول بكل ذلك مشروع إصلاح التعليم إلى مشروع إصلاح الإصلاح في إطار ما اصطلح عليه بالمخطط الاستعجالي لإصلاح منظومة التربية و التكوين والذي من أهم ما يعاب عليه أنه يشتغل نظريا و عمليا بمنطق التسرع و الانفعال بدلا من التريث و الاتزان.
إن كل المشاريع والأفكار السياسية الهادفة لتدبير حسن للشأن التربوي يكون مآلها الإجهاض و البتر والإعاقة والموت المبكر ما لم تستند لتوصيات العلوم الإنسانية (علم الاجتماع-علم النفس,علوم التربية....) التي هي الوحيدة القادرة على التشخيص العلمي للسرطانات الناخرة للجسم التعليمي والتنظير المحكم لكل إصلاح يناغم ويزاوج بين العقلنة و التطبيق , النظرية و الواقع وينهي حالة الطلاق بينهما و التي كان من نتائجها تيتيم المدرسة المغربية و تشريدها في غياهب التيه والعراء.
إن تقدم كل المجتمعات البشرية تاريخيا كان رهين تقدم المستوى التعليمي بها . فالمدرسة هي القلب النابض للنسق المجتمعي , وكل المؤسسات الاجتماعية تحيى بشرايين الفكر و المعرفة و الثقافة التي منبعها قلب المدرسة. وعليه فالنتيجة المنطقية لهذا الترابط الجدلي العميق بين النسقين التعليمي و المجتمعي تفيد أن تقدم كل المجالات الاجتماعية يستشرط تقدم المدرسة , وضعفها مؤشر على وهنها و علتها . وبمنظور المنطق الأرسطي نقول:
_ كل المؤسسات الاجتماعية بجميع الدول ترتبط بالمدرسة...
_ المغرب دولة.
_ إذن كل المؤسسات الاجتماعية بالمغرب ترتبط بالمدرسة.
_ المدرسة المغربية تعيش مشاكل..
_ إذن كل المؤسسات الاجتماعية بالمغرب تعيش مشاكل.
وبالفعل فتدهور المنظومة التربوية تولدت عنه أمراض و ثغرات و استشكالات في تدبير مجالات الصحة و الكرة و العاب القوى و الفن و الإعلام و الطرق و الفلاحة و المعمار و البيئة و الصناعة و القيم و الأخلاق و التواصل والسياحة و العدل......
ومن وجهة نظري المتواضعة ,انطلق في مقاربتي لإشكالية أزمة التعليم بالمغرب من تصور يربط واقع الأزمة ببراثن العنف الرمزي الذي افترض أنه الجوهر الخفي لكل مشاكلنا التعليمية. ومن أجل تبيان دلالات و حجاج هذا التصور(الذي ليس بدوغمائي بل يقبل كل التفنيد و الدحض) سأقف قليلا عند مفهوم العنف الرمزي كإشكال سوسيو تربوي تحكمه قوانين ومتغيرات.
ارتبطت نظرية العنف الرمزي في المجال التعليمي بأطروحة إعادة الإنتاج التي بلورها كل من السوسيولوجيين بيير بورديو و جون كلود باسرون في كتابهما إعادة الإنتاج . وتستند هذه النظرية لفكرة مضمونها أن المدرسة تعمل وفق تقسيم المجتمع إلى طبقات, وهي بذلك تهدف إلى إعادة إنتاج الطبقات السائدة في المجتمع ,وكذا المحافظة على الوضع القائم الذي أنتجها, فإذا كان المجتمع يضم طبقات متفاوتة من حيث الثقافة واللغة المادية والمعنوية, فان هذه المعادلة الاجتماعية تنتقل إلى المجال المدرسي الذي يتيح حق التعليم العمومي المجاني لتلاميذ ينحدرون من فآت اجتماعية متفاوتة.
وهكذا فان الأطفال منذ البداية _قبل ولوجهم المدرسة_ غير متساوين في الرأسمال الثقافي ,أي غير متكافئين في امتلاك المهارات اللغوية الملائمة لتسهيل عملية التواصل التربوي,وبذلك فان المدرسة تسعى لتحقيق وظيفتها (إعادة الإنتاج) عن طريق فرض معيار ثقافي ولغوي خاص,هو معيار أقرب إلى اللغة و الثقافة السائدتين في الأسر الغنية البرجوازية,وابعد من ثقافة الأسر و الطبقات الشعبية الفقيرة.وبذلك فان المدرسة تقوم على "ايتوس" مضمر وخفي عبارة عن نظام قيمي مستبطن بعمق و إحكام.
والوظيفة الجوهرية لهذا الايتوس تتجلى في كونه يؤدي إلى خلق نوع من الاستعداد لدى الأطفال يسميه بورديو بالهابتوس,وذلك عن طريق العمل التربوي الذي يسعى أساسا لتشريب التعسف الثقافي (التطبع الثقافي) المفروض من قبل الجماعة المسيطرة.
إن مضمون هذه النظرية هو أن المدرسة تمارس عنفا رمزيا عير مباشر على الأطفال , حيث أن طفل الطبقة الغنية يعيش تكاملا وامتدادا بين ثقافة أسرته و ثقافة مدرسته, مما يسهل غليه التوافق الدراسي, فيكون محبوبا من طرف مدرسيه و ينجح في انتزاع اعترافات رمزية من قبيل : تلميذ مجتهد, تلميذ ذكي , جوائز,علامات جيدة. أما تلميذ الطبقة الفقيرة فيعيش اغترابا بالمعنى الماركسي وتناقضا كليا بين واقع الأسرة وواقع المدرسة يحول دون الاندماج المدرسي السليم مما يعرضه لأشكال متنوعة من العقوبات: عنف جسدي ,عنف نفسي.....مما يسبب له الهدر و الفشل الدراسيين.
هكذا فلو حاولنا تفكيك الخطاب المروج في الكتب الدراسية بالمغرب واستقراء مضامينها لوجدناها ملطخة بأعراض العنف الرمزي .لنتأمل جميعا (لا الحصر) الوضعيات التالية:
- تلميذ في مستوى الثالث ابتدائي بمدرسة قروية نائية يطالب بفهم نصوص قرائية تتكلم عن القطار و السينما والأسواق الممتازة و الطرق السيارة و المطار و الميترو....إنها تيمات و موضوعات تثير إحساس التلميذ بالاغتراب..أي يحس أنه ليس هو المستهدف من هذا الخطاب لأنه خطاب حامل ومحمل بمواضيع وقضايا مفارقة لواقعه الإنساني و الاجتماعي والنفسي.
- مدارس و اعداديات بالوسط الحضري تدرس لتلامذتها التربية الموسيقية و التكنولوجيا و التربية النسوية و التربية البدنية واللغات وآخرون في مدارس أخرى يحرمون منها.
- فئة من المتعلمين تدرس بأقسام عادية وأخرى بأقسام مشتركة.
- عدم تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بكل المدارس.
- فئة تدرس الاعلاميات تطبيقيا وأخرى كأفكار نظرية.
- هذا علاوة على مشاكل البنيات التحتية كانعدام المرافق الصحية و الرياضية وتواضع الإطعام المدرسي و انعدامه أحيانا وتحريم متعلمين من الرحلات و الأنشطة الإبداعية و المسرح المدرسي.....
كل هذا تمخضت عنه مظاهر مرضية و نتائج سلبية جعلت المدرسة المغربية ينظر إليها كقطاع غير منتج علما أنه يحضا بميزانية مالية هامة ويحتل القضية الثانية في اهتمام الدولة بعد قضية الوحدة الترابية للمملكة.ومن أجل نهضة حقيقية للشأن التعليمي ببلادنا لا بد من تنظير شمولي علمي و تدبير سياسي عميق يرجع للمدرسة هبتها و مكانتها في تطعيم اللحمة المجتمعية بشكل يخدم غايات المجتمع المغربي ويصون حقوق الطفل / المتعلم وكرامة المدرس الذي هو أهم فاعل تربوي يلامس مشاكل التربية و التعليم بشكل واقعي معيشي عكس أولئك الذين ينظرون للحقل التعليمي من داخل غرف مكيفة بعيدة عن ضجيج الفصل, ويقرصنون كل نظرية جديدة تظهر بالساحة التربوية الغربية ليقوموا باقتلاعها من جذورها الطبيعية الغربية ويطالبوا بزرعها بواقع مختلف مناخيا و اجتماعيا وتربويا.ومن هنا أختم فأقول: إصلاح التعليم يقتضي البدء من تشخيص الواقع أولا للتمكن من بناء نظرة إصلاحية ثانيا...ذلك أن وصف الدواء يتم بعد تشخيص الداء و ليس العكس.
نشرت ب ريف ستار و جريدة الصباح
بقلم جمال الدين البعزاوي/أستاذ الفلسفة بنيابة الحسيمة
( Jamal_philo@hotmail.com)

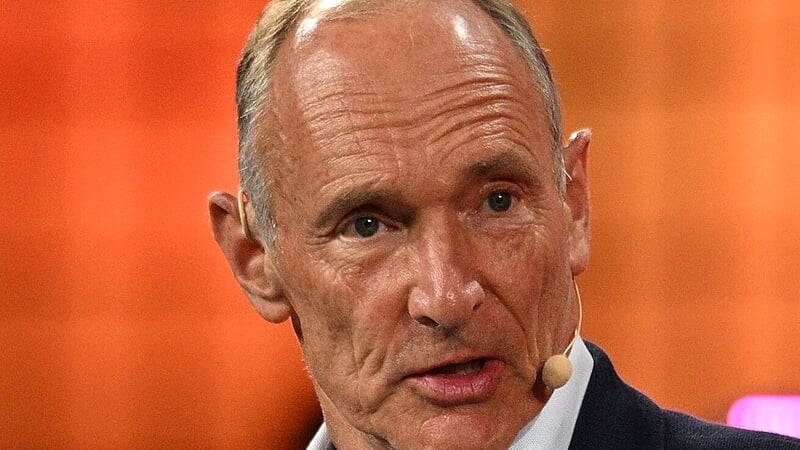






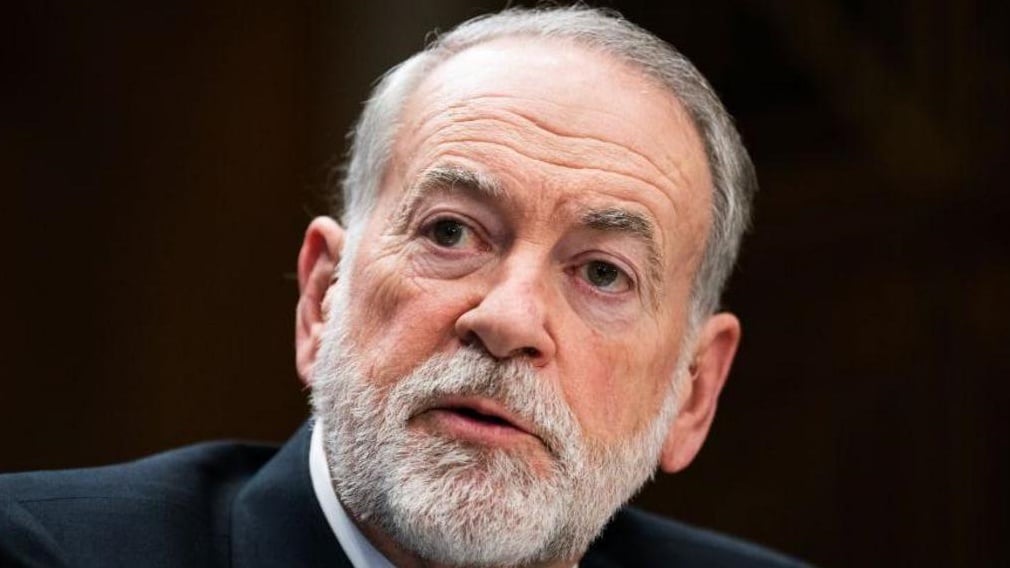



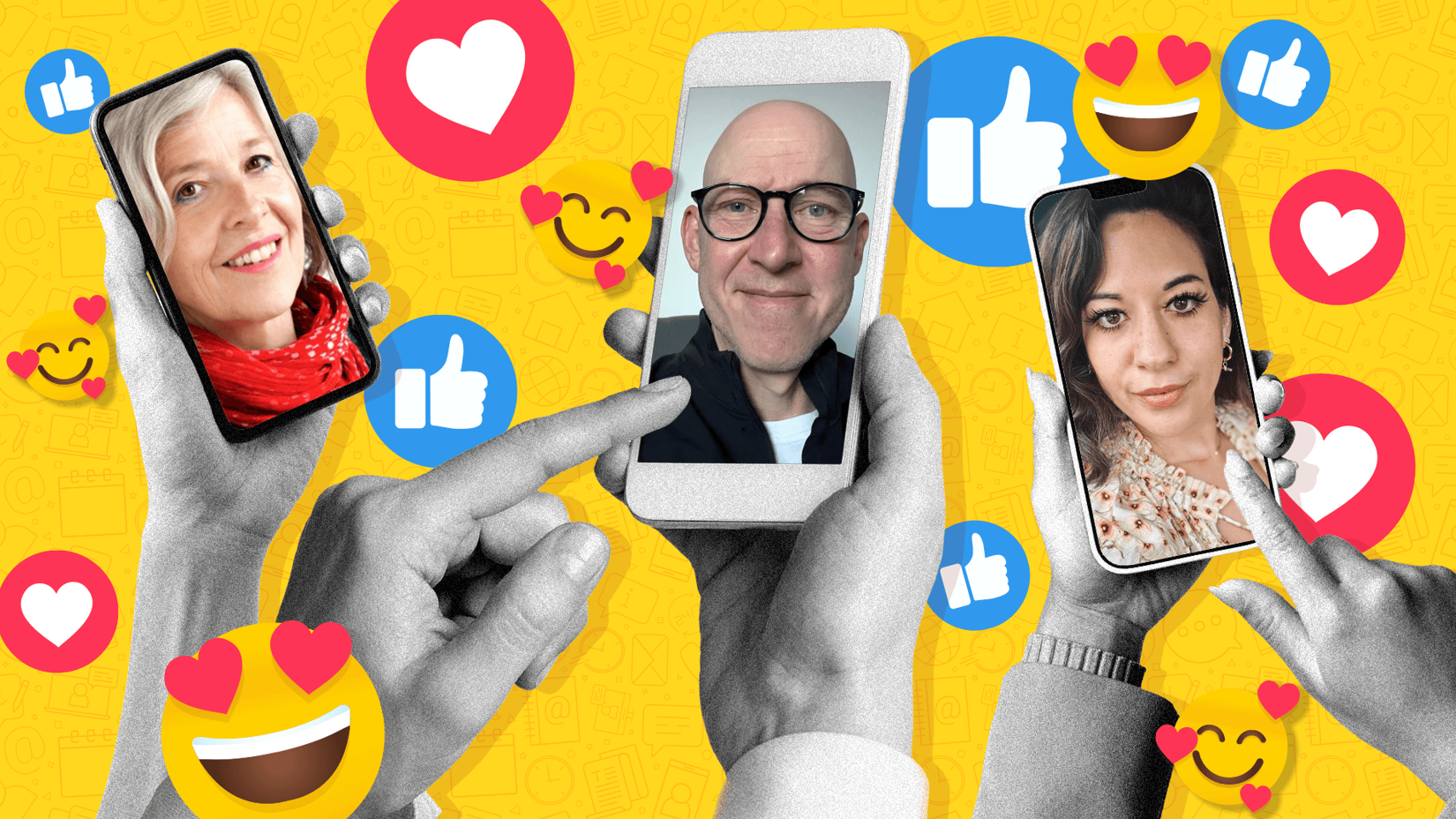

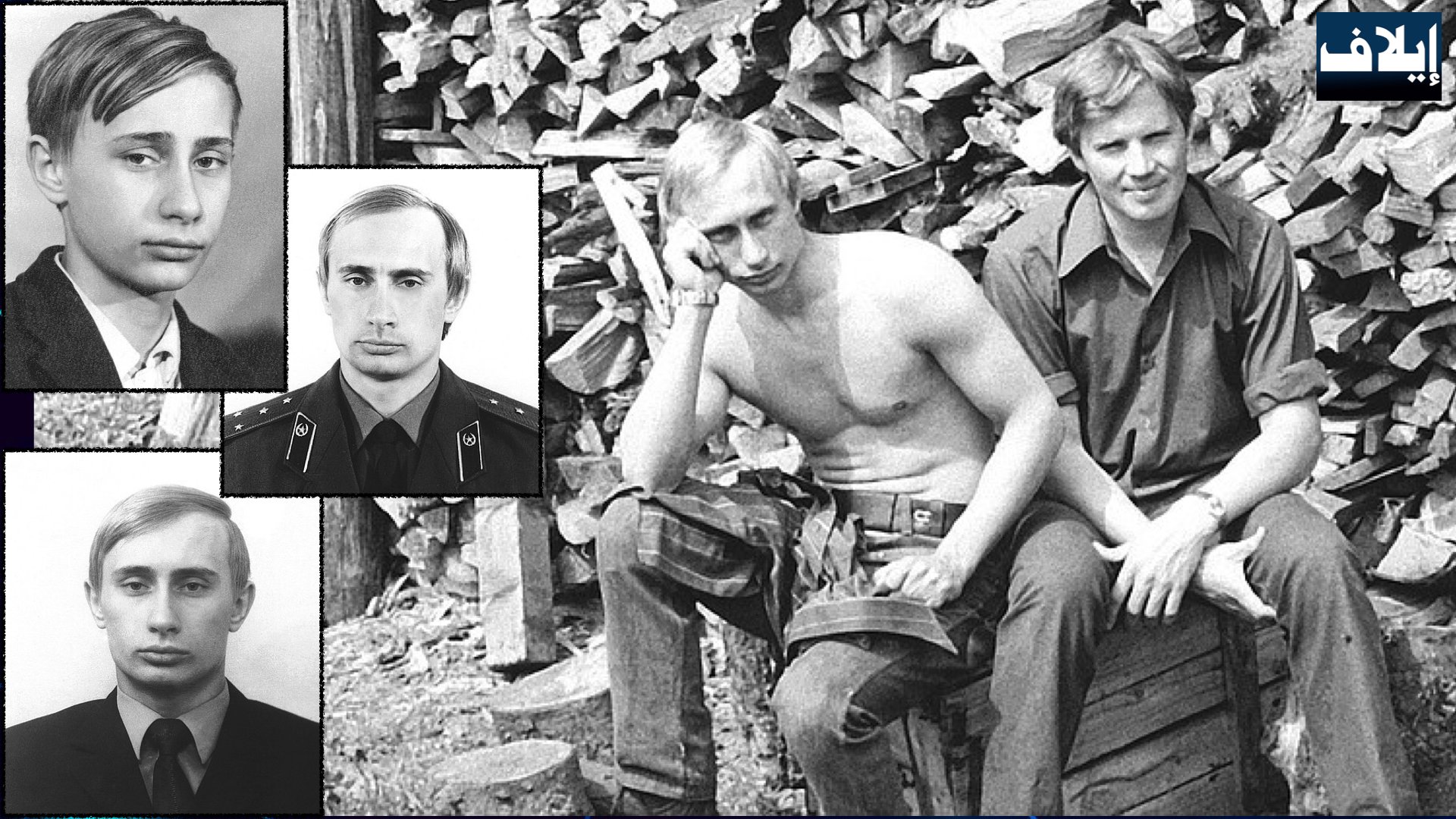


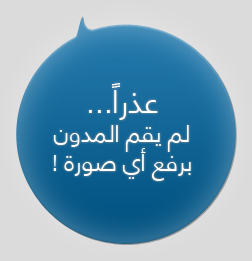
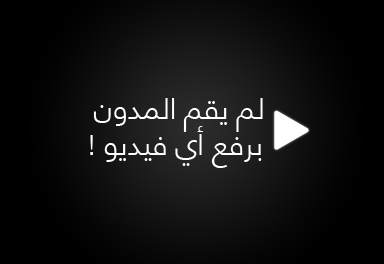

التعليقات (0)