فوضى الرؤية

على امتداد دراسته الثرية في رؤيا يوحنا البشير نقلنا الكاتب شبّر الى فضاءات معرفية هي غاية في الأهميه . ذلك أن هذه الرؤية لم تتعرض الى دراسة نقدية تحليلية في الخطاب العربي قديمه وحديثه .. ويمكن أن نستدعي جملة من الأسباب الكامنة وراء هذا المنحى، وهي أسباب بلا شكل تملك من الوجاهة الشىء الكثير ، لعل أهمها هي سمة التوترات الفوضوية التي لا تحيل الى معنى، والتي أوقعت بعضا ممن حاولوا قراءة هذا النص في إشكالية الرفض والاتهام المنهجي الذي سيطر على وعيهم .. إن قراءة شبّر هنا تأتي في تصورنا بشكل مغاير ومهم، ذلك أنه حاول أن يقرأ الأبعاد الرمزية ولكن ليس بصفتها الاسقاطية كما راح يفعل ذلك مفسروا وشراح الأناجيل الذين وقعوا تحت بوح المقدس في بواطنهم وصدقية المتعالي في ذواتهم ، وصرخة الروح القادمة من مخيال وجودهم الكوني . إن الكاتب في رأيي يستحق كل الثناء وكل التقدير على هذا الجهد الكبير الذي بذله في البحث والتقصي والدراسة والحفر المعرفي الذي أتى بالنهاية على أسس هذا النص الأنجليلي المقدس ..
إن ما لفت انتباهي هنا هو التحليل الذي قدمه الكاتب هو التداخل العجيب بين بنية اللغة الدلالية وتوظيف الرمز داخل هذه اللغة، وهو مبحث مهم اود ان أذهب في تحليله على نحو أعمق، أي في جدلية تلك العلاقة القائمة بين هذين النسقين المعرفيين، ذلك ان التجربة الدينية عادة لا يمكن اختزالها بالضرورة في اللغة الدينية، أو في الخطاب الديني التصوري الذي عادة ما يتبع منهجية صارمة في التوظيف الدلالي لنسق التعبير في بوحه الأخير اي ما يريد ان يقوله أخيرا في دال رمزي فقط .
إن اللغة، لكي تمارس وظيفتها التمفصلية والتعبيرية والتواصلية الدلالية ، لا يتطلب نظمها في لغة تأملية ترقى على الوجود ، حيث أن اللغة مرتبطة بالمفهوم أو ما تحيل إليه من معاني مشتركة . وعلى ذات النسق التصوري المرتبط عادة بالرمز على نحو مباشر وغير مباشر .
يظهر ذلك الأجناس الأدبية التي تحفل بها كتب العهد الجديد وعلى الأخص رؤيا يوحنا ، ففيها نصادف قصصا وقوانين ونبوءات وتراتيل ورموزا وأمثالا. والحال أن هذه الأجناس الأدبية في مستواها القبل مفهومي، تتكون فيها اللغة الدينية الأولية. فمن المؤكد أن هذه اللغة عندما تخضع لتأويلات متباينة وجدالات خارجية و لتمزقات داخلية خاصة بالجماعة المؤمنة، فإنها تكون مجبرة على التعبير عن نفسها في أفكار موثوقة قابلة لأن تفهم ، وعلى المجاهرة بالإيمان حيث يتميز أولا عمل المفهوم المراد . هذا بالإضافة إلى أن "عقيدة" الكنيسة المسيحية - عندما تكون في مواجهة مع اللغة الفلسفية - تستعمل اللغة غير المفهومة أو غير المستعملة سواء باللجوء إلى استعارة خارجية أو إلى توضيح داخلي من أجل أن توضع في نفس مستوى الفلسفة. وبذلك تدخل اللغة الدينية على نحو ملائم في اطار آخر . فمن هذا التغيير للقانون والجدل بين المستوى القبل مفهومي والمستوى المفهومي نشأ جنس مختلط للغة الخطاب الديني الرمزي التي نشاهدها عند كتبة الأناجيل كافة في ضرب الأمثال الدائم والمستمر .
علينا أن ناخذ بعين الاعتبارهنا وظيفة الرمزية في مستواها القبل أدبي يعني قبل أن تسمح لنا بإنتاج مثبت ومدون في نصوص بالمعنى الدقيق للمؤلفات المكتوبة اي الخطاب الشفهي ، أي كيف مارس هذا النمط ظغطه علي الوعي في الدين الكنسي فيما بعد . فالحضارات التي لم تعرف الكتابة لا تعرف سوى هذه الوظيفة للرمزية. فرمزية التقليد الشفوي باعتبارها تفتقد إلى قانون واضح ووجود متميز، تكشف عن نفس البعد الثقافي، يعني كونها واسطة رمزية . فإذا كان بإمكان التجربة الإنسانية أن تصور كلاميا وتحكى وتؤسطر في رموز ظاهرة وفي رسوم وقصص وأساطير، فذلك لأنها كانت دائما مرتبطة من الداخل برمزية محايثة، ضمنية وأساسية، والتي يحيلها الأدب الى قانون للرمزية المستقلة.
واذا أردنا أن نعمق وجهة النظر هذه فيمكن أن نركز على الطابع العام للتفمصلات الدالة للفعل الثقافي . فالثقافة هي عمومية لأن الدليل عمومي . حيث نستعيد عبارة كلود ليفي اشتراوس - أن المجتمع ليس هو الذي ينتج الرمزية، بل الرمزية هي التي تنتج المجتمع. من هنا تأكيد الطابع التأسيسي للوسائط الرمزية التي تضمن دلالة الفعل. فهذا الطابع يتمفصل مع سمة الفعل المشار إليه أعلاه، يعني أنه يؤول إلى التفاعل بين عدة عوامل. لكن فكرة التأسيس تضيف لفكرة التفاعل هذه، السمة التي يؤلف بها التأسيس كليات غير قابلة للاختزال إلى أجزائها
هناك الطابع البنيوي للتركيبات الرمزية. فالرموز تشكل نسقا في حدود أنها تحافظ على علاقات التعاون أو التفاعل أو كما قيل أعلاه عن علاقات بين الأدلة. فقبل تأليف نص على المستوى الأدبي أو الديني ، تقدم الرموز تركيبا دالا في قلب الوعي الجمعي . وهكذا لفهم طقس ما، يتعين التمكن من إعادة وضعه في نسيج الطقوس التي من أجل فهمها يجب موضعتها بدورها في عبارة خاصة في نظام لغوي ، وبصورة تدريجية في مجموع المعتقدات والتواطؤات التي تشكل شبكة الثقافة من أجل تثمين الدور الاجتماعي للطقوس الممارسة وتأثيرها على البنيات الاجتماعية الأخرى..
كما ويمكن الحديث بهذا المعنى عن تنظيم رمزي وتحديد للفعل الإنساني كسلوك محكوم بقواعد حيث أن فكرة القاعدة تميل بدورها نحو فكرة التبادل. فكلود ليفي اشتراوس في أعماله الأولى قد بين كيف أن تبادل الممتلكات والرموز والنساء يشكل أنساقا متجانسة داخل نفس الثقافة. فبإدخال معيار التبادل نبعث واحدا من الأدلة الأكثر قدما للفظة رمز كعلامة اعتراف بين فريقين، كل واحد منهما حارس لجزء مقطوع من الرمز الكلي، وأن تقارب هذين الجزأين يعطي للرمز قيمته الدالة التي تفعل فعلها وذلك بإعادة ربطه (هكذا بالمجاهرة بالإيمان الكنسي المسيحي التي تسمى أحيانا رموزا، لأن أعضاء الجماعة المؤمنة بوسائلها الخاصة يراقبون انتماءهم المشترك لهذه الجماعة). فهذا المعيار الجديد يؤكد المعيار السابق ويصححه في نفس الوقت، فبقدر ما تبرر قاعدة التبادل التحويل إلى السوسيولوجيا الثقافية للإجراءات المطبقة أولا على النظام نظام اللغة، بقدر ما يحذر الطابع الملموس للتبادل ضد فصل الرمزية عن الفعل الذي يحكمها. ففي الفعل الاجتماعي تفعل قاعدة التبادل فعلها، حيث تنتمي الى المنطق غير الصوري للحياة الواقعية. وبهذا المعنى فترابط النسق الرمزي المغلق ليس هو المعيار الرئيس لوصفه، بل هو فعاليته الاجتماعية.
يمكن القول -لكي نوقف التحليل هنا- إن الأنساق الرمزية تقدم سياقا وصفيا للأفعال الفردية.
وفي المحصلة، فإن الرموز المحايثة للجماعة ولثقافتها تمنح "وضوحا أساسيا" للفعل وتشكل معه شبه نص.. البنية التشابهية .......
منذ المرحلة الشفوية، أمكننا رؤية الرمزية تتكثف في الأنشطة الشفوية المستقلة والقابلة للتحديد على الوجه الأكمل. فالرموز ، تستجيب لهذا الاعتبار المزدوج:
نقصد مؤقتا بالبنية التشابهية ، بنية العبارات بمعناها المزدوج حيث يحيل فيها المعنى الأول إلى معنى ثان. وهذا الأخير هو الذي يقصده الفهم فقط، دون أن يتمكن مع ذلك من الوصول إليه مباشرة. يعني بوجه آخر أنه بواسطة المعنى الأول سنوظف فيما بعد المجاز .
على سبيل المثال رمزية الشر في منطقة تعابير الإقرار بالشر، وعلى وجه الخصوص تعابير الإقرار بالذنوب في لغة التقليد الكنسي المسيحي. فرمزية الإقرار قد تبوأت إذن مكانة في النشاط اللغوي المحدد بكيفية مضبوطة، والذي له قوته الخاصة الغير معبرة والمتمثلة في ذات الفرد المضبوعة دوما بثقل الرمزية الطاغي والذي لا يمكن الفكاك من أسره .
الرمزية هي بالتأكيد ذات طابع ظاهري ويمكن فعلا الكشف عن طبقات عديدة من بين رموز الشر الأولى المقر به داخل طابعها هذا ، إذ نصادف على سبيل المثال في أدنى درجته، رمزية الطاهر والنجس المرتبطة بطقس التطهر الذي لا تختلط فيه الطهارة أبدا بأدران الجسد. فالقذارة هي مثل الوسخ دون أن تكونه، وأن رمزية طقوس الطهارة هي التي تـكشف - على الصعيد العملي- المهمة الرمزية المتضمنة في تمثل القذارة ، قبل أن تعين القوانين الدينية أو المدنية حدود الطاهر والنجس، وأن النصوص الأدبية سواء كانت عبرية او مسيحية ، تضفي قوة لغة قابلة للنقل على الإحساس القاتم. فالشر في درجته القصوى يتميز بشكل ترابطي بكونه ذنبا أمام الله وخطيئة لن تقبل الغفران . وهذا مناقض لروح المسيحية ذات المصادر الرمزية. ولهذا السبب فهو يعبر المسيح عن نفسه في أكبر عدد من الصور:خطأ الهدف، واتباع الطريق الملتوية والتمرد وصيرورة الزنا والانحناء للريح وللعاصفة ولتفاهة الفراغ ولكل الرموز التي لها مقابلها في رمزية الغفران كالهداية والتكفير عن الإثم والطاعة والإخلاص بشكل موثق وهو ما عبرت عنه المسيحية في فوضى تصوراتها عن الغفران .
وهكذا رأت رموز جديدة النور: كعبء الخطيئة واستبداد الحيرة وقرار الإدانة من لدن قاض يحكم بشكل تعسفي.
ثم انه من الملاحظ في الواقع أن هذه الرمزية الأولى لن تكون هي نفسها مستساغة لنا إلا عبر رمزية من درجة ثانية ومن طبيعة سردية أساسا هي رمزية "أساطير" البداية والنهاية. وأنا آخذ هنا لفظة أسطورة بالمعنى حكاية الأحداث المؤسسة الطارئة ، وهو ما يعرف بحكاية الأصول. إذ من المؤكد أن الأسطورة ليست أسطورة إلا بالنسبة إلينا نحن المحدثين الذين كونا فكرة عن زمن تاريخي، به زمن الأصول فلفهم الأسطورة كأسطورة يتعين فهم ما أضافته إلى وظيفة الأساطير الأولى التبشيرية بفضل بنيتها السردية الأصلية. وهكذا تتمثل الوظيفة الأولى لأساطير الفناء والخراب والضلال الإلهي والعصيان والرد عليها في أساطير الإعلاء والإلهام والمغفرة كما هي مرتبة، في إضفاء وحدة العالم المادي على الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك فالسرد يولد حركة ودينامية وتوجيها من البداية إلى النهاية: تاريخ نموذجي يعبر تواريخنا. وبشكل جوهري فالأسطورة تعطي تأويلا سرديا للغز الوجود، يعني التنافر بين الخير الأصلي للخلق والشر التاريخي الذي ينعيه الحكماء. فالأسطورة تحكي، كحدث طارئ على أصل الأزمان، الصدع الذي تكشف عنه الحكمة........














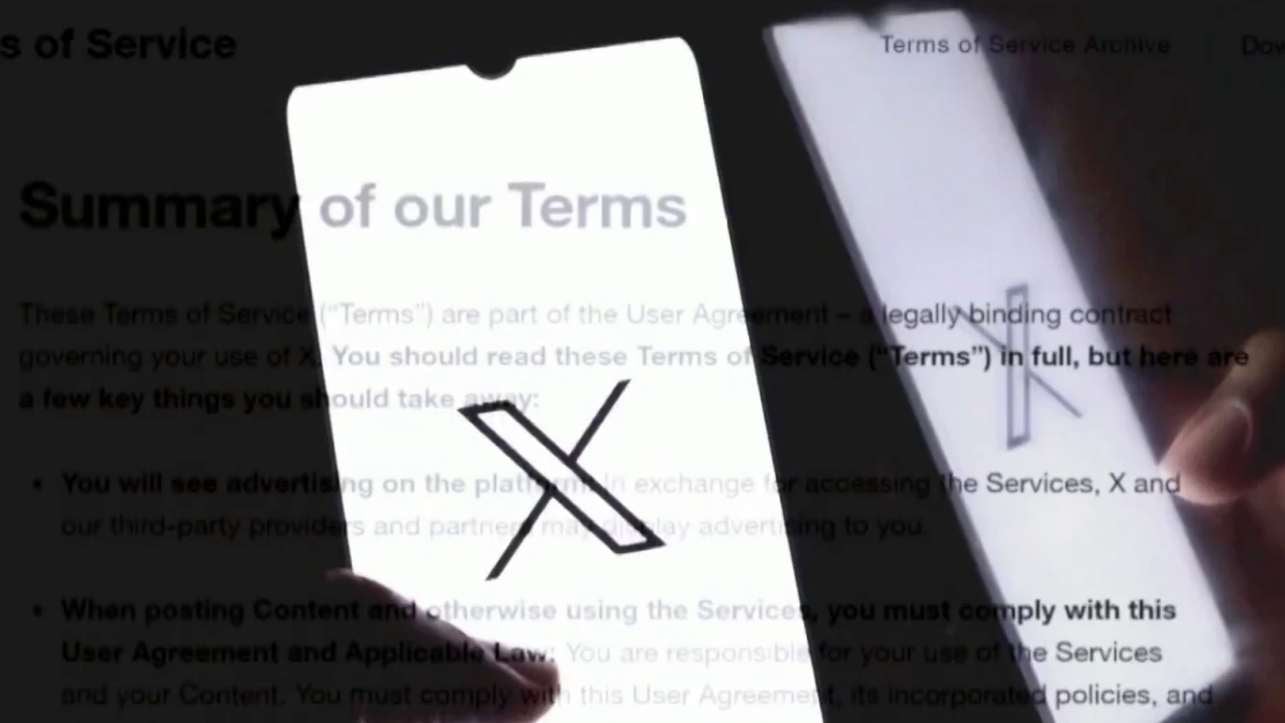





التعليقات (0)