فرضية صِدام الحضارات: قراءة في أواليات الفكر السياسي الغربي المعاصر

أ. محمد عطوان
كلية القانون والسياسة- جامعة البصرة- العراق
mohamed_atwan2@yahoo.com
مقدمة:
لعل في تناول فرضية (صدام الحضارات) درساً وبحثاً، تحديدٌ لملامحها الظاهرية، وتوصيف لآليات عملها، وفحص لبنياتها، من خلال قراءة تتلمس أهداف تلك الفرضية وغاياتها، بحيث تكفل لنا هذه الممارسة فهماً نسبياً في الأقل لحركة مفاصل الحضارة داخلياً، ولعلاقتها مع الحضارات الأخرى، فهماً معرفياً ينأى عن المؤثرات الأيديولوجية، وفهماً أخر يتتبع دوافع السلطة الموجهة له، وإغفال ذلك يتيح لبعض الخطابات امتلاك القدرة التفويضية على إحداث فجوة فاصلة بين ما هو معرفي وأيديولوجي.
وعبر هذه القراءة يجري رصد فرضية (صدام الحضارات) باستثمار علاقتها بفرضية (نهاية التاريخ) لـ فوكوياما. واستفادة هنتنغتون من الشفرة التي أباح الأول شرعية تصديرها ويشيع معها أن النموذج الليبرالي قد أنتصر بانتهاء حروب الأيديولوجيات والطريقة التي أستشف بها هنتنغتون هاجس أفول الغرب، وما جعله يعكف على إنتاج فرضيته التي افترضت توالدا غير منقطع لأعداء محتملين. ولذلك عنونت أسماءً لحضارات بائدة وأخرى حاضرة، في أجواء بدت فيها تلك الحضارات هي المادة الأساسية التي أخذ هنتنغتون يرمم خطابه بها، ويبحث في كيفية تقييسها، وكيف يجري تنظيبها غربياً، ومن ضمنها الحضارة الإسلامية، مع الأخذ بنظر الاعتبار (المركزية) التي تحكم تفكير الغرب ونظرته (الجوهرانية)، أو (الثبوتية) القديمة إلى الأشياء.
فكما كان العالم منقسماً على نفسه إلى معسكرين في فترة ما يسمى بالحرب الباردة، فأن الوضع الجديد أخذ يتشكل على أساس ثنائية الغرب وما عداه، وهكذا تكررت الثنائية التقليدية القائمة في السابق على معيار الـ (نحن) والـ (هم)، عاودت هذه المرة لتجعل من الآخر أو الآخرين موضوعات للغرب. وأن فرضية (صدام الحضارات) إذ تركز على إثبات كينونة الهويات المتعددة من خلال توسيمها، فأن ذلك التركيز لا ينحو بقصد الإقرار بشرعية وجودها، بل بقصد ترسيم سقف فكري وعقائدي لتمرير برنامج (تقويض) الحضارات المضادة. ما يعني أن تسويق فرضية الممانعات الثقافية الصادرة عن تغاير الثقافات لا تتقاطع مع منطق العولمة، بقدر ما هي تعبير عن مشروع استشرافي اتساقي مع معطيات العولمة، لإثبات إمكانية قيام الصدام بين تلك الثقافات، في محاولة تمهيدية لتذويبها أو محقها أو تهميشها، وتوجيه مسارها ـ في أقل تقدير ـ باتجاه قطار العولمة، وبالتالي سنشهد نهل فرضية صدام الحضارات والعولمة من نبع واحد؛ هو الغرب المركزي.
أولا: فوكوياما ونهاية التاريخ.
ثانيا: تفعيل البعد الثقافي في السياسة الدولية.
ثالثا: دول القربى معيار التحالفات الجديد.
رابعا: النزعة المركزية.
خامسا: تأكيد نزعة الاستشراق.
أولاً: فوكوياما ونهاية التاريخ
أدت التغيرات الكبرى في ميزان القوى الدولية في مطلع التسعينيات من القرن الماضي بدوافع موضوعية وتاريخية، والانعطافة التي أحدثتها (البيروسترويكا) التي أطلقها ميخائيل غورباتشوف في الاتحاد السوفيتي السابق، أدت دوراً كبيراً في ظهور أطروحات فكرية أصبحت مثار اهتمام التفكير الإستراتيجي الغربي، لأهميتها القصوى في عالم ما بعد الحرب الباردة و أهمها فرضية ( نهاية التاريخ) للاقتصادي فرانسيس فوكوياما التي صدرت في العام 1989م.([1])
ولذلك، لابد من التعرض ابتداء إلى بعض من المرتكزات الحداثية في الفكر الغربي، فلقد عُرف عن الفكر السياسي الغربي منذ بيكون وديكارت اهتمامه الواضح بتطبيق معرفياته، من خلال إعادة قراءة تاريخه، قراءة قائمة على أساس الانفصال والاتصال، والنظر وإعادة النظر، والنقد ونقد النقد، لتجاوز جل أزماته الحادثة، التي أصبحت مصاديقا للغرب، فهي التي أسهمت في تأسيس مدركاته الجماعية، وهي التي حفظته من الوقوع في فخاخ (الاطلاقية) و(الأسطورية) واللاعقلانية، كما إنها هي التي جنبت التاريخ الحضاري الغربي الوصول إلى حافة الانهيار والتردي([2]).
وهناك من يؤكد ـ مجانبة لهذا المنظور ـ أن الربط الميكانيكي المطلق بين أجزاء الواقع الفعلي والصورة التي يعكسها الفكر عنه عملية يكاد يكون جانبا منها مضللاً والنتائج التي تترتب عنها نتائج فاسدة، ولذلك يؤكد فوكوياما على مفهوم الوعي ـ كمقدمة تسبق القرار في العالم المادي ـ اعتقاداً منه بوجود قوة مستقلة للأفكار تتعدى قوانين الواقع المادي الموضوعي، وهي في تصوره المصدر الوحيد للقوة، وأن كل حججه تستند إلى الظفر الذي تحقق لبعض الأفكار في معزل عن حركة التاريخ.([3]) وهذا ما يجعل الواقع ـ في تصوره ـ يعكس صوراً متموجة ومتداخلة الأجزاء كالصورة التي تعكسها المرآة المهشمة.() وعلى سبيل المثال يقول غراهام فولر: إن تركة ما يقرب من نصف قرن من الحرب الباردة قادت الولايات المتحدة إلى وضع هدف الاستقرار فوق أي اعتبار في سياستها تجاه العالم الثالث، حيث كان يُنظر إلى عدم الاستقرار بوصفه عاملاً يلعب لصالح السوفيت آنذاك، وإن ثمن الاستقرار، هو ديمومة الحفاظ على أنظمة حكم استبدادية، وتنفيذ سياسات قمعية غير ديمقراطية باسم الحفاظ على الاستقرار.([4]) إلا أن الوضع تغير منذ نهاية الثمانينيات حيث شهد العالم من خلال ما سُمي بالنظام العالمي الجديد، الدعوة إلى تبني (الديمقراطية) كنظام سياسي (يحكم) دول العالم، وبحسب هذا الزعم عمل فوكوياما على تسقيط البدائل التاريخية عموماً، وأحل محلها نظاماً اقتصادياً اجتماعياً سياسياً ثقافياً يحاول أن يجيب عن ما ينشأ فيه من مشكلات.([5]) بمعنى آخر أن المعادلة القديمة بين الأمن والحرية لم تعد ضرورية بالنسبة للغرب، ولا مبرر للضغط والتركيز على الضبط والتحكم، فقد حُسم الأمر لصالح الحرية ووصل التاريخ إلى نهايته. ولابد أن يبدأ التحول من الضبط والسيطرة إلى تطبيق التعددية السياسية والاقتصادية. ولم يعد مقبولاً من دول العالم الثالث أن ترجئ هذا المطلب، بسبب المشكلات والاضطرابات الأمنية الداخلية فيها، لتقلل من هامش الحرية.([6]) ولذلك يغدو التاريخ هنا مشطوراً ـ بتعبير فوكوياما ـ ومتاحاً من داخل هذا النظام وممنوعاً من خارجه، بحيث يمكن عد هذا الشطر من قبيل الحتم والضرورة. إن فوكوياما يحاول فلسفة انهيار الكتلة الاشتراكية وانتهاء الحرب الباردة تاريخياً، وإعلان انتصار الديمقراطية والمشروع الحر بأنه نهاية التاريخ. وان سيادة الغرب الديمقراطي الليبرالي باتت نهائية ولا مجال لتغييرات جذرية عميقة في التاريخ القادم للإنسان.([7]) إن التغييرات القادمة لن تعدو أن تكون إلا تفاصيل أو فرصة الشعوب الأخرى للاستجابة والتمثل للنموذج النهائي ـ أي النموذج الغربي ـ ولم يكن المقصود من وراء ذلك توقف الأحداث الهامة في التاريخ، بل: "لن يكون هناك أي تقدم أو تطور بعد ذلك فيما يتعلق بالمبادئ والعقائد والمؤسسات، بقدر ما تم فيه بلوغ الديمقراطية الليبرالية."([8])
وهنا، يقع فوكوياما فيما يمكن أن يسمى "وهم النهاية" ـ بتعبير بودريارد ـ أي الخيال الذي ينسجه الإيمان، بأن التأريخ البشري يتحرك بخط مستقيم، بل يعود إلى الوراء، قاضياً بحركته هذه على بعض الملامح التي سادت المجتمع البشري في القرن العشرين.(2) حينما يشير إلى أن فكرة (نهاية التاريخ) لا تدل على نهاية الحرب الباردة فحسب، بل على نهاية التاريخ بوصفه تاريخاً، وتنبئ بالوصول إلى نقطة النهاية لخط التطور الأيديولوجي للبشرية. وهذه الفكرة ليست جديدة، فقد أعلن هيغل عن تصور مشابه لذلك على أثر معركة (ايينا) في العام 1806م. كما توسم كارل ماركس في الشيوعية على أنها( نهاية التاريخ).(3) ونلاحظ أن كليهما حاول أن يقدم صياغة نظرية لنهاية التاريخ بالاعتماد على أحداث سياسية معينة من مثل انتصار مبادئ الثورة الفرنسية، وتوسيع حق الانتخاب. وهذا التصور جعل هيغل يؤمن ويتأثر به، كما رأى ماركس أيضاً أن الرأسمالية قد وصلت إلى حالة الانفجار بفعل تناقضاتها الداخلية، خصوصاً بين نمطي الإنتاج الجماعي والملكية الفردية، وما سيؤدي إليه من انبثاق مملكة الإنسان: الشيوعية(4).
وقد أفاد فوكوياما من الرأيين فأتبع المنطق الجدلي لهيغل، لكنه، ابتعد به عن الماركسية التي استخدمت ذات المنطق ليرجح بأن العالم لن يشهد نهاية الحرب الباردة، وهو عندما يؤسس على ذلك، فانه مدرك تماماً أن معوقات التنمية كثيرة لدى دول العالم الثالث، وهذا ينسحب على أن كثيراً من دوله لن تتمثل لقيم الديمقراطية التي ينشدها الغرب، وعلى هذا الأساس فأنه يؤكد على رجحان حصول التقاطع وما يمكن تسميته بـ(الصِدام) بين الدول الرافضة من جهة، وسلوك الديمقراطيات الصناعية من جهة أخرى، وهذا بدوره سيؤدي إلى شطر التاريخ مما سيجعل من العالم الثالث عرضة لصراعات دينية وقومية وأيديولوجية ساخنة.([9])
لقد ساعدت القوى الاقتصادية على ترسيخ دعائم النزعة القومية من خلال إحلال الحواجز الطبقية، وخلقت كيانات ممركزة ومتجانسة لغوياً في مسار تلك العملية، وهذه القوى الاقتصادية نفسها ساعدت في الوقت الحاضر على تفكك وانحلال الحواجز القومية من خلال إنشاء سوق واحدة عالمية متكاملة.([10]) وليس بعيداً أن تمثل حرب الخليج الثانية حينها أنموذجاً بليغاً على توجه الغرب إلى مثل هذا النمط من التدخلات التي أنهت وحدة العالم الثالث على الجانب الذاتي، وأضعفت تبعاً لذلك إرادة التحرر ـ بعمومياتها ـ فيه، ودشنت عهد إملاء سلطة المحتل من الخارج في صورته المستحدثة، ممثلا بسلطة الولايات المتحدة التي تهدف إلى اجتثاث جذور الممانعة المحتملة لمشروع هيمنتها العالمي، تلك الجذور الكامنة في الهوية الدينية والقومية.([11])
وحين يقال أن هيغل لم يتوصل إلى خلاصة نهائية تمكنه من بلوغ اللحظة المطلقة في إدراك السلطة، فأن فوكوياما فعل ذلك عندما عد الديمقراطية الليبرالية هي هذه اللحظة المطلقة أو نقطة النهاية.([12]) ولا يعني أن الليبرالية الغربية لن تواجه في مسيراتها تحديات أخرى دينية أو قومية، وإنما هناك علائم تؤكد ظهور صحوة دينية ليست إسلامية فحسب، بل مسيحية ويهودية أيضاً.([13])
ومن أجل إعطاء تفسير منطقي لما يذهب إليه فوكوياما بإزاء هذين التحديين يمكن القول أن الشعوب غالباً ما تنبري إلى الاعتقاد بفكرة نهاية التاريخ في حالتين: حالة الانتصار وحالة الانكسار، ففي الحالة الأولى يكون التاريخ قد انتهى بوصوله إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه البشر من رقي وحضارة وتطور وهو ما يوجد في الفلسفات القومية بشكل عام، وفي الحالة الثانية يكون العالم على وشك النهاية، وهذا ما تعبر عنه الفلسفات الدينية في غالب الأحوال.([14]) لذلك تُرجح وجهة نظر فوكوياما كفة انتصار الأفكار التي تشمل على الهيمنة الاستعمارية للحضارة والتي تتجاوز الإمبراطوريات التقليدية وسقوطها.([15]) والتي تعتمد بالدرجة الأساس على فكرة الاستثمار الاقتصادي، إذ يمثل العامل الاقتصادي لدى فوكوياما أحد المحركات الرئيسة في التطور التاريخي، التطور الذي يؤدي إلى الرأسمالية بدلاً من الاشتراكية كنتيجة نهائية، وهذه النهاية هي الديمقراطية الليبرالية في السياسة، والرأسمالية في الاقتصاد، ويشكلان معاً وجهين لنظام واحد.([16])
وهنا يلاحظ أن فوكوياما يرفض التصور الدائري الذي نادى به كل من شبنغلر وكاسيرر وشفايتزر وما يرتبط به من مصادر القوة التقليدية، مهتماً من جانبه بالأفكار أكثر من اهتمامه بالمؤشرات الاقتصادية المادية. يقول فوكوياما: "إن الرأسمالية تمثل طريقاً متاحاً للدول كافة، الراغبة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وهذا يتم لقاء التزام هذه الدول بمعايير الديمقراطية الليبرالية."([17]) ويبدو أن السبب في تعذر انتشار هذه القيم، وكذلك تبنيها بالشكل الكامل، هو انتشار مؤسسات القطاع العام التي بواسطتها يمكن للدول أن تؤمِّن توزيعاً عادلاً للثروة بالنسبة لأفرادها. وهذا ما لا يقبله منطق الاقتصاد الحر، وبالتالي سيمثل اتساع دائرة القطاع العام عقبة كأداء أمام عولمة الاقتصادات الحرة، وهو ما دفع (تارنوف) وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، في فترة وارن كرستوفر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، إلى عدم قبول تفاؤل فوكوياما بشأن الانتصار، ورأى ضرورة وضع قيود تحِد من قدرات الولايات المتحدة الأمريكية. ولا يُعد هذا الوضع نوعاً من التنازل، بمعنى انهيار الدولة أو الحضارة، ولكنه لا يعني التفاؤل أن تقضي (نهاية التاريخ) بان تصبح الولايات المتحدة زعيمة العالم.([18])
أصبح الغرب في عصر التنوير والحداثة والمعلوماتية بزعامة الولايات المتحدة قوة تنزع إلى امتلاك الأفق كله. وعلى الرغم من التاريخية المحدودة لـ(الذات) الغربية، فأنها أضحت حاملة لذلك التاريخ بل أصبحت مجسدة له نفسه. لأن التاريخ ـ بحسب زعم الغرب ـ بدأ في الشرق وانتهى في الغرب، كحركة الشمس التي تبدأ من الشرق وتنتهي في الغرب، إنها فكرة نهاية التاريخ.([19])
ولو تأملنا التشويش الفكري الذي يسود الغرب والتراجع القيمي الواضح، والمعيار المادي الذي يهدد ابسط متطلبات الإنسانية والحضارة، لوجدنا إنها أفقدته مقومات وجوده، فضلاً عن قيادته للعالم، وإن لم يُلمس ذلك ظاهراً([20]).
وحيث أن هذا التوصيف ليس بكاف، وللتصورات الأوروبية إزاء الأحادية الأمريكية ما يُعضد ذلك، خصوصاً بعد أن أدرج جورج دبليو بوش كلاً من العراق وإيران وكوريا الشمالية ضمن محور أسماه (محور الشر)، و لم تصدر انتقادات ضد الولايات المتحدة بهذا الصدد عن المثقفين الأوروبيين فحسب، ولم تصدر عن رجال السياسة والرأي العام. فبالقدر الذي كان من المفترض أن تكون نهاية التاريخ مكللة بانتصار القيم والمؤسسات الغربية لا الأمريكية فحسب، على نحو يجعل من الديمقراطية الليبرالية واقتصاد السوق الخيارين الوحيدين القابلين للاستمرار، فأن هوة عميقة باتت تفصل بين الإدراكّين الأمريكي والأوروبي للعالم ويزداد الشعور بتضاؤل القيم المشتركة لكليهما يوماً بعد يوم.([21])
وتأسيساً على ما سبق، فأن ما صدر عن فوكوياما إنما ينطوي على خلاصات تقودها أيديولوجية تتصل بمفكرها فحسب، بمعنى آخر أن توجيه الإدراك نحو شيء أقل تحديداً وغائم ـ وهو ما يترتب على تصريح بوش أيضا ـ هو من غايات الايدولوجيا، فالفكرة لا تحيل إلى شيء معين، أو هي تُعيّن كل شيء، ولا تُعيّن شيئاً على وجه التخصيص.([22]) إن فوكوياما في هذه الحالة يترك لنفسه خيار تحديدها كما يشاء، لذلك فأن توليد ظاهرة بلا ظرف وبلا سبب واضح، لا ينتج إلا ظاهرة/طفرة مفتعلة العليات تموت بموت حاجتها الأيديولوجية.
من هنا برزت فرضية (صدام الحضارات Clash of civilizations) بصيغة أكثر رجاحة، معبرة عن تصور مستقبلي آخر جديد، راسمة معالم خريطة للعالم قائمة على هندسة واقع ثقافاتي/حضاراتي، متخطية فرضية (نهاية التاريخ)، مانحة عجلة الكولنيالية أو مابعد الكولنيالية مبررات جديدة للصراع لم يتمكن فوكوياما من توظيفها.
لقد أعرب هنتنغتون Huntington عن قلقه حيال مستقبل الغرب ومستقبل هيمنته الكونية، معتبراً أن السياسة الدولية صارت تتحرك بعد انتهاء الحرب الباردة خارج حقبتها الغربية لتغدو متركزة على التفاعل بين الحضارة الغربية وحضارات أخرى غير غربية، و لم تعد شعوب هذه الأخيرة ـ في نظر هنتنغتون موضوعاً للتاريخ ـ على نحو ما يقول إدوارد سعيد أو هدفاً للكولنيالية الغربية، بل أصبحت نداً للغرب، ومحركه للتاريخ وصانعه له.([23])
ثانياً: تفعيل البعد الثقافي في السياسة الدولية
يحاصر جماع وعي أغلب المفكرين الغربيين شبح الخواء الفكري وتراجع الروح النقدية في خطابهم المعرفي المعاصر، حيث ينبؤنا (جاك دريدا) الفيلسوف الفرنسي، الذي اقترن اسمه بالمنهج التفكيكي في النقد الأدبي، والذي عرف أيضا عدائه الواضح للشيوعية من خلال كتابه (أطياف ماركس)، بمداهمة الشيوعية للعالم ثانيةً، بعد أن زالت بنحو كامل عن الوجود، بِعَدِّها كائناً شبحياً يرعب الرأسمالية على الدوام، نظراً لقوة الوعد الكامن فيها، بالقدر الذي تظهر فيه هشاشة الواقع الرأسمالي في عالم سيء ولوحته قاتمة سوداء.([24])
ففي الوقت الذي كانت فيه حركة غورباتشوف وأطروحته تنحو منحى غرائبياً مختلفاً عمن سبق، كانت الكتابات الجادة في الغرب تستشرف أفول نجم الولايات المتحدة، مثلما تؤشر حالة سقوط الاتحاد السوفيتي، إذ أثار كتاب بول كنيدي(نشوء وسقوط القوى العظمى)، السؤال الجوهري:هل تعيش الولايات المتحدة الآن مرحلة وهن وأفول أم ماذا؟ هل تُعد الولايات المتحدة اليوم مشكلة الرقم واحد في الانحطاط النسبي؟ ([25])
نظراً لافتقار النظام أحادي القطبية، لقوى رئيسة تتحدى القوة العظمى المهيمنة فأن الأخيرة تكون عادة قادرة على إبقاء سيطرتها على الدول الصغيرة، لمدة طويلة، إلى أن تضعف نتيجة عوامل تآكل داخلية أو بواسطة قوى من خارج النظام. ولذلك برهن كل من دريدا وكنيدي وآخرون على تزايد قلق الغرب على مكانته ورغبته في المحافظة على بقائه في الصدارة ليظل هو القوة (الذات) المهيمنة على العالم. ومن هذا المنطلق درج صناع القرار الغربيين على توفير خصم ضديد دائم التشكل في الوعي الغربي، وهذه مهمة المفكرين والمنظرين في خلق صراع جديد مع الآخر، لأجل زجه في صدام يخصب فضاء المواجهة، ما دامت حصيلته مطمئنة وهي الظفر للأقوى سياسياً واقتصادياً وعسكرياً ومعرفياً.([26])
وبما أن هنالك تاريخ عداوة في كل ثقافة، فأنه يفترض على المرء لكي يتخطى حدود مشاهدته، ويتحقق له المعنى، أن يتحمل جزءا من ذاته كان قد صنعه مسبقاً، ليصاحبه في رحلته، أي بمعنى آخر، تشييد أنموذج حياة متخيل سلفاً.([27])
وفي لمحة بسيطة لكتابات باري بوزان نجده هو الآخر يرسم الخطوط العامة للنمط الجديد لعلاقات الأمن العالمي التي أخذت بالتشكل بعد التحولات الكبرى التي طرأت في العامين 1989-1990 وتأثيرها على مستوى الأمن، وآلية عمل ما كان يدعى بالعالم الثالث. فقد جرى تصنيف العالم إلى مركز وأطراف بدلاً من التصنيف السابق شرق وغرب، فالمركز عنده الإقتصادات الرأسمالية المسيطرة على العالم كله، أما الأطراف؛ فهي الدول التي شغلتها معوقات التنمية وطموحات الوقوف بمصاف الدول المعترف بها من النواحي الصناعية والمالية والسياسية. وحيث أن المركز أصبح متعدد الأقطاب، فأن فرصة نشوب تصادم داخل المركز ضعيفة، إذا ما قيست ظرفية نشوبها لدى الأطراف، وهذا يتم من خلال حدوث التصادم بين الهويات الحضارية المتنافسة من جهة، وعامل الهجرة من جهة أخرى، فهما يمثلان أهم قضيتين في هذا المجال.([28])
وبحسب تعبير برنارد لويس فأن: " الغرب يواجه عصراً تبدلت فيه أساليب صعدت فوق مستوى القضايا والمعضلات، وفوق مستوى الحكومات التي تطرحها لتتجاوز إلى ما يصل إلى مستوى الصدام بين الحضارات."([29])
وعلى هذا الأساس يتلقف هنتنغتون هذا المصطلح ويعمل على صياغة مضامينه في عمل تأسيسي وإن بدا كأنه هامش مطول لأفكار برنارد لويس ليخرجه عنواناً لفرضية كانت وما تزال الأكثر إثارة للجدل، بين مؤيد متحمس ومعارض متوجس.([30])
فبمجرد أن حلت فرضية (الصِدام)، توارت على الفور فرضية (نهاية التاريخ)، ولعل السبب كان كامناً في الوظيفة التي تؤديها فكرة الصدام، حيث تقدم فرضية (نهاية التاريخ) قراءة عن عالم الحرب الباردة، وما يترتب عليه من أنظمة وسياقات، وهو ما يبعث على الاطمئنان لمستقبل الولايات المتحدة بتأكيدها على الانتصار النهائي لـ (اللّيبرالية) في حين أن فرضية(صدام الحضارات) تشير إلى ما هو مستقبلي، وتحذر من خطر المواجهة والحرب المحتملة، وتدعو صراحة إلى الحيطة والتحسب، والاستعداد للدفاع عن النموذج الحضاري الأمريكي.([31])
ترك سقوط الاتحاد السوفيتي كدولة عظمى واستحالته إلى دول قومية متنازعة، آثاره على المستوى الفكري وتحديداً على صعيد العلاقات الدولية، ما ترتب على ذلك استبدال معظم القوالب والمصطلحات السابقة والعائدة إلى فترة عالم الحرب الباردة والتي حكمت عليها الوقائع الجديدة بالانقراض. وفي محاولة جريئة لسد الفراغ النظري الكبير، يحاول هنتنغتون، أن يمرر أفكاره في هذا المجال متناولاً جوانب هامة في هذا السياق، سواء ما يتعلق منها بنهاية التاريخ أو عودة النزاعات التقليدية بين الأمم ـ أي النزاعات التي تتسم بالسمة الثقافية ـ أو تراجع الدولة القومية إلى غير مكانتها من خلال استشرافات، وتصورات مركزية شاملة لما ستكون عليه السياسات الدولية في السنين المقبلة.([32])
يشير هنتنغتون إلى إن المصدر الرئيسي للنزاعات في هذا العالم لن يكون أيديولوجياً أو إقتصادياً في المحل الأول، فالانقسامات الكبرى بين البشر ستكون ثقافية، والمصدر المسيطر للنزاع في المستقبل سيكون ثقافياً.([33]) ولذلك أصبحت فكرة الكيانات والعداوات التقليدية سانحة هذه المرة في أن تدنو من الصدارة، ومرد ذلك اختلاف الرؤية بالنسبة للعلاقات الكونية(التصورات الفلسفية) من حضارة إلى أخرى، وكذلك التفاعلات المتبادلة بين الحضارات التي من شأنها أن تنّمي أو تنّشط الفوارق والضغائن بينها.
ومن العوامل الأساسية التي أسهمت في تعزيز فكرة الصراع بين الحضارات؛ "ما تركه التحديث في بعض المجتمعات من فراغ في مجال الهوية الذاتية الأمر الذي دفع الدين إلى التحرك، ليملأ هذه الفجوة، وحصل أن أخذ الأمر شكل حركة توصف أنها أصولية"([34]). ولا يغفل دور العولمة هنا في الحد من سلطة الدولة الأمر الذي يعني تزايد أهمية الدين والقيم الثقافية وتنامي الوعي بالاختلاف(أي الوعي بالفوارق وليس بثقافة الاختلاف) المتأتي من التفاعل والتقارب بين أطراف العالم.([35])
وفي ظل هذه الأوضاع، تعتمل في ذاكرة المرء حميمية ما إلى الماضي أو ما يمكن أن يُطلق عليها مشاعر النستالوجيا التي تنتاب شعوب الثقافات المختلفة، كل الثقافات، فيحصل المأزق التاريخي بأن يكون المرء في بيئة متشابكة مربكة تنذر بزوال قضيته العامة أو خصوصيته القومية. يقول محمد باقر الصدر: " إن المسلم الذي يعيش في ظل أنظمة تتعارض مع القرآن أو الإسلام يجد نفسه مضطراً إلى ممارسة التناقض في حياته باستمرار، ويظل في دوامة هذه الولاءات المتعارضة، وقد لا يجد حلاً للتناقض إلا بالتنازل، وهذا التنازل أما يكون على حساب ذاته وثقافته وهويته، أو يكون على حساب دوره الاجتماعي فيتحول إلى طاقة سلبية."([36]) كل ذلك يجعل من الشكل العام للعالم ـ بحسب هنتنغتون ـ مرتبطاً إلى حد كبير بالتفاعل بين سبع أو ثمان حضارات كبيرة تشمل الحضارات الغربية، والكونفشيوسية، واليابانية، والإسلامية، والهندية، والسلافية، والأرثوذكسية، والأمريكية اللاتينية، وأضيفت إليها الأفريقية على تردد.([37]) ولم يكن هذا التوصيف بليغاً أو يعتمد على نوع من المغايرة بقدر ما يحتكم في وجوده إلى مرجعية تشريحية سابقة، أسس لها من قبل المفكر والمؤرخ الإنجليزي أرنولد توينبي عندما قال: " إننا لا نزال في الفصل الأول فقط من قصة الصراع مع حضارات: المكسيك، والبيرو، والمسيحية الأرثوذكسية، والإسلام، والعالم الهندوسي، والشرق الأقصى. يقول توينبي: أخذنا منذ زمن وجيز نشاهد بعض آثار صراعنا مع هذه الحضارات، ولكننا، لم نبدأ في مشاهدة آثار الهجوم المضاد الذي ستقوم به علينا، وستكون هذه الآثار هائلة بلا شك."([38]) وكأن ما يشير إليه المفكر الإنجليزي ضرب من الاستشراف خاصة إذا ما أنعمنا النظر مليا بالشواهد الواقعية التي حصلت في السنوات الأخيرة، في كوسوفو وأفغانستان، والتي يعدها هنتنغتون الجانب العملي والعمدي من نظريته.
وبناء على ما تقدم أصبح من الضروري معاينة فضاء الحضارة/الثقافة، لدى هنتنغتون وما ينطوي عليه من معان ودلالات، وتشخيص إمكانيته البحثية، في ما تتضمنه أو تحتمله تلك الحضارة أو الثقافة من قوى صراعية، لتكون المصدر العريض للنزاعات والصراعات في القرن الحالي، بدلاً من أشكال الصراع التقليدي.
ليست الحضارة والثقافة ساكنتين، فهما " تنشآن... عن احترام منهجي حثيث لعادات وتقاليد منتقاة ". ومن أجل الاقتراب من مفهوم هنتنغتون للثقافة والحضارة، يشير قاموس ويبسترNew International Dictionary بتعريفه الثقافة أنها " نموذج كلي لسلوك الإنسان ونتاجاته المتجسدة في الكلمات والأفعال وما تصنعه يداه. وتعتمد الثقافة على قدرة الإنسان على التعلم ونقل المعرفة للأجيال التالية، أما اللغة والمعتقدات والأنظمة السياسية والقانونية والأعراف الاجتماعية. فهي إرث المنتصرين وأبناء السوق وتعكس حكم السوق على الأفكار، عبر التاريخ الشعبي."([39]) وفي محاولة بسيطة يصوغ هنتنغتون تعريفه للحضارة، لكن، بأسلوب آخر لا يختلف عما سبقه، خاصة لو تأملنا في مفردات بنيته. فيقول "إنها كيان ثقافي يتحدد بعناصر موضوعية مثل اللغة والتقاليد والاهم الدين. وللناس في الحضارات المختلفة آراء مختلفة عن العلاقة بين الله والإنسان والفرد والمجموعة، والمواطن والدولة، إنها فروق أساسية بدرجة أكبر من الاختلافات بين الأيديولوجيات السياسية. "([40])
وهذه العناصر أقل قابلية للحلول الوسط والتسويات من نظيراتها السياسية والاقتصادية. ففي الاتحاد السوفيتي السابق يقول هنتنغتون: "يمكن للشيوعيين أن يصبحوا ديمقراطيين ويمكن أن يصبح الفقراء أغنياء والأغنياء فقراء، لكن الروسيين لا يمكن أن يصبحوا إستونيين، ولا يمكن الآذريون أن يصبحوا أرمن."([41]) وهذا من منطلق أن الإنسان لا يختار إرثه كما لا يختار ماضيه، وإنما يجره جراً، وأكثر من ذلك يتمسك به، ويتحصن في مواضعه عندما يجد نفسه عارياً قبالة ما يهدده من المحيط الخارجي.([42]) وهو ما يمكن أن يحيلنا إلى قول ميرسيا إلياد: "إن الأساطير تنحط وأن الرموز تدخل طي الزمن والعلمنة، ولكنها لا تزول أبداً حتى في أشد الحضارات ميلاً إلى الوضعية."([43]) إن في التشوش والاغتراب يقول هنتنغتون: "تبرز الحاجة إلى توليد هويات أكثر معنى."([44])
تستدعي التراتبية المتسلسلة التي تحكم حقيقة الانتماء ـ في غالب الأحوال ـ نوازع الهوية، لأن هذا التدرج الغريب في الحضارة، مرده إلى عناصر ذاتية تتركز على التماهي الذاتي للجماعات، بحيث يمكن لحضارة ما أن تشتمل على عدد من الدول القومية أو دولة قومية واحدة، كما قد تحتوي بعض الثقافات الكبرى على ثقافات فرعية، فالحضارة الغربية تشتمل في تقدير هنتنغتون على عدد من الدول القومية، تبرز بوجهين رئيسيين، أوروبي غربي من جهة وأمريكي شمالي من جهة أخرى، فأما الحضارة اليابانية، فتشتمل على دولة قومية واحدة، في حين تتفرع الحضارة الإسلامية إلى أربعة فروع: عربي، وتركي، وماليزي، وإيراني، ويدلل على هذا التماهي توصيف هنتنغتون؛ " إن ثقافة قرية في الجنوب الإيطالي قد تختلف عن ثقافة قرية في الشمال، ولكنهما يشتركان في ثقافة إيطالية عامة تميزهما عن القرى الألمانية، والمجتمعات الأوروبية، وبالتالي ستشتركان في ملامح ثقافية تميزهما عن المجتمعات الصينية أو الهندية. إن الحضارة لدى هنتنغتون: "هي أوسع تجمع ثقافي."([45]) كما يفهم منه إن مفهوم الثقافة ينصرف إلى العادات، والتقاليد، والفكر، والسلوك، والاقتصاد، والاجتماع، والمخيال الشعبي، والعمران، والملبس، والمآكل...الخ. ومن جهة أخرى، فأن عد الحضارة أوسع تجمع ثقافي متأت من أن محدداتها ـ كما أسلفناـ هي " اللغة، والتاريخ، والدين، والعادات، والمؤسسات". لذلك فهي تمثل حسب عباراته؛ " أوسع مستويات الهوية ". وهكذا يجعلنا هنتنغتون أمام تعريفين للحضارة بتعبير الجابري: الأول يجعل منها هوية ثقافية، والثاني يجعل منها أوسع مستويات الهوية. ولكن، دون تحديد المستويات الأخرى التي لم يدخلها ضمن مجال" الهوية الثقافية."([46]) فالمصالح ـ مثلاً ـ لا تفهم ولا تدرك ـ لو أمكن تخيلها ـ مستقلة عن مجال انتسابها، فهي بحاجة إلى معرفة الذات قبل الانطلاق في تحريكها. والعقل وحده غير كاف لقيادة المصالح، وإنما يتوجب قبل أي شيء التهيئة الناجزة لترميم الهوية، كيما يتم تحقيق سماتها، فالمناخ الفكري والثقافي والنفسي لعب دوراً كبيراً في تحقيق الإمكانات الكامنة في الواقع المادي، وفي تحديد المسار النهائي لهذا الواقع. وأن تبني ألمانيا النازية لأسلوب الإبادة لحل بعض المشاكل التي واجهها المجتمع الألماني لم يكن لينبع من الاعتبارات الاقتصادية أو السياسية وحدها، فهو أمر مرتبط بإطار ثقافي وحضاري ونفسي أوسع. إن في أحوال التغييرات المجتمعية المضطردة تكون الحاجة ماسة إلى التعريف بالهوية. ولاشك في أن الدين يقدم بنحو بليغ إجابات فاصلة بهذا الخصوص، فالأديان كما يقول الترابي:" تزود الناس بإحساس بالهوية وباتجاه في الحياة."([47])
إذن، أصبحت الهوية الثقافية العامل الرئيس في تحديد صداقات دولة ما وعداوتها.([48]) إذ مع انتهاء الحرب الباردة أخذت الجماعات التي تؤطرها ثقافة مشتركة تقفز بجرأة على الخلافات الأيديولوجية لتتخطاها، فمثلاً تتجه الصين الأم وتايوان باتجاه علاقات أوثق، لأن الاهتمام بالوحدة الثقافية شرط مسبق للتكامل الاقتصادي.([49]) إن هذا الأمر يثقف لفكرة العودة إلى تعاطي الهوية الثقافية في جانبها الأكبر والأهم متجسدا في الدين، والذي نعلم أن هنتنغتون، قد أخذه عن توينبي، فقد اعتبر الأخير أن الدين عامل عظيم الأهمية، وعّده الملاذ الوحيد الذي لجأت إليه الأغلبية على مدى تاريخ الحضارات.([50]) لقد أصبح الدين مسلّمة في فرضية هنتنغتون وهذا ما يدفعه إلى أن يصف التظاهرات العارمة لجموع المسلمين في سراييفو في العام 1994، وهم يلّوحون بعلمي السعودية وتركيا، بدلاً من أعلام الأمم المتحدة وشمال الأطلسيNATO)) دليل على توحدهم مع رفاقهم المسلمين.([51]) ونعتقد أن السبب في ذلك مرده التغيرات الكبيرة التي شهدها العقد الأخير من القرن الماضي. وعلى وفق ذلك تغير السؤال التقليدي: إلى أي جانب أنت؟ ليحل محله السؤال: من أنت؟ ولذلك بات على كل دولة أن تجد له إجابة وجودية، هذه الإجابة هي: هويتها الثقافية، التي تحدد مكان الدولة في السياسة العالمية، كما تحدد أصدقاءها وأعداءها.([52]) فعندما يُصّعد العنف نلاحظ أن القضايا المتنازع عليها، وإن قلت أهميتها تجنح إلى أن يعاد تشكيلها على أساس ثنائية الـ (نحن) والـ (هم) ليتعزز تماسك الجماعة والتزامها.([53]) كانت الهويات في الماضي هامشية لا قيمة لحركتها، تصبح أساسية وفاعلة في أوقات الأزمات، وتسمى الصراعات الطائفية حروب هويات.([54]) فالفرنسيون والألمان والبلجيك والهولنديون، راح يتزايد قلقهم، ومسؤولياتهم تتعاظم بالنظر إلى ذواتهم كأوروبيين، وتنطبق ذات المعايير على مسلمي الشرق الأوسط الذين توحدوا وهرعوا لمساعدة البوسنيين والشيشانيين. والحال نفسه مع الصينيين في أسيا، عندما راحوا يوحدون مصالحهم مع مصالح البر الرئيسي. والروس يتوحدون مع الصرب والشعوب الأرثوذكسية الأخرى ويدعمونها. هذه الحدود الأوسع للهوية الحضارية تعني وعياً أعمق بالاختلافات الحضارية والحاجة إلى ما يميز (نحن) عن (هم).
ثالثاً : دول القربى معيار التحالفات الجديد
ويرى هنتنغتون أن الأصول الثقافية تتجه الواحدة إلى ضم فروعها وامتداداتها إليها وتتجاذب الأجزاء المتناثرة من الذات القومية المتضخمة إلى الذات المركز، إذ يحدث هذا في الصين وأجزائها الكونفشيوسية، وفي اليابان وامتداداتها البوذية، وفي أميركا الشمالية وجاراتها البروتستانتية، وفي أميركا اللاتينية ومكوناتها الكاثوليكية، كما يحدث في تركيا وجاراتها الإسلامية.([55]) وأن ما يدفع إلى الاعتقاد بهذا السلوك هو أن الشعوب المنتمية إلى حضارة واحدة عندما تدخل في حرب مع شعب من حضارة أخرى تحاول الحصول على مساندة الشعوب الأخرى التي تشترك معها في نفس الحضارة([56])، على نحو ما عبر عنه غورباتشوف في البيروسترويكا بأن الصراع القادم لن يكون صراعاً بين أفكار وهويات وحسب، وإنما الصراع الغالب سيكون مسلحاً بين الدول ذات الإرث الحضاري المختلف.([57]) وأن التحالفات العسكرية والارتباطات الاقتصادية تتطلب تعاوناً بين الأعضاء، والتعاون يعتمد على الثقة، والثقة تنبع بسهولة من القيم والثقافة المشتركة.([58]) يقول جين كيركباتريك: "لقد أدهشتني هذه المقولات لأنها مثيرة، وأن كانت محل شك."([59])
ويمكن عد هذا الأمر صيغة مستحدثة سعى هنتنغتون إلى إضفائها كمنحى يحكم سير العلاقات بين الدول، كما أراد أن يؤكد من خلاله فكرة تفيد؛ أن الدول والمجتمعات تشعر الآن بعد أن أعّيتها سنوات العداوات والنزاعات والحروب العسكرية والأيديولوجية والسياسية، بقناعة تامة أن جذرها الثقافي/الديني المشترك يستوجب اشتراكا في مجريات السياسة والاقتصاد، وتسعى هذه الدول إلى تحويل الأسواق والتجمعات الاقتصادية والتكتلات والتحالفات السياسية إلى أخرى ثقافية المضمون.([60]) وهذه من الأسس التي جمعت معاً عشر دول إسلامية غير عربية: إيران، باكستان، تركيا، آذربيجان، كازخستان، قرقيزستان، تركمانستان، طاجكستان، أوزبكستان، وأفغانستان.([61]) ويصل الحال إلى امتدادات عبر قومية، عندما يجري الحديث عن خصوصية الثقافة الإسلامية على سبيل المثال، عندما يرزح تحت ظلها مجتمعات مختلفة وأقوام متعددة، و تجمعهم في ذات الوقت جميعاً رؤية محددة للعالم، هي النظرة إلى الكون والمجتمع والحياة. بحيث يعزو هنتنغتون ذلك إلى؛ "أن العالم أصبح مكاناً أصغر وأخذت التفاعلات بين شعوب الحضارات المختلفة في التزايد، فقد ولدَّت الهجرة في شمال أفريقيا إلى فرنسا عداوات فيما بين الفرنسيين، وزادت في الوقت نفسه من الترحيب بهجرة البولونيين الكاثوليك الأوروبيين الطيبين، وهذه التفاعلات بين شعوب الحضارات المختلفة تعزز الوعي بالحضارة لدى الناس، الأمر الذي عزز بدوره الاختلاف والعداوات التي تضرب أو يعتقد أنها تضرب جذورها في أعماق التاريخ."([62]) ولم يتوقف الأمر عند حدود الدائرة الغربية الأوروبية، بل تعداه إلى حدود أميركا، حيث ركز هنتنغتون على المخاطر التي تتعرض لها الهوية الأمريكية بسبب الانفجار الديموغرافي لأهالي دولة المكسيك، الذي رأى في تقديره أنه يسبب صدام حضارات داخل الولايات المتحدة ، فهناك عملية مكسكة Mexicanization لأميركا عندما يتحدث المكسيكيون المهاجرون بلغتين الإنكليزية ولغتهم، فيستشعر هنتنغتون من هذا الوضع خطورة تشكل ثقافة ثنائية في المستقبل bilingual education تتحول إلى نظام سياسي وسلطة ثنائية. وهذا المثال ترتسم حوله أو تتقاطع عنده التفاعلات والتواصلات، أو القطيعة والانكسارات، ويمكن أن يلاحظ ذلك بدرجة عالية في أزمات ما بعد الحرب الباردة وفي أماكن بدا الصراع فيها جلياً في "القوقاز والبوسنة أو في الخليج الفارسي{كذا}، على الرغم من أن هذه النزاعات ليست حرباً شاملة بين الحضارات، إلا إن كلاً منها يتوفر على عناصر تعبئة حضارية تكتسب أهميتها مع استمرار الصراع."([63]) ويقف الدين في مقدمة هذه العناصر، وهو في تنام يصل إلى مستوى الأخذ بـ (انتقام الرب) بتعبير جيل كيبل حينما يوفر أساساً للهوية والالتزام يتجاوزان الحدود الوطنية، بإمكانية تعمل على وسم دول الحضارة الواحدة من خلال إنضاج الوعي القرابي بين دول تشترك بمقومات ثقافية متعددة. ([64]) يعزو هنتنغتون ذلك مستشهداً بقول مسؤول تركي: " إنك من المستحيل ألا تتأثر عندما ترى أقاربك يُقتَلون... لذلك لم يكن الأمر اعتباطا ـ يضيف هنتنغتون ـ أن نرى في أيام الحكومة السوفيتية، أن الأرمينيين يُرّقوَن إلى أعلى الرتب، ويعيَنون في الوحدات المقاتلة بنسبة أكبر من المسلمين([65]). ويسوق هنتنغتون الشواهد الإعلامية التي تدعم دعاواه في هذا الموضوع، حيث يقول: "إن صدام حسين أنكر في حرب الخليج القومية العربية، حين لجأ إلى الاستنجاد باسم الإسلام، وفي ذات الموضوع يعرف الخامنئي الحرب ضد العراق بأنها حرب بين الحضارات ويعدها بالحرب المقدسة ضد الغرب، باخساً خصومة الأمس مع العراقيين."([66]) وهي كما نرى: أساليب سياسية درج صَدام والخامنئي، كلاهما إلى تبني معطياتها، لدمج الجماهير معهما من أجل سبك خطابهما التثويري، الذي يمنح المشتغلين عليه شرعية تثبيت الصورة وتحديد الغايات، الغايات السلطوية أو على نحوها. وبذلك فأن هنتنغتون يسعى لاستصدار تعميم لازم للغرب يرى بأن هذا النوع من الصراعات يجترح نمطاً جديداً من العداوات التاريخية، ويكفي الإشارة إلى ما تشهده دول الاتحاد السوفيتي السابق من صراعات دامية بين الأرمن والآذريين، وفي جمهورية جورجيا وبين القوميات المختلفة في الاتحاد السوفيتي السابق، وبين الهند والباكستان، وفي قبرص وفي أسبانيا وبريطانيا وفرنسا وبين البلجيكيين فيما بينهم واحتمالات تفاقمه في الولايات المتحدة نظراً لتعدد الأعراق والخصوصيات الثقافية والحضارية.([67]) لقد كان الاتحاد السوفيتي السابق ويوغسلافيا السابقة يهيمنان وبشكل قسري على أكثر من حضارة، وما أن أزفت ساعة الانهيار والتفكك، أعلنت هذه الدول عن مرجعياتها الثقافية.([68]) لقد حلت صراعات طائفية كثيرة محل صراع القوة الكبرى الواحدة. ولأن هذه الصراعات الطائفية تتمحور على جماعات من حضارات مختلفة، فأنها بتعبير هنتنغتون: تميل إلى الأتساع والتصاعد، حيث يحاول كل جانب أن يحشد الدعم من الجماعات والدول التي تنتمي لنفس حضارته، وكلما طال أمد خط التقسيم زاد احتمال تورط دول القربى في أدوار الدعم والكبح والوساطة، ونتيجة لبروز هوية دول القربى فأن إمكانية تصعيد صراعات خطوط التقسيم بين الحضارات أكبر من إمكانية تصعيدها داخل الحضارات.([69]) والأرجح احتمالاً تورط المسلمين من جهة وغير المسلمين من جهة أخرى، والتصعيد يحصل على الأرجح، إذا تنافست الدول الإسلامية التواقة إلى تقديم المساعدة لإخوانها في الدين المستعدين للمعركة، لكنها حرب بعيدة الوقوع بسبب مصالح الدول القريبة ذات المرتبتين الثانية والثالثة في عدم التورط بصورة بالغة.([70]) ولا بد من الإشارة إلى تلك المستويات من الصراع بشيء من التفصيل، فهي تنشب بين المختلفين حضارياً، وفقاً لمدونة خطوط التقسيم الحضارية، فعلى المستوى الرئيس هناك دول تتقاتل فيما بينها مثل الهند وباكستان، وما تُحدِثه إسرائيل من قتال مع العرب، أو قد تكون جماعات محلية أو دولاً أجنبية على أحسن تقدير مثل البوسنة وأرمن ناجورنو كاراباخ، وربما يدخل المستوى الثاني من الصراع في مثل هذه الحروب وهذه عادةً ما تكون بين أطراف يرتبطون مباشرة بالأطراف الرئيسة، مثل حكومات الصرب وكرواتيا في يوغسلافيا السابقة، وحكومات أرمينيا وأذربيجان في القوقاز وعلى صلة بالصراع أيضاً هناك دول الدرجة الثالثة البعيدة من القتال الفعلي، ولكن لها روابط حضارية بالمشاركين فيها، مثل الدول الإسلامية بالنسبة ليوغسلافيا السابقة وروسيا وإيران بالنسبة للصراع الأرميني الأذربيجاني، وهؤلاء غالباً ما يكونون دول المركز في الحضارات.([71])
وبناء على ما تقدم، يهمنا معرفة ماهية خطوط التقسيم الحضارية والكيفية التي مكنت دول الحضارة الواحدة من التحرك عبر آلية خطوط التقسيم هذه. إن انقساماً ظهر بعد نهاية الحرب الباردة في أهم خط تقسيم في أوروبا، مثلما أشار وليام والاس ما بين الكاثوليكية والأرثوذكسية وخطر هذا الانقسام يمتد الآن بين فنلندا وروسيا ودول البلطيق وروسيا، قاطعاً بيلاروسيا وأوكرانيا، فاصلاً أكثر فأكثر ما بين أوكرانيا الغربية الكاثوليكية وأوكرانيا الشرقية الأرثوذكسية، ويتجه الخط غرباً ليفصل ترنسلفانيا عن بقية رومانيا ويخترق يوغسلافيا، وبالتحديد على امتداد الإمبراطوريتين العثمانية والهابسبورغية.([72])
ويستطرد هنتنغتون كثيراً في مسألة النزاع ما بين الحضارتين الإسلامية والغربية الذي بدأ قبل 1300 عام ويشرح "مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية وانبعاث القومية العربية والأصولية الإسلامية، وتزايد اعتماد الغرب على نفط دول الخليج الفارسي[كذا] واندلاع حروب عديدة بين العرب وإسرائيل بفعل الغرب."([73])
رابعاً: النزعة المركزية
تظهر نزعة التمييز والشطر والثنائية بصورة بليغة في الإدراك الغربي، خصوصاً بعد أن جعل الغرب مركزيته هي المعيار في الفكر والوجود، وحاول تبعاً لذلك اختراع العدو أو صنعه عبر تقسيم العالم قسمة أنطلوجية جغرافية، سياسية، فكرية، أيديولوجية، بل ومعرفية قائمة على تفرد في التفكير لا يمكن تأمل الكون فيه إلا من خلال أضداد مزدوجة يحدد كل ضد فيها الآخر ويمنحه هويته.([74]) وبالإمكان تلمس ذلك بوضوح لدى هنتنغتون عندما يقول: " إن الحضارة الغربية هي حضارة كونية كلية، تناسب كل الناس، فالمفاهيم والاتجاهات الثقافية المجتمعية الخاصة بتلك الحضارة، تختلف بصورة أساسية عن تلك السائدة في الحضارات" والأفكار الغربية عن الفردية والليبرالية، والدستورية، وحقوق الإنسان والمساواة والحرية، وحكم القانون، والديمقراطية، والأسواق الحرة، وفصل الكنيسة عن الدولة، بدت وكأنها دخيلة على بقية الثقافات.([75]) غير أنها مثلت حصيلة تراكم وتفاعل ثورات غربية هائلة لم تكن لتتم أو لتؤثر خارج محيط التجربة الخاصة بالإنسان والمجتمع الأوروبي، لولا فواعل الثورة الدينية البروتستانتية، وتشكل ونضج النزعة الفردية، والثورة العلمية المنهجية وصولاً إلى الثورة التقنية المعلوماتية.([76])
وهو ما يبرر حقيقة اندفاع الفرنسيين آنئذ وهم في أوّج عصر المركزية الأوروبية حينما اعتبروا أن من أولويات عملهم التاريخي، تعميم أفكار الثورة الفرنسية في الحرية والإخاء والمساواة والعدالة وحقوق الإنسان، وعندما صاغوا مقولتهم الثقافية هذه بعبارة: دور فرنسا في تحضير العالم، مما أغراهم في نقل تلك القيم والمفاهيم على كل المستويات الإدارية والتربوية إلى المستعمرات والشعوب الشرقية.([77])
و لمعالجة تفاصيل واقع ثنائية (الأنا) و(الآخر) عبر التاريخ لابد ـ ابتداءً ـ من معرفة الدوافع الموضوعية التي حفزت الغرب على تبني هذه الفكرة وتفصيلها بشكل علمي. يقول توينبي: "إن نجاح الحضارة الغربية مادياً قاد إلى فرض الغرب لفكرته، إن النهر الغربي هو النهر الوحيد الذي تنبع منه الحضارة."([78]) وعلى نحو وصفي ومعياري، يشير هنتنغتون إلى " أن المعتقدات الغربية العالمية تفترض أن شعوب العالم بأسره لا بد لها أن تعتنق القيم والمؤسسات والثقافة الغربية، لأنها تجسد أرقى فكر ولأنها أكثرها استنارة، وليبرالية، وعقلانية، وحداثة وتحضراً … أن الغرب يدخل في ما سوف تسميه الأجيال القادمة بالعصر الذهبي."([79])
لقد برزت فكرة المركزية تاريخياً عند الإغريق()، حين مثلتها بصورة خاصة تعميمات كل من أفلاطون وأرسطو، عندما ابتدعا نوعاً من السياسة تحكمها فكرة المجال السياسي، وهي فكرة مقدسة عندهم، تقوم على تمييز بين الداخل والخارج، حيث تقع بشائر وإمكانيات الإنجاز البشري في (الداخل) بينما لا يوجد شيء من ذلك في (الخارج)، ذلك لأنهم كانوا يعتبرون من هو خارجي في مرتبة أدنى من ضحايا الظلم الخاسرين في الداخل.([80]) إنها فكرة قائمة على الاختزالية في الغالب، تعرف (الآخر) بأنه مختلف بشكل أساسي عن (نحن) حيث كان (الآخر) بالنسبة إلى أرسطو هو الغريب الذي لم يتمكن من استخدام وفهم اللغة المشتركة، ونتيجة لذلك أصبح عبداً... وهو على هذا النحو أخذ يلعب دوراً حاسماً في تطور هوية (الأنا) كما إنه مثل شرطاً لغناها، ونضجها، إلى الحد الذي يصبح معه رفض الآخر يعادل موت الذات.([81])
لذلك فأن تحصيل المعرفة يجري لدى جانب على حساب الجانب الآخر، وبالتالي فأن جميع ما يرمي إليه هذا الجانب، هو تكريس نزعة مركزية واضحة، كان لها ما يحققها تاريخياً، وهو ما يكشف لنا حقيقة حلم قيام الإمبراطورية العالمية التي نادت بها البابوية آنذاك والذي لم يكن من أجل نشر قيم الدين المسيحي، وإنما كانت هناك رغبة ـ بتعبير الجابري ـ في إحياء الإمبراطورية الرومانية القديمة، التي كرست حكم أوروبا للعالم قبل ظهور المسيحية وبعدها، من خلال تصميم رؤية جديدة للكون تستغني عن الدين وأخلاقياته واستشرافاته الغيبية.([82])
وفيما بعد تحول ذلك (الآخر) إلى موضوع علمي معرفي، ومشروع بحثي ميداني، مما جعل الغرب يقترب منه بهذه الطريقة، ممعناً بالوصول إليه، لإدارته وأحكام السيطرة عليه، وضبطه.([83]) إن استشراقاً كهذا إنما وجد لتعزيز مركزية الغرب وهيمنته على الأطراف التابعة. ففي سياق عقلانية (الحضارة) وعلميتها وموضوعيتها، وبراءة إنتاجها قدَّم الغرب تصوراً عاماً وهو أن التطور الأوروبي الغربي ليس مقيداً بشروط التاريخ الغربي وسياقاته، وإنما هو نمط كوني ثابت لا مفر من أن تسلكه المجتمعات الأخرى سبيلاً للتقدم والتطور، فلم يكن الغرب نمطاً أحادياً يمثل خصوصية ثقافية معينة كأي نمط آخر، وإنما هو النمط العالمي.([84]) كما حرص الغرب على تقديم السياق التاريخي بين الدول والمجتمعات باعتباره صراعاً حضارياً، جرى تحديد شروطه مسبقاً، وليس تنافساً ثقافياً مفتوحاً بتلقائية، بحيث نجح الغرب، في هذا الصراع، في أن يقف منفرداً في تمثيله للآخر الحضاري، وتقديم ذاته باعتباره: الواقعي المجسد، العلمي التقني، الكوني الممتد، والدينامي المتحرك دائماً.([85]) لذلك بات لزاماً على تلك الشعوب كافة ـ وفقا للمنظور الغربي ـ أن تنشد عناصر نهضتها خارج نطاق ثقافتها الخاصة، وتتبنى قيم أوروبا الفكرية والسياسية بحيث يكون التاريخ الغربي هو التاريخ الحقيقي والمنطقي والإيجابي الوحيد ويتم ذلك من خلال تدعيم مشروع تمديني للشعوب يتم على منوال ترسيمة التاريخ الغربي؛ النموذج التنموي العمومي للجميع الذي ينأى بمعزل عن تراثها الثقافي وبناها السياسية والاقتصادية وطموح شعوبها.([86])
يقول فؤاد عجمي في معرض رده على مقال (صدام الحضارات): "إن الغرب وهو يصنع نفسه على مر القرون، ساعد أيضاً في صنع الآخرين، لذلك كان هنتنغتون منزعجاً من جراء نزع الطابع الغربي عن المجتمعات، وإضفاء الطابع الوطني عليها، وشاعراً بالقلق من إرادتها الظاهرة في أن تمضي في طريقها الخاص."([87]) أي أن هناك كما يقول هنتنغتون: "انكفاءً واضحاً إلى الداخل، وإضفاء طابع آسيوي في اليابان وانتهاء تراث نهرو، وإضفاء طابع هندوسي في الهند، وإعادة (أسلمة) الشرق الأوسط .. إن غرباً في أوج قوته، يواجه كيانات ليست غربية، ترغب في تشكيل العالم بطرائق غير غربية."([88]) الأمر الذي جعل هنتنغتون يطرح سؤال التحديث والتغريب الذي يقف عنده في(صدام الحضارات)، فهو يرى أن الحداثة تصبح مرادفة للتغريب وقد تسفر عن حركة ارتجاعية وعداء مرير. وهو ما يجعل المجتمعات غير الغربية، تطرح على نفسها مسألة ما إذا كانت تستطيع أن تكون حديثة دون أن تكون غربية.([89])
وليس هناك من شيء أدل على النزعة المركزية والتمييز عند هنتنغتون أكثر من امتعاضه من نزعات التمنع التي تبديها الذوات الثقافية الأخرى، وهو ما ساعد هنتنغتون على الإقرار بمبدأ تعددية الثقافات وقيمومتها، بخلاف ما كان يذهب إليه فوكوياما. إن هنتنغتون يسعى إلى حمل الثقافات غير الغربية على الاعتقاد: بأن الحضارة ذات طبيعة غربية خالصة، وأن الغرب والحضارة صنوان متلازمان تاريخياً، بدءاً من الجذر اليوناني، مروراً بالجذع الأوروبي، وانتهاء بالامتداد الأمريكي.([90])
وليس ببعيد فأن مقولة التاريخ الكوني، أو الشمولي في القرنين الماضيين، قد انطلقت من الأدبيات التي رعتها المركزية الأوروبية في مرحلة صعدوها، واعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية جزءاً لا يتجزأ من مسيرة التاريخ الكوني.([91]) إن الغرب يحاول الحفاظ على وضعه المتفوق والدفاع عن مصالحه على إنها مصالح (المجتمع العالمي) بحيث أصبحت هذه العبارة على يد هنتنغتون هي التسمية المهذبة لما كان يطلق عليه (العالم الحر) بهدف إضفاء شرعية كونية على الأعمال التي تعبر عن مصالح الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى.([92])
يقول إندراوس ستيفنسن في كتابه (القدر البّين): "إن الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بنِعم فريدة من نوعها، فإذا كانت الحروب والثورات التي شهدتها البشرية شراً وبالاً عليها، فمن المؤمل أن تسود الحضارة والتنوير وإمبراطورية الديمقراطية أرجاء العالم في يوم من الأيام، وأفضل مثال على ذلك هو الولايات المتحدة الأمريكية، لأن تاريخها مفتاح لفهم التاريخ العالمي وإلى أن يأتي اليوم الذي تعود فيه الحضارة والديمقراطية والتنوير، فأن الشعوب المتحضرة هي التي يجب أن تحكم من هم أدنى منها.([93]) لذلك، يرى هنتنغتون، أن من البديهي اعتبار الحضارة الغربية التي تقود مسيرتها الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحاضر، الحضارة المتفوقة على الحضارات الأخرى، على الأصعدة العسكرية والسياسية والاقتصادية كافة.
لقد اختفى الخصم السوفيتي من خريطة العالم، وأصبح الصراع (الغربي ـ الغربي) بعيد الاحتمال، لأن الديمقراطيات ـ بتعبير فوكوياما ـ لا تتصارع، وباستثناء حالة اليابان، فأنه لا يوجد تحد اقتصادي حاد سيواجه الغرب، وأن المؤسسات الدولية كـ مجلس الأمن، وصندوق النقد الدولي، تستلهم مصالح الغرب فيما تريد أو تقرر، بحيث لا يعدو مصطلحا (العالم الحر) و(المجتمع العالمي)، أن يكونا سوى وجهين للعملة نفسها.([94]) إلا أن مثل هذا الوضع يواجه بمعارضة شديدة من قبل الآخرين، الذين يتفقون مع وصف جيورجي أرباتوف لمسؤولي صندوق النقد الدولي بأنهم: (البلاشفة الجدد) الذين يحلو لهم مصادرة أموال الآخرين، وفرض قواعد من السلوك الاقتصادي والسياسي، غير ديمقراطية أو غربية، وخنق للحريات الاقتصادية.([95]) وهذا ما يؤكد بروز ثنائية عالم هنتنغتون في هذا السياق، حيث لا يأخذ النظام العالمي لديه شكلاً أحادياً أو متعدد الأقطاب، وإنما يقوم على واقع ثنائية هجينة، قوامها نظام أحادي/متعدد الأقطاب، يضم قوة عظمى واحدة، وقوى أخرى في الطرف الآخر.([96]) وأن مثل هذه الآلية التي تقسم الغرب عن المجتمعات الأخرى تتزايد أهميتها في الأجندة الدولية، وستفرز ثلاث قضايا تتضمن مساعي الغرب من أجل([97]): الحفاظ على تفوقه العسكري بأتباع سياسات منع الانتشار والانتشار المضاد للأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية وطرائق السيطرة عليها وتقنياتها، وإشاعة قيم ومؤسسات الغرب بالضغط على المجتمعات الأخرى لاحترام حقوق الإنسان والأخذ بالديمقراطية الغربية كما يتمثلها ويفهمها الغربيون، وحماية التماسك الثقافي والاجتماعي للمجتمعات الغربية بتقييد عدد المسموح بقبولهم من غير الغربيين كمهاجرين أو لاجئين، وفي تلك المجالات الثلاثة واجه الغرب ومن المرجح أن يظل يواجه صعوبات لحماية مصالحه ضد مصالح المجتمعات غير الغربية.
وهنا، يحدد هنتنغتون مهمات الدول غير الغربية للحيلولة دون إعطاء الغرب فرصة للتوسع وبسط هيمنته، من خلال إجتراح خيارين في تحديد مواقفها من ميزان القوى الجديد، فأما الانعزال وانتظار أفول السيطرة الغربية، أو خلق نوع من التوازن مع الغرب.([98]) لذلك يتقصد هنتنغتون ـ كما أسلفنا ـ تثبيت وتعيين الثقافات غير الغربية، لتقف مجتمعة في تمثيلها لخصوصيات الذات الثقافية، ولم يترك لها إلا مجالاً ضيقاً لتقديم نفسها طواعية أو قسراً، عاداً إياها ثقافات مثالية مجزأة، ضيقة، محدودة، محلية، خصوصية، ساكنة، جامدة.([99]) وهذه التوصيفات إنما انبنت لتفعل فرضية (الصِدام) بذات الكيفية التي قسمت العالم إلى محاور متنافرة كما جاء في خطاب رئيس الولايات المتحدة (جورج ووكر بوش) عندما قسَّم العالم إلى محورين، محور خير ومحور شر، ويعني بذلك المجتمعات الغربية وحضارتها تمثل محور الخير، بينما المجتمعات المتبقية تمثل محور الشر، وهذه المقولة تُعبر عن أيديولوجيا جديدة على أساسها يريد الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية فرض هيمنته وسيطرته الجديدة على العالم.
ستكون هذه الأيديولوجية من وجهة نظر هنتنغتون المحور الذي تدور حوله الأمور وهكذا تستمر الحرب الباردة، ولكن على جبهات متعددة، حيث تتصارع وفقاً لفرضية هنتنغتون العديد من أنظمة القيم والأفكار من قبيل: الإسلام والكونفوشيوسية للصعود والسيطرة على الغرب.([100]) لذلك يعتمد مستقبل الغرب هنا على وحدته ذاته، وتماسكه الطوعي عبر المحافظة على وحدة الحضارة الغربية، ووفقا لهذا الطرح فإن من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أن تحققا تكاملاً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً أكبر في مواجهة الحضارات الأخرى التي تدرك بعض الاختلافات القائمة بين أوروبا والولايات المتحدة ([101]).
خامساً : تأكيد نزعة الإستشراق
كان اليسار في الغرب يرى الحركات الإسلامية مظهراً من مظاهر صعود التيارات الفاشية المعادية للديمقراطية، وترى القوى الليبرالية تلك الحركات تجسيداً لطغيان التقاليد الإقطاعية المتخلفة التي تعيشها هذه البلدان، ولكن، مع تنامي الحركات الإسلامية، وتصدرها ساحة الفعل السياسي في البلدان الإسلامية بدأت هذه القوى (الليبرالية) تُغيّر من نظرتها لهذه الحركات، وخصوصاً عندما هيمنت تلك الفكرة بفاعلية على أعمال الساسة والمفكرين الغربيين، وقد رأى هنتنغتون على سبيل التخصيص " أن حروب المسلمين حلت بدلاً من الحرب الباردة، وهذه الحروب المدنية والصراعات المحلية بين الدول وهذه المستويات جميعاً من شأنها أن تتحول إلى صراع كبير بين الحضارات، بين الإسلام والغرب أو بين الإسلام والآخرين، ومن المتعذر تفادي ذلك كله، فثمة احتمال أن تنتشر أعمال عنف كهذه بشكل أكبر وعلى نحو متكرر وبأنماط مختلفة([102]).
وفي ضوء هذه المغايرة الجديدة ـ لفهم واقع الإسلام وحركيته ـ أُشغِل الغرب بمسألة الصراع الثقافي بعدما ظن وقتاً طويلاً إنه قد هيمن على المسلمين وثقافتهم وأعاض عنها بثقافته. والحقيقة لم تتمكن الجامعات الغربية ولا المناهج الغربية المهتمة بتوجيه مدركاتهم أن تغذيهم بما يراد لهم من علم وثقافة([103])، بل على العكس من ذلك شملت الصحوة الدينية كل مجتمعات العالم تقريباً وليس الإسلام وحسب، فمع بداية السبعينات اكتسبت الرموز والمعتقدات والمبادئ والممارسات والسياسات والتنظيمات الإسلامية احتراماً متزايداً ودعماً في كل أنحاء العالم المكون من بليوني مسلم، تمتد جغرافيته من المغرب إلى إندونيسيا، ومن نيجيريا إلى كازخستان، حيث تحركت (الأسلمة) بادئ ذي بدء إلى عالم الثقافة لتنتقل من ثم إلى المجالات الاجتماعية والسياسية([104]). ولذلك من البديهي أن تتبدى دوافع النزعة الثقافاتية لدى هنتنغتون بصورة جلية عندما ركز عمله بالأساس على الجانب الثقافي، وآيته في ذلك : إن معرفة الغرب بالإسلام والشعوب الإسلامية لم تكن لتنشأ وتترعرع من الهيمنة والمواجهة فحسب، وإنما من الكراهية الثقافية بالدرجة الأساس([105]). وإن استمرار الإرث الحضاري للحروب الصليبية والشعور المسيحي، بخطر الإسلام، واستمرار آثار الاستعمار الأوروبي الحديث للعالمين العربي والإسلامي له الشأن في خلق منافسات مشحونة بالتوتر المصاحب لتراث تلك العداوات التاريخية الضخم([106]). وساهمت الأطروحات الاستشراقية أيضاً، في ترسيخ وإدامة هذا اللون من التصور في المخيال الغربي. ويشخص تصور (رينان) إنموذجاً في هذا السياق سواء من حيث وضوحه أم من حيث تأثيره في المستشرقين المتأخرين وتلامذتهم الغربيين. يرى رينان المعادي بطبعه للفلسفة العقلية والعلم، أن (العِرق) العربي ككل الشعوب السامية منزو في حلقة الغنائية والنبوية الضيقة، ويضيف: إن المسلمين هم أول ضحايا الإسلام، وهي الفكرة التي رددها أيضاً فون غرونباوم و فوليني حيث يقول الأخير: إن سبب بؤس المسلمين كامن في طبيعة مؤسساتهم الاجتماعية، بسبب الطغيان المشحون من الدين.([107]) وأعقبهم في الآونة الأخيرة أيضاً كل من برنارد لويس وهنتنغتون، و ساهم هذان المفكران أكثر من غيرهما في تسويق فرضية الصدام وثقافة المواجهة([108]). حيث عدَّ لويس الإسلام الخطر الأكبر الذي يهدد العالم الغربي ونعته بالخطر (الأخضر)، ورأى أن على الغرب أن يتحِدَ لمواجهة هذا الخطر([109]). وهو ما دفع وسائل الإعلام الغربية، إلى إطلاق مصطلح القنبلة الإسلامية على القنبلة النووية الباكستانية. في حين لم يطلق على قنبلة الهند "القنبلة الهندوسية " أو على القنبلة الإسرائيلية بالقنبلة اليهودية ولم يسمع أحد بقنبلة مسيحية على الرغم من تصنيع أوروبا وأميركا لها. وبتعبير رودنسون: " إن الإسلام في نظر الغرب يتعدى أن يشكل خطراً وحسب، بل إنه معضلة فالحرب الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على أفغانستان لم تكن حرباً ضد الإرهاب بالمعنى الدقيق للعبارة، حيث يقول فوكوياما: " إن الأمر ـ لسوء الحظ ـ ينصرف إلى خطر أوسع من ذلك بكثير، وليس معنياً بجماعة معينة من الإرهابيين فحسب، وإنما يخص جماعة من الإسلاميين والمسلمين المتطرفين الذين تلغي هويتهم الدينية جميع القيم الإسلامية الأخرى([110]). حيث مثلت أحداث الحادي عشر من أيلول 2001 الجانب العملي من فرضيتي لويس وهنتنغتون، كذلك غيرت من مواقف وآراء كثير من الغربيين تجاه العلاقة بين الغرب والإسلام والتي عملت على زيادة التوتر والصدام، ومنها إصدار حكم بتعويض الأميركيين عن الخسائر المالية من السعودية، من جراء الحدث آنف الذكر، باعتبارها مركز الإسلام، كأجراء للحد من غلواء هذا الخطر([111]).
قاد التحسب لمثل هذا الخطر (توينبي) من قبل إلى التحذير من مغبة ظهور الصحوة الإسلامية التي تمت الإشارة إليها، فيقول في كتابه الحضارة في الميزان: " صحيح أن الوحدة الإسلامية نائمة ولكن يجب أن نضع في حسباننا أن النائم قد يستيقظ إذا ما انتفضت البروليتاريا (ويقصد بهم بسطاء المسلمين) ضد السيطرة الغربية، وإذا ما نادت بزعامة معادية للغرب، إذ يمكن لهذا النداء أن يوقظ أصداء التاريخ البطولي للإسلام، فالإسلام يمكن أن يتحرك ويقوم بدوره التاريخي إذا تغير الوضع الدولي، وأرجو أن لا يتحقق ذلك"([112] ). وعلى المدى البعيد يقول هنتنغتون: " لن يفي آدم سميث ولا توماس جيفرسون بالاحتياجات النفسية والعاطفية والأخلاقية للمهاجرين إلى المدينة أو الجيل الأول من خريجي المدارس الثانوية. ولا المسيح قد يفي أيضاً وإن كانت فرصته أكبر، على المدى الطويل.. وسينتصر محمد"([113]).
الغرب إذن في تعامله مع العالم الإسلامي محكوم ومأسور بمحددات وأطر ثقافية ذات نوعين أولهما: موروث مستقر في ذاته وموصول بمركزيته الثقافية. وثانيهما: متأت من مقدرة الثقافة الإسلامية على أبداء الممانعة الفعالة لتغدو في المحصلة مؤثرات خارجية تستحضر النوع الأول خاصة مركزيته الدينية.([114])
فلا مناص- كما أسلفنا – من سيطرة تاريخ عداوة ديني مترسب لدى الغرب المركزي في تناوله لمعطيات العلاقة مع المسلمين. يقول هنتنغتون: "إن هذا التفاعل العسكري الذي يمتد عمره قروناً بين الغرب والإسلام ليس من المرجح أن ينحسر، بل قد يصبح أكثر خطراً"([115]).
وعندما يتحدث هنتنغتون عن الإسلام هنا، لم يكن ليقصد الإسلام بمعناه الضيق، بحصره وتحديده بسلوك الأصولية الإسلامية وحسب، وإنما المشكلة الهامة والرئيسة فيه الإسلام نفسه، فهو حضارة مختلفة، شعبها مقتنع بتفوق ثقافته، وهاجسه ضآلة قوته([116]). فالمسلمون يُعنون بمسألة التمايز بين حضارتهم والحضارة الغربية، وعلى تفوق ثقافتهم أيضاً، والحاجة إلى الحفاظ على ثبات وديمومة تلك الثقافة ضد الهجوم الغربي. " يخشى ويمتعض المسلمون من القوة الغربية وما يمثله ذلك من خطر بالنسبة لمجتمعاتهم ومعتقداتهم"([117]).
يقول غرونباوم: " تكمن وراء هذا الارتياب مشكلات العلاقة بين شرائح ذات تنشئة اجتماعية كونية وبين شرائح ذات تنشئة اجتماعية خاصة، ولذلك تتصف رسالة الإسلام الدينية وأيديولوجيته الجماعية بنزعة كونية وترتبط في الوقت نفسه بعناصر ثقافية مخصوصة على مواطن ما([118]). ولذلك ترسخ هذا المبدأ أحياناً الوضعية التاريخية نفسها، التي قد يسيطر عليها التنازع المعين والمكشوف بين إرثين ثقافيين أثنين. يقول هشام جعيط: جعل هذا الأمر الغرب ينظر إلى الإسلام عبر التاريخ على أنه قوة عسكرية مهددة ومجال اقتصادي حيوي وعدو أيديولوجي، وتمت على وفق هذا المعيار ولادة أوروبا ، ولا يمكن أن تتم إلا عبر الإسلام([119]).
وفي ظل وجود المهيمنات التاريخية والحضارية بين العالمين المسيحي والإسلامي لم يكن سهلاً على المسيحيين أبداً أن يغيروا من نظرتهم إلى ذواتهم وإلى المسلمين على السواء، وأن ينسلخوا من ذاكرة التاريخ، وأن يتجردوا من أعباء تركة معركة (بواتيه) التي تذكرهم بالمحاولة الإسلامية قبل أكثر من ألف عام عبر فرنسا بهدف (أسلمة أوروبا) وكذلك الحصار العثماني لمدينة فيينا في العام 1529. و لم يكن من البساطة أن يصفح المسلمون عن الماضي المثقل بذاكرة الغزو والهيمنة والإستعمار، حيث ما زالت أعراض حروب الفرنجة حافلة في نفوس بعض المسلمين حينما حاول بعض الصليبيين (مسحنة) العالم الإسلامي([120]).
وهنا يستلزم التمييز بين ما يزمع هنتنغتون إثارته بشأن الصدام مع الآخرين وبين ما يفهم من المرجعية العقيدية التي يتوفر عليها الإسلام كـ حضارة، حيث يقول بهذا الصدد: "على الرغم من وجود جذور لحروب المسلمين في أكثر الأسباب عمومية، إلا أن هذه الأسباب لا تتضمن الطبيعة المتأصلة في التعاليم والمعتقدات الحضارية الإسلامية، أو التي في الحضارة المسيحية، والتي يتمكن المتمسكون بها استخدامها لتبرير السلم والحرب على وفق ما يرون"([121]). وهو ما ينم عن نزوع عقلاني حيال فهمه لتلك الآلية. ومع ذلك فقد جهدت الإستراتيجية الأمريكية في اختيار الإسلام ليكون بديلاً عن الشيوعية وليملأ الفراغ العدواني، حتى ليمكن القول إن المسألة لا تتعدى كونها ضرورة سياسية وإستراتيجية أمنية تقتضيها سياسة ملء الفراغ العدواني الذي تفرضه ديمومة واستمرارية الحضارة الغربية([122]). مثلما يكشف لنا هذا الأمر التعاطي الواضح بين هذا النوع من الحقائق المتنافرة، فمن جهة التفتت الولايات المتحدة فوجدت بعد عام 1990 أن حلفاءها التقليديين يتمثلون في أعضاء المؤتمر الإسلامي باستثناء إيران والعراق (سابقا) وسوريا، وهؤلاء الثلاثة كانوا مصادر إعانة للولايات المتحدة!! فكان للتناقضات التي تثيرها نظمهم السياسية، الأثر الواضح في تدعيم إستراتيجية الولايات المتحدة الإقليمية في الشرق الأوسط، أو وسط آسيا أو غيرها. ومن جهة أخرى اكتشفت الولايات المتحدة أيضاً إنها بحاجة إلى القوة الإسلامية، ولكن على نحو آخر في مناطق عديدة من العالم ومن أهمها منطقة البلقان والقوقاز وآسيا. فبغض النظر عنها تركت لها مساحة الحركة والحيوية والعلاقات، ولم يكن بن لادن والطالبان إلا أنموذجاً حقيقياً للمعادلة الصعبة([123]). إذ من العبث بمكان تبرئة الحركات الإسلامية من القصور البادي على سلوكها، فقد جعلت دائماً من سلوكها موضوعاً للاستدراج، وتنازلت عن أن تكون بديلاً عن إنشاء الفعل ومباشرته من خلال الوعي المعين لغايته وهدفه.
وعلى الرغم من ضمان الولايات المتحدة التحكم بمجريات الأحداث فأنها تدرك تماماً مكمن الممانعات الثقافية البادي على سلوك الثقافات الإسلامية، وعلى هذا الأساس تسعى الولايات المتحدة الأمريكية دائماً لامتلاك حق الوصاية في وضع المعايير والقيم التي من خلالها تتمكن من تذليل وخرق مفهوم السيادة الفكرية والسياسية للحضارات الأخرى، ومنها قيم حقوق الإنسان والديمقراطية. وهذه القيم على الرغم من سموها إلا أنها وظفت سياسياً من قبل الغرب ضد دول الممانعة، عبر توجيه مفهوماتها الخاصة حيال الدول الإسلامية. ويؤكد هنتنغتون على ذلك بقوله: "إن من شأن الاختلاف في الثقافة والدين أن يتسبب في خلق خلافات حول القضايا السياسية، ومن ثم تتفاوت صور الخلاف التي تدور مثلاً حول حقوق الإنسان في ضراوتها وأشكالها."([124])
خاتمة
وعلى هذا الأساس جرى توصيف أهم ما يمكن أن يشكل نسيج وعماد فرضية (صدام الحضارات) مع العناية والاحتراس من الحكم الصريح أو التقييم المعياري لها، مكتفين بسرد ما يجانب حقيقتها فحسب، وعرض الطريقة التي حاول هنتنغتون تدعيمها، فما كان منا إلا متابعة المرجعيات التي دفعت الكاتب إلى توظيفها، والظروف التي ساهمت في إنشائها اعتماداً على ما كتبه الأولون كـ شبنغلر وتوينبي وبرنارد لويس وغيرهم.
ولعل ما يلفت الانتباه هنا، إن هذه الفرضية من المستبعد أن تكون قد كتبت بعيداً عن إرادة وسلطة صانع القرار الأمريكي، ولاشك في أن كاتبها قصد صياغة ملامحها لصالح هدف أيديولوجي إستراتيجي تهتدي به السياسة الأمريكية في السنوات المقبلة. لقد حاول هنتنغتون لأول مرة استدراج مفهوم الثقافة والحضارة إلى مجال السياسة الدولية بعّده الطابع الموضوعي الذي ترتسم في ضوئه معالم الخريطة السياسية الجديدة، على خلفية الاختلال الكبير الذي حصل في ميزان القوى الدولية، أي من خلال الخريطة الجديدة التي تقسم العالم إلى سبع أو ربما ثمان حضارات، والتي ستحدث أهم النزاعات في المستقبل على امتداد خطوط التقسيم الثقافية التي تفصل بين تلك الحضارات. وهو بذلك يستخدم – كإستراتيجي – الجانب الثقافاتي في الأطروحة السياسية لكي يضفي الشرعية على السلوك الجديد في المجابهة الأمريكية، وهي تشكل مصير الأقاليم القصية على وفق ثنائية (الغرب والبقية).



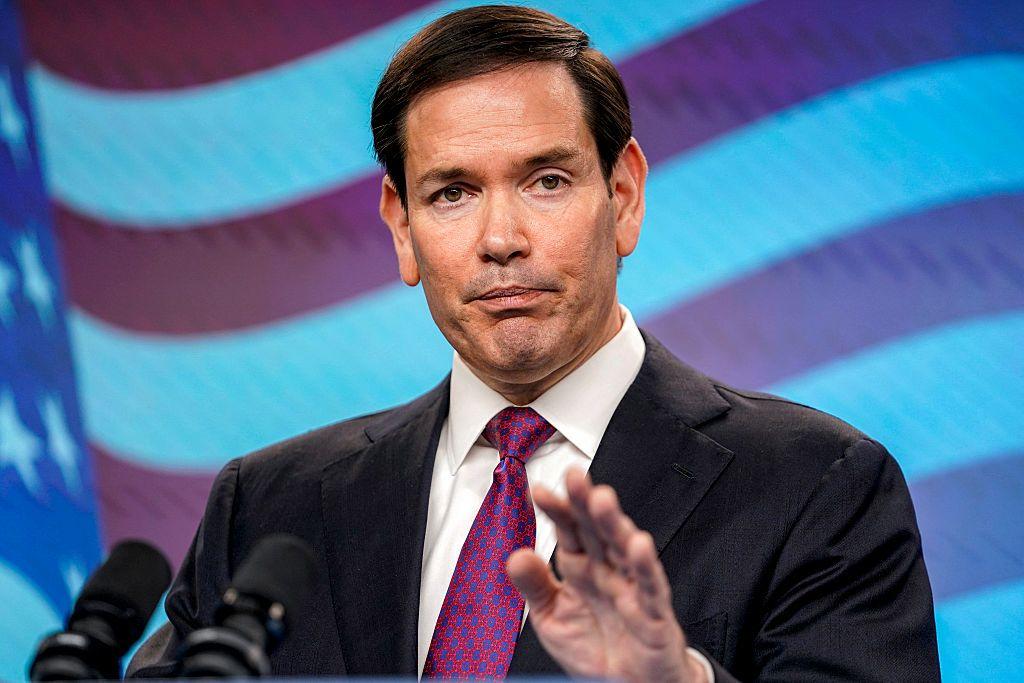








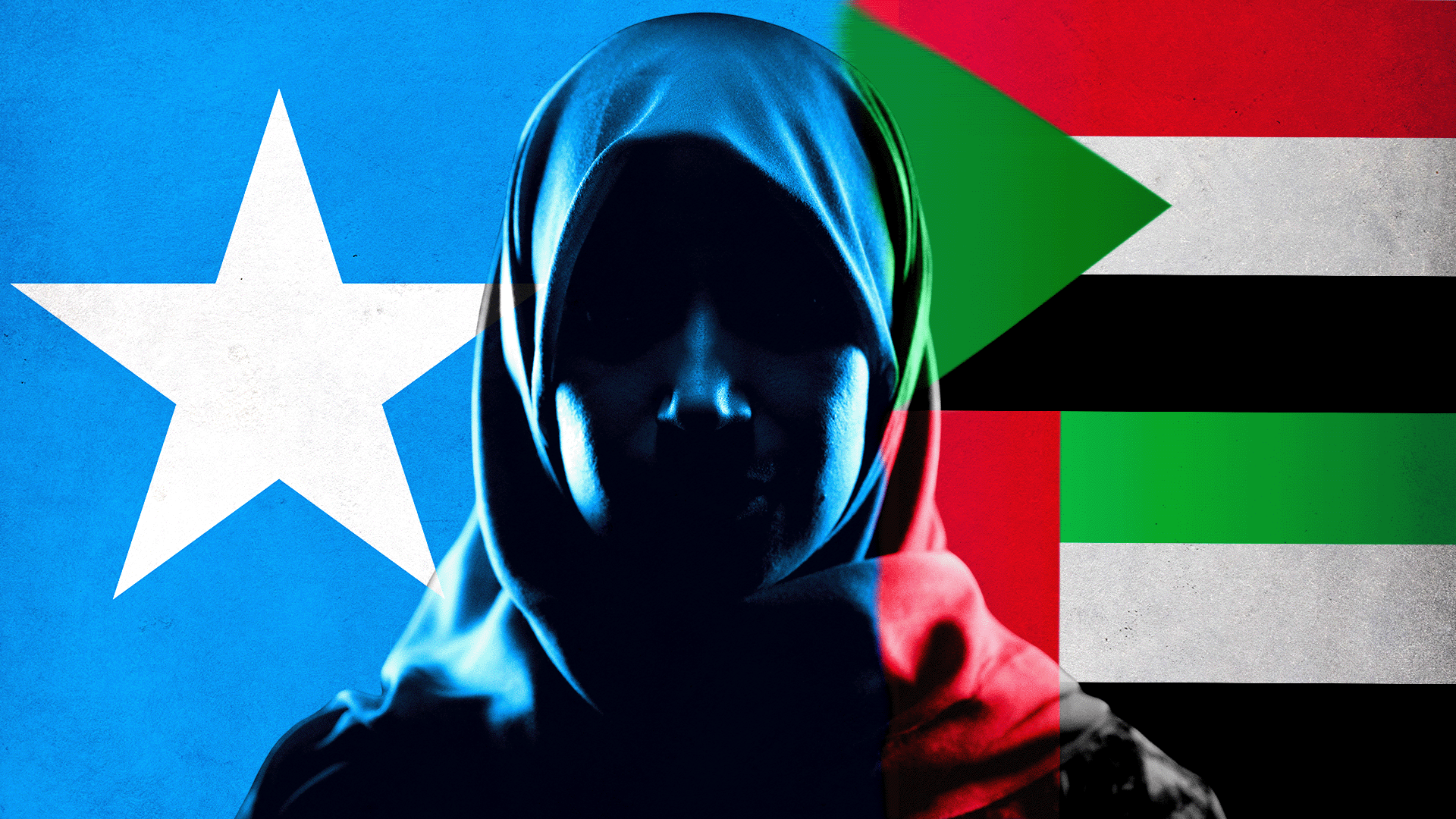



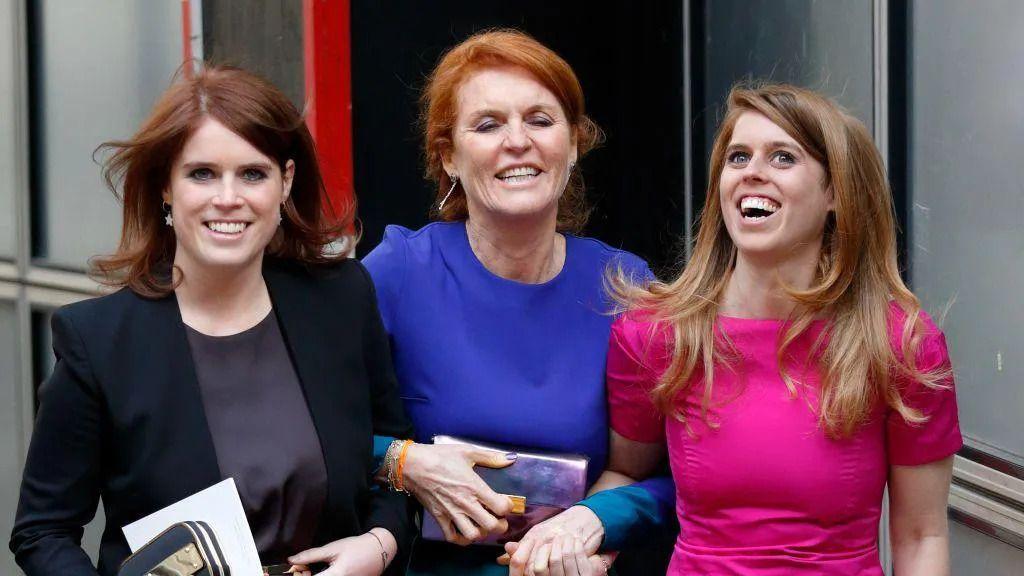
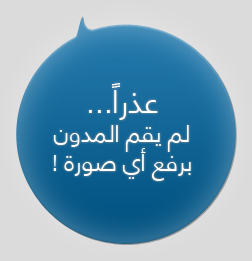
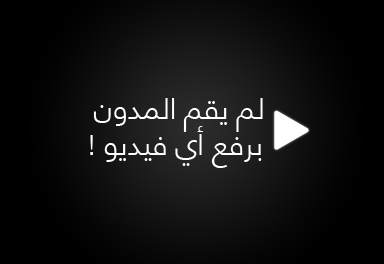

التعليقات (0)