طفلة عراقية في شيكاغو تريبيون

طفلة عراقية في (شيكاغو تريبيون)
محمود سعيد/ شيكاغو
فرضتْ شيكاغو حبَّها عليّ، وربما على كثيرين يعيشون فيها، كما تفعل أيُّ حسناء. ولعلّها تملك الكثير من صفات الغادة: فهي لعوبٌ متقلّبة متحيّرة ساحرة. فمن طقسٍ مثلجٍ ودرجة برودة عشرين تحت الصفر، إلى حرارةٍ تتجاوز مئة وعشر درجات؛ ومن رياح عاصفة تقتلع الأشجار، إلى نسيمٍ عليلٍ يبهج الروح. إنها مدينة النقائض والبحيرة الخلابة وناطحات السحاب والغابات التي لا تنتهي، والأثرياء الذين يجلسون على كنوز هائلة، والمتشردين المدقعين الذين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء.
اليوم الأحد، أعيش قرب البحيرة على بلمنت وكلارك. في بضع دقائق أصل إلى أجمل بقعتين في شيكاغو: شاطئ البحيرة، ومركز المدينة. لن أترك الأحد يفلت مني. ففي مثل هذا اليوم تَكشف شيكاغو عريَها: راقصة ستريبتز تمتِِّع أهلَها بمفاتن جسدها؛ مهرجانات مستمرة، مسيرات، أسواق خاصة وعامة، مسابقات جمال، حيوانات، معارض طيران، أطعمة،... إنها عاشقةٌ من طراز لحوح لا تترك عاشقَها يرتاح يوماً واحداً.
الجو رائع، فلأسرعْ قبل أن ينقلب! ذلك أنّ شيكاغو تغيِّر جوَّها كما تبدِّل الراقصةُ ملابسَها في وصلات رقصها. استعددتُ للخروج. أمسكتُ الصحيفة، فوقعتْ عيناي على صورة طفلة عراقية في شيكاغو تريبيون.
أرجعتني الصورةُ إلى بغداد، حبّةِِ القلب، المدينةِ المستحيلة. طفلةٌ بدت كأنها لم تبلغ الثانية من عمرها، تصرخ ودماءُ والديها تطرّز وجهَها الجميلَ وملابسَها التقليدية. لم أستطع التحديق فيها. تركتُها. نزلتُ من شقتي إلى شارع كلارك؛ فعندما يضيق صدري، أترك الشقة، وأتمشّى في هذا الشارع قليلاً، فينقلب الضيقُ إلى بهجة. أمامي مراهقةٌ تقتلع عينيَّ بحداثة زيّها وتنافرِه: جاكتة من الجلد الأسود مليئة بميداليّات فضية وأزرار، وشراريب، وتنّورة قصيرة جدّاً، وجوربان أبيضان طويلان، فوقهما جوربان آخران أحمران إلى ما تحت الركبة، وقميص أحمر ياقتُه بنفسجيةٌ صارخة. أما الشعر فعدة ألوان: تبدأ بالأسود، فالبنفسجي، فالأحمر الناري، فالأزرق، فالبرتقالي الفاقع. وكلُّ تلك الألوان تجلِّل وجهاً فائقَ الجمال، وبشرةً بيضاءَ ناصعة، وعينين أبنوسيتين كبيرتين. أما صديقها فيرتدي زيّ روّاد الفضاء في "ستار ترك،" لكنه يصفّف شعرَه بطريقة الخوذة الرومانية المشهورة. وكان يمسك كفَّها حبّاً وخوفاً من أن تصبح كائناً فضائيّاً فتنفلت من بين يديه وتتلاشى في السماء.
عندما أتمشى في كلارك، يبرز أمامي شارعُ الرشيد دائماً. الشارعان متميّزان. هنا وهناك تجد أزياءَ الدنيا كلّها. لكنّ ما لن تجده في الرشيد إنما هو تنوّع المطاعم، إذ قد لا يوجد شارعٌ في العالم في تنوّع مطاعم كلارك وكثرتها. إنه ساحر لطيف وبهيج. يُخرج عفاريتَه لتتسلّل بخفّة جنّيّ إلى بطون جميع الخلائق، تدفعهم إلى ملء مطاعمه الأنيقة. فبالإضافة إلى الأكلات الأمريكية الشهيرة، كالستيك والهمبركر والهوت دوغز، هناك البيتزا الإيطالية، إلى جانب السوشي الياباني، والدجاج المحمّر على الطريقة الهندية، والبرياني الباكستاني، والكباب العربي والإيراني، والكسكس المغربي، ووو... إلى ما لا يستطيع حصرَه المرءُ في يوم أو أسبوع. لكنّ تلك المطاعم، على تعددها، لا تقدّم وجباتٍ اشتُهرتْ في العراق منذ آلاف السنين: ككبّة الموصل، والقوزي، وعروق التنّور، وكبّة الحامض، والقليا، ولحم بعجين الموصلي، والباجة,.. فتلك الأطباق لا تجدها إلاّ في شارع الرشيد.
أسرق من وقتي بعضَ الساعات أقضيها في كليّة ترومان كلَّ شهر. تعرّفتُ إلى بعض المدرِّسين الرائعين الطيّبين. لم أسأل أيَّ أميركي عن تاريخ الكليّة، ولماذا قُرنتْ باسم ترومان. نويتُ ألفَ مرة ولم أفعل. أنسى دائماً. أهو مَنْ فكّر في إنشائها؟ أساهَمَ بشيءٍ مما يملك؟ ما تقدّمه الكليّةُ من خدمات إلى الوافدين عظيمُ الشأن.
اقترن اسمُ ترومان بقرحةٍ في قلوب العالم كله. فالقنبلتان اللعينتان اللتان ألقاهما على هيروشيما وناكازاكي وصمتا التاريخَ كلَّه بالعار. لكني أحبّ كليّةَ ترومان، وأحبّ بعضَ مدرّسيها، وأعتبرهم إخوةً. ومن يحبّ يتجاوز عن أشياء كثيرة. ومع ذلك فإنّ عقلي يرفض التجاوز.
دعوتُ جان إلى وجبة عراقية لا تتوافر في المطاعم: كبّة موصل. أعجبتْه إلى حدّ الجنون. اشترى منها، وأخذ يُعدّها في داره. اتصل بي يشكرني على هذا الطبق اللذيذ الذي لم يجده في شارع كلارك.
دخلتُ ستاربكس. تجذبني رائحةُ القهوة الطرية. عندنا، نحن العرب، ضعفٌ أمام المرأة والقهوة! أنحن وحدنا في ذلك؟ أفْضَلُ مَن يُعدّ القهوةَ في العالم هم البدو، والقرويون حول الموصل. يُعدّونها بعملية معقّدة طويلة، ليصبح طعمُها رائعاً بالرغم من مرارته. وأسلافهم، لا غيرهم، هم من أطلق اسم "الخمر" على القهوة، فشاع في العالم كله. وأذكر أنني قبل أكثر من عشرين سنة تعرّفتُ إلى مهندس سويسري توقّف في البصرة، وسأل عن الطريق إلى بغداد. دعوتُه إلى قهوة تركية في مقهى البدر المطلّ على شطّ العرب. كان الوقت عصراً، وكان النهر العريض يتهادى ببطء، ومئاتُ السفن الصغيرة الخشبية "اللنجات" راسية قرب المقهى محمّلةً بالتوابل، قبل أن تعود إلى الهند والباكستان وسيرلانكا وبنكلادش وأندنوسيا وماليزيا وسنغافورة بآلاف الأطنان من التمور. قال المهندس إنّ المنظر هنا على حافة النهر جميل جداً، لكنّ طعم القهوة أجمل وألذ ولم يذق مثلها طيلة حياته. قلت له إنه سيمر في طريقه عبر تركيا، وسيرى الكثير من المقاهي التي تقدمها إليه على هذه الطريقة.
جلستُ في ستاربكس، ووجهي إلى تقاطع بلمنت وكلارك. لماذا يجتذب هذا الشارعُ براعمَ الشباب النضرة الجميلة؟ حدّقتُ بوجوه الفتيات: كلّهنّ جميلات. التفتُّ، لا أدري لماذا، فرأيتُ على المنضدة القريبة الصورةَ نفسَها: الطفلة العراقية المبقّعة بالدماء تصرخ أمامي على وجه شيكاغو تريبيون، تصرخ بفمٍ تَسَعُ مرارتُه العالمَ كلَّه. الشابة الأنيقة تقرأ الموضوعَ وعيناها مبلّلتان بالدموع. احتقنت عيناي وأنا في مكاني. ضاق صدري من جديد. تركت كوبَ القهوة في مكانه والأبخرةُ اللذيذةُ تتصاعد منه. خرجتُ. لم يعد شارعُ كلارك يبهجني. توجّهتُ نحو البحيرة، نحو الحديقة التي اعتدتُ الذهابَ إليها عصراً. أجملُ ما في شيكاغو حدائقها. في هذه الحديقة المطلّة على البحيرة أبكّر صيفاً في فجر يوم أحد مماثل في مناسبة عروض الطيران. اخترتُ مرةً مقعداً فيها يطلّ على المياه الشاسعة، حيث تلتهم أعماقُ السماء بصخبها طائراتٍ حربيةً تفوق سرعتُها سرعةَ الصوت، تأتي من جميع البلدان الصناعية لتعرض فنونها. أنظر إليها وقلبي يخفق كي لا يصطدم بعضُها ببعض. إنه أجمل أيام السنة. في ذلك اليوم يستحيل أن تجد مقعداً في أية وسيلة نقل متوجّهة إلى شيكاغو إلاّ إذا حجزتَ قبل شهرٍ في الأقل. وحينما بدأ الغزوُ (الأميركي للعراق) لم أعد أستطيع الذهابَ إلى تلك الحديقة. كنتُ أسمع أصواتَ الطائرات من شقّتي القريبة وأعيش رعبَ أطفالنا حين تقصفهم مثلُ هذه الطائرات. ثم لعنتُ نفسي كيف استمتعتُ بمنظر هذه الأشياء الرهيبة من قبل!
قبل أن أصل الحديقةَ اقتحم عينيَّ لونُ أوراق تلك الشجرة: أحمرُ ناريّ. ابتسمتُ؛ فقد تذكّرتُ أننا الآن في منتصف الخريف. لا أدري إنْ بقي من العمر متّسعٌ لكي أرى مدينةً في أيّ بقعة من العالم أجملَ من شيكاغو في الخريف. يَسحرني تعددُ ألوان الأشجار. في شارعٍ واحدٍ عشراتُ الألوان: من أخضرَ زاهٍ، إلى أخضرَ مكمود، فأصفرَ فاقعٍ، فبرتقالي، فأحمر، وبنفسجي،... أمام البحيرة الكبيرة تندلع معركتان جميلتان أزليتان: الأولى في السماء، بين مياه النافورة العالية جداً والغيوم، والثانية على الأرض. فجأة تندفع أعدادٌ لا حصر لها من السناجب الرمادية الرائعة: تتقافز، تلهو، تندفع لتلتهم ما يُلقيه المتسكّعُ من فتات خبز قبل أن تحطّ عليه أسرابُ الحمام الجميل. أسجن نفسي بضع دقائق أرقب المعركة. حيوانات بريئة لا تبغي سوى ديمومة الحياة. التصق بي شابٌّ لاحظ ما يجري برهة، ثم فتح الجريدةَ على صورة الطفلة، فاخترقتْ عينيَّ كلماتٌ: "حدث في تل عفر، في...". عميتْ عيناي. تلك البريئة المفجوعة بوالديْها. كيف ستحيا؟ تلك الطفلة في تل عفر أصبحت وحيدةً في بلدٍ غارقٍ في الحروب؟ هل ستتذكر تلك الفاجعة عندما تكبر؟
أحياناً أركب الباص إلى مركز المدينة. من السيّئ أن يضيع الإنسانُ في أيّ مكان في العالم، لكني أترك لنفسي أن تضيع هناك. أكاد أصرخ بكل صوتي: "دعوني أضيع. ضياعي حياة!" لا أحسّ بالوقت. متحفُ الفن المعاصر، المتحف العلمي، الشاطئ، مدينة الألعاب: كلُّ هذه المعالم لا تستهويني غير مرة واحدة. وكما لا يمكن أن تقيم علاقةً دائمةً مع بغيّ، كذلك لا يمكن أن تأتي يوميّاً إلى المتحف نفسه. مركز المدينة وحده يُغرقني. يطغى اتساعه على وقتي ووجودي. أشعر بالمتعة في كلّ خطوة في شوارعه. تذهلني نظافتُه، كأنّ شوارعَه ممرّاتُ قصرٍ ملكي يحرص العاملون فيه على تنظيفه كلَّ لحظة. أتوجد في كلّ العالم بقعةٌ أنظف من شوارعه؟ المدن كالنساء؛ وكما في كلّ امرأة نكهةٌ مثيرةٌ تختلف عن الأخرى، كذلك المدن: هناك مدن تَفتح لك ذراعيها ما إنْ تدخلها، كصبيةٍ عاشقةٍ لا تتركك حتى تسعدك وتنالَ منك ما تريد؛ وهناك مدن منغلقة تصفعك وتردّك محسوراً مقهورًا.
دفعةٌ من الخلف. كدتُ أقع. عفواً. ضحكةٌ أنثوية. التفت إلى اليمين. شابة مسرعة أطول مني كثيراً، نحيفة، جميلة، واسعة العينين. ابتسمتِ الشابة. ابتسمتُ. تجاوزتني بخطواتها السريعة. هنا كلهم يسرعون، لا أحد يدري لماذا. كانت الجريدة في يدها تشدّ أصابعَها عليها لئلاّ تضيع. رأيتُ وجهَ الطفلة مرة أخرى؛ تبدو أنها لم تتجاوز السنة ونصف السنة فقط. أكاد أسمعُ صراخها، كفّاها مصبوغتان بالدم. دماء في خدّيها، دماء في ثوبها، دماء على رأسها. يبدو أنها كانت في حجر أمّها عندما أصابت الرصاصاتُ رأسَ هذه الأخيرة أو رقبتَها أو صدرَها. كيف نجت إذاً؟ إنها المصادفات المعجزة من دون شك. يا إلهي أيُّ رعبٍ في عينيها! لماذا يفتح الطفل عينيه عندنا فلا يجد غير الرعب؟!
التفتُ إلى اليمين حيث غابةُ ناطحات السماء ملتمّةٌ بعضُها على بعض في فوضى عارمة ساحرة ولكن متناغمة. هناك في قلب العمارات الشاهقة، وبين شوارعها النظيفة، تفاجأ بنصب وتماثيل غايةٍ في الإبداع. ببيكاسو، مَن جاء بكَ إلى هنا؟ أضخمُ نصبٍ له أمام مبنى البلدية. لونُ النصب بنيّ قاتم جميل جدّاً اضطرّ المعماريُّ إلى أن يحيطَه ببناياتٍ يقترب لونُها منه ليخلقَ إيقاعاً شعريّاً هامساً بينها يسري إلى قلب الناظر فيحسّ بنشوة فنية عارمة تدقّه في مكانه كمسمار لا يتحرّك. كيف تأتّى لهذا الفنان الشيوعي الكاره لأمريكا أن يزيّن شيكاغو بمثل هذا النصب الرائع؟ بدا وكأنّ عبقريته ابتدعت النصبَ خصيصاً ليهديه إلى شيكاغو، رافضاً أن يتسلّم أيّ فلس. أأراد برفضه الشيكَّ الذي أرسلتْه إليه بلديةُ شيكاغو أن يصفعَ الرأسماليين الأمريكان ليُفهمهم أنْ ليس بالفلوس وحدها يحيا الإنسان؟ أم أراد أن يخلّد في أمريكا لا فنَّه فحسب بل أيضًا كرمَه وسموَّ أخلاقه اللذين يفتقدهما أثرياءُ أميركا؟
مركز شيكاغو مليء بتحفٍ فنيةٍ مهداةٍ من فنّانين عاشوا وماتوا في أوطان بعيدة عن أمريكا. مقابل راندولف سنتر هناك نصبٌ آخر لا يقلّ روعةً عن نصب بيكاسو، لكنه بالأبيض والأسود. حاولتُ عبثاً أن أعرف من أبدعه. رأيتُ لوحتين برونزيتين فيهما قائمةٌ بأسماء بلدية شيكاغو، لكني لم أجد اسمَ الفنان. ترى لماذا فضّلوا أن يكتبوا أسماءَ بضعة عشر شخصًا لا علاقة لهم بالإبداع، وأهملوا اسمَ النبيّ المبدع؟
من مئات النصب التي تستفزّ النظرَ بوجودها نصبُ الهنديين الأحمرين على جوادين متقابلين. أبدع الفنان في إبراز ملامح الهنود الحمر، قوتهم، سموّهم إلى المعالي. لم أستطع العثور على اسم المبدع أيضاً. كان مكان هذين التمثالين موفَّقاً أيضاً: فمن هناك تمرّ مئاتُ آلاف السيارات يوميّاً. وجود التمثالين هناك يَفرض على المُشاهد سؤالاً ملحّاً: لماذا أبيدَ هذا الشعبُ المضيافُ النبيلُ القويّ المسالم الطيّب؟ وهل إقامةُ مثل هذه التماثيل نوعٌ من الاعتذار والندم على إبادةٍ لم يكن لها ما يبرّرها إطلاقاً؟
في شيكاغو نصب كثيرة هائلة رائعة تستوقف النظر، وتدفع متسكّعاً مثلي إلى الاقتراب منها، لكنها تصدّ الآخرين. فازدحام السيارات شديد، والتوقف ممنوع. عليك أن تضيع يوماً كاملاً لتنظر إلى أيّ نصب أو تمثال؛ عليك أن تأتي في حافلة، أو تستقلَّ أحدَ خطوط المترو، وأن تسير على قدميك في الأقل ساعة. لذا فإنك تجد كثيرين من سكّان شيكاغو لم يروا هذه التماثيل إلا مصادفةً.
كنتُ أسأل نفسي باستمرار: أتوجد قيمةٌ للفن إنْ لم يحترمْ؟ أيُحترم بمعزلٍ عن الشعب؟! تعلّم الأمريكان الفنَّ من وراء البحار، لكنْ هل تعلّموا كيف يحترمونه؟ فلقد ظلّ بعيداً عن الجمهور. في إيطاليا تجد التماثيلَ قريبةً إلى الناس، في مراكز المدن، تستطيع أن ترى غيرَ واحدٍ في نصف ساعة، تستطيع أن تقرأ شيئاً عن المبدع، عن الظروف التي رافقت الإبداع. وفي إحدى ساحات مدريد يجلس سرفانتس في قمة عالية كإلهٍ ينظر إلى مخلوقاته الرائعة: دون كيخوتي وحصانه الهزيل، سانشا بانزا وحماره، الأميرة بزيها الرائع، صاحب الخان،.. الخ. في بغداد أيضاً تستطيع أن تقرأ شيئاً ما عن التماثيل، وفيها نصبٌ أكثرُ وأحدثُ من كثير مما تجده في عواصم الدنيا: فهناك نصب الحرية الذي لا يقل بهاءً عن نصب بيكاسو، وهناك أبو نؤاس، ودليلة وقربها الأربعين، ونصبُ الجندي المجهول،... (ترى أبقي منها شيء بعد الاحتلال؟ عندما فجّرت الميليشياتُ نصبَ المنصور دمعتْ عيناي وأنا على بعد آلاف الكيلومترات!).
أجملُ صباحات العالم لن تجده في شيكاغو أو باريس أو مدريد، بل في بغداد. بغداد واحةُ أبنيةٍ عريقة منسجمة مع نفسها، محاطةٍ ببساتينَ شاسعة، وبغاباتِ نخيلٍ لا تنتهي حتى تبدأ من جديد. تشرق الشمسُ في بغداد فتلفعها بأشعةٍ ذهبيةٍ تجعلها تتوهّج كقطعةٍ من الماس الأصفر، فيغمرك شلالُ ضوءٍ لا أول له ولا نهاية. أتذكّر صباحَ بغداد كلما مررتُ في كورنيش البحيرة هنا، ربما لانعكاس الضوء على سطح الماء؛ فلطالما ارتبط الضوءُ بسطح دجلة الساحر هناك. اخترع العراقيون القدماء منذ أكثر من عشرة آلاف سنة مقولة "إنّ كلّ شيء خُلق من الماء." وعندما كُتبت التوراةُ أخذت المقولة كما هي، ثم تردّدتْ في المسيحية والإسلام. يحبّ العراقيون الماء إلى درجة العبادة، وهناك فئة عراقية يكوّن الماءُ جزءاً كبيراً من طقوسها.
يَقسم دجلة بغدادَ قسمين. يلعب معها بحنانٍ وحبّ، يدور ويعتدل ويلتوي وينفرج، يغيِّر شكلَه كي لا تملّ منه، يتلوّى في داخلها كالأفعى. يتمطّى، ينتشر، يلتمّ، يأخذ حريته كاملةً في التحرك إلى حدّ النشوة. في بعض الأمكنة يتّسع حتى يتفرّع إلى بضع نهيْرات صغار تحيط جزراً صناعيةً مختلفة الأحجام، لكنه يعود ليتّحد ولينهي اللعبة، فيصبح نهراً جبّاراً هائلاً.
ما إنْ أصل إلى أيّ مدينة حتى أستعلم عن أنهارها. في شيكاغو نهران كبيران تراهما في عَلم الولاية، لكنك لا تستطيع أن ترى أيّاً منهما على الأرض؛ فقد احتكرتهما الصناعة: باتا أرستقراطيين، خاصّين. أسوأ ما صنعه المعماريون في شيكاغو أنهم قتلوا هذين النهرين. وقد تعيش بضعَ سنوات في ضواحي شيكاغو فلا تدري أن هناك نهراً على بعد بضعة أمتار! الغابات الكثيفة تحجبه. لكني لحسن الحظ رأيتُ شريطاً سينمائياً عن نهر شيكاغو. ليس كدجلة، بل متواضع، ضيق، مغتال، يصرخ طالباً النجدة، لكنّ 911 لا يستطيع أن ينجده: فمَنْ قتله قويٌّ يُخشى بأسُه. من ارتكب تلك الجريمة؟ إنها أرصفةُ شحنٍ هائلةٌ تزوِّد السفنَ النهرية ببضائع وموادّ أولية تُنـقل إلى أميركا والبلدان الأخرى. وبعد أن التهمتْ تلك الأرصفةُ معظمَ شواطئه تركت قسماً ضئيلاً منه لناطحاتِ سحابٍ وفنادقَ هائلة. وهذا يعني أنّ ساكن شيكاغو العاديّ لن يستطيع أن يراه قطّ.
عكسُ ذلك في بلدي تماماً. فالنهر عندنا كائنٌ شعبيّ، بسيط، متواضع، لكلّ الناس، بالرغم من أنه سيدُ المدينة من غير منازع. تراه عندما تَعبر أحدَ الجسور المتعددة، وتراه على بعد خطوات عندما تجلس في مقهى مبنيّ عل ضفته، وتراه في مئات المطاعم على الجانبين، وتراه عندما تتمتّع باحتساء الجعة في بار أو عندما ترشف العصير أو القهوة.
في بغداد منظر فريد لن تراه في أيّ مدينة أخرى في العالم. كورنيش دجلة المسمى "شارع النهر" يمتدّ نحو ميل كامل تنتشر عليه مطاعمُ وباراتٌ وملاهٍ. إنْ جلستَ في مكانٍ ما ستكون قريباً من الماء، تصافح الماءَ، تأكل من الماء، تتمتع بالماء. وفي كلّ مطعم حوضُ ماءٍ فيه عشراتُ الأسماك الحية. تختار منها ما تريد، ثم تتمتّع بالسمكة تُشوى أمامك بطريقة فريدة. "المسقوف" ورثها العراقيون عن أجداد عاشوا قبل أكثر من عشرة آلاف سنة. تُشّك السمكةُ بعصا تُغرز أمام نيران يتصاعد لهيبُها، وبعد بضعة دقائق تقدَّم إليك وجبةً شهية.
منذ عشرات آلاف السنين كانت بغداد نقطةَ التقاءِ خطوط التجارة العالمية. هناك كانت ترتاح القوافلُ من عناء سفر طويل. بغداد عاصمة خطّ الحرير القادم من الصين، وخطّ التوابل القادمة من الهند وبلدان آسيا كلّها، وخطّيْ قوافل أوربا وأفريقيا. في بغداد وبقية دول الهلال الخصيب يحدث أضخمُ تبادلٍ للبضائع يغذّي القاراتِ الثلاث. لو لم تكن تلك البقعة وافرةً في إنتاجها الزراعي والحيواني لما تمكّنتْ من تزويد قوافل الدنيا بالطعام والراحة والمنام. ولذا اختارها أحدُ أعظم عباقرة التاريخ العربي، وهو المنصور، وبناها على شكلٍ دائريّ جعل منها معجزةَ الفن والعمارة كما هي الآن.
وأصبحت مركزَ الثقافة العالمي لنحو ستمئة سنة، ثم تلتها سبعةُ قرونٍ عجاف، قبل أن تعود الآن بؤرة يتجمع فيها بشر وافدون من جميع أنحاء الأرض؛ لكنّ هؤلاء البشر يختلفون عن أولئك: فهم ليسوا بتجّار، بل جنودٌ مرتزقةٌ جاؤوا من جميع أنحاء العالم. وأحدُهم هو مَن أطلق النارَ على والديْ تلك الطفلة. تقول الجريدة إنّ السيارة التي كانا يستقلاّنها رفضت الوقوف، فأطلق الجنودُ وابلاً من نيرانٍ رشّاشة قتلتهما في الحال. سبحت الطفلة بدماء والديها، لكنها بقية حية. إنها تصرخ. لقد خلّدت الجريدةُ صراخَها إلى الأبد. بدأتُ أسمع صراخها ما إنْ رأيتُها، وسيَسمع صراخَها كلُّ من يعيش في هذا العالم الوحشي.
حدّقتُ بناطحات السحاب. لا أملُّ من النظر إليها. قبل أن أجيء إلى شيكاغو، كنتُ أقول لنفسي: ماذا في ناطحات السحاب من جمال؟ اسمنت، حديد، زجاج، كلها تصدّ النظر. ثم اكتشفتُ خطأ تصوّراتي. لقد جعلتْ مهارةُ المعماري وعبقريتُه من تلك البنايات حيواتٍ بهيجةً غايةً في التناسق والجمال. ومن بعيد، وحينما انظر إلى تلك البنايات المتفاوتة في ارتفاعها وزينتها وجمالها الفريد، يسحرني الموقفُ مرةً أخرى، فأقضي وقتاً لا أستطيع حصرَه.
وصلتُ الحديقة. ما أجمل لعبَ الأطفال! هناك في الحديقة أقضي وقتاً غير محدود أراقب الأطفالَ يعيشون عصرَهم الذهبي قبل أن يكبروا ويطحنَهم الصراعُ على مكاسب الحياة. الأطفال آلهة؛ وكما تدّعي الآلهة أنها خلقتنا، وأنّ بمقدورها خلقَ الجديد دومَا، فكذلك الطفل: إنه يستطيع أن يخلق لعبه وسعادته في كل وقت. أطفال يركضون وراء بعضهم، ينزلقون على صفائح صقيلة، يتأرجحون، يتعلّقون على قضبان متفاوتة الارتفاع، يضجّون. هنا يلعب الأطفالُ بحدائق مجهّزة بأحدث المرافق وأمتعها. لكني رأيتُ مناطقَ فقيرةً يلعب أطفالهُا بالحجارة، بأغصانٍ مكسورة، بعظامِ الحيوانات؛ لم يسعدهم الحظُّ بمثل تلك المتع الرائعة. قَطعتْ ضحكةُ طفل، بعمر تلك الطفلة المكلومة، أحلامَ يقظتي. كان يلاحق خنفسةً ويهمّ بإمساكها لكنه يتردد فيترك لها فرصة للهروب، وأمّه الشابة تنظر إليه وتبتسم.
توجهتُ نحو مسطبة تجلس عليها عجوزٌ تراقب من بُعدٍ طفلتين تلعبان. وقبل أن أجلس قربها، رأيتها تسحب الجريدة لكي تفسح لي مكاناً قربها. وقعتْ عيناي بالرغم مني على الطفلة ملوّثةً بدماء والديها. سمعتُ صراخَها مرة أخرى. ابتعدتُ. توجّهتُ نحو مسطبة أخرى. هل ستقدر تلك الطفلة أن تلعب في المستقبل وقد صُرِع والداها في لحظة جنون طائش؟
كلب صغير جدّاً، بألوان تتفاوت بين الأصفر والرمادي والبني والأبيض، عيناه واسعتان جاحظتان، له شاربان أبيضان طويلان، ينظر بعمق إلى كلّ من يقترب منه. أسنانه بيضاء متراصّة، سلسلتُه جميلة بلون الذهب، لم يترجّل من دفء صدر عجوز تحتضنه كابن لها. لستُ أدري كيف اكتشفته طفلةٌ في عمر السنة، تقدّمتْ نحوه وهي تتأرجّح في مشيتها، ووالدتهُا الشابة تنحني وراءها، وتمدّ ذراعيها كي لا تسقط. الطفلة تغرّد بسعادة كالبلبل، محيّيةً الكلبَ، والكلبُ ينظر إليها بنظرات ودود، والعجوز ترحب بالطفلة وتشارك أمها الشابة الضحك. حين اقتربت الطفلة من الكلب مدّت يدها الصغيرة، لكنّ أمها أبعدتها عنه: "لا، لا تمسيه." والعجوز تردّد: "دعيها، لن يؤذيها، دعيها." جلستُ إلى جانب العجوز. أخذتْ تربّت على شعر الكلب وهو ينظر إليها بفخر وامتنان، ثم عاد ينظر إلى الطفلة. ربما رآها أقربَ إليه من الجميع، والطفلة ما تزال تحاول احتواءَ الكلب. أصدر الكلب همهمةً ناعمةً أقربَ إلى الغناء، ثم نظر إلى أمّ الطفلة. عندئذ سمحت الأم للطفلة بأن تمسّد ظهرَه وهي تقهقه. أتساءل: لماذا لا يسترسل الناسُ هنا في الإنجاب؟ فالعناية الطبية ممتازة، والدراسة متوافرة، والمستقبل مضمون. هل سيصبح لأطفال العراق مثلُ هذا المستقبل وهم في هذه الدوامة من العنف، والانقلابات، وتدخل الدول العظمى، ولعنة النفط؟ ما إنْ يبلغ الطفل عندنا الثامنة عشرة حتى يجد نفسه جنديّاً في جيش، في معركة، في صراع. حياته كلُّها ألغام، قتلٌ، سجنٌ، أسرٌ، تشريدٌ، تجويع.. قائمة لا تنتهي. أجيال تعيش وتموت في العراق من دون ألعاب البريئة.
غيرَ بعيد من شقتي حديقةٌ خاصةٌ بالكلاب. يتجمّع كلَّ يوم عشراتُ النساء والرجال، كلٌّ مع كلبه، يأتون بهم للتنزه في الحديقة يوميّاً. الحديقة معرضٌ مميزٌ للكلاب: كبيرة، صغيرة، متوسطة، غريبة الشكل. قربنَا أيضاً مستشفى للكلاب. وفي الجهة الأخرى من الشارع حلاّق لها، يبتدع قصّاتِ شعرٍ مميزةُ، ويتقاضى عن عمله أضعاف ما يتناوله غيرُه من قصة شعر الإنسان. لا أحد هنا يؤذي الحيوانات. يضمنون مستقبلهم. قالت لي صاحبةُ قطّ يبلغ من العمر اثنتيْ عشرة سنة: "مع الأسف أنه لن يعيش غير سنة واحدة أخرى في الأكثر. إنه مصاب بالكلى. لكنه سيموت سعيداً لأنني أرعاه بشكل جيد، وآخذه إلى الطبيب لفحصه كل شهر."
هنا كلُّ شيء له قيمة: النبات، الحيوان، الإنسان. ثمة من يرعاه. وفي بلدي يُقتل النباتُ والحيوانُ والإنسان. لا يوجد من يهتم بالآخر، وأكبرُ الظنّ أن لا تجدَ تلك الطفلةُ أحداً يهتمّ بها بعد قتل والديها. سيكون مصيرها شديدَ الإظلام. لو استطاع من يجدها أن يعثر على دار للأيتام يضعها فيه، فستعيش في جوع دائم وسوء تغذية إلى ما لا نهاية، لكنها ستكون نوعاً ما سعيدة. إلاّ أنّ العثور على دارٍ للأيتام معجزةٌ في العراق تحت هيمنة الاحتلال والميليشيات. فمثل تلك المؤسسات قليلة جدّاً، وهي مكدّسةٌ كعلب السردين بأضعاف ما تستوعب. وقد يَحْضر بعضُ الأطفال يوميّاُ إلى الدار، لكنها غير مسؤولة عنهم في أخطر فترات اليوم، إذ عليهم أن يغادروها حين يحلّ الظلام. أين ينامون إذاً؟ في الشوارع، تحت الجسور، في المقابر، في كلّ مكان ولا مكان.
ستَتْبع تلك الطفلةُ مثيلاتها من ضحايا الحرب. فمن يشعل الحربَ لا يفكّر بالأطفال، وإلا ما تلوّث بآثامها. ستنسى ذاكرتُها الهشةُ أبويْها بعد أيام، أو شهور في الأكثر. لكنّ أصواتَ الرصاص المرعب سيستقرّ في العقل الباطن، يدمّر نفسيتها، ويقلق راحتَها ما عاشت. أهمّ مشكلة ستقع على رأسها أنها ستنشأ على سطح أرض معادية، قاسية، لا تعرف الرحمة. عليها أن تشبع معدتها. ستلتقط ما يرميه المارّةُ في الشارع من خضار فاسدة، وبقايا طعام متعفّن، أو ربما حبوب تخرج مع روث الحيوانات. فإنْ قاومت المرض، فمن المستحيل أن تقاوم الطفيليات كالقمل والديدان المعوية. ولأنها لن تنشأ في رعاية أمّ تنظّفها وتعتني بها، فستصاب ربما بالأكزيما، أو الجرب، أو الرمد، وربما العمى، لكنها ربما تعيش بضع سنوات أخرى. حينئذ سينمو جسدها في ظل سوء التغذية نمواً بطيئاً ومشوّهاً، إلا أنها بالتأكيد ستضطر إلى العمل طيلة النهار، وستتعرض للاغتصاب وهي في الخامسة من عمرها، وستعاني من آلام وأمراض لا تحصى، وسيُقضى عليها قبل أن تراهق. فإنْ ساعدها الحظ على البقاء فستنتهي إلى تناول المخدرات، وإلى أكواخ البغاء، ثم السجن. وربما سيكون ذلك المكان الوحيد الذي تضمن فيه لقمة بسيطة ثلاث مرات في اليوم ورداء رمادياً كالحاً يسد عريها. لكنها في كل الأحوال لن تعيش طويلاً. ربما سيقام لها تمثال بعد موتها في شيكاغو أو بغداد يدل على مآسي أجيال أبيدت في الحروب، لكنّ أحداً ما لم يستطع أن يخترق مشاعرها ليكشف كيفية استقبالها ذلك العالم المعادي المميت وهي طفلة بريئة لا يد لها بما حدث، كبراءة الهنود الحمر المسالمين الطيبين.
---
محمود سعيد روائي عراقي مقيم في أمريكا














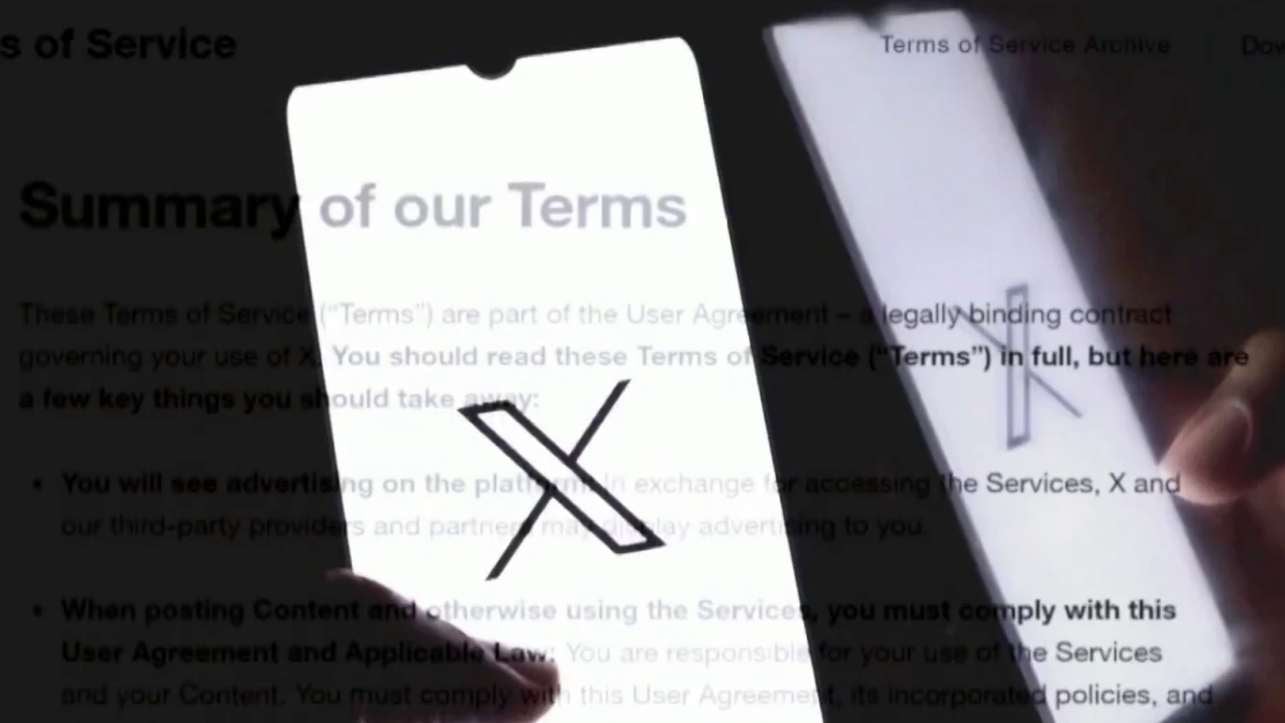





التعليقات (0)