سيميوطيقا العلامة وتحولات الصورة "أحمد عبد الكريم"

د. ياسر منجي
فنان وناقد تشكيلي
كلية الفنون الجميلة –جامعة حلوان-مصر
يجابهنا "أحمد عبد الكريم" هذه المرة بما يحرضنا على محاولة سد ثغرة معيبة؛ تتموقع في الإطار المنهجي للمقاربات النقدية التي طالما تناولت أعماله، حاجزة إياها في إسار تصنيفة اعتسافية حَجَرَت عليها في خانة (التراث)، نتيجة لمخاتلة مفرداتها البصرية ذات الجذور الشرقية حيناً، وبإغراء من دواعي الاستسهال في القراءة النقدية أحياناً.
وللإنصاف فإن هذا المأزق لا يقتصر في مد سياجه حول "عبد الكريم" ومتناولي أعماله بالقراءة والتحليل فقط؛ بل هو مأزق ذو حبائل تكبل عدداً من نقاد العرب، الذين ما برحوا يتخذون التراث رفاً جاهزاً، يحَمّلونه – دونما سند تحليلي معمق – أعمال كثير من الفنانين، الذين أُخِذوا بجريرة استرفادهم مفردات بصرية شرقية مُتبلة بنكهة تاريخية. وفي هذا السياق تراكمت التوصيفات والتصنيفات سابقة التجهيز؛ فهذا (فنان شعبي) لمجرد ظهور وحدات تستحضر رائحة الريف أو ذكرى الحارة في أعماله، وذاك (فنان مصري) لمجرد تراقص أشباح مصرية قديمة أو تنويعات هيروغليفية فوق سطوح تصاويره، وثالث (فنان إسلامي) لمجرد توسله بالزخرف التوشيحي أو لتعويله على استدعاء الحروفي، ..... إلى آخر الترسانة الجاهزة من التوصيفات والتصنيفات المُعلبة والمكرورة، التي كثيراً ما يعتورها قصور الأداة المنهجية.
وهكذا، ربما يسنح لنا أن نتخيل كم من المرات ظُلمت أعمال "أحمد عبد الكريم"؛ حين كانت القراءات الجاهزة تمعن فيها تشريحاً بمباضع المقولات التراثية السطحية، حاشرة إياها قسراً في قوالب (المصري) و(الشعبي) و(الإسلامي)، دونما انتباه إلى ما تكتنزه وتنطوي عليه من رواء بصري؛ يدين في جاذبيته الآسرة لعملية باطنة شديدة التعقيد، تتعاقب فيها المراوحة – دون توقف – بين العلامة المعرفية والصورة الجمالية، وفق آلية رهيفة للتحول من البصري المحض إلى التدويني والكتابي؛ الأمر الذي يكفل لأعمال "عبد الكريم" الحق في أن نعاود اكتشافها بوصفها (مرقومات) بصرية، وليس باعتبارها مسطحات تصويرية بالمعنى الاعتيادي المستهلك.
و(المرقومات) التي ذكرناها تواً كاقتراح منا لتوصيف أعمال "عبد الكريم" التصويرية ثنائية الأبعاد؛ تسمية اصطلاحية تحيل إلى ضرب من الأسطح المُعلَّمة، التي تتواشج فيها الخطوط الكتابية والعلامات المحفورة، وتتماهى بداخلها أفعال (التخطيط) و(التزيين) و(التلوين). فحين نبحث في مادة "رقم" بمعجم "لسان العرب" نجد أن الرَّقْمُ والتَّرقيمُ: تَعْجيمُ الكتاب. ورَقَمَ الكتاب يَرْقُمُهُ رَقْماً: أَعجمه وبيَّنه. وكتاب مَرقوم أي قد بُيِّنتْ حروفه بعلاماتها من التنقيط. وقوله عز وجل: كتاب مَرْقُومٌ؛ كتاب مكتوب. والمِرْقَمُ: القَلَمُ. يقولون: طاح مِرْقَمُك أي أَخطأَ قلمك. والمُرَقِّمُ والمُرَقِّنُ: الكاتب والرَّقْمُ: الكتابة والختم. والمرقوم من الدواب: الذي في قوائمه خطوط كَيَّاتٍ. والمرقوم من الدواب الذي يكوى على أَوْظِفَتِهِ كَيّاتٍ صغاراً. ويقال للصَّناعِ الحاذقة بالخِرازة: هي تَرْقُمُ الماء وتَرْقُمُ في الماء، كأنها تخط فيه. والرَّقْمُ: خَزّ مُوَشّى. والرَّقْمُ: ضرب من البُرود. والرَّقْمِ والرَّقْمُ: ضرب مخطط من الوَشْي، وقيل: من الخَزِّ. ورَقَمَ الثوب يَرْقُمُه رَقْماً ورَقَّمهُ: خططه. ورَقْمُ الثوب: كتابه. والأَرْقَمُ حية بين الحيتين مُرَقَّم بحمرة وسواد وكُدْرَةٍ وبُغْثَةٍ. والأَرْقَمُ من الحيّات الذي فيه سواد وبياض، والجمع أُراقِمُ. والرَّقِيمُ: الدَّواة؛ وقيل هو اللوح. وقيل: الرَّقِيمُ الكتاب. والرَّقْمتانِ روضتان بناحية الصَّمَّانِ. ورَقْمةُ الوادي: مجتَمَعُ مائه فيه. والمرقومة أرض فيها نُبَذٌ من النبت.
ونفس المعاني نجدها في "القاموس المحيط"، ويزيد عليها تفصيلاً: والتَّرْقيمُ والتَّرْقينُ: عَلامةٌ لأهْلِ ديوانِ الخَراجِ، تُجْعَل على الرِّقاعِ والتَّوقيعاتِ والحُسْبانات، لئلاَّ يُتَوَهَّمَ أنه بُيِّضَ كيْ لا يَقَعَ فيه حِسابٌ. أما في "الصّحّاح في اللغة" فالرَقْمُ: الكتابة والخَتْمُ. قال تعالى: "كتابٌ مَرْقُومٌ".
والخلاصة مما سبق نبشه لغوياً أن (الترقيم) و(الترقين) – ومن ثم (المرقومات) و(المرقونات) – ما يختلط في جوهره (التخطيط) و(الخط)، بـ(العلامة) و(الإشارة)، ويتماهي في مظهره (الوشم) و(الوَسْم) في (التوشية) و(الزخرف)، وتتوازى في مجتلاه (الصورة) و(اللون) مع (الكتابة) و(التدوين). وهنا تحديداً – في مركزية العلاقة بين الصورة (المرسومة) والعلامة (المكتوبة) – يمكن أن نطمح في الكثير من البوح من لدن أعمال "أحمد عبد الكريم"؛ التي تدشن نموذجاً قياسياً للعلاقة الباطنية المشار إليها سلفاً، بين ما هو معرفي تدويني وما هو جمالي تصويري؛ تلك الثنوية الجديرة برد الاعتبار لجهود هذا الفنان، الذي كثيراً ما جارت جهوده البحثية والتأليفية – خصوصاً بحوثه في جماليات الفن الإسلامي - على شطره كفنان نزق ومتمرد، ومفعم بالرغبة في استنطاق المركوم البصري الشرقي، وفق نصوص صياغية عصرانية تستهدي تحولات الراهن والجاري بصرياً.
دعونا هنا نبرر ما نقول به من ثنوية ظاهرية للطبيعة الواحدية، التي يتموضع في مجتلاها التدوين والصورة في أعمال "أحمد عبد الكريم"؛ بوصفهما مظهران لطاقة إدراكية ووجدانية، تتذرع خلال نشاطها الاتصالي، بوسائل تتباين (ظاهرياً) من حيث الأداة والمجال، وإن كانت في طبيعتها السرانية أوجهاً لتجليات (الجمالي- المعرفي). فما (التدوين/ الكتابة) على الحقيقة إلا صورة ترميزية مختزلة، وما الصورة إلا رمز كتابي لم ينسلخ بعد عن موضعيه في الزمان والمكان، "ومن هذا الوجه؛ فإن المصور حين يرسم مواضع (الصورة) من اللوحة، فإنما هو (يكتبها) في آن. وليس هذا من قبيل التزيد البلاغي، ولا هو من صنف التعويل على مقولات ذات صلة بالشأنين الصوفي التأويلي أو الفلسفي المفعم بالمسائل الاحتمالية المفترضة، وإنما هو أمر أثبتته مباحث اللغة وحسمته دراسات المعنيين بنشأة الكتابة وتطورها. فالكتابة – على التلخيص، وفقاً لما يمكن استخلاصه من هؤلاء - تصوِّر الأفكار عن طريق ائتلاف حروف، هي في أصلها صور، وهو أمر يصدق عكسه على الصورة التي تتشخصن في مرآها كتابة/ فكرة لها أصل ومصداق في عالم الموجودات. وهذه الطبيعة (الثنوية- التبادلية) التي تقوم عليها العلاقة بين الكلمة المكتوبة والصورة المرسومة؛ تستبين صدقيتها من تأمل ما مرَّت به الكتابة من أطوار، قبل أن تصل إلى الطور الهجائي المستخدم في أيامنا"(1)، وهي أطوار لخصها الباحثون في الخمسة التالي ذكرهم:
1- الطور الصُّوري Pictography: أو (الدور الصوري الذاتي) وفيه لجأ الإنسان القديم إلى تصوير ما يريد التعبير عنه بالصور والرسوم. وهي طريقة في الكتابة استلزمت آلاف الصور، فضلاً عن أنها تعجز عن التعبير عن المعاني والأفكار المجردة .
2- الطور الرمزي Ideography: أو (الدور الصوري الرمزي) وفيه رمز الإنسان إلى المعاني أو إلى الأفكار المجرَّده بالصور، فإذا أراد التعبير عن المحبة مثلاً، كان يرسم ما يرمز إليها كالحمامة مثلاً. وفي هذا الطور أصبح في المستطاع رواية قصة قصيرة؛ برسم صور متسلسلة تدل على أشخاصها وأحداثها. وهكذا انتقلت الكتابة من (الصورة/ الكلمة) إلى (الصورة/ الرمز). ونحن ما زلنا نستخدم هذه الطريقة في الإشارات المرورية.
إلا أنه مما يعيب هذه الطريقة؛ أن كل فكرة وكل حدث يقتضي أن تقابله علامة خاصة. مما يهدد بازدياد عدد العلامات المستعملة إلى ما لا نهاية له، ففي الكتابة المصرية القديمة، كان المتضلعون بالهيروغليفية يعرفون حتى 2500 علامة مختلفة، وفي الكتابة الصينية كان يحصى 45000 علامة على الأٌقل. هذا إلى ضرورة اتفاق المُرسل والمستقبل على ذات المعنى لكل علامة، وإلا استحال التواصل والتبست المفاهيم.
3- الطور المقطعي Logography: يعتبر هذا الدور بحق بداءة الكتابة الهجائية، إذ لجأ الإنسان فيه إلى تمثيل مقاطع الكلمة بصورة لا علاقة لها بالكلمة نفسها، "فلو افترضنا أن كاتباً مصرياًَ أو بابلياً أراد أن يكتب كلمة تبدأ بالمقطع (يد) كما في "يدحر"؛ فإنه كان يصور صورة يد، وهكذا انتقلت اللغة من دور لا يتم التعبير فيه عن معانيها إلا بألوف الصور، إلى دور يكفيها فيه لهذا التعبير بضعُ مئات"(2).
4- الطور الصوتي أو الأكروفوني : Acrophony كلمة يونانية مؤلفة من كلمتين؛ Acros وتعني: البدء و phone وتعني الصوت. أي اتخاذ الصورة رمزاً للحرف الأول من اسم هذه الصورة ."وفيه لجأ الإنسان إلى استخدام الصور للدلالة على حروف الكلمة بدلاً من مقاطعها، فهو – بهذا المفهوم – يعتبر تطوراً لـ (الطور المقطعي) أو مرحلة متقدمه منه"(3)، إذ يكفي للتعبير عن الأشياء والأفكار جميعاً عدد محدود من الصور يساوي عدد الحروف الهجائية. فللتعبير عن كلمة (شرب) مثلاً قد يرمز الإنسان القديم إلى الحرف (ش) بالشمس، وإلى الحرف (ب) بالبيت. ونحن اليوم نلجأ أحياناً إلى تعليم أطفالنا الحروف الهجائية مستخدمين الأسماء التي تبدأ بحرف معين لتعليم هذا الحرف، فنقول مثلاً (ب) بطة،.. الخ. وما يلفت الانتباه أن أصوات الحروف العربية يعبر عنها بصدر أسمائها، فالاسم (جيم) مثلا يعبر صدره، وهو ج، عن الصوت: ج،.. وهكذا.
5- الطور الأخير وهو الهجائي الصرف Phonographic: هو مرحلة متطورة من الطور السابق (الطور الصوتي أو الأكروفوني)؛ إذ تم فيه استبدال الصور الرامزة إلى الأصوات بالحروف، وإذا كان الباحثون ينسبون إلى المصريين استخدام الطريقة الأكروفونية، السابق ذكرها في سياق هذا البحث، فإنهم يعزون اكتشاف الكتابة الهجائية إلى الفينيقين؛ سكان الشاطىء الممتد من "اللاذقية" شمالاً إلى "الكرمل" جنوباً إلى "البقاع" وقليلاً بعده إلى الشرق.
ولعل هذا التجذر الصوَري للكتابة هو ما دفع بالفنان المفاهيمي الأمريكي "لورانس وينر" Laurence Weiner (من مواليد 1942) إلى إطلاق مقولته: "حين تتعاطى مع اللغة، فلا حد لما يمكن أن ينتج من تداعي الصور وتشظيها. إنك تتعامل مع كيان مطلق؛ فاللغة - بوصفها أكثر ما طورناه وعكفنا على توسيعه من أنساق في عالمنا – هي الأكثر استعصاء على التجسد والتشيؤ، إنها لا تكف عن التوسع والتوليد أبداً"(4).
وهنا ندلف إلى الصميم مما يطرحه علينا "عبد الكريم" في معرضه الحالي، وهو عينه ما سبق وأن طالعنا به مراراً ضمن دورات دولاب تطور تجربته الفنية؛ فهل يمكن مثلاً تجاهل الإغراء الكامن في (صور) هداهده ودوابه وأسماكه، حين يستفزنا مرآها العلاماتي كي ننطق بصوت مسموع: (هدهد)، (حمار)، (بطة)، (سمكة)!! فإذا بنا – ونحن نستعرض أعماله تباعاً - نجتر من جديد ذكريات التعليم الأولى في المدرسة والكُتّاب؛ حين كنا نستفتح بدايات العلاقة الأولى بالكتابة المقروءة، من خلال الصورة الشارحة، عبر جسر من الأصوات الملفوظة، فنكرر خلف المعلم الهتاف بأسماء (صور) الموجودات، ونحن نتلقى في ذات الوقت (أشكال) العلامات الحروفية المكونة لأبجدية الكلام. وكأن "أحمد عبد الكريم" – عبر استدراجه إيانا – قد نجح في تضفير الصوَري Pictography والرمزي Ideography، بالمقطعي Logography والصوتي Acrophony من مراحل اللغة (المكتوبة/ المصورة/ المنطوقة)، ليحيل أديم مسطحه التصويري إلى (مرقوم) بصري لغوي يستنطق الصورة بلسان العلامة؛ أو إن شئت فقل: إنه لا يني يمارس ضرباً من التحويل (الخيميائي) لمعدن الصورة الاعتيادية، طموحاً نحو نفاسة الاكتناز المعرفي للعلامة (السيميائية)؛ غير أن هذا بدوره يتطلب شيئاً من التوضيح، فقد كثُرت الكتابات التي تناولت "عِلم السيمياء"، من زوايا مختلفة، بعضها من وجهة نظر تراثية، وبعضها الآخر من وجهة نظر الدلالة الحداثية. ووقع القارئ العربي في حيرة من أمره للتوفيق بين مفهوم علم السيمياء في دلالته التراثية، وبين المفهوم الذي اكتسبه المصطلح على أيدي المشتغلين في علم الدلالة، أو المشتغلين في علم اللسانيات عامة.
وعندما يحاول الباحث في مصطلح (السيمياء) أن يؤرّخ بإيجاز لهذا العلم يلتقي في فترة مبكرة من حركة التأليف في المصطلحات العلمية بالعالم المشهور "جابر بن حيان" (توفي عام 200هـ ـ 815 م) الذي بلغ مرحلةً متقدمة في علم الكيمياء، وكان خياله العلمي الطموح يُفضي به إلى أن ينقل المعادن التي يعالجها من حالةٍ إلى حالة، وتطلّع إلى أن يحوِّل المعادن الخسيسة إلى معادن ثمينة، وكان هذا حلم البشرية منذ قديم الزمان، ولكن مَخْبَرَه المتواضع بأجهزته لم يمكِّنه من ذلك، فتحول عنده الطموح من عالم التحقيق إلى عالم التخييل والوهم. وتحوَّل عنده علم الكيمياء إلى علم السيمياء/ الخيمياء Alchemy الذي كان في مفهوم ذلك العصر يقترب من السحر. فعلم السيمياء، كما أطلق عليه صاحب كتاب "أبجد العلوم" اسم "ما هو غير حقيقي من السحر"(5)، وأضاف "... وأطال "ابن خلدون" في هذا العلم"(6)، وقال: إن لفظ "سيمياء" عبرانيٌ معرَّب، أصله "سيم يه" ومعناه: اسم الله"(7). وعرَّفه "التهانوي" في كتابه "كشّاف اصطلاحات الفنون" بأن السيمياء "هو "علم تسخير الجن"، كذا في بحر الجواهر(8). وبعض أنصاف العلماء أدخلوا تحت علم السيمياء علوماً عدّة منها: (علم أسرار الحروف) وهو من تفاريع السيمياء.
وإذا استفتينا معجمات اللغة العربية لتفتينا في مفهوم هذا المصطلح وجدناها تقول:
"والسُّومة والسيمة والسيماء والسيمياء: العلامة، والخيل المسوَّمة"(9): هي التي عليها السمة، وقد يجيء السيما والسيميا ممدودين...."(10). وها نحن مرة أخرى بإزاء التوازي الثقافي المراوغ؛ بين (العلامة) في بُعديها الصوَري والتدويني، والنشاطات النفسية الباطنية الطامحة نحو تغيير (جوهر) الأشياء وتحويل (معادنها) من الخسيس إلى النفيس. وهل يخرج نشاط الفنان عن هذا الإطار التحويلي (السيميائي)؟ وهل يشذ نشاط المصور والرسام والحفار والنحات – بل وفنانو الوسائط الجديدة – عن الدرب الذي سبق وأن سار فيه سلفه ممارس (السيمياء) القديمة؟ أوليس هو أيضاً يروم (تحويل) خاماته وأصباغه وأوراقه وقماشه إلى (جوهر) أسمى، يتعالى على طبيعة مكوناته المادية الخسيسة؟
وما دُمنا في سياق المعجمات، وفي إطار مصطلَحيْ الكيمياء والسيمياء يجدر بالذكر أن تقول إن المعجمات الأجنبية فرَقت بين هذين المصطلحين، فالكيمياء (Chemistry) هو علم الكيمياء المعروف و(Alchemy) يرمز في هذه المعجمات إلى ما نطلق عليه في العربية مصطلح السيمياء، وعند التعريف نقول هذه المعجمات الأجنبية إنه علم كيمياء القرون الوسطى(11)، وأطلق عليه بعضهم اسم (الخيمياء) لقرب اللفظتين بالدلالة لفظاً ومعنىً، ويمكننا هنا ملاحظة التشابه في اللفظتين (السيمياء) العربية و(Alchemy) الأجنبية وخاصة بـ(ال) التعريف التي لازمت المصطلح على اعتباره من أصول عربية.
إن مفردات "أحمد عبد الكريم" البصرية – وإن كانت مسترفدة من مرجعيات ماضوية شرقية، ومتكئة على موروث حضاري بصري – لا تكف عن مكاشفة متلقيها بفوران تحويلي خيميائي، تتذبذب فيه الصورة المرسومة والعلامة المدونة تذبذباً بندولياً بين الفضائين المعرفي والجمالي؛ فكائناته الطليقة والموشومة فوق مسطحاته التصويرية، تستنطق لاوعي المتلقي وتنخسه لتبتعث من قاعه موروثات المعاني، التي سبق وأن راكمتها أجيال حضارية تعاقبت على أرض بلاده، وهي بهذا تستحضر دور الرمز Symbol والعلامة Sign؛ على نحو ينضح بجماليات (عقلية) ذات طبيعة خاصة، تتمحور بالأساس حول طاقة الأسلوبين الكنائي والمجازي Allegorical. وفي ذات الوقت لا تفتأ هذه المفردات نفسها تدغدغ عين متلقيها وتمَسّدها، ضامنة لها قسطاً وفيراً من فرصة تأمل المهارات التصويرية، وتوليفات الحلول الصياغية واللونية، التي يجيد "عبد الكريم" التأليف بينها، ليقدم نماذج تطبيقية تصدح بالخبرات المهارية التي راكمها في مشواره الفني المكتنز؛ فهو تارة يبدهك بدفقات لعجائن لونية دسمة، تنداح في فضاء المسطح لتتداخل حدودها تارة أو تنفصم تارة أخرى، أو تتراكب في شفافيات هلامية لا تعبأ بمنطقية حسابية، لتتكشف في الصميم منها هداهد ساجية على الماء، أو واقفة متوثبة على كُتل مركزية، وكأنها شاهد يرصد انبثاق الموجودات في فجر الخلق والظهور الكوني.
وكثيراً ما تنساب العجينة اللونية في أعماله، لتمارس دور البطانة التحتية متراكبة الطبقات متعاقبة الدرجات، ليأتي الوشم والوسم والتخطيط، بارتعاشات خطية متوازية متراصفة متماوجة، تستحضر رقراقية الماء في اختيال النيل، وتبتعث عبقرية الحل المصري القديم لمفهوم الماء في التصاوير الجدارية؛ ذلك الكيان (الزجزاجي) المتكسر المتأود. الذي يجيد "عبد الكريم" توظيفه كحضور بصري ملمسي وزخرفي وتكويني في آن؛ فهو يكفل لمسطحه مزيّة التنوع في الوحدة، ويتحاور - عبر شفافيته النصفية – مع الطبقة اللونية القارة بأسفل منه، منتجاً تنويعات متآلفة على المفتاح النغمي اللوني الخاص بكل لوحة. ثم إنه كثيراً ما يلعب دور الغلالة الضبابية التي تتفتق في بعض مواضعها؛ لتظهر من خلالها طيور ترعى مطمئنة، ومراكب نيلية تسري براكبيها وئيداً، وجذوع نخل حُبلى بالتأود الأنثوي وواعدة بطرح كريم. وأحياناً أخرى ينحسر هذا التخطيط المائي المتوازي، وينكمش في ركن محسوب من اللوحة، ليلعب دور الوشم الزخرفي النباتي على جسوم أسماكه وطيوره وأناسه؛ فإذا ما أمعنت في تأمله ألفيت نفسك في مواجهة تراكم من رموز وعلامات وملامس، تلخص في دفترها القديم خلاصة الذكرى الموروثة والحكايا المنسية، التي لا تزال تسري أصداؤها متخللة أكوام البوص و(الهيش) في مستنقعات وبرك الريف المصري، وهو ما يحرضك "عبد الكريم" على تخيله – دون رؤيته مباشرة – حين يتخذ لتكويناته تركيباً تراكمياً تتعاقب فيه المساحات اللونية والخطية عبر بعضها البعض، أو تتوالى تقسيمات المسطح التصويري بنائياً، على نحو تستشعر معه أنك تراقب الهداهد والبط النيلي والمراكب والأشجار، بينما أنت جالس في جزيرة من جُزر (طرح البحر) في منتصف النيل، تحفك أعواد البوص وتخفيك تجمعات العشب، فلا يعود أمامك إلا استراق النظر من خلال فرجات النبات.
غير أن جماليات أعمال "أحمد عبد الكريم"؛ لا تنحسر في إسار تداعيات العلامة البصرية وفق تحولات (السيمياء/ الخيمياء) القديمة وحسب، بل تغادرها وترتحل معها تطوراً صوب التعاطي الآني مع (السيمياء) بوصفها علماً علاماتياً دلالياً، وتخصصاً عصرانياً يستهدي الصورة بذات قدر استهدائه الكتابة. فعندما جاء العصر الحديث، اكتسب مصطلح السيمياء دلالة جديدة، جعلته يخرج من سياقات الكيماويين إلى سياقات اللسانيين، لأن العالم "دي سوسير" Ferdinand de Saussure (1857- 1913) كان قد طرح مصطلح (Semiologie) فاستعمله سيميائيو باريس في حقلهم، "ومن هنا يبقى هذا المصطلح طريقة مفيدة لتمييز عملهم عن السيمياء (Semiotics) العالمية المتبعة في أوروبة الشرقية وإيطالية والولايات المتحدة"(12). وأطلق علماء اللسانيات العرب على هذا العلم اسم (السيميوطيقا) وترجموه تارة باسم (علم الرموز) وتارة باسم (علم الدلالة)، ونقلوا عن "تشارلز موريس" Charles W. Morris (1903- 1979)؛ أن علم السيمياء يهتم بمعاني الإشارات قبل استعمالها في قولٍ أو منطوق معين، ويؤدي علم الدلالة عند "موريس" إلى دراسة ما سماه "دي سوسير": الترابطات، وما يسميه السيميائيون المتأخرون قوائم التبادل، ولقد حاول "بول ريكور" Paul Ricoeur (1913- 2005) البرهنة على أن السيمياء تهتم بالعلاقات التبادلية فقط"(13). ويفضِّل الأوربيون مفردة السيميولوجيا التزاماً منهم بالتسمية السوسيرية، أمّا الأمريكيون فيفضّلون السيميوطيقا التي جاء بها المفكر والفيلسوف الأمريكي "تشارلس ساندرز بيرس" Charles Sanders Pierce (1839- 1914). أمّا العرب، خاصة أهل المغرب العربي فقد دعوا إلى ترجمتها (بالسيمياء) محاولة منهم في تعريف المصطلح، والسيمياء مفردة حقيقية بالاعتبار، لأنها كمفردة عربيّة ـ كما يقول الدكتور "معجب الزهراني": ـ"ترتبط بحقلٍ دلالي لغوي ـ ثقافي، يحضر معها فيه كلمات مثل: السِّمَة، والتسمية، والوسام، والوسم، والمِيسم، والسِّيماء والسيمياء (بالقصر والمد) والعلامة". وتنتمي السيمياء ـ أيَّاً كانت التسمية ـ في أصولها ومنهجيتها إلى البنيوية، إذ البنيوية نفسها منهج منتظم لدراسة الأنظمة الإشارية المختلفة في الثقافة العامة"(14).
ولئن كان "دي سوسير" هو الذي استخلص مسمى السيميولوجيا، فإن "رولان بارت" Roland Barthes (1915- 1980) هو الذي مارس التحليل السيميولوجي على أكمل وجه، جاء بما يقلب مقولة "سوسير" إذ زعم أن اللسانيات هي الأصل، وأن السيميولوجيا فرعٌ منها، ثمّ جاء "جاك دريدا" الذي اعترف بجهود "بارت"، إلا أنه دعا إلى قلب مقولة "بارت" نفسها، ولا نريد أن ندخل في تفاصيل هذه التحليلات، وإنما نقول: "إن كلمة علم الدلالة Semantique المشتقة من الكلمة اليونانية Sêmaino "" والمتولدة هي الأخرى من الكلمة séma أو العلامة. هي بالأساس الصفة المنسوبة إلى الكلمة الأصل Sens أو المعنى، فالتغير الدلالي هو تغير في المعنى، والقيمة الدلالية لكلمةٍ تكمن في معناها"(15).
وما دمنا في هذا السياق؛ فمن الجدير بالذكر أن "أحمد عبد الكريم" نفسه من المعنيين بمثل هذه المباحث، فله عدد من الجهود النظرية في حقل السيميائيات، تنضاف إلى أبحاث أخرى تدور حول الرموز البصرية وجماليات الملامس السطحية؛ الأمر الذي يكشف عن عمق تواشج الشقين: التقني التطبيقي والمفهومي الرمزي في بنيته الذهنية الإبداعية. غير أنه في أعماله لا يعمد إلا تطبيق نظريات جامدة وإقحامها في فضاء العمل الفني، فهو ليس من أولئك النفر الواقعين في قبضة النظرية المنصاعين لوطأتها الكاسحة، بل إن ما يكفل لأعماله طزاجتها وتمتعها بطابعها التلقائي والعفوي؛ هو تحرره من سطوة المقولة الأكاديمية في حميّا أدائه الفني، فمدار الأمر هنا أن ذهنيته المحملة بمفاهيم الحقول البحثية المذكورة؛ تعمل بوصفها رافداً مغذياً لمصفاة لاوعيه الذي يستحضره خلال تدفقه على مسطحاته التصويرية، فإذا بالعلامات ومحمولاتها الذهنية والرمزية والنظرية، وقد انطلقت عفو الخاطر مسترسلة مع مراكبه الورقية حيناً، أو قبعت راسخة في كتل بيوته القروية على خط الأفق من اللوحة حيناً آخر، أو انفجرت لونياً راسمة الحدود الخارجية والمساحات الظلية لكائناته الخارجة من ضبابية غلالاته الملمسية. وطاقة العلامة السيميائية هي ذاتها التي تكفل لـ"أحمد عبد الكريم" أن يغمض عينه الواعية، ليحملق بعينه الوجدانية الباطنة على اتساعها، كي يرى في تداريز اللحاء الخارجي للنخله مركباً ورقياً، ليستحيل السموق العمودي - المتصاعد صوب الأعلى في جذع النخلة – إلى استرسال أفقي وئيد متهاد، تتراكم بموجبه طبقات اللحاء في تكسر موجي يستعيد جريان النيل ويجاوبه، وهكذا بوسيلة صوَرية مقتصدة يفلح "عبد الكريم" في نسف قاعدة تعارض الأفقي مع الرأسي، ليفاجئنا – دون تقعر تقني ودون اللجوء لحلول معقدة – بما لم نكن نتوقعه، تحت وطأة انصياعنا للمفاهيم سابقة التجهيز. وهو أمر جدير بتحريضنا على معاودة قراءة أعماله من جديد وفق منهج مغاير، لا يعبأ بالظاهري والمعتاد والمكرر، وهو أمر أعتقد جدارته بكشف مزيد مما لم يُكتشف بعد في طوايا تجربة هذا الفنان الفريد والطازج دوماً؛ "أحمد عبد الكريم".
--------------------------
(1) ياسر منجي: "مراوحات المقدس الباطني ومطارحات الجمالي المعرفي، التلاقح الحضاري بين المنمنمة الإسلامية وفنون الصورة المكتوبة"، الكلمة والصورة، مطبوعات دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، 2010.
(2) أنيس فريحة: "حروف الهجاء العربية، نشأتها، تطورها، مشاكلها"، بيروت، الجامعة الأمريكية، د. ت، ص3.
(3) جرجي زيدان: الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية، دار الحداثة للطباعة والنشر، بيروت، 2007، ص133، 134.
(4) Gerti Fietzek & Gregor Stemmrich. ed. Having Been Said: Writings & Interviews of Lawrence Weiner 1968-2003. Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 2004.
(5) صديق القنوجي:أبجد العلوم، ج2، ق1، ص392.
(6) المصدر نفسه، ص392.
(7) المصدر نفسه، ص392.
(8) التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون، 1/999.
(9) من الآية القرآنية في سورة "آل عمران"، [14]. والقائلة: "زُيِّن للناس حُب الشهوات مِن النساء والبنين، والقناطير المُقنطرة من الذهب والفضة والخيل المُسوَّمة".
(10) ابن منظور: لسان العرب، مادة: سَوَم.
(11) راجع أي معجم أجنبي، فكلها تورد التعريف نقلاً عن بعضها.
(12) روبرت شولز: السيمياء والتأويل، ترجمة سعيد الغانجي، ص247.
(13) المصدر نفسه، 248.
(14) دليل الناقد الأدبي، الرويلي والبازعي، ط3، 177 ـ 178.
(15) المصدر نفسه.







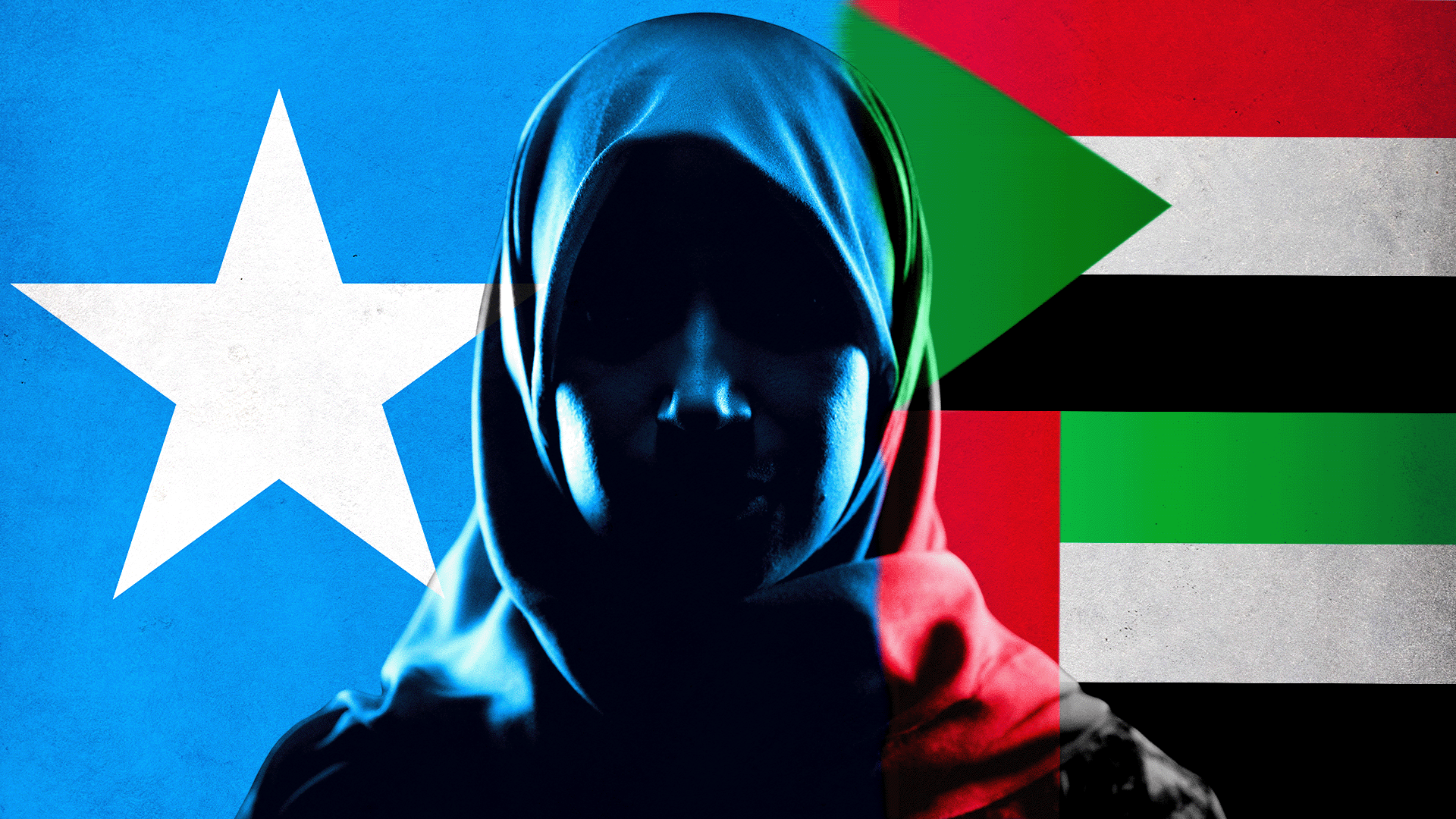
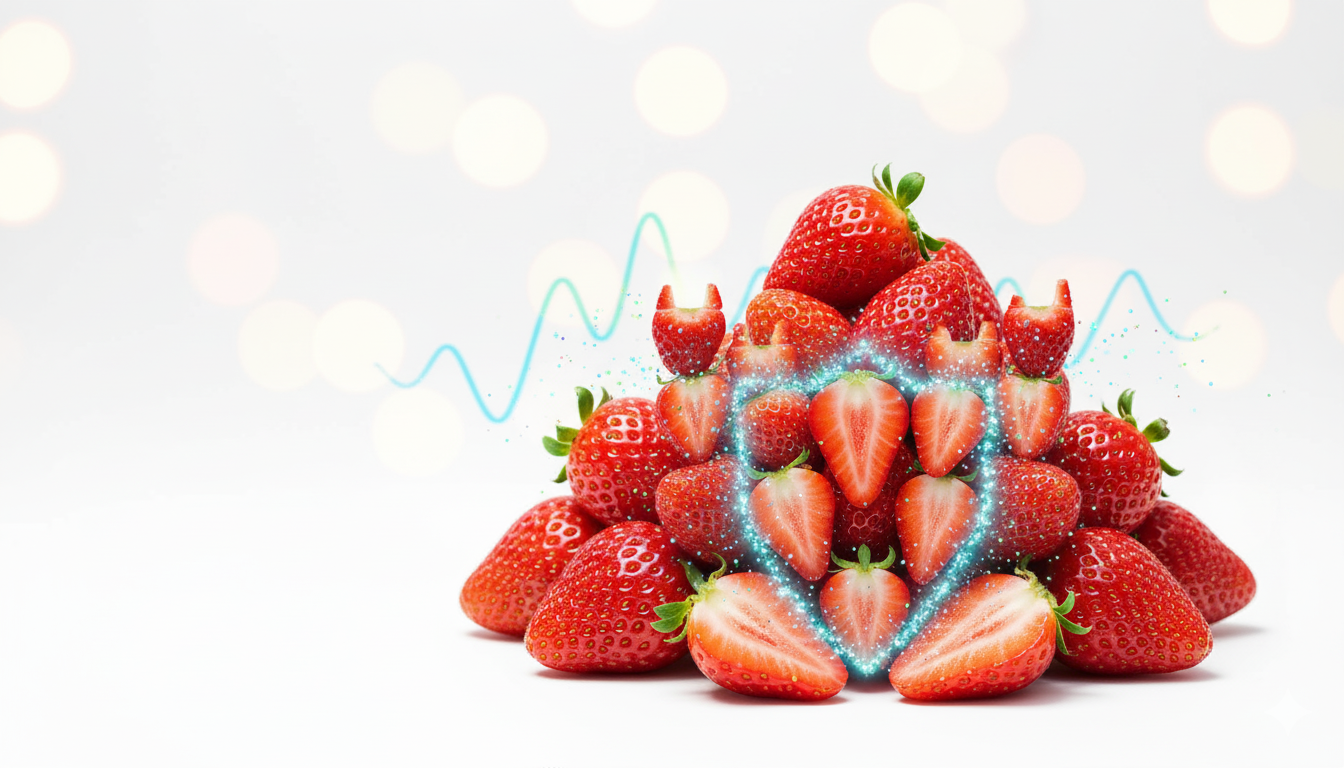







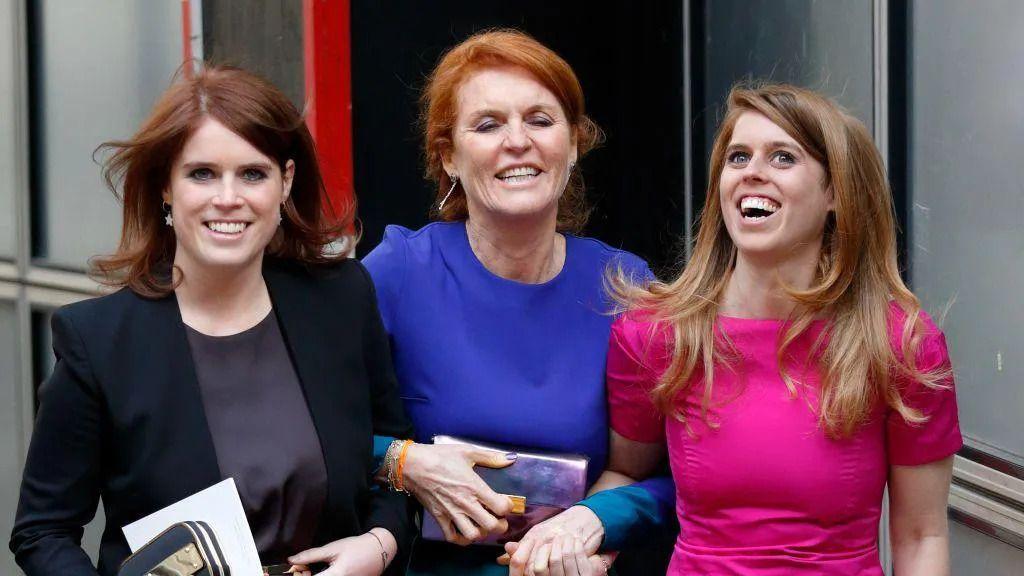
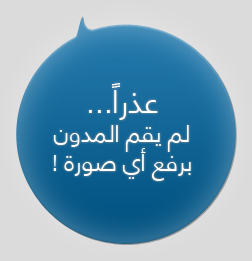
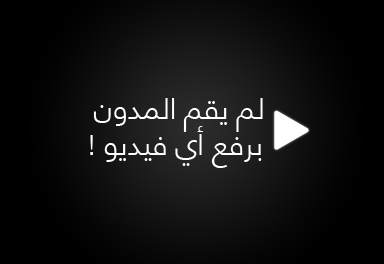

التعليقات (0)