مواضيع اليوم
ديوان الشّعر العربي مُترْجَماً

|
ديوان الشّعر العربي مُترْجَماً:
هل تصحّح أنطولوجيا أدونيس الفرنسيّة بعضاً من رؤى الاستشراق؟
عبداللّطيف الوراري
 |
|
في سلسلتها الخاصّة بالشعر أصدرت غاليمار، الدار العريقة والأشهر في تاريخ النّشر الفرنسي وفي الأوساط الثقافية، كتاب ديوان الشعر العربي القديم، وهو يتّخذ صفة مختاراتٍ شعريّة اختارها وقدّم لها الشاعر أدونيس، وترجمتْها حورية عبدالواحد بتعاونٍ مع الشّاعر نفسه. وسوف يُتيح الكتاب للقارئ الفرنسي خاصة والفرنكفوني عموماً التعرُّف على غنى الشّعر العربي في أزهى عصوره مثل الجاهلي والأموي والعباسي، والاقتراب من عوالم ومتخيَّلات شعريّة باذخة ومتنوّعة رعاها الفحول من مثل امرئ القيس وطرفة والأعشى وعمر بن أبي ربيعة وأبو نواس والعباس بن الأحنف وأبوتمام وابن الرومي وأبو بكر الصنوبري والمتنبي وأبو العلاء المعري وابن زيدون، كما يمثّل الكتاب دعوةً سانحةً للباحثين في تاريخ هذا الشّعر من المستشرقين أو المستعربين إلى إعادة النّظر في معظم النّتائج والفرضيّات الّتي استخلصها الأوائل منهم عن جماليّات الشّعر وأساليبه، حتّى نعتوه في كلّ الأزمنة بأنّه شعر غنائيّ، مع أنّه من أخصب تُراثات الشعر العالمي وأعرقها وأصفاها معدناً، ولا يقلّ من حيث النوعيّة عن الشعر الياباني أو الصيني أو الفارسي أو حتّى الأوروبي الحديث نفسه.
وليست هذه أوّل أنطولوجيا شعريّة تصدر بالفرنسيّة، فقد سبقتْها أنطولوجيّاتٌ ومنتخباتٌ آخرها كتاب ذهب ومواسم، أنطولوجيا الشّعر العربي القديم في جزأين صدرا عن دار سندباد/أكت سود بين عامي 2006 و2008 ترجمه عن العربية كلّ من هوي يونغ وباتريك ميغارباني، ولكنّها الأهمّ والأدعى للاهتمام، طالما أنّ الّذي أشرف عليها أكثر النّاس علماً بهذا الشعر، وأوسعهم نظراً فيه، إلى جانب وضعه الاعتباري والرّمزي كشاعرٍ حديثٍ مثيرٍ للجدل، ليس داخل الثقاقة العربية، بل أيضاً الفرنسيّة الّتي عبر إليها منذ سنوات مُترْجَماً ومُحتَفى به. وتستمدّ الأنطولوجيا روحها وبناءها حقيقةً من ديوان الشعر العربي، المختارات الّتي باشر أدونيس في نشرها في مجلة شعر في أواخر خمسينيات القرن الفائت، قبل أن يُصدرها في بيروت في أجزاء ثلاثة بدءاً من العام 1964، وذلك في سياق القراءة المعاصرة الّتي اجتهد فيها وأوّلها داخل مشروعه الحداثي، مُثْبتاً أن الحداثة مهما تقدّمت لا تمثل حالاً من الانقطاع الكلّي عن التراث الشعري. ولذلك، لم يكن اختياره مجرّد جمع لـ جمْهرةٍ من أشعار العرب بل كان تأويلاً جماليّاً ونقديّاً يستوعب أسئلة جوهريّة مرتبطة بالفعل الشّعري نفسه، وإلاّ لما ظلّ طيلة أربعة عقودٍ مرجعاً رائداً ولافتاً للشّعر العربي، ولما خُصَّ ـ نتيجة ذلك ـ بطبعتيْن أُخرييْن الأولى صدرت في دمشق عن دار المدى 1996، والثانية في القاهرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة 2006. فضلاً عن منتخبات الدّيوان الشعريّة الّتي لا تخلو من جهْدٍ وأيضاً من ميْلٍ، كان أدونيس يخصّ كلّ طبعة، وفي أيّ جزء منها، بمقدِّمة عدّها البعض بياناً شعريّاً لما احتوتْهُ من نزعة ثوريّة خارجة عن السائد في التأويل والتلقّي. أو بعبارةٍ أخرى، كان يتّخذ المنتخبات ذريعةً ليستعيد مجدَّداً نبرة احتجاجه على القراءات الجاهزة والمغرضة. وكما الطبعات العربيّة، صدّر أدونيس الأنطولوجيا الفرنسيّة، التي ضمّت أشعاراً لما يزيد عن مئة وستّين شاعراّ عربيّاً، وزاد عدد صفحاتها عن ثلاثمئة، بتقديم أكّد فيه من البدء أنّ اختياره للأشعار ذاتيٌّ، وقال: أحاول إعادة النظر في الشّعر العربي من زاويةٍ جماليّةٍ بحتة تتجاوز وجهات النظر التاريخية والاجتماعية، مُضيفاً أنّ الشّعر يأخذ قيمته الخاصة من الدّاخل، أي من قوّته وثراء تعبيره وتجربته. هكذا، لا يمكن أن نعتبر الشّعر وثيقة تاريخية أو اجتماعية. إنّه الصّوْت الّذي يكتفي بحدّ ذاته. وليس مهمّاً في ذاته أن يكون امرؤ القيس وسواه قد تغنّى بالليل في الصحراء أو بأيّ موضوع آخر. إنّ المُهمَّ هو الطريقة الّتي تغنّوا بها، ومن ثمّة كيف أمكنهم بلوغ الكونيّ؟ وكيف أنّ هذا الصوت لا زال تعبيره يُحافظ على طراوته وعمقه وحساسيّته في الإبداع كما في البيئة الحالية تاريخيّاً واجتماعيّاً؟ لقد اخترْتُ خيْطاً يُفضي بنا، من شاعر إلى آخر، نحو الفرد قبل المجتمع، والإبداع قبل التاريخ، والشعر قبل الموضوع أو الغرض الشعري. كما آثرْتُ الشاعر الذي يتميّز بصوْتٍ مُتفرّد، صوته هو. وإذا كان هذا الصّوْت، بخاصّة، صوت اللغة الشعرية الغنية، والذي لا يخضع إلاّ لضرورته الداخليّة الخاصة، بمنأى عن كلّ محاكاة أو تكرار أو ارتباط بالتّعبير المشترك. من هنا، لاحظ أنّ الشعر كان ،دائماً، محلَّ تنازُعٍ بين قوة التقليد وقدرة التجديد، وأنّ المزيّة كانت بمدى استحقاق اللغة العربية كـموهبة ربّانية لدى الشاعر العربي. لهذه الاعتبارات المعرفية والمنهجيّة الّتي ساقه إليها اختياره الشّخصي للمختارات الشعرية، نفهم لماذا لم يتقيّد الشاعر أدونيس بمعايير جاهزة، وبدا متأثّراً بذائقته الخاصة ووعيه الفنّي والنقدي، وبالنّتيجة لماذا أسقط قصائد المناسبات كالهجاء والمديح والرثاء وسواها من الأغراض، مستعيضاً عنها بالتّيمات الّي تظهر داخلها تفرّد صوت الشّاعر وتجربته الحميمة ومخيّلته وشرطه الإنساني. بل إنّ تدخُّل الشاعر وخياره الانتقائي يتراءى للقارئ واضحاً بخصوص وضع هذا الشّاعر أو ذاك داخل الأنطولوجيا، بين محتفى به كشاعر الحكمة المتنبي الّذي خصّه باثنتي عشرة صفحة، وفيلسوف الشعراء المعري بعشر صفحات، وطرفة بن العبد بتسع صفحات،والمحدث أبي تمام رائد التجديد الشعري في العصر العباسي بأربع صفحات، وبين أقلّ احتفاء مثل الشاعر مهيار الذي ارتبط باسمه رمزيّاً حين أفرد له نحو صفحة، وثالث لم يأت على ذكره مثل الخارجي قطري بن الفجاءة، بل وأيضاً النابغة الذبياني الذي اعتبر لدى كثيرين الشاعر الأكثر أصالةً في جاهليّته. إنّ الأمر، فيما يبدو، يندرج في خيارٍ شعريّ ـ جماليّ يتوافق مع رؤية أدونيس وذائقته، اللّتيْن داخلهما تعديلٌ في الحساسيّة يميل إلى الفكر منه إلى البناء والشّكل الفني، ومع روح التّرجمة الّتي لا يبقى منها في القصيدة إلا أثر الـــــوعي لا ماء كـــــتابتها وإيقاعها، وإن كان يُدْرك أنــــّهليست الكلمات هي ما يجب ترجمته، بل إيقاع الخطاب، بتعبير هنري ميشونيك. ـــــ |


















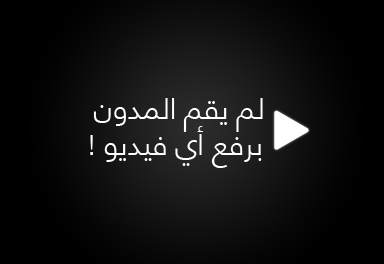

التعليقات (0)