حيرة نعم يأس لأ – فهمي هويدي

هذا أسبوع الحيرة والبلبلة بامتياز، إذ تعين على كل المصريين وغيرهم ممن تعلقت أبصارهم بالشأن المصري في كل مكان أن يحبسوا أنفاسهم طوال الأسبوع انتظارا لما يمكن أن تعلنه المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس المقبل،
ولو أنه مجرد قلق تعلق بما سيصدر في ذلك اليوم لهان الأمر، لكنه قلق يثير العديد من الأسئلة حول مستقبل الثورة ومن ثم مستقبل مصر، وقد لا أبالغ إذا قلت إن مستقبل العالم العربي بأسره أصبح بدوره على المحك.
خلال الأشهر السابقة كنا مطمئنين نسبيا دون أن نعرف الكثير عما يجري وراء الكواليس. وكان مبعث اطمئنانا النسبي أن الأمور كانت تمضي في مسارها الصحيح.
وأنه رغم العثرات والمطبات فإن خطوات تأسيس النظام الجديد ظلت مستمرة، وكانت هناك ثقة في أن المجلس العسكري سوف يسلم السلطة في الموعد الذي أعلنه، وهو 30 يونيو الحالي، خصوصا أنه أوفى بالكثير مما وعد به في التوجه صوب ذلك الهدف.
هذا الوضع اهتز الآن واختلف. إذ ارتبك الجميع حين فوجئوا بالإعلان عن أن المحكمة الدستورية ستقول كلمتها يوم الخميس القادم 14/6 في الطعن على قانون الانتخابات وفي دستورية تعديل قانون إفساد الحياة السياسية (العزل)،
لم أكن وحدي الذي كان ضحية هذا الارتباك، لأنني ما لقيت أحدا ممن يفترض أنهم يعرفون أكثر مني، إلا ووجدته يسبقني ويردد ذات الأسئلة التي حِرت في الإجابة عليها:
لماذا الجمع بين القضيتين في جلسة واحدة؟
ولماذا تذكرت المحكمة الدستورية أخيرا الطعن في قانون انتخابات مجلس الشعب، بعد مضي أكثر من شهرين على ذلك الطعن الذي قدم في ظروف مريبة، وقد سبق التلويح به من جانب رئيس الوزراء في الضغط على مجلس الشعب حين اتجه إلى سحب الثقة من الحكومة؟
وهل هي مصادفة أن يعلن الحكم في القضيتين قبل 48 ساعة من إجراء الانتخابات الرئاسية؟
وما هي السيناريوهات المطروحة بعد ذلك؟
وهل يمكن أن ينتهي الأمر إلى حل مجلس الشعب وإعادة الانتخابات الرئاسية من جديد؟
وفي هذه الحالة هل يؤدي ذلك الاحتمال إلى تأجيل تسليم السلطة للمدنيين في 30 يونيو، بما قد يستصحبه ذلك من بقاء المجلس العسكري في السلطة إلى أجل قد يطول أو يقصر؟
ما اهتز ليس فقط قدرتنا على الفهم والتفسير، ولكن الأخطر والأسوأ أن ثقتنا فيما يحدث اهتزت وتأثرت.
ورغم أنني طول الوقت كنت أحد الذين يرجعون بعض النوازل إلى حسن النية وسوء التقدير، وما زلت حريصا على ذلك، إلا أنني لم أجد فيما يحدث ما يساعدني على الاستمرار في الالتزام بذلك الموقف.
وإزاء الصمت الرسمي الذي لم يقدم لنا إجابة عن أي من تلك الأسئلة، فإنني لم أعد قادرا على الاستمرار في إحسان الظن، ولا أريد أن أقطع بإساءة الظن ــ رغم أن أغلب الشواهد ترجح هذه الكفة ــ فإنني لا أملك سوى الإقرار بأنني أشم فيما يجري روائح غير مريحة وغير مطمئنة، تبعث على التوجس والقلق.
لقد قيل لي إن المحكمة الدستورية حرة في تحديد مواعيد الفصل في القضايا المعروضة عليها. وبالتالي لا ينبغي أن يحمل تحديد تاريخ 14/6 للفصل في القضيتين الحساستين المعروضتين عليها بأكثر مما يحتمل،
وإذ احترم هذا الرأي إلا أنني لا أراه مقنعا بما فيه الكفاية،
من ناحية لأن تحديد مواعيد النطق بالأحكام حق للمحكمة لا ريب، ولكن ما هو مصيري وسياسي منها يتأثر بملاءمات الأجواء العامة.
إذ كما أنه لا يتصور أن تصدر المحكمة قرارا بالفصل في شرعية ترشيح أي شخص لرئاسة الجمهورية بعد انتخابه وحلفه اليمين، فإنه يظل من غير الملائم أن يصدر ذلك الحكم قبل 48 ساعة من التصويت.
وقد ذكرني النائب عصام سلطان بأن ثمة طعنا في دستورية المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية التي تبيح إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، قدم عام ١٩٩٥، لكن ذلك الطعن ينتظر دوره أمام المحكمة الدستورية منذ 17 عاما، ولم يبت فيه حتى الآن!
مشكلة الشك الذي يتولد عن أزمة الثقة أن بذرته لا تنبت شجرة واحدة، ولكنها تصنع غابة في نهاية المطاف، أعني أن القرائن التي بين أيدينا هذه الأيام لا تدعونا فقط لإساءة الظن بترتيب إعلان الحكم في جلسة الخميس، لكنها أيضا تحرضنا على إعادة قراءة السجل من أوله.
بدءا من قتلة الثوار الذين لا يزالون مجهولين إلى الآن
ومرورا بتبرئة مساعدي وزير الداخلية،
وانتهاء بإقصاء بعض المرشحين للرئاسة،
وإعلان ذلك في الصباح ثم تقديم أحدهم طعنا في القرار عند الظهر، الأمر الذي أدى إلى إعادته إلى السباق في المساء.
ثم الإسراع بمساندته ودفعه إلى مقدمة السباق الرئاسي في وقت لاحق.
الحاصل الآن يبرر الحيرة لا ريب، لكنه لا يسوغ اليأس بأي حال، لأنه أيا كان اللغط أو الالتباس والعبث، فالثابت أن هذا البلد شهد ثورة عظيمة دفع الشعب فيها ثمنا غاليا ليحطم قيوده ويخرج من «القمقم»، الأمر الذي يستحيل معه إعادته إلى محبسه مرة أخرى،
وأهم ما ينبغي أن نستخلصه من الأزمة التي تمر بها أن الجميع باتوا مدعوين للاستنفار والاحتشاد دفاعا عن الثورة وعن الحلم الذي صار في متناول أيديهم، في حين تجمعت الغربان في الأفق متأهبة لاختطافه منهم.




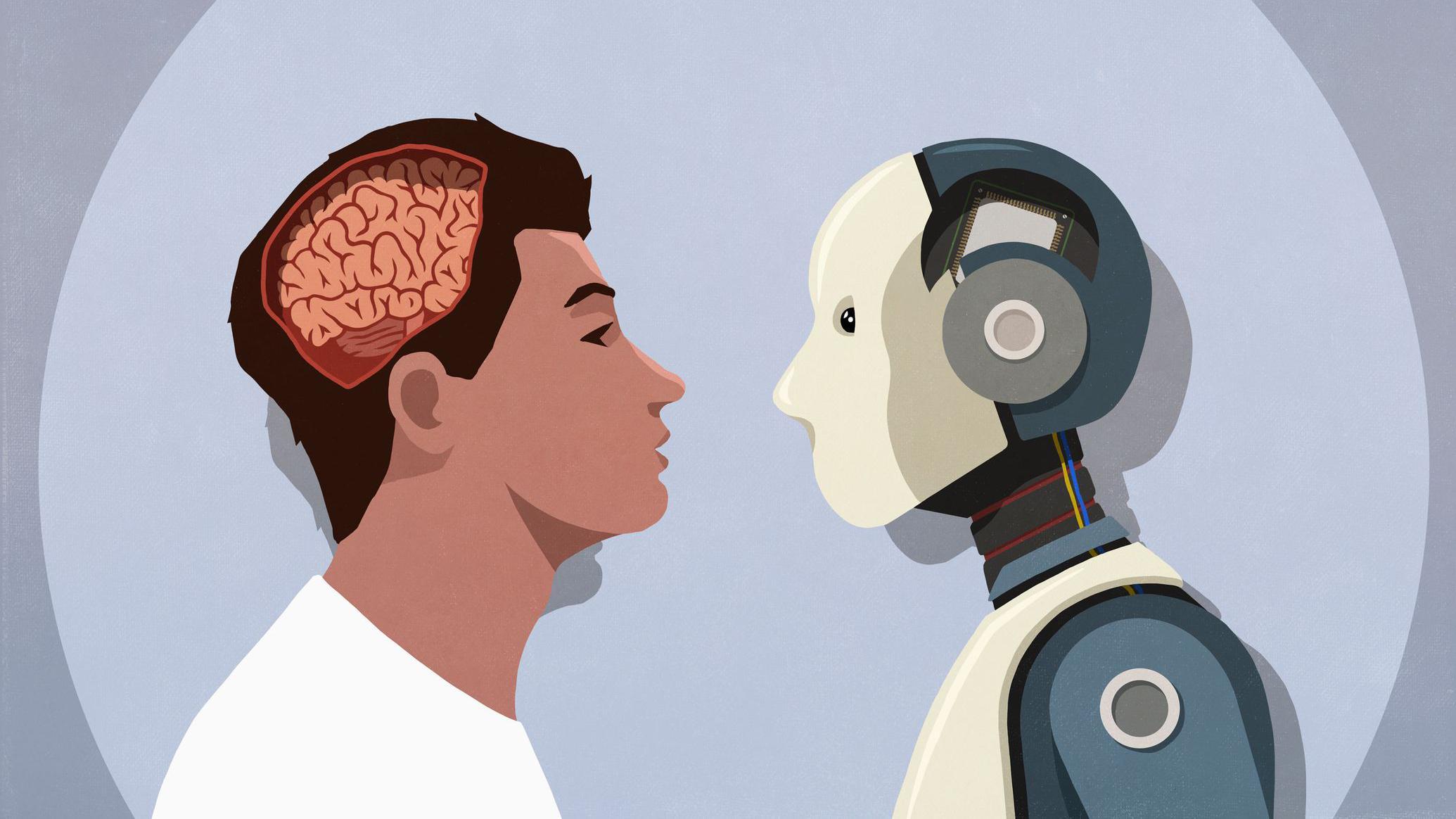















التعليقات (0)