حماية الثورة السعودية(الجزء الأول)

إن هذا الارتباط العضوي بين الثورة السعودية وقيم القبيلة العدنانية يجعل من الحديث عن حماية الثورة خارج إطار القبلية ضرباً من العبثية، فالثورة السعودية التي خرجت من رحم القبلية كانت ولا تزال تستمد قيمها وتستوحي مبادئها من قيم القبيلة وأعرافها الفطرية التي اختارها الله تعالى كأسس ومرتكزات لشرائعه السماوية جميعها (قل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين).
أطلق السعوديون على ثورتهم لقب "السلفية" في إعلان شبه واضح عن المرجعية شبه العرقية للثورة، فالسلف الصالح الذين يتم تعريفهم تجاوزاً بأنهم الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان من أهل القرون الإسلامية الثلاثة الأول؛ هم في الحقيقة ليسوا كذلك. فلم يكن أهل تلك القرون جميعهم صالحين (بالمفهوم السعودي)، بما فيهم الصحابة، فضلاً عن التابعين. فالصلاح عند السعوديين له مقاييس ومعايير تختلف جذرياً عن دلالته الاصطلاحية لدى غيرهم من الفئات العرقية والطائفية كالشيعة والصوفية والأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والمرجئة والقدرية فضلاً عن الباطنية والعلوية والدروز إلى آخره، ولكي يكون السلف في نظرهم صالحاً يلزمه اجتياز اختبار عقائدي غاية في الصعوبة والتعقيد، إنه اختبار التوحيد الخالص خلوصاً مطلقاً من جميع شوائب الشرك والنفاق والكهنوتية، وهذه الانتقائية جعلت من سلفهم الصالح فئة قليلة إذا ما قورنت بسلف غيرهم من أهل تلك القرون، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أظهرت هذه الغربلة العقائدية حجم الارتباط الثقافي النوعي بين السلف السعودي الصالح والقيم القبلية العدنانية التي كان العشرة المبشرون بالجنة أكثر من يمثلها –ثقافياً وعرقياً- من الصحابة، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر رضوان الله عليهم.
فالثورة السعودية (التي اصطلح أعداؤها على تسميتها بالوهابية) ثورة ثقافية تقدمية ذات مرجعية قبلية عدنانية، تهدف للتحرر والانعتاق من عبودية البشر والثورة على كل أشكال الكهنوت والتخلف الديني، ولكن ضمن إطار العرف القبلي العدناني كمرجعية ثقافية معيارية.
يقول ابن تيمية: "من أصولهم اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة"(العقيدة الواسطية)
وابن تيمية إذ يستشهد هنا بحديث العرباض بن سارية (رغم ما في سنده من كلام) للإشارة إلى ماهوية المرجعية الثقافية/العرقية للخط السلفي الذي انبثقت منه الثورة السعودية فيما بعد؛ نجده في المقابل يرفض، أو –على الأقل- يشكك في حديث العترة حيث يقول:
"والحديث الذي في مسلم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله فليس فيه إلا الوصية باتباع كتاب الله، وهذا أمر قد تقدمت الوصية به في حجة الوداع قبل ذلك، وهو لم يأمر باتباع العترة لكن قال (أذكركم الله في أهل بيتي) وتذكير الأمة بهم يقتضي أن يذكروا ما تقدم الأمر به قبل ذلك من إعطائهم حقوقهم والامتناع من ظلمهم، وهذا أمر قد تقدم بيانه قبل غدير خم، فعلم أنه لم يكن في غدير خم أمر يشرع نزل إذ ذاك، لا في حق علي ولا غيره، لا إمامته ولا غيرها"
ويقول: "وأما قوله (وعترتي أهل بيتي) و (إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض) فهذا رواه الترمذي وقد سئل عنه أحمد بن حنبل فضعفه، وضعفه غير واحد من أهل العلم وقالوا لا يصح..."(منهاج السنة)
وقع ابن تيمية هنا في خطأ علمي مقصود حين زعم بتضعيف الإمام أحمد لحديث العترة فالحديث موجود في المسند بروايتين، إحداهما من طريق أبي إسحاق الملائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض) والثانية من طريق الأعمش عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل وعترتي، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإن اللطيف الخبير أخبرني إنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض، فانظروا بم تخلفوني فيهما(.
بل ورواه الحاكم في مستدركه عن زيد بن أرقم بهذا النص: (لمّا رجع رسول الله صلى الله عليه وسلّم من حجّة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقمن فقال: كأنّي قد دُعيت فأجبت إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله تعالى وعترتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض، ثم قال إن الله عزّ وجلّ مولاي وأنا مولى كلّ مؤمن، ثم أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال من كنت مولاه فهذا وليّه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه) وقال عنه صحيح على شرط الشيخين.
من الصعب تخيل شخص كابن تيمية –بما يملكه من غزارة علمية- يقع في خطأ كهذا إلا إذا كان مقصوداً، فيبدو أن الرجل أدرك بنظرته الفلسفية مدى التعارض الشديد بين حديث العترة وحديث العرباض، وأن كلاً من الحديثين يحدد خطاً ثقافياً سلفياً يختلف تمام الاختلاف عن الآخر، فوجد نفسه مضطراً كي يختار أحد الخطين أن يلغي الآخر. ولكن الغريب أنه بالرغم من انتماء بن تيمية لمدرسة الحديث نجده يخالف أصول مدرسته بشكل سافر في هذه المسألة بالتحديد، فالمقابلة الجرح تعديلية والتخريجية بين حديث العرباض وحديث العترة لا يمكن أن تأتي في صالح الأول على حساب الثاني، ليبرز لنا هذا السؤال: لماذا تجاوز بن تيمية هذه المقابلة واختار حديث العرباض وألغى العترة؟!
هنالك عامل مشترك واحد بين الحديثين هو تأكيدهما على قضية الشعب المختار، فقد أجمع الحديثان على فقدان النص الديني لقيمته العملية في غياب المرجعية البشرية التي تتناوله بالشرح والتفسير، وأن الاعتماد على النص المجرد وحده بمعزل عن تلك المرجعية سيؤدي حتماً إلى الضلال والانحراف (وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ) (كتاب الله تعالى وعترتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض). والمرجعية هنا ليست مرجعية العقل أو العلم أو الصلاح والتقوى بالمفهوم الصوفي، بل مرجعية بشرية فئوية حددها كل من الحديثين تحديداً عرقياً/ثقافياً دقيقاً، بيد أن التضارب الظاهر بين الحديثين يكمن في تحديد الماهوية العرقية لتلك الفئة المرجعية (الشعب المختار)، ومدى تناغمها مع عقيدة التوحيد الخالص خلوصاً مطلقاً من الشرك والكهنوت.
في آخر أيام النبي بدأت ملامح الخطين السلفيين المتناقضين تظهر بوضوح خصوصاً بعد إسلام العباس بن عبد المطلب يوم فتح مكة، والتفاف بني هاشم حوله باعتباره كبير البيت الهاشمي آنذاك، ليجد نفسه –فجأة- زعيماً لحزب سياسي عشائري يحظى بنوع من التقديس الكهنوتي بسبب قرابته العرقية من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ساهم احترام النبي له –بصفته عمه الأكبر- في إضفاء المزيد من القدسية عليه من جهة؛ وتعليق بني هاشم للمزيد من الآمال والأحلام والطموحات السياسية على شخصه من جهة أخرى. فتشكلت من هذا الحزب النواة الأولى للخط السلفي الذي يسمى اليوم بـ "آل البيت". أما الخط الثاني فهو خط أبي بكر وعمر ومن تبعهم من العشرة المبشرين بالجنة، والذين لقبوا فيما بعد بـ "أهل السنة والجماعة".
هنا بدأت تتضح حقيقة العلاقة بين النسق الثقافي والانتماء العرقي لكل خط على حدة، فالخط الآل بيتي نحى بالدين منحى كهنوتياً ضيقاً لا يختلف كثيراً عن الكهنوتية اليهودية التي كانت سائدة في المدينة قبل الهجرة، صحيح أن الآل بيتيين انقسموا بعد ذلك إلى شيعة وصوفية؛ إلا أن ذات الطابع الكهنوتي ظل عاملاً مشتركاً بين المذهبين.
أما الخط العدناني فكان على النقيض تماماً، فمن اسمه "السنة والجماعة" يظهر مدى كفره المطلق بالكهنوتية الفردية، وإيمانه بفلسفة الجماعة، أي الإجماع أو الحس الجمعي، وهو مصطلح مرادف لـ "العرف الاجتماعي". (يرجى الرجوع لمقالنا "آل محمد وآل إبراهيم")
يقول بن تيمية: "وقد سموا بأهل السنة والجماعة لأن الإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمدون عليه، والإجماع ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، ولأن النبي أخبر بأن الفرقة الناجية (هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي)"(العقيدة الواسطية)
ولكن هل صحيح أن الأمة انتشرت وكثر فيها الاختلاف فقط بعد العصور السلفية الأولى؟!
إن الدارس لتاريخ تلك العصور يدرك عكس هذا الكلام، فالاختلاف الذي بدأ وتضخم فيها ربما يفوق –في بعض جوانبه- ما حدث بعدها، والسلف الذي عاش فيها لم يكن كله صالحاً البتة والإجماع الذي يتحدث عنه ابن تيمية لم يكن إجماع الأمة بأسرها بل إجماع فئة قليلة منها، وهو ما أوضحه شيخ الإسلام في معرض رده على سؤال حول مذهب أهل المدينة حين قال:
"....لم يذهب أحد من علماء المسلمين إلى أن إجماع أهل مدينة من المدائن حجة يجب اتباعها غير المدينة، لا في تلك الأعصار ولا فيما بعدها، لا إجماع أهل مكة ولا الشام ولا العراق ولا غير ذلك من أمصار المسلمين. ومن حكى عن أبي حنيفة، أو أحد من أصحابه أن إجماع أهل الكوفة حجة يجب اتباعها على كل مسلم، فقد غلط على أبي حنيفة وأصحابه في ذلك، وأما المدينة فقد تكلم الناس في إجماع أهلها، واشتهر عن مالك وأصحابه أن إجماع أهلها حجة، وإن كان بقية الأئمة ينازعونهم في ذلك والكلام، إنما هو في إجماعهم في تلك الأعصار المفضلة، وأما بعد ذلك فقد اتفق الناس على أن إجماع أهلها ليس بحجة، إذ كان حينئذ في غيرها من العلماء ما لم يكن فيها، لاسيما من حين ظهر فيها الرفض، فإن أهلها كانوا متمسكين بمذهبهم القديم منتسبين إلى مذهب مالك إلى أوائل المائة السادسة، أو قبل ذلك أو بعد ذلك، فإنهم قدم إليهم من رافضة المشرق من أهل قاشان وغيرهم من أفسد مذهب كثير منهم لا سيما المنتسبون منهم إلى العترة النبوية، وقدم عليهم بكتب أهل البدع المخالفة للكتاب والسنة، وبذل لهم أموالاً كثيرة، فكثرت البدعة فيها من حينئذ، فأما الأعصار الثلاثة المفضلة فلم يكن فيها بالمدينة النبوية بدعة ظاهرة البتة، ولا خرج منها بدعة في أصول الدين البتة كما خرج من سائر الأمصار، فإن الأمصار الكبار التي سكنها أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وخرج منها العلم والإيمان خمسة: الحرمان، والعراقان، والشام، منها خرج القرآن والحديث والفقه والعبادة، وما يتبع ذلك من أمور الإسلام، وخرج من هذه الأمصار بدع أصولية غير المدينة النبوية. فالكوفة خرج منها التشيع والإرجاء، وانتشر بعد ذلك في غيرها. والبصرة خرج منها القدر، والاعتزال، والنسك الفاسد، وانتشر بعد ذلك في غيرها. والشام كان بها النصب والقدر. وأما التجهم فإنما ظهر من ناحية خراسان، وهو شر البدع. وكان ظهور البدع بحسب البعد عن الدار النبوية، فلما حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان ظهرت بدعة الحرورية وتقدم بعقوبتها، والشيعة من الأصناف الثلاثة الغالية، حيث حرقهم علي بالنار، والمفضلة حيث تقدم بجلدهم ثمانين، والسبائية حيث توعدهم وطلب أن يعاقب ابن سبأ بالقتل أو بغيره فهرب منه. ثم في أواخر عصر الصحابة حدثت القدرية في آخر عصر ابن عمر وابن عباس وجابر وأمثالهم من الصحابة. وحدثت المرجئة قريباً من ذلك. وأما الجهمية فإنما حدثوا في أواخر عصر التابعين بعد موت عمر بن عبد العزيز.... وأما المدينة النبوية فكانت سليمة من ظهور هذه البدع، وإن كان بها من هو مضمر لذلك، فكان عندهم مهاناً مذموماً؛ إذ كان بها قوم من القدرية وغيرهم، ولكن كانوا مذمومين مقهورين بخلاف التشيع والإرجاء بالكوفة، والاعتزال وبدع النساك بالبصرة، والنصب بالشام؛ فإنه كان ظاهراً.... والكلام في إجماع أهل المدينة في تلك الأعصار، والتحقيق في [مسألة إجماع أهل المدينة]، أن منه ما هو متفق عليه بين المسلمين؛ ومنه ما هو قول جمهور أئمة المسلمين؛ ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم. وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب: [الأولى] ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم؛ مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد؛ وكترك صدقة الخضراوات والأحباس، فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء. أما الشافعي وأحمد وأصحابهما فهذا حجة عندهم بلا نزاع، كما هو حجة عند مالك. وذلك مذهب أبي حنيفة وأصحابه.... المرتبة الثانية: العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان، فهذا حجة في مذهب مالك، وهو المنصوص عن الشافعي، قال في رواية يونس بن عبد الأعلى: [إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فلا تتوقف في قلبك ريبًا أنه الحق] وكذا ظاهر مذهب أحمد أن ما سنه الخلفاء الراشدون فهو حجة يجب اتباعها، وقال أحمد كل بيعة كانت في المدينة فهي خلافة نبوة، ومعلوم أن بيعة أبي بكر وعمر وعثمان كانت بالمدينة، وكذلك بيعة علي كانت بالمدينة ثم خرج منها، وبعد ذلك لم يعقد بالمدينة، وقد ثبت في الحديث الصحيح حديث العرباض بن سارية، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة)....والمرتبة الثالثة: إذا تعارض في مسألة دليلان، كحديثين وقياسين جهل أيهما أرجح وأحدهما يعمل به أهل المدينة ففيه نزاع: فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة، ومذهب أبي حنيفة أنه لا يرجح بعمل أهل المدينة، ولأصحاب أحمد وجهان أحدهما هو قول القاضي أبي يعلى، وابن عقيل أنه لا يرجح. والثاني وهو قول أبي الخطاب، وغيره أنه يرجح به قيل هذا هو المنصوص عن أحمد، ومن كلامه قال: إذا رأى أهل المدينة حديثاً وعملوا به فهو الغاية، وكان يفتي على مذهب أهل المدينة ويقدمه على مذهب أهل العراق تقريراً كثيراً، وكان يدل المستفتي على مذاهب أهل الحديث.... فهذه مذاهب جمهور الأئمة توافق مذهب مالك في الترجيح لأقوال أهل المدينة. وأما المرتبة الرابعة: فهي العمل المتأخر بالمدينة، فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أم لا؟ فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية، هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم...."
نفهم من هذا الكلام أن الإجماع السلفي المعتبر لدى أهل السنة والجماعة لم يكن سوى إجماع أهل المدينة وحدهم دون سواهم من مواطني الامبراطورية الإسلامية التي كانت حدودها تمتد آنذاك من الصين إلى أسبانيا، بمعنى أن مفهوم "الإجماع" ليس رديفاً لمفهوم الديموقراطية أو رأي الأغلبية، بل محدداً بفئة خاصة تملك صفات نوعية فريدة، وأنه لو اجتمعت هذه الفئة على أمر وجب على الأمة الالتزام بإجماعها. وهنا يسترسل بن تيمية في تبيان ماهية هذه الفئة المرجعية من أهل المدينة الذين ينطبق عليهم وصف "الجماعة" فيقول:
"وإذا تبين أن إجماع أهل المدينة تفاوت فيه مذاهب جمهور الأئمة، علم بذلك أن قولهم أصح أقوال أهل الأمصار رواية ورأياً، وأنه تارة يكون حجة قاطعة، وتارة حجة قوية، وتارة مرجحاً للدليل إذ ليست هذه الخاصية لشيء من أمصار المسلمين، ومعلوم أن من كان بالمدينة من الصحابة هم خيار الصحابة، إذ لم يخرج منها أحد قبل الفتنة إلا وأقام بها من هو أفضل منه، فإنه لما فتح الشام والعراق وغيرهما أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الأمصار من يعلمهم الكتاب والسنة، فذهب إلى العراق عبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وعمار بن ياسر، وعمران بن حصين، وسلمان الفارسي وغيرهم. وذهب إلى الشام معاذ بن جبل، وعبادة بن الصامت، وأبو الدرداء، وبلال بن رباح وأمثالهم. وبقي عنده مثل عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف ومثل أبي بن كعب ومحمد بن مسلمة وزيد بن ثابت وغيرهم. وكان ابن مسعود وهو أعلم من كان بالعراق من الصحابة إذ ذاك، يفتي بالفتيا ثم يأتي المدينة، فيسأل علماء أهل المدينة فيردونه عن قوله فيرجع إليهم، كما جرى في مسألة أمهات النساء لما ظن ابن مسعود أن الشرط فيها وفي الربيبة، وأنه إذا طلق امرأته قبل الدخول، حلت أمها كما تحل ابنتها، فلما جاء إلى المدينة وسأل عن ذلك أخبره علماء الصحابة أن الشرط في الربيبة دون الأمهات، فرجع إلى قولهم وأمر الرجل بفراق امرأته بعد ما حملت، وكان أهل المدينة فيما يعملون إما أن يكون سنة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وإما أن يرجعوا إلى قضايا عمر بن الخطاب ويقال: أن مالكاً أخذ جل الموطأ عن ربيعة، وربيعة عن سعيد بن المسيب؛ وسعيد بن المسيب عن عمر؛ وعمر محدث. وفي الترمذي عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: (لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر) وفي الصحيحين عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: (كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر ) وفي السنن عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ). وكان عمر يشاور أكابر الصحابة، كعثمان وعلي وطلحة والزبير؛ وسعد وعبد الرحمن؛ وهم أهل الشورى؛ ولهذا قال الشعبي انظروا ما قضى به عمر؛ فإنه كان يشاور. ومعلوم أن ما كان يقضي أو يفتي به عمر ويشاور فيه هؤلاء أرجح مما يقضي أو يفتي به ابن مسعود أو نحوه؛ رضي الله عنهم أجمعين. وكان عمر في مسائل الدين والأصول والفروع إنما يتبع ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يشاور علياً وغيره من أهل الشورى، كما شاوره في المطلقة المعتدة الرجعية في المرض إذا مات زوجها هل ترث ؟ وأمثال ذلك. فلما قتل عثمان وحصلت الفتنة والفرقة وانتقل علي إلى العراق هو وطلحة والزبير لم يكن بالمدينة من هو مثل هؤلاء، ولكن كان بها من الصحابة مثل سعد بن أبي وقاص وأبي أيوب ومحمد بن مسلمة وأمثالهم من هو أجل ممن مع علي من الصحابة، فأعلم من كان بالكوفة من الصحابة علي وابن مسعود وعلي كان بالمدينة، إذ كان بها عمر وعثمان وابن مسعود، وهو نائب عمر وعثمان ومعلوم أن علياً مع هؤلاء أعظم علماً وفضلًا من جميع من معه من أهل العراق، ولهذا كان الشافعي يناظر بعض أهل العراق في الفقه، محتجاً على المناظر بقول علي وابن مسعود، فصنف الشافعي كتاب [اختلاف علي وعبد الله] يبين فيه ما تركه المناظر وغيره من أهل العلم من قولهما، وجاء بعده محمد بن نصر المروزي، فصنف في ذلك أكثر مما صنف الشافعي قال: إنكم وسائر المسلمين تتركون قوليهما لما هو راجح من قوليهما، وكذلك غيركم يترك ذلك لما هو راجح منه. ومما يوضح الأمر في ذلك: أن سائر أمصار المسلمين غير الكوفة كانوا منقادين لعلم أهل المدينة لا يعدون أنفسهم أكفاءهم في العلم، كأهل الشام ومصر مثل الأوزاعي ومن قبله وبعده من الشاميين ومثل الليث بن سعد ومن قبل ومن بعد من المصريين وأن تعظيمهم لعمل أهل المدينة واتباعهم لمذاهبهم القديمة ظاهر بين. وكذلك علماء أهل البصرة كأيوب وحماد بن زيد، وعبد الرحمن بن مهدي، وأمثالهم. ولهذا ظهر مذهب أهل المدينة في هذه الأمصار فإن أهل مصر صاروا نصرة لقول أهل المدينة وهم أجلاء أصحاب مالك المصريين كابن وهب، وابن القاسم، وأشهب: وعبد الله بن الحكم. والشاميون مثل الوليد بن مسلم، ومروان بن محمد، وأمثالهم، لهم روايات معروفة عن مالك. وأما أهل العراق كعبد الرحمن بن مهدي وحماد بن زيد، ومثل إسماعيل بن إسحاق القاضي وأمثالهم، كانوا على مذهب مالك، وكانوا قضاة القضاة وإسماعيل ونحوه كانوا من أجل علماء الإسلام. وأما الكوفيون بعد الفتنة والفرقة يدعون مكافأة أهل المدينة، وأما قبل الفتنة والفرقة فقد كانوا متبعين لأهل المدينة ومنقادين لهم لا يعرف قبل مقتل عثمان أن أحدًا من أهل الكوفة أو غيرها يدعي أن أهل مدينته أعلم من أهل المدينة، فلما قتل عثمان وتفرقت الأمة وصاروا شيعًا ظهر من أهل الكوفة من يساوي بعلماء أهل الكوفة علماء أهل المدينة. ووجه الشبهة في ذلك أنه ضعف أمر المدينة لخروج خلافة النبوة منها وقوي أمر أهل العراق لحصول على فيها لكن ما فيه الكلام من مسائل الفروع والأصول قد استقر في خلافة عمر. ومعلوم أن قول أهل الكوفة مع سائر الأمصار قبل الفرقة أولى من قولهم وحديثهم بعد الفرقة. قال عبيدة السلماني قاضي على - رضي الله عنه – (لعلي): رأيك مع عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة. ومعلوم أنه كان بالكوفة من الفتنة والتفرق ما دل عليه النص والإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الفتنة من هاهنا، الفتنة من هاهنا، الفتنة من هاهنا، من حيث يطلع قرن الشيطان). وهذا الحديث قد ثبت عنه في الصحيح من غير وجه. ومما يوضح الأمر في ذلك أن العلم إما رواية وإما رأي، وأهل المدينة أصح أهل المدن رواية ورأيًا. وأما حديثهم فأصح الأحاديث وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث أحاديث أهل المدينة ثم أحاديث أهل البصرة. وأما أحاديث أهل الشام فهي دون ذلك، فإنه لم يكن لهم من الإسناد المتصل وضبط الألفاظ ما لهؤلاء ولم يكن فيهم - يعني أهل المدينة، ومكة والبصرة، والشام - من يعرف بالكذب لكن منهم من يضبط ومنهم من لا يضبط. وأما أهل الكوفة فلم يكن الكذب في أهل بلد أكثر منه فيهم، ففي زمن التابعين كان بها خلق كثيرون منهم معروفون بالكذب لا سيما الشيعة فإنهم أكثر الطوائف كذبا باتفاق أهل العلم؛ ولأجل هذا يذكر عن مالك وغيره من أهل المدينة أنهم لم يكونوا يحتجون بعامة أحاديث أهل العراق، لأنهم قد علموا أن فيهم كذابين ولم يكونوا يميزون بين الصادق والكاذب فأما إذا علموا صدق الحديث فإنهم يحتجون به كما روى مالك عن أيوب السختياني وهو عراقي فقيل له [في] ذلك فقال: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه أو نحو هذا. وهذا القول هو القول القديم للشافعي؛ حتى روي أنه قيل له: إذا روى سفيان عن منصور عن علقمة عن عبد الله حديثا لا يحتج به؟! فقال: إن لم يكن له أصل بالحجاز، وإلا فلا شك أن الشافعي رجع عن ذلك وقال لأحمد بن حنبل: أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا صح الحديث فأخبرني به حتى أذهب إليه شاميًا كان أو بصريًا أو كوفيًا ولم يقل مكيًا أو مدنيًا؛ لأنه كان يحتج بهذا قبل....وأما الفقه والرأي فقد علم أن أهل المدينة لم يكن فيهم من ابتدع بدعة في أصول الدين، ولما حدث الكلام في الرأي في أوائل الدولة العباسية وفرع لهم ربيعة بن هرمز فروعًا كما فرع عثمان البستي وأمثاله بالبصرة وأبو حنيفة وأمثاله بالكوفة وصار في الناس من يقبل ذلك وفيهم من يرد وصار الرادون لذلك مثل هشام بن عروة وأبي الزناد والزهري وابن عيينة وأمثالهم، فإن ردوا ما ردوا من الرأي المحدث بالمدينة فهم للرأي المحدث بالعراق أشد ردًا، فلم يكن أهل المدينة أكثر من أهل العراق فيما لا يحمد وهم فوقهم فيما يحمدونه وبهذا يظهر الرجحان. وأما ما قال هشام بن عروة: لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلاً حتى فشا فيهم المولدون: أبناء سبايا الأمم فقالوا فيهم بالرأي فضلوا وأضلوا. قال ابن عيينة: فنظرنا في ذلك فوجدنا ما حدث من الرأي إنما هو من المولدين أبناء سبايا الأمم، وذكر بعض من كان بالمدينة وبالبصرة وبالكوفة والذين بالمدينة أحمد عند هذا ممن بالعراق من أهل المدينة. ولما قال مالك - رضي الله عنه - عن إحدى الدولتين إنهم كانوا أتبع للسنن من الدولة الأخرى قال ذلك لأجل ما ظهر بمقاربتها من الحدثان؛ لأن أولئك أولى بالخلافة نسبًا وقرنًا. وقد كان المنصور والمهدي والرشيد - وهم سادات خلفاء بني العباس - يرجحون علماء الحجاز وقولهم على علماء أهل العراق كما كان خلفاء بني أمية يرجحون أهل الحجاز على علماء أهل الشام ولما كان فيهم من لم يسلك هذا السبيل بل عدل إلى الآراء المشرقية كثرت الأحداث فيهم وضعفت الخلافة"
ويمكن تلخيص ما سبق في النقاط التالية:
1- المقصود بعبارة "الجماعة" في مذهب أهل السنة والجماعة هو مجلس الشورى العُمري الذي كان –آنذاك- يمثل القيم والأعراف القبلية العدنانية ثقافياً وعرقياً. وعندما يتحدث ابن تيمية عن مذهب أهل المدينة فهو لا يقصد بـ "أهل المدينة" سكانها وقاطنيها؛ بل يقصد تحديداً مجلس الشورى العُمري الذي لم يكن فيه أنصاري واحد برغم من أن الأنصار كانوا يشكلون غالبية سكان المدينة. (وكان أهل المدينة فيما يعملون إما أن يكون سنة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وإما أن يرجعوا إلى قضايا عمر بن الخطاب، ويقال: أن مالكاً أخذ جل الموطأ عن ربيعة، وربيعة عن سعيد بن المسيب؛ وسعيد بن المسيب عن عمر؛ وعمر محدث) (وكان عمر يشاور أكابر الصحابة، كعثمان وعلي وطلحة والزبير؛ وسعد وعبد الرحمن؛ وهم أهل الشورى؛ ولهذا قال الشعبي: انظروا ما قضى به عمر؛ فإنه كان يشاور. ومعلوم أن ما كان يقضي أو يفتي به عمر ويشاور فيه هؤلاء أرجح مما يقضي أو يفتي به ابن مسعود أو نحوه؛ رضي الله عنهم أجمعين) (ومما يوضح الأمر في ذلك: أن سائر أمصار المسلمين غير الكوفة كانوا منقادين لعلم أهل المدينة لا يعدون أنفسهم أكفاءهم في العلم....وأن تعظيمهم لعمل أهل المدينة واتباعهم لمذاهبهم القديمة ظاهر بين....ولهذا ظهر مذهب أهل المدينة في هذه الأمصار....وأما الكوفيون بعد الفتنة والفرقة يدعون مكافأة أهل المدينة، وأما قبل الفتنة والفرقة فقد كانوا متبعين لأهل المدينة ومنقادين لهم لا يعرف قبل مقتل عثمان أن أحدًا من أهل الكوفة أو غيرها يدعي أن أهل مدينته أعلم من أهل المدينة، فلما قتل عثمان وتفرقت الأمة وصاروا شيعًا ظهر من أهل الكوفة من يساوي بعلماء أهل الكوفة علماء أهل المدينة. ووجه الشبهة في ذلك أنه ضعف أمر المدينة لخروج خلافة النبوة منها وقوي أمر أهل العراق لحصول علي فيها لكن ما فيه الكلام من مسائل الفروع والأصول قد استقر في خلافة عمر....قال عبيدة السلماني قاضي علي - رضي الله عنه – (لعلي): رأيك مع عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة....ومما يوضح الأمر في ذلك أن العلم إما رواية وإما رأي، وأهل المدينة أصح أهل المدن رواية ورأيًا....وأما الفقه والرأي فقد علم أن أهل المدينة لم يكن فيهم من ابتدع بدعة في أصول الدين)
2- إن المفاضلة بين السلف الصالح (بما فيهم الصحابة فضلاً عن التابعين) تتم على أساس اقترابهم أو ابتعادهم –ثقافياً- من مجلس الشورى العُمري الذي كان –آنذاك- ممثلاً أعلى للإجماع العدناني. (فلما قتل عثمان وحصلت الفتنة والفرقة وانتقل علي إلى العراق هو وطلحة والزبير لم يكن بالمدينة من هو مثل هؤلاء، ولكن كان بها من الصحابة مثل سعد بن أبي وقاص وأبي أيوب ومحمد بن مسلمة وأمثالهم من هو أجل ممن مع علي من الصحابة، فأعلم من كان بالكوفة من الصحابة علي وابن مسعود، وعلي كان بالمدينة إذ كان بها عمر وعثمان وابن مسعود، هو نائب عمر وعثمان، ومعلوم أن علياً مع هؤلاء أعظم علماً وفضلًا من جميع من معه من أهل العراق) (قال عبيدة السلماني قاضي علي - رضي الله عنه – (لعلي): رأيك مع عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة)
جاء الإسلام كثورة ثقافية تهدف لإعادة إحياء الملة الإبراهيمية الحنيفية، ملة الفطرة والصبغة الإلهية الأولى (فطرة الله التي فطر الناس عليها) (صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة) وذلك بعد أن عبثت يد الكهنوت فيها وأخرجتها عن نسقها التوحيدي الخالص. فمنذ البدء كانت قيم الصحراء والبداوة بما تحويه من عناصر الكرامة وروح الإباء وعزة النفس تمثل درع حماية طبيعي لملة التوحيد أن تتآكل وتهتريء ويتخللها الشرك والوثنية وعبودية البشر، وظلت الملة في أحضان أبنائها قوية راسخة عميقة الجذور وعصية على التغيير منذ عصر الخليل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وأبنائه البررة حتى وفاة سليمان عليه الصلاة والسلام، حيث اختطفها –بعد ذلك- الكهنة الصادوقيون وأخضعوها لقيم المدينة وثقافة السخرة، لتتحول إلى مجرد كهنوت كنعاني وثني.
وعندما فشلت المسيحية في إعادتها لأصلها الأول؛ أرسل الله تعالى نبيه في مهمة محددة، وهي آخر مهمة نبوية (رسالة) يكلف الله بها بشر، لذلك كانت المهمة هذه المرة لا تحتمل الفشل؛ إنها ليست مجرد إحياء الملة وتطهيرها من الكهنوت؛ بل والإبقاء عليها كذلك إلى الأبد.
هذه المرة؛ لم يؤيد الله نبيه بمعجزات عظيمة كتلك التي جاء بها من قبله من الأنبياء، لم يولد من غير أب، ولم يحي الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص، ولم يحمل عصًا كعصا موسى. فالمعجزات لا تقنع إلا من رآها وعاينها، فهي لا تصلح لإنشاء أديان أبدية الاستمرار والبقاء، فائدتها محصورة في إقناع جيل واحد أو جيلين بصدق نبوءة النبي، أي لإنشاء أديان مؤقتة بزمن محدد ولفئة معينة من البشر، وهي صفات لا تنطبق على الرسالة الأخيرة؛ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم.
إن رسالة من هذا النوع تحتاج لمعجزة أبدية لا يعتريها انقطاع أو غيبة، معجزة ثقافية، حاضرة وعملية، وقائمة أمام أعين الأجيال إلى الأبد. لا تختبئ في سرداب، ولا ينوب عنها ولي فقيه.
عندما أرسل الله رسوله الأخير؛ سلّحه بسلاحين اثنين: الوحي (القرآن والسنة) والجماعة. أما الوحي فهو حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وأما الجماعة فهي وحي عملي يمشي على الأرض إلى يوم القيامة. أما الوحي فقد انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتجمدت نصوصه منذ أربعة عشر قرناً ونيف، وأما الجماعة فهي المصدر الأبدي لنفخ الروح في تلك النصوص الجامدة كي لا تموت.
عندما ضعفت قبضة العدنانيين على مقاليد الدولة بسقوط الخلافة الراشدة، ثم ازدادت ضعفاً بسقوط الأمويين؛ خلت الساحة أمام الآل بيتيين لينشروا مذهبهم ويمكنوا لكهنوتهم في ظل الشعوبية العباسية، ولم يقترب نجم العباسيين من الأفول حتى كانت مذاهب آل البيت قد اكتسحت الامبراطورية من أصقاعها إلى أصقاعها. وقبل ثلاثة قرون من الآن؛ عندما ظن الظانون أنه لم يعد لملة التوحيد وجود على سطح الكوكب؛ خرجت الثورة السعودية من قلب الصحراء الإبراهيمية لتفاجئ العالم بأن الجماعة لم تمت، وأن الخط السلفي العدناني عصي على الانقراض.
وعندما فشل أعداء الثورة في مواجهتها عسكرياً وسياسياً وثقافياً بشكل واضح وصريح كما يفعل الرجال؛ لجأوا لأسلوب العصابات والتنظيمات السرية، أسلوب الدعوة العباسية القديمة التي لم يكترث بها الأمويون ويلقوا لها بالاً حتى فاجأتهم على حين غرة. وهم الآن يعدون نفس الهولوكوست الأموي لآل سعود.
وإذا كانت فلول الأمويين قد وجدت لنفسها ملاذاً آمناً في أسبانيا؛ فإن أسبانية اليوم تقف بخيلها وخيلائها مع التنظيم الآل بيتي الحديث بكافة أجنحته وفروعه، بما فيها القاعدي والإخونجي، رغم ادعائهم بمحاربة الإرهاب، وذلك في تكالب عالمي سافر ومكشوف ضد الثورة السعودية برموزها وقبائلها ومؤيديها وحتى حلفائها.
خرجت الثورة السعودية من رحم القبلية العدنانية لتكتسب قوتها من قوة القبيلة، وتستمد مقومات بقائها واستمرارها من قيم الوحدة والتلاحم القبلي الأسطوري، قيم النخوة والفزعة والشهامة الفطرية العدنانية منقطعة النظير. رجالها فرسان القبيلة الشجعان، قادتها مشايخ القبائل، قيمها ومبادئها هي قيم القبيلة وأعرافها (المروءة، الكرم، الشجاعة، الشرف، عزة النفس....)، أما دستورها فهو مذهب مجلس الشورى العمري (السنة والجماعة).
وعندما اكتشف الآل بيتيون أن القبيلة هي نقطة القوة ومحور الارتكاز الوحيد للثورة السعودية؛ علموا أنه لا يمكن القضاء على هذه الثورة إلا بالقضاء على الثقافة القبلية. ولكنها مهمة ليست باليسيرة في مجتمع بدوي حتى النخاع، كالمجتمع السعودي، لذلك كان عليهم صياغة خطط بعيدة المدى، تبدأ بتحضير البدو، وتنتهي بالمجتمع المدني والعولمة والديمقراطية والملكية الدستورية....يتبع





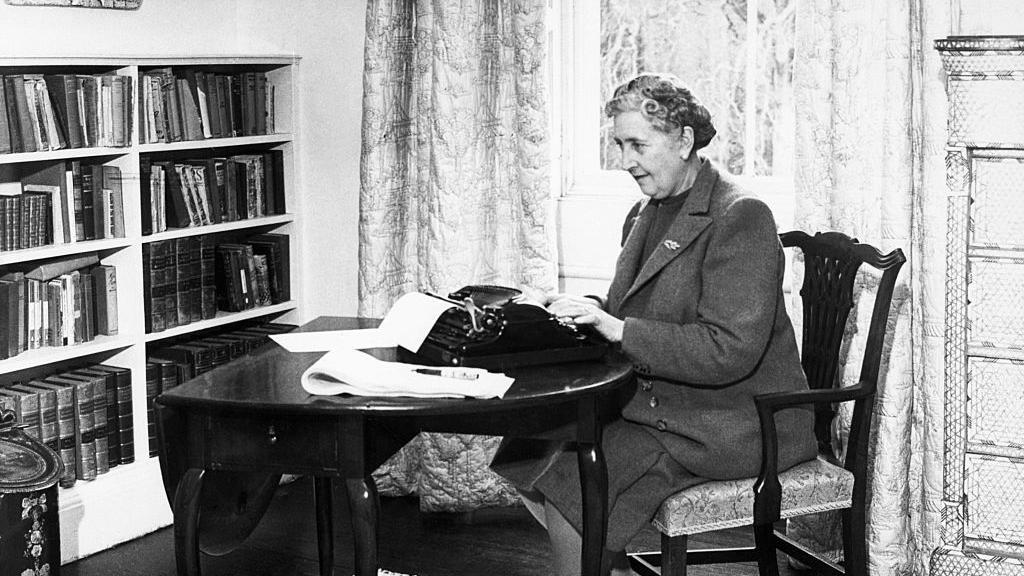











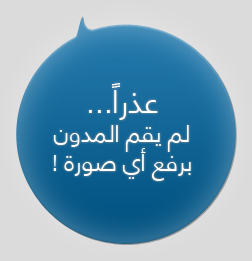

التعليقات (0)