تطور الإطار القانوني للإستثمار في الجزائر

تطور الإطار القانوني للإستثمار في الجزائر:
لقد كان لقانون الاستثمارات في الجزائر عدة تطورات و تغيرات تماشيا مع الأوضاع الاقتصادية والظروف السياسية التي كانت تشهدها كل مرحلة خاصة في سنوات التسعينيات حيث قامت الدولة في هده الفترة بتعديلات و إصلاحات اقتصادية ومالية هامة من بينها إصدار قوانين لتشجيع المستثمرين وفتح الأبواب الموصدة أمامهم و إنشاء هيئات مكلفة بترقية و دعم الاستثمار.
وعلى هذا الأساس،سوف نستعرض تطورات قوانين تشجيع الاستثمار بالجزائر قبل فترة التسعينات و بعدها و كذلك الهيئات المكلفة بتدعيمه وترقيته.
1.2- مرحلة قبل التسعينات.
إن التوجه الاشتراكي للجزائر غداة الاستقلال أدى إلى وجوب تدخل الدولة في جميع فروع الاقتصاد، وهذا ما انعكس جليا على مختلف التشريعات المتعلقة بالاستثمار والتي تميزت بنوع من الحذر والتحفظ اتجاه الاستثمار الأجنبي المباشر.
و شملت هذه الفترة إصدار عدة قوانين لتشجيع الاستثمار:
1.1.2- قانوني الاستثمار لسنة 1963 و لسنة 1966
أ- قانون الاستثمار لسنة 1963 :
ركز هذا القانون على الاستثمارات الأجنبية في قطاعات ثانوية غير القطاعات الإستراتيجية التي كانت محتكرة من طرف الدولة،بالإضافة إلى إمكانية استرجاع وتملك حصص المستثمر الأجنبي.و قد نص هذا القانون على حرية الاستثمار والمساواة أمام القانون خاصة في المجال الجبائي.
كما أنّ هذا القانون بصفة عامة،لم يعرف تطبيقا فعالا في الواقع، بسبب أنّ المستثمرين شككوا في مصداقيته، باعتبار أنّ الجزائر كانت تقوم بتأمينات (1963-1964) حيث بيّنت الإدارة الجزائرية نيّتها في عدم تطبيقها مادامت لم تبادر بدراسة الملفات التي أودعت لديها.[29]
ب- قانون الاستثمار لسنة 1966:
بعد فشل قانون 1963 تبنّت الجزائر قانونا جديدا لتحديد دور رؤوس الأموال في إطار التنمية الاقتصادية، و مكانته و أشكاله، و الضمانات الخاصة به،حيث جاء مختلفا عن سابقه من خلال المبادئ التي وضعت فيه.
و ارتكز هذا القانون على مبدأين أساسيين:[30]
- يشير المبدأ الأول:إلى تأكيد الدولة لفكرة احتكار المجالات الحيوية ( مادة 02)،وللمستثمرين حق الاستثمار في قطاعات أخرى بعد الحصول على اعتماد مسبق من قبل السلطات الإدارية ( مادة 04)، يمكن للدولة أن تكون لها مبادرة الاستثمار إمّا عن طريق الشركات المختلطة وإمّا عن طريق إجراء مناقصات لإحداث مؤسسات معيّنة ( مادة 05).
- أما المبدأ الثاني،فتمثل في منح الضمانات والامتيازات،حيث تتمثل الضمانات في المساواة أمام القانون لا سيما المساواة أمام القانون الجبائي ( المادة 10)،حق تحويل الموال والأرباح الصافية ( المادة 11)، و تتمثل الامتيازات هي الأخرى في أنّها جبائية تتعلق بالإعفاء التّام أوالجزئي أو التناقصي من رسم الانتقال بعوض، والرسم العقاري ( لمدّة عشر سنوات) والرسم على الأرباح الصناعية والتجارية وغيرها ( المادة 14).
وفشل قانون 1966 في جلب المستثمرين الأجانب لأنّه كان ينص على اتفاقية التأميم و لأنّ الفصل
في النزاعات كان يخضع للمحاكم و القانون الجزائري.
2.1.2 – فترة الثمانينات:
في قانون الاستثمار لسنة 1982 رقم 82/13 المؤرخ في 28/09/1982،أكّدت الجزائر نيّتها في تبني شكل من أشكال الاستثمار الأجنبي المتمثل في ” الشركات المختلطة”.
و يوضح هذا القانون نسبة مشاركة الشركات الأجنبية التي لا يمكنها تجاوز 49% من رأسمال الشركة المختلطة،في حين 51% المتبقية تمثل نسبة المشاركة المحلية ( المادة 22)، و تستفيد الشركات المختلطة من مجموعة من الحوافز المختلفة و التي يمكن إجمالها في الإعفاء من الضريبة العقارية لمدّة خمس سنوات و من الضريبة على الأرباح الصناعية و التجارية لمدّة ثلاث سنوات المالية الأولى … ( المادة 12) و كذلك يقدم هذا القانون ضمانات للأطراف الأجنبية كالحق في المشاركة في أجهزة التسيير و القرار،و ضمان حق التّحويل.[31]
و كشفت حصيلة تطبيق هذا القانون على إنشاء شركتين مختلطتين فقط رغم ما صاحب هذا التشريع من خطاب سياسي تحفيزي و لم يتغيّر الوضع حتى بعد تعديل هذا القانون بموجب القانون رقم 86/13 حيث بقي هذا الأخير حبرا على ورق.
و إلى جانب قانون الشركات ذات الاقتصاد المختلط قامت السلطة على مستوى آخر بإصلاح قانون المحروقات بمقتضى القانون رقم 86/14 وقد نجح هذا القانون نسبيا في جذب الاستثمارات الخاصة الأجنبية و التي وصل عددها إلى أكثر من 30 عقدا و ربما يفسر هذا النجاح بمردودية هذا القطاع بالمقارنة مع بقية القطاعات الأخرى من حيث المزايا التفضيلية.[32]
و الملاحظ على التشريعات السابقة أنّها كانت تنطوي على تفرقة اقتصادية و قانونية بين المستثمر الأجنبي و المحلي من جهة،والعام والخاص من جهة أخرى، وهذا إلى غاية التسعينات مع صدور قانون النقد و القرض لسنة 1990.
2.2- مرحلة التسعينات:
أهم ما يميّز هذه الفترة،هو الظرف السيئ الّذي شهدته الجزائر من خلال عدم الاستقرار السياسي و الأمني و الاختلالات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد الوطني،لكن رغم هذه الأوضاع،شهدت هذه المرحلة قوانين و مراسيم لتشجيع الاستثمار كما يلي:-
1.2.2- قانون النقد و القرص :
يعتبر القانون رقم 90/10 الصادر في 14 أفريل 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض من القوانين التشريعية الأساسية للإصلاحات،فهو يهدف إلى إضفاء الأهمية لمكانة النظام البنكي الجزائري،بالإضافة إلى ذلك يعتبر بمثابة تنظيم جديد لمعالجة ملفات الاستثمارات الأجنبية على مستوى بنك الجزائر،كما اسند لمجلس النقد و القرض مهمة إصدار القرارات المطابقة للمشاريع المقدّمة،ومنه فإنّ قانون النقد و القرض ليس قانونا خاصا بالاستثمار،لكن له علاقة به فهو منظم لسوق الصرف وحركة رؤوس الأموال.
إنّ أول ما جاء به قانون النقد و القرض في مجال الاستثمار الأجنبي هو استبدال معيار الجنسية الذي يفرق بين المستثمرين الأجانب و المستثمرين المحليين، بمعيار الإقامة الذي يفرق بين المقيم و غير المقيم. حيث يرخص لغير المقيمين بتحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل نشاطات اقتصادية غير مخصصة صراحة للدولة أو المؤسسات المتفرعة عنها أو لأي شخص معنوي مشار إليه صراحة بموجب نص قانوني[33] ،وبذلك فإنّه يمكن للمستثمرين غير المقيمين أن يؤسسوا شركات يملكونها بصفة كلية و بدون مشاركة أو مساهمة من المؤسسات الجزائرية.
كما أنّ هذا القانون في مادته 183 يشجع على إقامة علاقات استثمار بين المتعاملين الوطنيين والأجانب رغبة في خلق مناصب شغل جديدة أو لجلب التكنولوجيا،وفي المادة 184 تم وضع ضمانات فيما يخص طرق نقل وتحويل رؤوس الأموال والمداخل والفوائد للمستثمرين الأجانب،أما بالنسبة للمقيمين في الوطن فيحق لهم تحويل أموالهم للخارج من أجل ضمان تمويل النشاطات التكميلية في الخارج لعملهم في الجزائر.
عطفا على ما تقدم يظهر قانون ناجح من خلال ارتكازه على إهمال التمييز بين الملكيات لرأس المال أو الجنسية،فهذا القانون لا يفرق بين المستثمر الوطني والأجنبي بل يعمّمه إلى مقيم وغير مقيم،وكذلك احتواء القانون على جملة من الضمانات كحرية تحويل الأرباح،فضلا عن ضمانه لاستثمارات أجنبية ذات أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني (خلق فرص عمل،نقل التكنولوجيا).
- المرسوم التشريعي رقم 93/12:
جاء هذا المرسوم التشريعي بعد ثلاث سنوات من صدور قانون النقد والقرض،وهو يبيّن الإرادة الواضحة للدولة من أجل ترقية الاستثمارات،وكذا تحقيق سياسة الانفتاح الاقتصادي،حيث أحدث عدّة تغيّرات،وبذلك فهو يرتكز على ما يلي :-
• المعاملة المماثلة لكل المستثمرين على حد سواء.
• إعفاء القطاع الخاص الوطني والأجنبي من القيود التي كانت في ظل القوانين السابقة،فأصبح يتم الاقتصار على التصريح بدلا من إجراءات الموافقة التي كانت من قبل.
• منح العديد من الحوافز و الامتيازات للمستثمرين قصد تشجيع و تطوير الاستثمار.
ويلاحظ أنّ هذا القانون فتح المجال لرؤوس الأموال الأجنبية حيث يرخص لها الاستثمار في كل القطاعات لإنتاج السلع والخدمات ما عدا القطاعات الإستراتيجية للدولة كقطاع المحروقات حيث أنّها فتحت مجال المساهمة و الشراكة في المشاريع نظرا لحاجة الدولة إلى لاستثمار في هذا القطاع[34].
إنّ أهم ما يميّز قوانين و مراسيم هذه المرحلة هو إعطاء الأولوية للقطاع الخاص على عكس المرحلة السابقة، وما يؤخذ على هذه القوانين والمراسيم من وجهة نظرنا،هو أنّها كانت جزئية و الدليل على ذلك التعديلات التي حدثت فيها.
3.2- مرحلة ما بعد التسعينات.
تميّزت هذه الفترة بعودة الاستقرار السياسي والأمني وتحسن في الأوضاع الاقتصادية،ممّا استلزم مواكبة هذه الأوضاع الجديدة بصدور حزمة كبيرة من القوانين والمراسيم والأوامر كلها تدخل في عمق الإصلاحات وقد مسّت كل القطاعات بدون استثناء،ومن التشريعات التي عالجت موضوع الاستثمارما يلي : -
1.3.2- الأمر رقم 01/03 المؤرخ في 20 أزت المتعلق بتطوير الاستثمار
جاء هذا الأمر المتعلق بتطوير الاستثمار من أجل إعطاء دفع جديد لمسيرة الاستثمارات في الجزائر،وذلك بعد النتائج السلبية التي خلّفها المرسوم التشريعي رقم 93/12،حيث أنّ التجربة دلّت على بعض النقائص والقصور فيها،طالما أنّه لن يحقق ما كان منتظرا منه،رغم الضمانات والحوافز التي قدمت فيه.
إذ بين مجموع الملفات المودعة لدى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار التي بلغ عددها 48 ملفا، من سنة 1993 حتى سنة 2001،تمّ تجسيد 10% منها فقط.[35]
لذلك جاء الأمر رقم 01/03 المتعلق بتطوير الاستثمار في ثوب جديد ليعزّز الحوافز و يشجع على المزيد من الاستثمارات ويتفادى بطبيعة الحال ما وقع فيه المرسوم التشريعي السابق من مآخذ.
ومن الحوافز الإضافية والضمانات ضمن الأمر رقم 01/03 المتعلق بتطوير الاستثمار،نجد أن بنود القانون الجديد تضمنت الكثير من الحوافز الإضافية كما تميّزت بتأكيد ما كان يمنحه القانون السابق وتوضيح بنوده بشكل قاطع و ارتكز القانون الجديد على مبادئ أساسية أهمها[36]:
• إقرار مبدأ الحرية الكاملة للاستثمار و إلغاء أي نوع من التصريح المسبق.
• المساواة بين جميع المستثمرين في الحقوق و الواجبات.
• تسهيل انطلاق العملية الاستثمارية من خلال إيجاد إطار يتولى التعامل مع المستثمرين،
و هو يتمثل حاليا بالشباك الموحد اللامركزي المتواجد حاليا في 06 ولايات تضم أهم المدن الجزائرية شرقا و غربا و وسطا و من الشمال إلى داخل الجنوب الصحراوي.
• أما عن الضمانات فهي تمتّع المشروع الاستثماري بحماية ضد التأميم و المصادرة أو أي
إجراء من هذا النّوع،و يضمن القانون للمستثمر حرية تحويل الأرباح ورأس المال في كل وقت.
المزايا و الإعفاءات الممنوحة للمستثمرين:
استنادا إلى المادتين 09 و 10 من الأمر 01-03،منح المشرّع الجزائري صنفين من المزايا، أدرجها ضمن النظامين: النظام العام والنظام الاستثنائي (الخاص)،ذلك أنّه إلى جانب استفادة المستثمر من الحوافز الجبائية والجمركية المنصوص عليها في إطار النظام العام،فإنّه يستفيد في إطار النظام الاستثنائي من مزايا و إعفاءات خاصة،لاسيما عندما يستعمل تكنولوجيا خاصة من شأنها المحافظة على البيئة،و حماية الموارد الطبيعية،وادّخار الطاقة،والمساعدة على تحقيق تنمية شاملة.
و فيما يلي إيجاز لأهم الحوافز الضريبية،وشبه الضريبية و الجمركية الممنوحة للمستثمرين:[37]
مرحلة بدء الإنجاز: يستفيد الاستثمار من الحوافز التالية :
- تطبيق النسبة المخفّضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص التّجهيزات المستوردة.
- الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة TVA فيما يخص السلع و الخدمات.
- الإعفاء من رسم نقل الملكية بعوض فيما يخص المقتنيات التي تمّت في إطار الاستثمار المعني.
أما فيما يخص النظام الخاص، فقد تم منح مزايا لفائدة الاستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة، يمكن إيجازها فيما يلي:
- الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار.
- تطبيق حق ثابت في مجال التسجيل نسبة مخفّضة 0.2% فيما يخص العقود التأسيسية و الزيادات في رأس المال.
- تتكفل الدولة جزئيا أو كليا بالمصاريف بعد تقييمها من الوكالة، فيما يخص الأشغال المتعلقة بالمنشآت الأساسية الضرورية لإنجاز الاستثمار.
- الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة TVA فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحلية،وذلك عندما تكون هذه السلع و الخدمات الموجّهة لإنجاز عمليات تخضع للضريبة على القيمة المضافة.
- مرحلة انطلاق الاستغلال: بعد معاينة انطلاق الاستغلال، تمنح المزايا التالية :
- الإعفاء لمدّة 10 سنوات من النشاط الفعلي من الضريبة على أرباح الشركات (IBS) و من الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) على الأرباح الموزّعة ومن الدّفع الجزافي (VF)، و من الرسم على النشاط المهني (TAP).
- الإعفاء لمدّة 10 سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء من الرسم العقاري على الملكية العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار.
- منح مزايا إضافية من شأنها أن تحسّن أو تسهّل الاستثمار مثل تأجيل العجز وآجال الاهتلاك.
ويمكن الإشارة إلى قانون المالية لسنة 1996،والمادة 138 من قانون الضرائب المباشرة،و كذا المادة 309 من قانون الضرائب،قد تضمنت عدّة مزايا للمستثمرين المنتجين والذين يصدرون سلعا و خدمات إلى الأسواق الخارجية،نذكر منها :
- إعفاء الشركات القائمة بعمليات بيع السلع والخدمات للتصدير من دفع الضريبة المفروضة على أرباحها المحققة بصورة مؤقتة لمدّة خمس (05) سنوات.
- إعفاء الشركات من أداء الدّفع الجزافي (VF) بصورة مؤقتة لمدّة خمس (05) سنوات.
- إمكانية استفادة المصدر من تخفيضات بنسبة تقدّر بنحو 50% تمنحها الشركات الوطنية للملاحة البحرية، و الجوية، و تلك التي تمنحها الموانئ، في مجال نقل البضائع.
2.3.2- القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة رقم 01/18 الصادر في 12 ديسمبر 2001.
ويتناول هذا القانون التعريف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والدور الذي يمكن أن تلعبه في تحريك التنمية.وقد بادرت وزارة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بوضع استراتيجية بعيدة المدى تقوم على المحاور الرئيسية التالية:[38]
الأول :تشخيص و دراسة محيط هذا القطاع،سواء كان ماليا،أو قانونيا أو ماديا،وبالتالي تحديد كل المعوقات.
الثاني:حددت فيه الأهداف التي تطمح لتحقيقها،ويأتي على رأس هذه الأهداف،التخفيف من حدث البطالة،وذلك بإنشاء حوالي 600 ألف مؤسسة مع آفاق 2020 بطاقة استيعاب لا تقل عن 06 ملايين منصب شغل.
الثالث: المساهمة في خلق محيط استثماري من شأنه أن يستقطب مزيدا من الأموال سواء كانت محلية أو أجنبية،ذلك عن طريق تمويل وتأهيل المؤسسات واليد العاملة،وتقديم الخبرات والتكنولوجيا اللازمة لذلك، وهذا يعني الاستفادة من التّعاون الخارجي،وتشجيع الشراكة الأجنبية.
ولتأكيد تحقيق هذه الإستراتيجية،جاء المرسوم التنفيذي رقم 02/373 الصادر في نوفمبر 2002 والمتعلّق بإنشاء صندوق ضمان القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرض توفير الضمانات الضرورية للحصول على القروض البنكية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
الأمر رقم 01/04 الموافق ل 20 أوت لسنة 2001 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية و تسييرها و خوصصة
يتكون هذا الأمر من 43 مادة موزعة على إحدى عشر فصلا، تتناول تعريف المؤسسات العمومية الاقتصادية، و شكل رأسمال الاجتماعي لها،وكيف يتم الاقتناء والتنازل،و تركيبة مجلس الإدارة، وإبرام الاتفاقيات،وغيرها من الأحكام والقواعد التي تنظم هذه المؤسسات،ويتناول الأحكام المتعلقة بالخوصصة ( من المادة 13 إلى المادة 19 من الأمر) و كذلك الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الخوصصة (المادة 20 إلى المادة 25)، و كيفيات الخوصصة،ومكانة العمال الأجراء منها،ومراقبة عمليات الخوصصة و الشروط العامة المطبقة على نقل الملكية وغيرها ( المادة 26-43)[39]، ويضاف إلى هذا الأمر،القانون رقم 01/17 المؤرخ في 21 أكتوبر 2001 والذي يتضمن تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وخوصصتها و بالدّرجة الأولى موافقة رئيس الجمهورية على الأمر السابق ذكره.
وتجدر الإشارة على المرسوم التنفيذي رقم 01/354 الذي يحدّد لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحيتها و كيفيات تنظيمها وسيرها.
4.3.2- الأمر 03/11 المؤرخ في 26 أوت سنة 2003 و المتعلق بالنقد و القرض:
تم إلغاء القانون رقم 90/10 المتعلق بالنقد والقرض بموجب الأمر 03/11 المؤرخ في 26 أوت 2003 الذي سمح بإعادة النظر في تنظيم وسير القطاع البنكي خاصة فيما يتعلق بدور كل من بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض وكذا عملية مراقبة البنوك والمؤسسات المالية إلى جانب قواعد الصرف وحركات رؤوس الأموال.
وأهم ما جاء في هذا الأمر فيما يخص تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر نذكر:[40]
• يسمح لغير المقيمين إنشاء بنوك و مؤسسات مالية لوحدهم أو بالمساهمة مع المقيمين،حيث نصّت المادة 84 و 85 من الأمر رقم 03/11 أنّه يسمح للبنوك والمؤسسات المالية الجنبية أن تفتح فروعا لها في الجزائر شريطة أن تتم المعاملة بالمثل.
• السماح بتحويل المداخيل و الفوائد و إعادة تحويل رؤوس الأموال وهذا ما نصّت عليه صراحة المادة 126 من الأمر رقم 03/11 “رؤوس الأموال و كل النتائج و المداخيل والفوائد و الإيرادات و سواها من الأموال المتصلة بالتمويل يسمح بإعادة تحويلها و تتمتع بالضمانات المنصوص عليها في الاتّفاقيات الدولية التي وقّعتها الجزائر”
4.2- الإطار المؤسسي للاستثمار في الجزائر
في مجال تدعيم الغطاء القانوني للاستثمار تمّ إنشاء هياكل إدارية ترمي لمساندة و تطوير مشاريع الاستثمار،حيث تمّ إنشاء:[41]
1.4.2- الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (ANDI)
و هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري في خدمة المستثمرين الوطنيين وضعت تحت إشراف رئيس الحكومة وهي تتولى المهام التالية:
• ترقية الاستثمارات وتطويرها ومتابعتها.
• استقبال المستثمرين المقيمين وغير المقيمين وإعلامهم ومساعدتهم.
• تسهيل القيام بالإجراءات التأسيسية للمؤسسات وتجسيد المشاريع بواسطة خدمات الشبابيك الوحيدة اللامركزية.
• تسيير المزايا المرتبطة بالاستثمار وتسيير صندوق دعم الاستثمار لتطوير هذا الأخير.
• التأكد من احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمرون خلال مدّة الإعفاء.
• المشاركة في تطوير وترقية مجالات وأشكال جديدة للاستثمار.
2.4.2- المجلس الوطني للاستثمار (CNI):
جهاز استراتيجي لدعم وتطوير الاستثمار يشرف عليه رئيس الحكومة ويضطلع بالمهام التالية :
• صياغة إستراتيجية،وأولويات الاستثمار.
• تحديد المناطق المعنية بالتنمية.
• إقرار الإجراءات والمزايا التّحفيزية.
• المصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار.
•
3.4.2- الشبابيك الوحيدة اللامركزية:
من أجل التّخلص من المتاعب البيروقراطيةوتسهيل الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب تمّ إنشاء الشبابيك الوحيدة اللامركزية على المستوى الوطني تشمل الإدارات والهيئات العمومية.
4.4.2-الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالمساهمة و ترقية الاستثمار (MDCGCPPI) و تضطلع بالمهام التالية :
• تنسيق الأنظمة المرتبطة بتحضير وتجسيد برامج الخوصصة.
• اقتراح إستراتيجيات ترقية وتطوير الاستثمار.
3- محددات أخرى:
1.3- الإستقرار السياسي والأمني:
يعتبر عدم الاستقرار السياسي و الأمني من أكبر العراقيل التي تواجه المستثمرين، فبعد فترة طويلة من الاستقرار السياسي و السلام الاجتماعي حكم الجزائر فيها ثلاثة رؤساء دولة خلال 29 سنة ( 1962-1991)،عقبها مرّت الجزائر بفترة عدم الاستقرار السياسي وكثرة الاضطرابات،حيث تعاقب على السلطة أربعة رؤساء دولة وأكثر من 10 حكومات هذا من جهة،ومن جهة أخرى تميّزت نفس الفترة باحتدام الصراع بين الحكومة والتيار الإسلامي، وقد تحوّل هذا الصراع للأسف إلى صراع دموي و نجم عن هذا التناحر سقوط الآلاف من الضحايا ابتداء من سنة 1992.
إنّ الوضعية السياسية والأمنية السيئة التي سادت الجزائر أثرت بشكل بارز على استقطاب رؤوس الأموال الوطنية و الأجنبية إليها وذلك لاعتبارات منها :-
• التأثير على التشريعات والأوامر وذلك لغياب الاستقرار الحكومي.
• الخطر الّذي يلاحق المستثمر الأجنبي و المحلي على حد سواء في نفسه و ممتلكاته نتيجة انعدام الأمن.
ولكن مع اعتماد سياستي الوئام المدني و المصالحة الوطنية، ساهم ذلك في عودة الأمن إلى الجزائر وتقليص درجة المخاطر وهذا ما عكسته تقييمات مختلف الجهات المتخصصة والمهتمة بالسوق الجزائري مثل مؤسسة لاكوفاس الفرنسية.
2.3- حجم السوق و احتمالات نموه:
بلغ عدد سكان الجزائر في 2005، 33.99 مليون نسمة وبمعدل نمو سكاني يقدّر بحوالي 2.2%، كما يبلغ الدخل الوطني الخام للفرد 3200 دولار[42].
بالإضافة إلى هذا فإنّ موقع السوق الجزائري يمكن أن يشكل نقطة انطلاق نحو أسواق أخرى نتيجة قربه الجغرافي من دول جنوب أوربا والدول الإفريقية جنوب الصحراء.
فضلا عن إمكانية الاستفادة من الفرص التي يتيحها تطبيق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي، كما يتميّز هذا السوق باحتوائه على الكثير من المواد الولية و المواد الطاقوية..
5- عوائق الاستثمار في الجزائر.
رغم ما يبذل من جهود لتهيئة المناخ الاستثماري في الجزائر، إلاّ أنّ هناك مجموعة من المعوقات التي ما زال يعاني منها الاقتصاد الجزائري، و التي يمكن أن تحدّ من تدفق تلك الاستثمارات إلى الجزائر إذا لم تأخذ تدابير جدّية للقضاء عليها.
هذا و لقد خلص التحقيق الّذي أجري في سنة 2005،والّذي شمل 600 مقاولة ( مؤسسة) إلى تحديد سلسلة من العوائق و المصاعب التي تعترض المستثمرين و نلخصها في:[58]
• مشكلة الوصول للقروض البنكية.
• ومشكل العقار الصناعي.
• مشكلة القطاع الموازي.
• و مشكلات ذات طابع إداري و تنظيمي
1.5- مشكلة الوصول إلى القروض البنكية:
فبالنسبة للقروض البنكية تشكل المشكلة الأكبر بالنسبة للمستثمرين في الجزائر، فتمويل الاستثمارات يعاني من بطء شديد،وهذا ما أكّده 72% من المستجوبين الّذين قاموا بتغطية ذاتية لميزانية الاستغلال في مقابل 70% ممن قاموا بتمويل استثماراتهم ذاتيا.
إن النظام البنكي الجزائري لا يزال دون المستوى المطلوب نتيجة لمجموعة من الأسباب كنقص الخبرة المهنية لدى المشرفين على البنوك الجزائرية،وكذا الاعتماد على الطرق التقليدية في تسيير البنوك، بالإضافة إلى سيادة القطاع العمومي الذي لا يزال مهيمنا على القطاع البنكي، و الذي زاد الطين بلة الفضائح الأخيرة للبنوك وهي بنك الخليفة و البنك التجاري و الصناعي،أدى إلى التشكيك في نجاعة النظام البنكي الجزائري وخلق نوع من التخوف لدى المستثمر الأجنبي في تعامله مع البنوك.
والأكثر من ذلك فإن الخدمات التي تقدمها البنوك رديئة جدا،فيستلزم تحصيل صك بنكي لدى نفس البنك وفي نفس المدينة يتطلب مدة تتراوح في العادة ما بين 06 و 17 يوما،وترتفع إلى ما بين 33 و34 يوم عندما يتعلق الأمر ببنكين مختلفين وفي مدينتين مختلفتين [59].
ومنه فإن إصلاح النظام البنكي وتحديث وسائل التسيير لهذا القطاع أصبح ضروري ليواكب الإصلاحات الإقتصادية وذلك لتحقيق النتائج المرجوة لترقية الإستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.
2.5- مشكل العقار الصناعي
يمثل العقار الصناعي هاجسا كبيرا أمام المستثمرين،الوطنيين والأجانب،ولطالما تعثرت مشروعات،ونفر مستثمرون لهذا السبب،ومشكل العقار الصناعي ليس بالجديد في الجزائر،حيث كشفت التجربة التي مر بها الإستثمار في إطار المرسوم التشريعي رقم 93/12 على أن العقار أصبح مع الوقت العائق الرئيسي أمام الإستثمار.
وبينت الدراسة السابقة أن 40 % من المستثمرين يستهلكون عادة في المتوسط خمسة (05) سنوات للحصول على عقار صناعي.
وتتمثل المشاكل التي يواجهها المستثمرون للحصول على العقار الصناعي أساسا في:[60]
- طول مدة رد الهيئات المكلفة بتخصيص العقار الصناعي والتي تفوق السنة.
- ثقل الإجراءات وتقديم نفس الملفات أمام هيئات ترقية الإستثمار،هيئات تخصيص العقار
ومرة أخرى أمام مسيري العقار[61].
- تخصيص أراضي بتكاليف باهظة تشمل تكاليف تهيئة دون خضوع هذه الأراضي لأي تهيئة أو في مناطق نشاط وهمية لعدم إنشائها بعد نظرا لوجود نزاع حول الملكية.
- عدم توافق طبيعة الأراضي الصناعية المخصصة ونوع النشاط.
مما سبق يبقى الوصول للعقار من أكبر الصعوبات ويشكل أهم المعوقات أمام قرار الإستثمار،بحيث يتطلب الحصول على قطعة الأرض مسارا طويلا وموافقة عدة سلطات وهيئات،وهذا يقودنا لإعتبار أن مشكلة العقار في الجزائر هي مشكلة ذات طابع لإداري وتنظيمي،فهي ليست ناجمة عن عدم وجود العقارات ولكن في عدم الإستغلال الكامل للعقارات بحيث 50 % [62] غير مستغلة،ومنه فإن التخفيف من عدد الإجراءات الإدارية للحصول على الأراضي اللازمة للمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء تساهم في حل مشكلة العقار الصناعي في الجزائر.
3.5- مشكلة القطاع الموازي
في الجزائر عددت وزارة التجارة 566 سوق موازية بمساحة إجمالية قدرها 2.7 مليون متر مربع،ينشط فيها أكثر من 100 ألف متدخل،أي 10 % من مجموع التجار المسجلين في السجل التجاري [63].
وأكدت الإحصائيات الرسمية أن القطاع الموازي في الجزائر يسيطر لوحده على 40 % من الكتلة النقدية المتداولة في السوق الوطنية،وهي نسبة مرتفعة جدا تؤكد عدم تحكم السلطات الإقتصادية في هذه الظاهرة نتيجة التساهل في معالجة هذا الملف [64] .
وبالتالي فإن الخسائر التي يسببها القطاع الموازي من خلال المنافسة غير الشرعية معتبرة جدا،وأن المنتجين الذين يعملون في إطار القانون يعانون فعلا وضعا مزريا غير مشجع على الإطلاق.
4.5- مشكلات ذات طابع إداري و تنظيمي
على رغم من سلسلة التوجيهات والتوصيات بشأن تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع الخدمات العمومية،إلا أن ثمة جملة من العوائق الإدارية والتنظيمية،رسخت إنطباعا سيئا لدى المستثمرين يمكن إجمالها فيما يلي:
- غياب هيئة مكلفة بإدارة وتنظيم الإستثمارات الأجنبية فقط.
- رجل الأعمال ينتظر أزيد من أسبوعين للحصول على تأشيرة في الجزائر[65].
- المدة اللازمة لجمركة سلعة معينة والتي قدرت ب 16 يوم ( وقد تصل 35 يوم في بعض الحالات)،هذه المدة لاتتجاوز ثلاثة أيام في المغرب وخمسة أيام في الصين وفي أقصى الحالات لاتتعدى 12 يوما.
- ينتظر حوالي شهر لتصل بضاعة من الخليج للجزائر،في الوقت الذي لايتطلب وصولها على أي ميناء أوربي حوالي الأسبوع،بالإضافة إلى أن أسعار الشحن من أي دولة عربية إلى الجزائر تفوق بحوالي ثلاث مرات أسعار الشحن نحو أي بلد في العالم [66] .
- إستنادا لدراسة لبعض المؤسسات الدولية لعام 2002،اتضح أن عملية الفصل في نزاع لدى المحاكم الجزائرية،يتطلب نحو 20 إجراء وحوالي 387 يوم،إلى جانب طول وتعقد الإجراءات القضائية [67].
5.5- مشكلة الفساد
يعتبر الفساد من المصطلحات العامة المتداولة وله تعارف متعددة لعل أهمها 68] :
1- استخدام الوظيفة العمومية لتحقيق مكاسب شخصية( تقرير التنمية في العالم لسنة 1996).
2- الفساد هو إستغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية(تعريف منظمة الشفافية الدولية 2004).
إن تأثير الفساد على الإستثمار سلبي وهذا طبقا إلى ماجاء في تقرير التنمية العالمي عن دراسة ميدانية شملت دولتي سنغافورة والمكسيك،يؤثر الفساد في هذين البلدين على الإستثمارات الأجنبية بما يعادل تأثير رفع المعدل الحدي للضريبة ب 50% على دخل الشركات [69].وعلى العكس من ذلك فإن تخفيض الفساد بنسبة 30 % يسمح بالرفع من معدل الإستثمار ب4% [70].
ويظهر تأثير الفساد على الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء باعتباره تكاليف إضافية يدفعها المستثمر وبالتالي إمتصاص جزء من أرباحه.
إن العوائق الإدارية والتنظيمية السابقة الذكر في الجزائر سوف تجعل المستثمرين يقدمون رشاوي إلى الموظفين في هذه الإدارات لتسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات العمومية.
وحسب المسح الذي قام به البنك الدولي وشمل 557 مؤسسة في الجزائر سنة 2003 ،فإن الرشاوي المقدرة المدفوعة 75 % ومتوسط نسبة الرشوة من %المبيعات تقدر 8.6

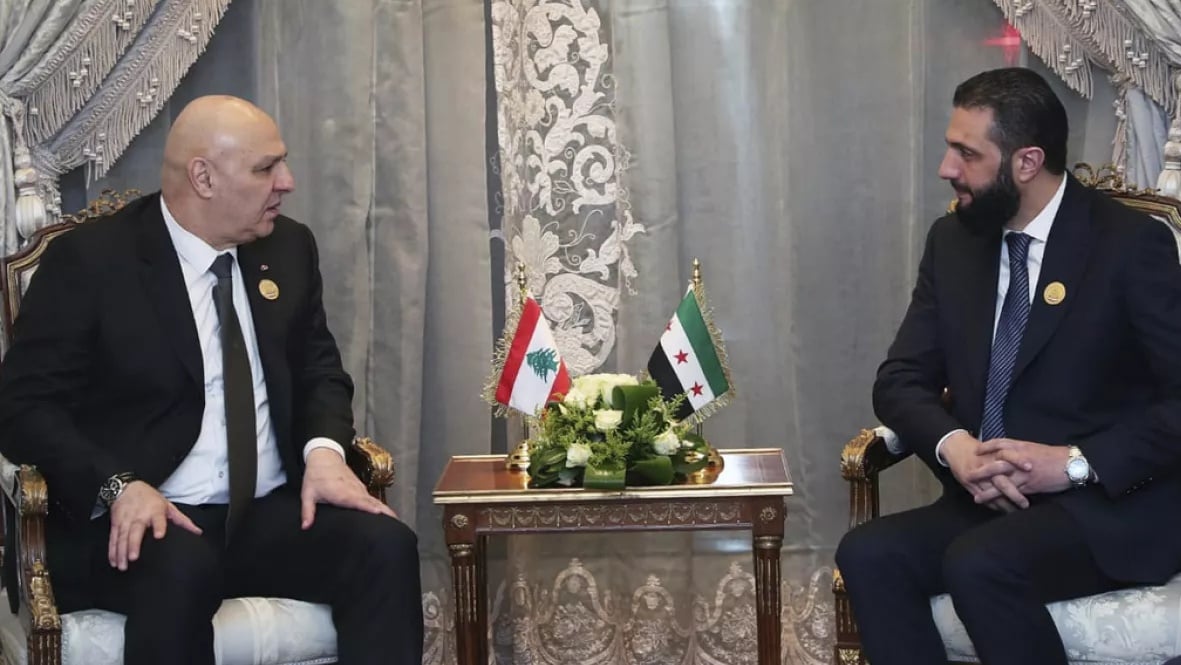




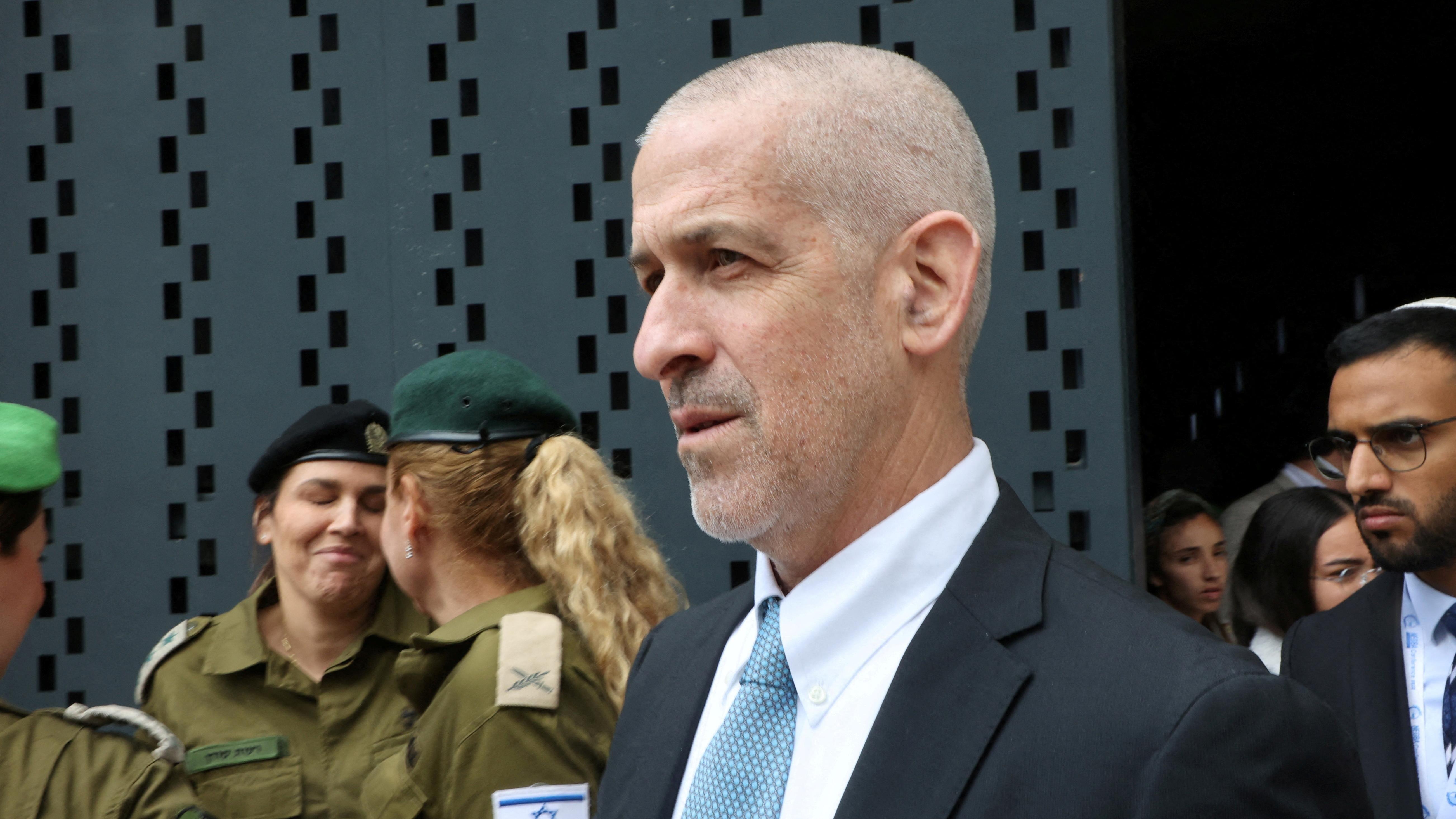











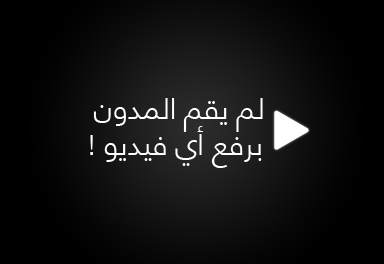

التعليقات (0)