ترجمة الشعر

ترجمة الشِّعر... هذه العلَّة التي في منتهى العافية.
عبد اللّطيف الورااري
ترجمة الشِّعر، هذه العِلَّة التي في منتهى العافية. لطالما فكّرْتُ، وأنا أقرأ الشّعر مُترجَماً أو بصدد ترجمته عن الفرنسية، في ما رآه الجاحظ، وهو يقول إنّ "الشعر لا يُستطاع أن يُترْجَم، ولا يجوزُ عليه النقل، ومتى حُوّل تقطَّع نظْمُه، وبَطُل وزْنُه، وذهبَ حسْنُه، وسقطَ موْضعُ التعجُّب، لا كالكلام المنثور". الشعر لا كالنثر. قد يجوز الأمر في النثر، الواضح والمعقول والعادي. أمّا في الشعر، الغامض والهشّ، فإنّه يصعب من وُجوهٍ كثيرة، حتّى يستحيل الأمر خيانةً، بله خسارة. لا يضيع المعنى فحسب، بل الأسلوب وإيقاع الكلمات وجرسها العابر للذّات وخطابها المفرد والخاص. هذا واقعٌ لسوء حظّ الشعر. لكن، أليس بالإمكان ترجمة الشعر؟ بلى. لا أنسى، هنا، رأياً ثانياً للشاعر الفرنسي بيير ليريس، وهو يرشدنا إلى أنّ "ترجمة الشعر أمْرٌ مستحيل، مثلما الامتناع عن ترجمته أمرٌ مستحيل". كثيرٌ من الثقافات الإنسانية الشفوية والمكتوبة، بما في ذلك الثقافة العربية ـ الإسلامية، التي يأخذ فيها الشعر وضعاً إعتباريّاً ولافتاً، وجدت في هجرة أدبها، من ضمن نتاجها الرمزي، إلى العالم ضرورةً لا ترفاً، ومجلبةً للاحترام والمجد، إذ هو يعكس وجهاً حيويّاً ومشرقاً من هويّة هذه الثقافة وتلك. وقد رأينا، عبر عهودٍ من حيويّة التاريخ، كيف كان تتفاعل الحضارات والشعوب وتتحاور، بقدرما تتناقله بينها من آدابٍ وفنون ومعارف، بل إنّ منها من تغيَّر وجهها بسبب الشعر مجسّداً في أغنية أو قماشة أو آنية قذفت بها الرياح إلى ما وراء البحر.
في زمننا، صار لترجمة الشّعر معنى الواجب. شعريّات الأرض الباذخة والعريقة انفتحت على بعضها البعض، في حوارٍ خلّاق ومتوهِّج يعلِّم الكائن كيف يُشرف على كينونة لغة إنسانيّةٍ بلا حدود، بمنأى عن الابتذال والتسطيح. ولقد انفتحت الشعرية العربية الحديثة، عن طريق الترجمة، على بعض هذه الشعريات، الفرنسية والإنجليزية ثمّ الروسية والإسبانية والألمانية والإيطالية فيما بعد، التي كان لها دور حاسم ومهمّ في سيرورة تحديث الشعر العربي، حتّى صار شعراءٌ ذائعو الصيت يشكّلون فنناً مضيئاً من شجرة هذا الشعر وذاكرته ومتخيّله، من أمثال إليوت وإديث ستويل وسان جون بيرس وروني شار وعمر الخيام ونيرودا وناظم حكمت وطاغور وويتمان وبودلير وخيمينيث وييتس وأوكتافيو باث وبورخيس وآرتو وإزرا باوند ولوركا وألن بو وريلكه وهولدرلين وإيلوار وبريتون وميشو وبيسوا وسواهم ، وصولاً إلى نماذج من الشعر الصيني وشعر الهايكو الياباني حديثي الاكتشاف. ولهذا، ليس في الإمكان أن نقرأ مسارات الحداثة الشعرية العربية بمعزل عن دور الترجمات الشعرية المتنوعة التي تمّت بمستويات متباينة. وإذا عدنا الى بدايات القصيدة الحديثة وجدنا أن الترجمات تحضر بنفس قوة الآثار المنتجة. تحضر أعمال أنشودة المطر وأباريق مهشمة وأقول لكم وأغاني مهيار الدمشقي ولن وحزن في ضوء القمر ، إلى جانب الأرض اليباب وأربعاء الرماد والرجال الجوف وأزهار الشر وعيون إلزا ومنارات وأوراق العشب وأغان غجرية وراعي القطيع. ولكم من شاعر عربي حديث، من جيلٍ إلى آخر، قد استضاف شاعراً أجنبيّاً، وارتبط اسمه به، وتحاور معه. السياب وستويل، عبدالصبور وإليوت، أدونيس وبيرس، سعدي وريتسوس، يوسف الخال وباوند، أنسي الحاج وآرتو، فؤاد رفقة وهولدرلين، المهدي أخريف وبيسوا، رفعت سلام وكفافيس، محمد بنيس ونويل، وإدريس الملياني ويفتوشينكو وقد يفرد شاعر أو ذاك جناحه على جملة شعراء عرب محدثين ومعاصرين، مثل إليوت ولوركا وبريتون وبيسوا. غير أنّ الأثر المتبادل، عن طريق الترجمة، بين الشعر العربي والشعر الأجنبي بلغاته المتباينة، لم يكن متساوياً وواقعاً بالقدر نفسه. نماذج محدودة من الشعر العربي القديم، بما فيه الأندلسي، من أحدثت أثرها في الشعر الآخر، لكن من الصعب أن نثبت إلى أيّ حدٍّ أثّر هذا الشاعر من شعراء العربية المحدثين في مجرى الشعر العالمي، وإن كنّا لا نغفل الهالة التي صارت لبعضهم تحت هذا التأثير أو ذاك، مثلما هالة محمود درويش أو أدونيس. هل يصحّ لنا أن نؤكِّد أنّنا أخذنا أكثر مما أعطينا بكثير، وتأثّرْنا أكثر مما أثّرنا؟!
في كلّ الأحوال، لقد أفدْنا من ترجمة الشعر التي تمّت على أيدي الشعراء أنفسهم، هؤلاء النادرين الذين لا يُضاهيهم أحد، والذين يأخذون على عاتقهم تحديد معنى الأدب، والذين يعلمون قبل غيرهم أنّ ثمة نواة في القصيدة يجب الانتباه لها ومعاملتها بكثير من«الاحترام والتبجيل»، أثناء ترجمتها أو نقلها إلى لغتهم الأمّ. فعلى المترجم أن يكون عارفاً بلغة الشاعر الذي يترجمه، وإيقاعها، وأسلوب تشخيصها للذات الكاتبة والعالم الحسي والعقلي. ويجوز له أن يخرج عن الأصل بمقادير، مبدعاً فيه، ومهتدياً إلى ذلك بحدسه وإصغائه شديدي الإرهاف. فمن سوى الشاعر المترجم، إذن، يُدرك أنَّه بصدد فعلٍ كتابيٍّ لا يقلُّ إبداعيّةً، ويقرّ في أصالته ومسؤوليّته أن يستضيف الشعر "الآخر" بيديه الأمينتين المرتجفتين، حتى لا يطير عنه خياله ويغيض ماؤه، فتأتي الترجمة بأقلّ خسارة، بل تبزُّ أصلها. يجب، بهذا المعنى، أن يؤمِّن الاختلاف حتؤ يبعث في لغته، بما يحمل إليها من تحوُّلاتٍ عنيفة أو رقيقة، حضوراً لما هو مختلفٌ، أصلاً، في الأصل, هذا النوع من الترجمة الإبداعية صارت له قيمته في الفترة ما بعد الاستعمارية، بعد عهود من سوء الفهم العظيم التي أشاعها الاستشراق.
بالنسبة لي، لا أعتبر نفسي مترجماً، أنا قارئ للشعر "الآخر"ـ الفرنسي تحديداًـ، وفي نيّتي أن أتعلَّم من متخيّلات شعرية غريبة عنّي بما توافر لها من أسباب العجب والفرادة والاختلاف، لكن سرعان ما وجدتُ نفسي أرتكب مثل تلك الخيانة الممتحنة لمدى خيالي. في ترجماتي المقترحة لنصوصٍ من الشعر الفرنسي المعاصر، لاسيما نصوص هنري ميشونيك وأندري فلتير وبرنار مازو وماري كلير بانكار، تبيّن لي أن لكلّ شاعر "عقدة إيقاعيّة"، وليس بمقدوري أن أعكسها إلّا على نحو تعويضيّ، إن ملأتها بذبذباتٍ من وجيبي الداخلي الذي يتجاوب مع تجاربهم المنادية عليّ، وأدخلتُها في علائق صوتيّة ودلاليّة جديدة تمنحها تأويلاً جديداً، وقيمةً مُضافة جديدة داخل لغتي التي أُبدع بها، وأحيا فيها . لكنّي، في كلّ يومٍ أكتشف ما معنى أن تصير الترجمة «محكّاً»، فلمّا نحن نترجم "فكأنّنا نلقى بين اللغتين تفاهماً هو من العمق والانسجام، بحيث تحلّان محلَّ المعنى وتتمكَّنان من جعل الفجوة بينهما منبعاً لمعنى جديد"، بتعبير موريس بلانشو.







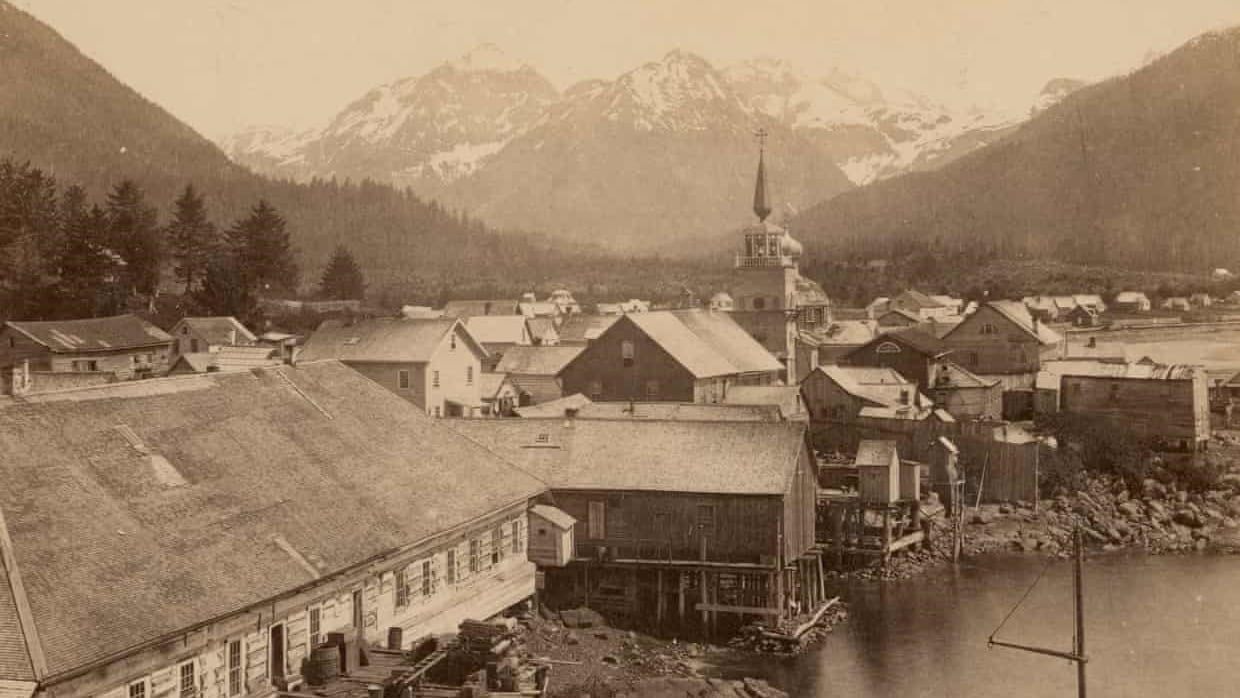


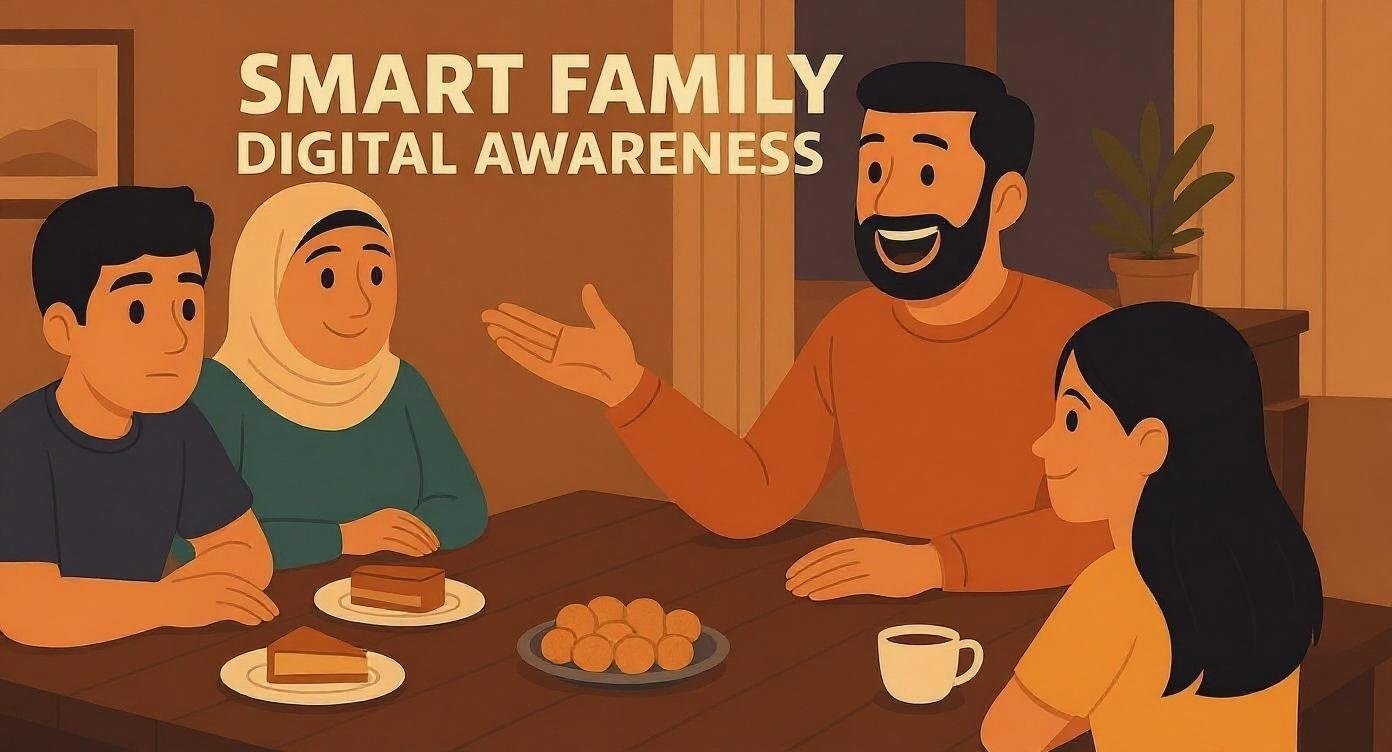







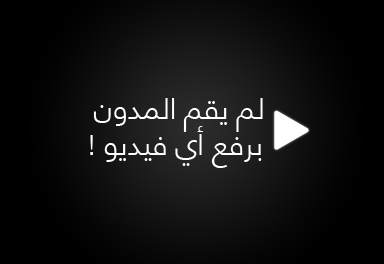

التعليقات (0)