بين العولمة والأصولية ـ 3 ـ

إن الشعوب المستلبة ترد على هذا العنف البنيوي غير المرئي بعنف جسدي قاتل ومرير . وترفضه رفضا قاطعا باسم القيم الدينية التقليدية التي لا تتورع عن استخدام أدوات الأصولية شرائط التسجيل التكنولوجية من أجل بث دعايتها ( انظر كيف تستخدم الحركات الأصولية شرائط التسجيل ومكبرات الصوت ومختلف وسائل الإعلام ) . إن الجهاد الإسلامي من جهة ، وظاهرة العولمة الغربية من جهة أخرى ، يجيشان في طياتهما الكثير من المشاعر اللاعقلانية الهائجة والخلط الفكري والمعنوي . وهذه أشياء تتطلب دراسة دقيقة ، لأنها لم تحلل بعد بالشكل الكافي . صحيح أن موازين القوى ليست متكافئة ، وإنما مختلة تماما لصالح القوى الغربية ، ولكنهما يؤديان إلى النتيجة نفسها تقريبا . لا ريب في أن أهداف العولمة الغربية هي غير أهداف الجهاد الإسلامي أو الحركات الأصولية الحالية ، ولكنهما يؤديان إلى إفساد ، بل وإفشال ، المشروع الديمقراطي الهادف إلى تحرير الشرط البشري . ولكي يدافع عن الديمقراطية ، فإن الباحث الأمريكي المذكور يضخم من حجم التضاد بين الجهاد / والعولمة . فالأول يريد بعث القوى الغامضة والمظلمة للعالم القديم ، عالم ما قبل الحداثة . ويقصد بالقوى الغامضة هنا : الأسرار الدينية ، والطوائف المتراتبة هرميا ، والتقاليد الخانقة للروح ، والعطالة التاريخية ، وأما الثانية ( أي العولمة ) ، فتذهب إلى ما بعد الحداثة وتتطرف إلى حد تغليب مصلحة السوق والبيع والشراء على حقوق الروح والفكر والفلسفة . ألا تحاول قوى التكنوقراط إلغاء تدريس الفلسفة باعتبار أنها غير ذات جدوى ؟!
وهكذا يصور الباحث السياسي الأمريكي كلا القطبين بطريقة سلبية . ولكنه إذ يفعل ذلك يبقى سجين عقل التنوير ، هذا في حين أن العولمة تجبرنا على إعادة النظر في جميع الأنظمة المعرفية الموروثة عن كل أنماط العقل بواسطة تطبيق قواعد الابستمولوجيا التاريخية النقدية عليها . بمعنى أن العولمة ( أو ما بعد الحداثة ) تجبرنا على إعادة النظر في عقل التنوير ذاته .
إن الأطروحة التي يقوم عليها كتاب الباحث الأمريكي المذكور والتي تقيم التضاد بين الجهاد الإسلامي / والعولمة الغربية تبدو جذابة بواسطة انحيازها الواضح للديمقراطية الإنسانية والكونية (أو القابلة للتعميم الكوني ) . ولكن لا يمكن الاعتماد عليها من أجل تأسيس مشروع لكتابه تاريخ نقدي للفكر – أو لمختلف تيارات الفكر – التي ظهرت في حوض البحر الأبيض المتوسط . وينبغي على هذا التاريخ أن يشمل رهانات المعنى وإرادات الهيمنة التي تجلت في هذه المنطقة منذ انبثاق الظاهرة الإسلامية في الجزيرة العربية بين عامي 610 و 632 م . نقصد بإرادات الهيمنة ورهانات المعنى أن كل فكر يحمل في طياته براءة المعنى وطهر المعرفة من جهة ، ثم الرغبة في السيطرة والهيمنة على الآخرين من جهة أخرى . لماذا ننطلق من الظاهرة الإسلامية ومن تلك الفترة بالذات ؟ ليس من أجل دحض قطب الجهاد .
ينبغي أن ننظر إلى الأمور من جهة نظر تاريخية ، لا مثالية تبجيلية . وينبغي أن نربط بين تحولات المعنى وبين تحولات القوى السياسية والاقتصادية والتقنية والتكنولوجية . فهناك دائما علاقة جدلية بين المعنى / والقوة ، بين المثال / والواقع ، بين المبدأ / والتطبيق . ينبغي أن نعيد النظر في الأطروحة التي دافع عنها المؤرخ البلجيكي هنري بيرين في الثلاثينات من هذا القرن ونلاحظ أن هذه الأطروحة قد عادت إلى الساحة من جديد مع ظهور الصدام الحالي بين الإسلام الراديكالي / والغرب . من المعلوم أن هذا المؤرخ كان قد تحدث عن حصول كسر دائم في حوض البحر الأبيض المتوسط بدءا من ظهور الإسلام الأولي في هذا الحوض . لقد حصل تشقق أو صدع حقيقي بسبب هذا الظهور وذاك التوسع . وعندما نقول " صدع " فإننا نقصد العنف ، وبالتالي إرادة في القوة والهيمنة . فالعنف مرتبط بالقوة . وإرادة القوة يدعمها أو يبررها الجهاد ( كحرب مقدسة ) في الأوساط الدينية ، كما وتبررها الحرب العادلة أو الشرعية في الأوساط العلمانية ( انظر بوش ) . ولكن من يتحدث عن الجهاد بالمعنى الديني يتحدث أيضا عن اللاهوت ورهانات المعنى . هكذا تتمفصل إرادة القوة مع رهانات المعنى في كلمة الجهاد . وبالتالي فالجهاد يحتوي على كلا الجانبين : المعنى والقوة .
لا ريب في أن الإسلام والمسيحية معنيان أكثر من غيرهما من الأديان التي لا تزال حية بمسألة الحرب المقدسة أو الجهاد . لماذا ؟ لأنهما انتشرا في شتى أنحاء العالم أكثر من غيرهما ( أكثر من اليهودية مثلا بكثير ) . ولكن من وجهة نظر الأنتبولوجيا الاجتماعية والثقافية ، فإنه لا يمكننا أن نحصر مفهوم الحرب المقدسة في الدائرة الدينية وحدها . فهي موجودة أيضا في الدائرة العلمانية . ولكنهم يتوهمون أنهم يتحاشون التلوينات الدينية إذ يغيرون المصطلح فيتحدثون عن الحرب العادلة أو الشرعية بدلا من الحرب المقدسة أو الجهاد . ولكن المصطلح الأول ليس أجنبيا على التلوينات اللاهوتية . ولهذا السبب فإننا نفضل استخدام المنظور الشمولي للأنتربولوجيا التاريخية من أجل تجاوز كلا الجانبين الديني والعلماني أو من أجل الإحاطة بهما معا . ويمكننا عندئذ أن نستخدم ثلاثة مصطلحات لا تنقصم هي : العنف ، التقديس ، الحقيقة . فهي موجودة بشكل ضمني أو صريح ، كامن أو ملتهب ، في كل فكر متماسك وكل ممارسة للبشر في المجتمع . فلا يخلو أي مجتمع بشري من هذه الأشياء الثلاثة التي تقيم علاقات جدلية وثيقة فيما بينها .
ينبغي أن نقول هنا ما يلي : إن كل خطاب بشري ينطوي في داخله على إرادة القوة لأنه يهدف إلى إقناع الآخرين به ، أي بمعناه . ولا ينجو من ذلك خطابي هذا الذي أكتبه هنا ، على الرغم من أنني أحاول احترام الحقيقة والتوصل إلى الموضوعية . ولكني بمجرد أن أدخل عالم الفكر والكتابة فإني أنافس الآخرين بالضرورة . إني أتعدى على منطقة المعنى التي يحتلونها قبلي ، وبالتالي فسوف ينزعجون . وكلما كان فكري قويا وقادرا على احتلال مساحة واسعة من منطقة المعنى كلما كان رد فعلهم عنيفا لأنهم يخافون على مواقعهم وامتيازاتهم . لهذا السبب تحصل حرب الخطابات أو حرب التيارات الفكرية بين بعضها البعض . وقد تؤدي هذه الحرب الكلامية إلى العنف الجسدي كما حصل معي تماما فأنا لم أغادر بلدي رغبة مني بتاتا على العكس فقد تم إهدار دمي من خلال الفتوى الشهيرة التي أصدرتها وتبنتها الجماعات الإسلامية بشكل فاضح وصريح مجافيا ومخالفا لكل القيم الإنسانية وكان ذلك ردا على قراءتهم المغرضة لما جاء من أفكار تحتل معنا واسعا من فضاءهم المعرفي في كتابي العولمة وخطاب ما بعد الحداثة . فالكلمة قد تقتل كالرصاصة . إذ حصل وأن وصلت في انتقاداتي إلى الدائرة الأسطورية أو الرمزية المقدسة لحكايات التأسيس ( أي تأسيس الدين ) ، فشنت الحرب " المقدسة " أو " العادلة " أو " الشرعية " ضدي فورا . حذار من الاقتراب من هذه المنطقة الحساسة جدا جدا . فقد يدفع المرء الثمن غاليا وها أنا أدفع الثمن غاليا في كل لحظة أعيشها في أقصى العالم .
إن التحليل التفكيكي للمصطلحات الشائعة يظهر لنا شيئا آخر غير معروف كثيرا من قبل المثقفين . إنه شيء يخص الحقيقة في تلك العلاقة الثلاثية المترابطة : العنف ، التقديس ، الحقيقة . ما هي الحقيقة ؟ بالنسبة للرأي الشائع ، الحقيقة هي الشعور بالتطابق التام بين القول / والفعل ، أو بين العبارة المقولة / والشيء الخارجي المحسوس الذي تشير إليه ، أو بشكل عام بين اللغة العادية / والتجربة أو المعرفة العملية التي يشكلها كل شخص عن الواقع . ونلاحظ أن الأديان والأنظمة الميتافيزيقية المثالية التي تعاقبت على تاريخ البشرية كانت تصور هذه الحقيقة وكأنها أزلية ، فريدة من نوعها ، مقدسة ، متعالية ، نهائية ، إلهية . هكذا صوروا لنا الحقيقة وهكذا طبعوها في أذهاننا ورسخوها بصفتها مطلقة . ولكن المفكر النقدي يرى الحقيقة بشكل مختلف . إن الحقيقة بالنسبة له هي مجموع آثار المعنى التي يسمح بها لكل ذات فردية أو جماعية نظام الدلالات الإيجابية المستخدمة في لغته . إنها مجمل التصورات المختزنة من قبل التراث الحي للجماعة القبلية ، أو للطائفة الدينية ، أو للأمة . فكل أمة أو طائفة تعتبر تراثها بمثابة الحقيقة المطلقة . إن الحقيقة ليست جوهرا أو شيئا معطى بشكل جاهز ونهائي ، وإنما هي تركيب أو أثر ناتج عن تركيب لفظي أو معنوي قد ينهار لاحقا لكي يحل محله تركيب جديد ، أي حقيقة جديدة . فالحقائق تنهار وتموت بحسب التصور الابستمولوجي الحديث ، وليست أبدية أو خالدة كما كان يتصور اللاهوت القديم أو الميتافيزيقا المثالية . هكذا نجد أننا مدعوون لتغيير تصورنا التقليدي عن مفهوم الحقيقة ، وهذا ليس بالأمر اليسير لأن هذا التصور التقليدي مرسخ في أذهاننا منذ الطفولة .
إن هذين التحديدين ، التقليدي والحديث لمفهوم الحقيقة ، يقيمان حدا عقليا فاصلا بين موقفين للعقل : موقف ميتافيزيقي كلاسيكي ، وموقف ابستمولوجي حديث . أما الأول فطالما وصف من قبل مؤرخي الفلسفة . وهو لا يزال يقاوم صعود الموقف الابستمولوجي الجديد الذي تفرضه الآن العلوم البيولوجية والمعلوماتية والاجتماعية . كل العلم الحديث ينحو الآن باتجاه تشكيل مفهوم جديد للعقل والحقيقة . بعضهم أصبح يدعوه بعقل ما بعد الحداثة ، أي الذي يتجاوز عقل الحداثة لأنه أكبر منه وأكثر اتساعا ورحابة . ولكني أحب تسميته بالعقل الذي هو في طور الانبثاق والتشكل . كان ميشيل فوكو وغيره قد أثبتوا أن الكثير من جوانب عقل التنوير قد أصبحت قديمة وبالية ، ولذلك نقدوها تحت اسم " الموضوعاتية التاريخية – المتعالية " بمعنى أن عقل التنوير على الرغم من التحرير الكبير الذي أنجزه بالقياس إلى العقل اللاهوتي المسيحي إلا أنه ظل بشكل ما أسير النظرة المتعالية التي انتقدها . إنه لم يستطع التحرر منها كليا ، ولهذا السبب دعيت إشكاليته بالتاريخية والمتعالية في آن معا .نحن نعلم أن اليهود والمسيحيين والمسلمين قد عاشوا طيلة العصور الوسطى داخل فضاء عقلي يدعى الآن بالفضاء العقلي القروسطي الذي أخذت الحداثة تتجاوزه أو تقطع معه بدءا من القرن السابع عشر أو حتى السادس عشر ( في أوروبا على الأقل ) . فقد استمدوا من ميتافيزيقيا أرسطو وفيزيقاه ومنطقه وبلاغته عددا كبيرا من الأدوات المفهومية والتحديات القسرية أو الإيجابية من أجل أن يبلوروا اللاهوت اليهودي ، فاللاهوت المسيحي ، فاللاهوت الإسلامي. وعلى الشاكلة نفسها نلاحظ أن بعضهم اليوم يقوم بترقيع معرفي إذا جاز التعبير ، أي لملمة من هنا وهناك . فهم يستمدون موضوعاتهم وإشكالياتهم ومنهجياتهم ومرجعياتهم لا على التعيين . إنهم يستمدونها من أنظمة الفكر الخاضعة للعقل اللاهوتي ، أو لعقل التنوير ، أو للعقل الذي في طور التشكل والانبثاق الآن ( عقل ما بعد التنوير أو ما بعد الحداثة ) . هذه الطريقة التلفيقية أو الترقيعية في الكتابة والفكر تثير الدهشة والاستغراب حقا . فمثلا نلاحظ أن بعضهم يحاولون أن يجدوا في النصوص الدينية التاسيسية ( كالتوراة ، والإنجيل ، والقرآن ) ، أو في تفاسيرها الأكثر رسمية وترسيخا للأفكار أو التعاليم التي تستبق على حقوق الإنسان ، والعدالة الاجتماعية ، والديمقراطية ، والكرامة الإنسانية … الخ . وهكذا يقول اليهودي بأن كل هذه الأفكار التي أنتجتها الحداثة كانت موجودة في كتابه منذ زمن طويل ، وبالتالي فلا شيء جديد تحت الشمس . لا يمكن أن يطرأ أي شيء جديد بعد التوراة . كذلك يفعل المسيحي والمسلم . ولكن هذا إلغاء للتاريخية : تاريخية العقل وتاريخية الفكر . فالتاريخ يعلمنا أن النظام الفكري للحداثة غير النظام للعصور الوسطى . ولكن المؤمن التقليدي المنغمس كليا في يقينياته لا يستطيع أن يرى ذلك . إنه يلغي التاريخ : أي يلغي إمكانية حصول أشياء جديدة في التاريخ …














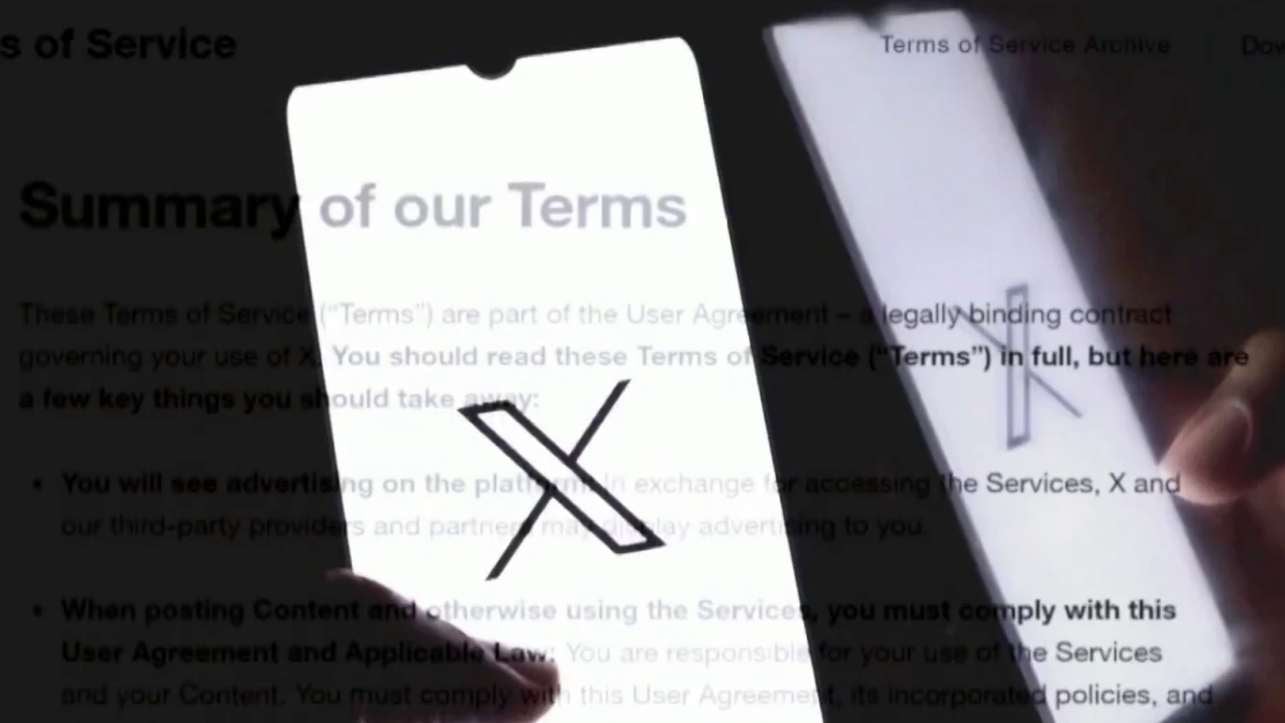





التعليقات (0)