بين العولمة والأصولية ـ 4 ـ

هذا يعني بالطبع أن بذور العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لم تكن موجودة في النصوص التأسيسية للأديان التوحيدية الثلاثة ، ولكنها كانت متصورة من خلال العلاقة الأساسية مع حقوق الله . لم يكن الإنسان قد استقل بعد أو حظي باستقلاليته الذاتية . هذا شيء لم يحصل إلا بعد عصر التنوير في أوروبا . عندئذ وثق الإنسان بنفسه إلى درجة أنه أصبح مقتنعا بأن عقله وحده يستطيع تسيير الأمور . وقل الأمر نفسه عن الديمقراطية . ولكن هناك فرقا كبيرا بين الديمقراطية بالمعنى الحديث للكلمة وبين الشورى . فالشورى محصورة بالفئة العليا من كبار المسلمين ، في حين أن الديمقراطية تشمل جميع البشر في المجتمع دون استثناء وبغض النظر عن اديانهم ومذاهبهم وأعراقهم وقبائلهم وعشائرهم .
وقل الأمر ذاته عن حقوق الإنسان . فقد كان يستحيل التفكير فيها ضمن الإطار العقلي للعصور الوسطى ، إلا من خلال علاقتها – أو خضوعها – لحقوق الله . وبالتالي فلا ينبغي إسقاط المفاهيم الحديثة على العصور القديمة كما يفعل التقليديون والأيديولوجيون . ينبغي التمييز بين العصور وبين إمكانيات العصور . فما كان مستحيلا التفكير فيه في العصور الوسطى أصبح ممكنا التفكير فيه في عصور الحداثة ، وما كان مستحيلا التفكير في عصور الحداثة قد يصبح ممكنا التفكير فيه في عصر ما بعد الحداثة على حد تعبير كرامشي …
ولكن ما علاقة كل ذلك بالإسلام المعاصر ؟ وأين هي همومه من هموم الحداثة وما بعد الحداثة والمناقشات الصاخبة الدائرة عنها في أكثر البيئات الأوروبية والأمريكية طليعة ؟ ولماذا كل هذا الاستطراد الطويل العريض ؟
الإسلام المعاصر وهمومه وقضاياه واقع تحت تأثير إعصار العولمة الكاسح مثله مثل غيره . صحيح أنه يتشدد ويتجهم حاليا على الحركات الأصولية وذلك من خلال طقوسه الشعائرية التي تجذب عددا كبيرا جدا من المؤمنين ؛ صحيح أنه قادر على تعبئة جيش كبير من المناضلين والأنصار المستعدين لكل التضحيات ؛ صحيح أنه يلفت انتباه كل الاستراتيجيين السياسيين على المستوى الدولي .. وهؤلاء محاطون بالمستشارين والخبراء من كل الأصناف والأنواع ، فمنهم اللبيب الحاذق ، ومنهم الدجال الذي يريد أن يجد له موقعا في السلطة . ولكن ينبغي القول أيضا بأن الاختبار التاريخي أو المحنة التاريخية التي يخوضها الإسلام كدين منذ عام 1970 قد خلقت حالة لا مرجوع عنها . وهذه الحالة الجديدة تؤثر في كل الأديان غير الإسلام . وفيما وراء الأديان تؤثر في شروط إنتاج المعنى وكيفية انتشاره واستهلاكه من قبل المجتمعات البشرية كافة . ولهذا السبب كرست مدخلا واسعا ومستفيضا لمسألة تحولات المعنى ، وبالتالي لتحولات الحقيقية الجارية تحت ضغط الظاهرة الكونية للعولمة.
ولكي أوضح الحالة التاريخية الراهنة لما أدعوه بالإسلام المعاصر ، ينبغي أن أولي بعض الأهمية للتسلسل الزمني للمراحل التاريخية التي مر بها . هناك بالطبع كتب عديدة جدا تتكلم عن الحداثة الإسلامية ، أو عن الإسلام الحديث ، أو عن الإسلام في مواجهة الحداثة . وكلها تعود في الزمن إلى الوراء حتى القرن التاسع عشر ( بداية عصر النهضة ) . في الواقع إن العناوين ينبغي ألا تخدعنا ، وذلك لأن مؤلفي هذه الكتب يهتمون أساسا بتقديم لمحة تاريخية عن المثقفين والباحثين العرب أو المسلمين الذين عاشوا في عصر النهضة . فقد حاول مثقفو النهضة أن يطبقوا على تاريخ المجتمعات الإسلامية قطعا متبعثرة ومقطوعة عن سياقها من المنهجيات الأوروبية التي ظهرت أثناء الحداثة الكلاسيكية لأوروبا ( أي في القرنين الثامن عشر والتسع عشر ) . فبعد أن جاءت البعثات من مصر و لبنان وغيرهما إلى أوروبا ، انبهر المثقفون العرب والمسلمون بهذه الحداثة ، فنقلوا منها إلى لغاتهم وبلادهم ما استطاعوا نقله أو فهمه واستيعابه . ولكنهم قطعوا فكر الحداثة الأوروبية عن سياقه الطبيعي إذ زرعوه في سياق آخر : هو السياق العربي – الإسلامي . وقد حظي هذا النقل بالقليل أو الكثير من النجاح طبقا لذكاء المؤلفين .لقد نقلوا أساسا المنهجية التاريخية كما كانت سائدة في القرن التاسع عشر في جامعات السوربون وبرلين واكسفورد … الخ . وهي المنهجية الفيولوجية – التاريخية المفيدة في تحقيق النصوص والمخطوطات القديمة ، ولكن الزمن تجاوزها الآن . وراح المستشرقون يصفقون لنجاحات تلامذتهم الكبار بعد أن عادوا إلى أوطانهم للتدريس في جامعاتهم ونقل العلم الأوروبي إليها . ولكن هذه النجاحات كانت نسبية جدا في الواقع . أقصد بالتلامذة هنا شخصيات من أمثال طه حسين ، وزكي مبارك ، وبشر فارس . فقد قلدوا منهجيات أساتذتهم المستشرقين وحاولوا ترجمتها وتطبيقها على الأدب العربي والتراث الإسلامي . ولكن الإسلام وتراثه لم يتأثرا أو لم يمسا كثيرا بهذه المحاولات الخجولة . أقصد أن تطبيق هذه المنهجيات المنقولة من أوروبا لم يصب التراث في العمق ولم يؤد إلى تأثير حاسم على كيفية فهم التراث الديني الإسلامي . ولو أنه فعل ذلك لما انفجرت الحركات الأصولية الحالية بمثل هذه القوة والعنف . ولو أن التراث التراث العربي - الإسلامي تعرض لمسح تاريخي شامل ولإضاءة نقدية – تاريخية شاملة لما حصل ما حصل لاحقا . هذه بديهة ينبغي أن يتأمل فيها المثقفون العرب المعاصرون ( وكذلك الأمر في ما يخص المثقفين الإيرانيين والأتراك وغيرهم من المسلمين ) . لو نجح التنوير الإسلامي ، لما ظهرت الأصولية وملأت الشارع والبيت والمدرسة والجامعات وكل شيء … لو أن الحداثة الفكرية – حتى في صيغتها البيولوجية والتاريخية للقرن التاسع عشر – استطاعت أن تفكك أطر الفكر التقليدي لما شهدنا انتشار هذه الممارسات المتطرفة والخطابات العتيقة في نهاية هذا القرن العشرين ! والدليل على ذلك أن المسيحية الأوروبية عاجزة عن توليد حركات أصولية بمثل هذا الحجم والضخامة . لماذا ؟ لأن عقل التنوير مر من هنا ، ولأن منهجية النقد التاريخي أصابت المسيحية في العمق وعزلتها ونفضت عنها ركام القرون . وهذا ما لم يستطع النهوضويون العرب أو المسلمون أن يفعلوه بالنسبة للتراث الإسلامي حتى الآن . أقول ذلك على الرغم من احترامي لجهودهم وجهد شخصية كبرى مثل طه حسين . وبالتالي فالتنوير لا يزال أمامنا وليس خلفنا . ينبغي أن أضيف هنا أنه بعد ظهور حركة الأخوان المسلمين في الثلاثينات من هذا القرن ، فإن المثقفين الحداثيين خافوا وتراجعوا . وراحوا يقدمون التنازلات للتيار التبجيلي التقليدي الذي أخذ يكتسح الشارع . هذا ما تجلى في كتابات العقاد بل وحتى في كتابات طه حسين .
هذا ما حصل في عصر النهضة الممتد من القرن التاسع عشر وحتى منتصف هذا القرن تقريبا. هذا ما حصل بعد عام 1945 ، أي بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة ؟ حصل أن حركات التحرر الوطني السياسية استطاعت أن تجير لصالحها القوة التعبوية أو التجييشية الهائلة للإسلام ، في الوقت الذي حافظت على قشرة سطحية من التوجه العلماني والتحديثي والاشتراكي . لماذا حافظت على هذه القشرة ؟ لأنه كان يوجد في صفوفها مناضلون شيوعيون أو ليبراليون متأثرون بالفلسفة السياسية للجمهورية الثالثة في فرنسا ( نذكر من بينهم بورقيبة مثلا وفرحات عباس وتلامذتهما …) . ثم استخدمت حركات التحرر الوطني قوة الإسلام التعبوية من أجل التخلص من الاستعمار عسكريا وسياسيا . ولكن الأولوية التي أعطيت للتحرر الوطني والسياسي من الاستعمار ، وكذلك استراتيجيات القوى العظمى الطامعة في ضم هذه الأمم الناشئة إلى معسكرها ، قد نجحت في تحجيم دور النضالية الإسلامية أو التيار الإسلامي ، وقلصته إلى مجرد دور ثانوي أو مساعد . ولكن الأمور لن تدوم على هذا النحو إلى الأبد فبعد هزيمة الجيوش العربية عام 1967 ، وبعد فشل عبد الناصر وموته عام 1970 ، وبعد ظهور أول العلامات على انحسار الهيمنة السوفييتية ، وبعد الازدياد الهائل في عدد السكان ، وبعد انكشاف محدودية سلاح البترول ، وبعد تراجع الفرحة بالاستقلال وتقلص مشروعية الأنظمة " الوطنية " إلى أقصى حد ، بعد كل ذلك أصبحت الساحة فارغة ومهيأة تماما لكي تدخل الحركات الأصولية إلى حلبة المسرح . هذا هو سبب نجاح الحركات الأصولية . فهذه العوامل السلبية كلها أدت إلى تقلص الأطر الاجتماعية للمعرفة في كل البلدان العربية والإسلامية . بمعنى أن المجتمع نتيجة أزماته وفقرة للفكر الأصولي التقليدي الموروث أبا عن جد . هذا هو السبب الذي أدى إلى نجاح الأصوليين ، وليس عبقريتهم أو إكتشافاتهم العلمية الخارقة في مجال الفكر الإسلامي !
وقد أخذت هذه الأصولية تحقق الانتصارات الصارخة عن طريق الاستيلاء على السلطة في إيران وتواصل زحفها في مناطق أخرى من العالم العربي والإسلامي حاظية بالقليل أو بالكثير من النجاح حسب الظروف والبلدان . إنها تواصل نضالها الهزيل والعالمي والشرعي والبطولي والمرعب والتراجيدي في آن معا ! إنها تواصله ضد عدو أكبر منها بما لا يقاس ، عدو واثق من انتصاره عليها في نهاية المطاف . ولكن الثمن البشري الباهظ لهذا النتصار أخذ ( لحسن الحظ ) يدفع كبار المسؤولين في الغرب إلى إدراك خطورة مواصلة التصعيد أو الرد بالتصعيد على التصعيد على طول الخط . لقد هالهم عدد الضحايا المتساقطة والدمار الكبير الحاصل ، فهل يفكرون بانتهاج سياسة أخرى تجاه الأصولية ؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة .
ينبغي أن نعلم أن الإسلام المعاصر قد تزامن صعوده مع نهاية الأيديولوجيات التبشيرية العلمانية في الغرب ( كالأيديولوجيا الماركسية أو الشيوعية مثلا ) . كما وتزامن مع ما يدعوه العالم البلجيكي الشهير إيليا بريغوجين : نهاية اليقينيات حتى في مجال العلم البحت . فالحضارة تعيش أزمة قيم على المستوى العالمي . والحداثة الغربية لم تعد واثقة من نفسها كما عليه الأمر في الماضي . في مثل هذا الجو انطلقت الحركات الأصولية وازدهرت . إننا نشهد الآن تزعزع مشروعية الدولة القومية الحديثة التي تشكلت في أوروبا في القرن التاسع عشر . كما ونشهد في الوقت ذاته استيقاظ الشعوب والأقليات العرقية – الثقافية والجماعات الإقليمية التي همشت زمنا طويلا . كما وقمعت من قبل الدولة المركزية سواء أكانت دينية أم علمانية . إن الإسلام المعاصر يعرف أن قيمة الأخلاقية والفقهية – القانونية التي كان يرتكز عليها النظام السياسي والاجتماعي للدولة الإسلامية ( و لا أقول الكلاسيكية) أقول إن هذه القيم قد أصبحت مهاجمة ومرفوضة في كل كان وذلك لأنها تبدو عتيقة وغير ملائمة لهذا العصر . ولذا فإن المسلمين أخذوا يتخلون عنها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ، وذلك بسبب ضغط العالم الحديث من حولهم . ولكن ، وعلى الرغم من كل هذه التكذيبات التي يكبدها التاريخ لمبادئة وأصوله وبرنامج عمله ، فإنه ( أي الإسلام الأصولي ) يظل قادرا على تجييش أنصار عديدين جدا . وهم في الغالب شباب حديثو السن ، مفعمون بالحماسة ، ومؤمنون بشكل لا مشروط بصلاحية خياراته، وتفوقه على النظام الغربي ، وأبدية رؤياه للعالم . هنا يكمن أحد الأسباب المحيرة لنجاح الحركات الأصولية .
في الواقع ، إن الأديان الثلاث ، ومن بينها الإسلام ، كانت قد شكلت دائما فعالية تفسيرية ولاهوتية وفقهية لكي تشكل المرافق الفكري للعقائد والطقوس الدينية ( أنظر حجم التفاسير القرآنية وكتب علم الكلام والفقه ! …) ولكننا نلاحظ الآن حصول تغير في ما يخص الإسلام الكلاسيكي ، إسلام الإنتاج والإبداع والإزدهار . فالانخراط السياسي هو الأهم بالنسبة للإسلام المعاصر ، إنه يتغلب على كل اعتبار ، إنه يتغلب على ضرورة إبداع مرافق فكري للممارسة الدينية او الشعائرية ، كما ويتغلب على أولوية البعد الروحي المؤدي إلى التواصل مع مطلق الله . لا . إن الحركات الأصولية الحالية لم تعد تفكر إلا بالقوة والسلطة ، أو التوصل إلى السلطة بأي شكل وهنا تحصل القطيعة بينها وبين الإسلام الكلاسيكي .
ولهذا السبب فإننا نفضل التحدث عن ا؟لإسلام الأقنومي ، بمعنى أن المسلمين قد حولو بأي شيء !… وحولته وسائل الإعلام الغربية إلى " بعبع " مخيف لم يتغير بمقدار شعرة واحدة منذ محمد وحتى اليوم خاصة بعد ضرب البرجين ومل يحصل في العراق في هذا الحين … هذا التصور التجريدي المضخم عن الإسلام يختلف عن التصور التاريخي الواقعي. ينبغي أن نعلم أن الإسلام ، كأي عقيدة دينية أو غير دينية ، هو نتاج القوى المحسوسة التي تشكله عقائديا وأيديولوجيا . وهذه القوى تدعى اليوم بالقوى الشعبوية ( وليس الشعبية ) . لماذا قلنا الشعبوية ؛ لأنها تجيش الشعب عن طرائق الغرائز والعواطف والعصبيات ، فلا يعود يفكر بعقله تقريبا . نقول ذلك وبخاصة أن التزايد السكاني الهائل قد زاد من ضخامة الظاهرة الشعبوية التي جيشها الأصوليون . فالدولة أو المجتمع عاجزان عن تلبية حاجات هذا السيل المتدفق من الأجيال الشابة ، فيصبحون بالتالي فريسة سهلة للدعاية الأصولية . عن الظاهرة الشعبوية ناتجة عن التزايد السكاني ـ، واقتلاع الفلاحين والبدو من جذورهم وهجرتهم إلى ضواحي المدن الكبرى لكي يشكلوا أحزمة البؤس ومدن الصفيح حولها . كما أنها ناتجة عن تفكك أو انحلال الأوساط الحضرية التجارية والمثقفة ( بمعنى الثقافة العالمية والمكتوبة ) ، وليس الثقافة الشفهية …
كيف يمكن في مثل هذه الحالة ألا تقوى الحركات الشعبوية والأيديولوجيا الأصولية المتطرفة التي تناسبها ؟ إن هذه الحالة مناسبة لتشكيل مخيال التمرد والانتفاضة ، أي لتشكيل جو مناسب للإنفجار . وقد فضلت أن أستخدم مصطلح التمرد لا مصطلح الثورة لأني أود أن أحصر هذه الأخيرة بالحركات الشعبية الحقيقية والمدعومة من قبل أيديولوجيا تقدمية ، مستقبلية ، تحمل في طياتها تحرير البشر ونقلهم إلى حالة إيجابية أفضل . إن هذه الأيديولوجيا المستقبلية هي التي تخلع المشروعية على الثورات الكبرى التي حصلت في التاريخ البعيد والقريب . أقول ذلك وأنا أستخدم كلمة أيديولوجيا بالمعنى الإيجابي للكلمة وليس بالمعنى السلبي الشائع . وهذا ما ينطبق على الخطاب القرآني الذي حول العمل التنظيمي والسياسي المحسوس لمحمد إلى نموذج أعلى يتجاوز التاريخ أو يخترق التاريخ . وكل ذلك عن طريق البلاغة المجازية التي يتميّز بها هذا الخطاب في اللغة العربية .














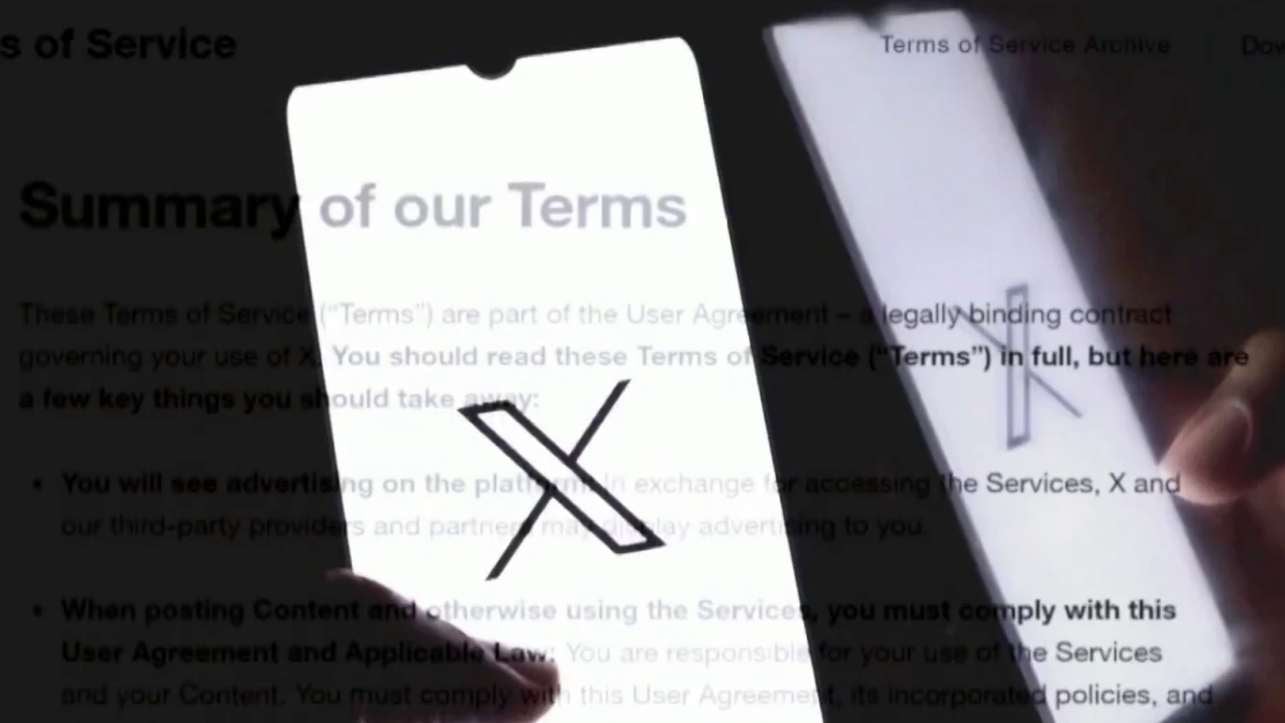





التعليقات (0)