انتماءات المواطن العربي وتناقضاتها

انتماءات المواطن العربي وتناقضاتها
ينتمي المرء إلى أفكار وروابط وعلاقات ومصالح وتواريخ وأوطان متنوعة، تختلط في عقله ووعيه وتحتل فيهما مواقع على هذا القدر أو ذاك من الأهمية. وعلى سبيل المثال، فإن المرء يستطيع الانتماء إلى شعب أو أمة أو وطن أو نظام أو حزب أو طائفة أو ثقافة أو مصلحة، كما يستطيع الانتماء إلى هذا كله، أو إلى أجزاء منه، مع ما يترتب على ذلك من سلوك يتفاوت باختلاف مفردات انتمائه. بيد أنه لا يوجد في الواقع إنسان واحد ينتمي إلى واحدة فقط من هذه المفردات، كما لا يوجد فرد واحد ينتمي مثلا إلى أيديولوجية تجب علاقاته الشعورية والعقلية مع وطنه وأمته وشعبه وحزبه وطائفته ... الخ. كي يعيش المواطن في توازن، يجب أن يقيم توازنا دقيقا بين انتماءاته، ما دام أي خلل في علاقاتها يبلبل عقله ووجدانه ويسبب اختلالا شديدا في علاقاته مع نفسه، ومع الواقع والآخرين، غالبا ما يقوده إلى أوضاع وممكنات سيئة قد تكون خطيرة بالنسبة إليه. لو غلب المرء، مثلا، الاعتبارات الطائفية على علاقاته مع وطنه وشعبه، فإنه سيتحول إلى ساحة تتناقض فيها انتماءاته وتتصارع، تغطي دوائر تأثيرها وسطه القريب ومجتمعه، وتنقل توتره الذاتي إليه، مع ما يرتبه هذا من نتائج وخيمة عليه أيضا.
عموما، يعيش المرء ضمن دائرتين من الانتماءات: إحداهما خاصة بالانتماءات العليا والجامعة، والثانية بالدنيا والجزئية. ومع أن إنسانا على وجه الأرض لا يخلو، كما سبق القول، من بعض جوانب الثانية، فان العاقل والعقلاني لا يحدد مواقفه وقناعته وسلوكه انطلاقا منها، بل يغلّب انتماءات الدائرة الأولى وما فيها من مكونات عليا وجامعة، تنبع منها وتتعين في ضوئها وتتداخل معها حياة الأفراد والمجتمع، التي لا تستمر إن هي فشلت في تخطي الانتماءات الجزئية والمصالح الخاصة النابعة منها أو المتكئة عليها، ولا مفر من أن يعتمدها المواطن حاضنة ينظر في هديها ومن خلالها على انتماءاته الجزئية والدنيا، ومن أن يرغب في أدراجها داخلها، وإلا ففي حصرها ضمن نطاق شخصي ضيق لا تتعداه إلى العمومية المجتمعية العامة، وإعادة تعريفها بين حين لآخر في ضوء الأولى وثوابتها وتحولاتها، التي هي إطار ينظم حياته ومصالحه وعلاقاته، ويرتقي بهويته الذاتية والعامة إلى مستوى من المواطنة والحرية يجعله مساويا لأي إنسان آخر، ويدرجه في جماعة يلتزم طواعية بسلامتها، ليتوافق انتماؤه الجزئي عندئذ مع انتمائه إلى جماعة مجتمعية ووطنية، ويكون للجوامع النابعة من انتماءاته العليا أولوية دائمة على ما عداها، ويتم إنتاج ما هو خاص في ضوء ما هو عام وعلى أرضيته، بل ويصير العام خاصا والخاص عاما، وينعكس تطابقهما على وحدة المجتمع ووعي مواطنيه.
تكون انتماءات المرء جامعة وعليا في حالات التقدم والنهوض العام والشامل، الذي ينقل الشعب والمجتمع من حال أدنى إلى حال أعلى. عندئذ يتعرف المرء في نفسه على المواطن الذي أولويته انتماؤه إلى مجتمع الشعب والأمة، بينما ترتقي انتماءاته الدنيا، التي تتوطن حيزه الخاص والشخصي، إلى صعيد الحيز العام والجامع، فيقلع عن تعيين نفسه بالجزئي والأدنى، عند تعريف نفسه، ويرد، إذا ما سئل عن هويته مؤكدا المستوى الأرقى من هويته، كانتمائه إلى أمة أو شعب دون أن ينسى أن يعين من خلاله هويته الدنيا كالمذهب أو الطبقة أو المنطقة ... الخ . بالمقابل، تبرز الانتماءات الدنيا في فترات تراجع وانهيار الدول والأمم، بل إنها تكون معيارا يقاس بواسطته مدى التراجع والانهيار في حقل الواقع العملي، الذي يعبر عن نفسه في حجم ومدى تراجع الانتماءات الجامعة، وتقدم الانتماءات الجزئية على حسابها، إلى أن تحل محلها، فيتذكر المواطن مثلا أنه ينتمي إلى طائفة وينسى أولوية انتمائه إلى شعب أو أمة ... الخ . يحدث هذا غالبا بعد وقوع هزائم تصيب جسدية عامة كالدولة والشعب والمجتمع والأمة، وتمس الحاجة إلى الانتماءات الجزئية في نظم الاستبداد بصورة خاصة، التي تجبر مواطنيها على الانخراط في انتماءات دنيا تمزقهم، وتمنعهم من الحفاظ على وحدتهم كشعب، وتمتنع عن تذكرهم بالانتماءات المجتمعية الملموسة، النابعة منها أو التي تعززها، ما دام أفضل وضع يتيح التحكم بالمواطنين ينشأ عن تغذية خلافاتهم وتحديثها، ووضعهم بعضهم في مواجهة بعضهم الآخر، بما يحقق الشروط التي تضمن للمستبد السيطرة عليهم، بأهون السبل.
بوجود هذين النمطين من الانتماء، يوجد نمطان من التفاعل في نفس الفرد وبين تكوينات المجتمع وفي داخله: نمط مفتوح تنتجه الانتماءات العليا الجامعة قوامه التنوع تنميه الحرية، ليس الانتماء إليه شخصي الأسس والمعايير، بل هو انتماء إلى مشتركات يتقاسمها أفراد يتكاملون ويتفاعلون بحرية وطواعية، يسوون بتكاملهم وتفاعلهم ما قد يكون ينهم من فوارق واختلافات. إنه، إذن، نمط انتماء تفاعلي وحر، هو ساحة لا حدود للحراك الفردي والمجتمعي فيها غير حدود السلامة العامة والالتزام الطوعي بالقانون، تغني مشتركاتها وجود الفرد وتثريه وتجعله ثروة وطنية تتوقف عليها مناعة الدولة والمجتمع. وللعلم، فإن هذا النمط من الانتماء لا يلغي الانتماء الجزئي بل يبدل طابعه ومعناه، بأن يفسح له مجالا يمكنه من تجاوز ذاته وأنسنة وظائفه، ويضفي عليه معان جامعة ما أن تحتل وعي حامله حتى يرى فيها فسحة تعينه على التخلص من أي انتماء مزدوج، وعلى إقامة قدر رفيع من التناغم مع قيم وواقع الجماعة الوطنية يتيح له العيش بسلام في رحابها والإسهام بفاعلية في ترقية عموميتها. مأخوذا لوحده، ومفصولا عن الانتماءات الجامعة، يكون الانتماء الجزئي انتماءا إلى متاريس يتخندق المواطنون وراءها، حيث يدفعهم الشك والحذر والخوف من الآخر، المختلف في انتمائه الجزئي، إلى ارتكاب جميع أنواع العنف والحماقات. والمتراس سجن ذاتي لا يتسع لغير الأنا، يجبر صاحبه على رؤية الانتماء الأعلى والجامع بدلالة، وتحت حيثية، انتمائه الجزئي والضيق، الذي لا يكون عندئذ إلا عدائيا ومدمرا، خاصة وأنه هيمنته تتوطد في فترات الهزائم والتراجع، ووسط أجواء يسيطر عليها الضيق الشديد بالآخر، والخوف الشديد على النفس، والانخلاع عن الشعب والأمة، والعداء حيالهما.
يتسم وضعنا العربي الراهن بتراجع الانتماء إلى قيم جامعة عليا ومشتركة، وتراجع الأواصر الوطنية والقومية المطابقة لها، وبروز انتماءات جزئية مغلقة، كان دورها يضعف وفعلها يتضاءل في حقبة صعود العرب عقب الحرب العالمية الثانية، ثم تبين في حقبة التدهور والإخفاق الشامل التي تلتها أن الانتماء العام والجامع لم يحظ، خلال صعوده، بترجمة عملية وواقعية من شأنها جعل العودة عنه صعبا، إن لم يكن مستحيلا، لذلك، فإن ما كان ينحسر ويتلاشى من انتماءات جزئية ما عتم أن أزاح الانتماءات الجامعة: من الواقع ومن نفوس أعداد كبيرة من المواطنين العرب، في كل دولة من دولهم وعلى صعيدهم القومي العام، فلا عجب أن عزز صعودها التراجع العربي وحوله إلى انهيار سريع، حتى صار المرء يشك في بعض الأحيان إن كان صحيحا ما يقال حول وجود حقبة حديثة هيمنت عليها انتماءات جامعة، ويستغرب أن ينحدر العرب خلال هذه الفترة القصيرة إلى الدرك الذي هم فيه حاليا!.
السؤال الذي يجب أن يطرح هنا هو التالي: هل يمكن للانتماءات الدنيا، المسيطرة اليوم، أن تخرجنا من مأزق لعبت هي نفسها دورا حاسما في انحدارنا إليه وغرقنا فيه؟ وهل سبق لأمة أن تقدمت وتحررت بفضل انتماءات جزئية ومغلقة ؟ هذا السؤال ليس نظريا. إنه بالأحرى سؤال عملي إلى أبعد حد، تختصر الإجابة عليه بجمل قليلة: لم تسيطر الانتماءات الدنيا على شخص أو حزب أو بلد أو دولة إلا وأدت إلى هلاكه وخرابه. ولم يتمكن فرد أو حزب أو بلد أو دولة من النهوض بواسطة انتماءات دنيا، جزئية ومغلقة ونافية للغير. ولا سبيل إلى خروج العرب، أفرادا وشعوبا، من مآسيهم ما داموا خاضعين لانتماءات دنيا، ناسين أو متناسين (بالقهر أو الغفلة) انتماءاتهم العليا الجامعة، وعاجزين أو عازفين عن إدراج الأولى تحت جناح الثانية، وعن إعادة إنتاجها بطريقة تعطل ما فيها من عناصر تأخر وتفجر. أخيرا، إن العمل على صعيد الانتماءات العليا هو مهمة الدولة الرئيسية إن لم تكن الوحيدة، وانتفاؤه في بلداننا علامة إضافية على سقوط الدولة وامتناع السلطوية عن القيام بواجباتها تجاه شعبها ومجتمعها.
ليس تلاشي الانتماءات العليا من حياة إنسان أو شعب أو دولة مسألة هينة يسهل التغلب عليها، بل هو علامة على سقوط أكبر يتصل بانتفاء وجود حملتها: دولا ومجتمعات وطبقات وأفرادا، أو برفضهم تبنيها والعيش في هديها. ذلك يعني أن المسألة تتجاوز القيم والمثل إلى داء وبيل يستوطن الواقع أيضا، يتطلب شفاؤه جهدا في الفكر والممارسة شاملا يجدد مضامين الانتماءات العامة، ويقلص حضور وتأثير الانتماءات الدنيا، في وعي وواقع البشر. إلى أن يحدث هذا، ستكون فرصنا في بدء تاريخ جديد قريبة من الصفر أو معدومة تماما!.
لا يتخلى أنصار الانتماءات الدنيا عنها بسهولة، خاصة إن احتلت وعيهم عقب تلاشي انتماءاتهم العليا الجامعة. في هذه الحالة، يصعب الحديث عن مجتمع وشعب ودولة، مثلما هو حال بلدان عربية كثيرة، ابتليت بهذه المرض، قبل أن تسير نحو الانهيار الشامل!
ميشيل كيلو كاتب وسياسي من سورية











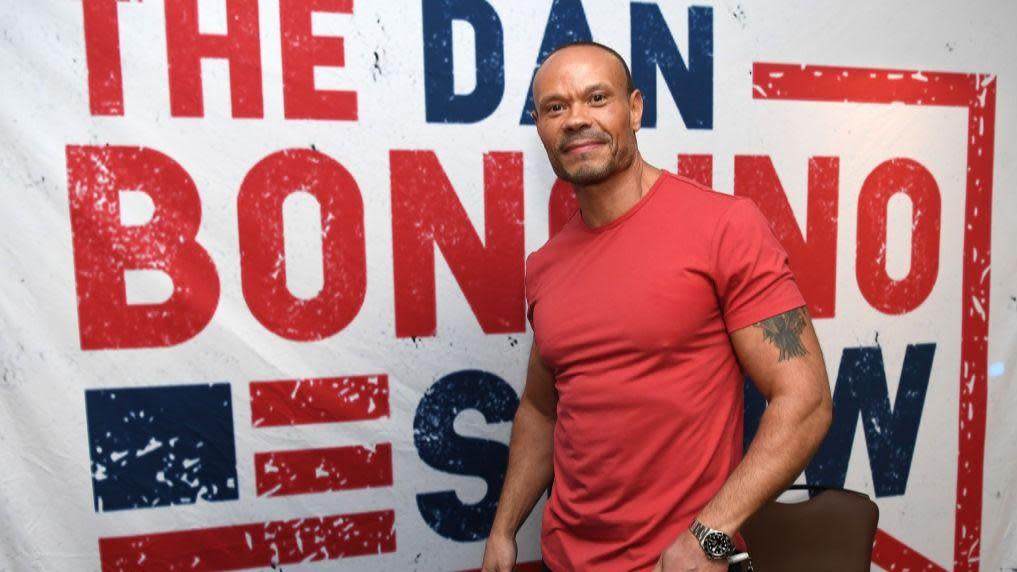








التعليقات (0)