الوراري: دائماً يسكنني قلقٌ بإزاء كتابتي الشعرية، والتجربة الشعرية الجديدة في المغرب فجّرت جماليّات

الوراري: دائماً يسكنني قلقٌ بإزاء كتابتي الشعرية، والتجربة الشعرية الجديدة في المغرب فجّرت جماليّات جديدة.

ميدل ايست اونلاين
أجرى الحوار: مصطفى تاج
شاعر وناقد مغربي من مواليد 1972 بالجديدة. صدر له: "لماذا أشْهَدْتِ عَليَّ وعْدَ السَّحاب؟"، و"ما يُشْبه ناياً على آثارها"، و"ترياق"، و"تحوُّلات المعنى في الشعر العربي".ونشر عدداً من الدراسات والمقالات والترجمات الشعرية في عدد من المنابر الثقافية العربية الرصينة، كما شارك في ملتقيات أدبية داخل المغرب وخارجه.ولأنه يمثل واحدا من طليعة الشباب العربي والمغربي في مجال الأدب والنقد، التقيناه، وكان هذا الحوار مع الشاعر والناقد عبداللطيف الوراري:
• كيف ابتدأت قصتك مع الكتابة، وكيف انزحت للشعر بالذات؟ وما الإكراهات التي واجهتها على دروب البدايات؟
ـ أتاح لي الصفّ الدراسي واجتهادي فيه أن أتعرّف، بعد كتاب الله، على كتُبٍ أخرى بما في ذلك المصوّرة التي كانت تقذف بي في أحلام اليقظة والعوالم العجيبة، مثلما واجهْتُ لأوّل مرّةٍ نصوصاً من الشعر في مادة المحفوظات، وتفتّقتْ موهبتي في موضوعات الإنشاء التي كنّا نُؤْمر بها، فأسرْتُ بمخيّلتي وخطّي الجميل أساتذتي وأضرابي في الفصل من الحسناوات والكسالى معاً.
لكنّ قدراً جميلاً كان بانتظاري في محطّة ما، بعد أن عاركتْني الحياة وزاد وعيي الشقيّ بها وقلّت الرفقة، إذ قادتْني يداي ـ لا أدري صدفةً أم هِبةً ـ إلى كتاب "ميزان الذهب في صناعة أشعار العرب" الذي كان بمثابة كتاب مقدّس، ثمّ قادتْني خُطاي إلى مكتبة، فاقتنيْتُ دواوين من الشعر ممّا يدّخر صاحبها منه، وكانت علاقتي بالشعر بدأت تتوطّد من سماعه وقراءته بين برامج إذاعية وملاحق ثقافية.
أذكر أنّي اقتنيْتُ: "رباعيات الخيام" بترجمة أحمد رامي، "الملاح التائه" لعلي محمود طه، "الحياة الحبّ" لإبراهيم محمد نجا، "الأجنحة المتكسرة" و"الأرواح المتمردة" لجبران خليل جبران، و"ديوان ابن زيدون". كما استعرت "أغاني الحياة" لأبي القاسم الشابي، و"ديوان إيليا أبي ماضي"، و"ديوان بهاء الدين زهير"، و"أحلى قصائدي" لنزار قباني. وقد فعلت فيّ هذه الدواوين فعل السّحْر، وقدحت ذهني، ووشمت وجداني، فصارت رؤيتي ـ نتيجةً لمقروئيّتي ـ رومانسيّةً وحالمةً ومتفائلةً.
لقد أحسسْتُ في قرارة نفسي، بعد سنواتٍ من اغترابي النفسي والوجودي، أنّي عثرْتُ على أصفيائي من الشعراء، فقرأْتُ ما خطّوه بكلّ جوارحي، وأذرفت معهم دموع هذه التجربة أو تلك، وارتفعْتُ وإيّاهم إلى مدارج الحلم والخيال.
لا أنسى أن أذكر، هنا، الشاعر من أصول فلسطينية وجيه فهمي صلاح الذي رعى موهبتي الشعرية من خلال برنامجه الإذاعي "مع ناشئة الأدب"، والشاعر محمد بنعمارة الذي كان صوته "في حدائق الشعر" يتصادى مع صوتي اليتيم.
هي، إذن، بداية كل شاعر وجد نفسه في حياة صعبة أعزل إلا من سريرته الزرقاء التي علمته شرط الوجود أيا تكن درجة المعاناة والألم. لذلك، لا أقول إن الصدفة هي التي قادتني إلى القصيدة، بل الضرورة التي تتغذى على شرطنا الإنساني.
• في ديوانك الأول "لماذا أشهدت عليّ وعد السحاب؟" تبدو الذّات عنيدة في حرثها للُّغة والرؤيا بحثاً عن الخروج والانعتاق. عن أيّ تجربةٍ صدرت أشعارك في هذا الديوان؟
ـ تكشف نصوص "لماذا أشهدْتِ عليّ وعد السّحاب؟"، وهي مجموعتي الأولى، عن ملامح من السّيرة الشعرية لذاتٍ تعيش تجربة خاصة، وتعبر عن قلق وجودي. ذات متشظية، مسكونة بالأمكنة ومحاصرة بالتخوم. وبما هي كذلك، تحاول هذه الذات الفكاك من أسرها لتحلق بعيداً في رحابة السماء حيث النور والحقيقة، لكن هناك أشياء أثمن تجعلها تنشدُّ إلى شرطها الإنساني ـ الأرضي.
في فضاء القصيدة، تعاين الذات الشاعرة وضعاً فادحاً ينعكس على بنية التشظي الثاوية خلف التجربة، مثلما ينعكس في تعدّد الموضوعات التي كانت تشغل الذات بوصف تجربتها تجربةً للعبور والانعتاق. ذلك ما أتاح لها التعبير داخل لُغةٍ بين قديمة وحديثة، صافية وحادّة، بكلّ تلويناتها المعجمية وتأويلاتها الممكنة.
وعلى كلّ حالٍ، إذا كانت تجربة الذات في المجموعة بمثابة متاه، فإنّها سرعان ما تتحوّل إلى أفق للرّغبة عندما ترعى الذّات مخاضات الوعد، فيما هي تشرق عبْر أصوات الطّبيعة الصّادحة، ومراقي الحبّ، وتخوم الحياة المتناثرة بين الأمكنة الهاربة.
• هل يعكس ديواناك اللاحقان "ما يُشْبه ناياً على آثارها" و"ترياق" استمراريّةً للديوان الأول، أم يُحدثان قطيعةً معه؟
ـ دائماً ما يسكنني قلقٌ من نوعٍ خاصّ بإزاء كتابتي الشعرية. كلّ نصّ أفرغ منه يحمل بذرة نقصانه، وبالتّالي يُديم علاقتي بقلق الكتابة. لكن دائماً ما كنتُ منحازاً إلى شعر القصيدة الذي يتحرك داخل جماليات الحداثة التي تشفّ، بدرجة عالية من الهشاشة، عن شرطها الإنساني والوجودي. لكن هناك ـ بشهادة من قرأني ـ تطوُّر في تجربتي وسيرورة متحفزة تعبر مجمل أعمالي الشعرية.
لقد كتبت الشعر العمودي، وطورت حاسّتي الشعرية في شعر التفعيلة، كما أن عملي الشعري يقترب، كتابيّاً وتخييليّاً، من جماليات قصيدة النثر، المشطورة تحديداً. لنقل إنّ أهم ما يشغلني هو رفْد المتخيّل الذي يدفع بالذّات إلى أقصاها في مخاطبة المطلق عبر وجوهٍ وحيواتٍ وعوالم متعدّدة. كلّ عملٍ شعريٍّ أُراهن عليه هو، في نظري، لانهائي، أي يتمّ في الآتي داخل جدل الاتصال ــ الانفصال.
• فيما يخصّ ديوانك "ترياق" الفائز بجائزة "دورة محمود درويش" التي يمنحها ديوان الشرق الغرب (برلين ـ بغداد)، كيف تلقّيْت آراء لجنة التحكيم وشهاداتها النقدية؟
ـ تأثّرت بشهادات اللجنة كمثل شهادة الناقد والشاعر البحريني د. علوي الهاشمي أو الناقد العراقي د. عبدالرضا علي أو الشاعر اللبناني شوقي بزيع، الذين حكموا برأيٍ شريف ونزيه في شخصي وفي حقّ مجموعتي الفائزة "ترياق" التي صدرت في بيروت عن مؤسسة شرق غرب ضمن ديوان المسار للنشر. ولا يمكن لهذه الجائزة بشهاداتها الثقيلة إلا أن يكون لها، بلا شكّ، أثرٌ في مسار تجربتي الشعرية، بعد أن أشعرتني بالمسؤولية وأخلاقيات الكتابة في هذه اللحظة المتوتّرة من وعي بالعالم وانهماكاته المتوترة.
• من خلال دواوينك الشعرية، هل يمكن القول إنّك تنتمي إلى مدرسة شعرية محددة؟
ـ أنا أنتمي إلى الشعرية العربية الأعرض التي تضرب بأطنابها في عمق التاريخ واللغة والثقافة، من الشعر الجاهلي حتى أيامنا، والتي لا تزال تجدد آليات عملها الكتابي والتخييلي، وتأويلها الخصيب للذات والعالم. أنتمي إلى النصوص التي تحمي العمق، وتتطور داخل جماليات اللغة العربية. وإنّي أزعم أن الصفحة التي أخط فيها / عليها شعري هي، سلفا، مسودة بحبر أؤلئك الشعراء من المتبتّلين في محراب العربيّة وهيكل الحبّ، والذين أتقاسم معهم ميراث الجهد الفني والعمق الذي يتهدّذه اليوم جهل الميديا.
• ماذا يعني لك التتويج المشرقي بعد حصولك على جوائز من لبنان والعراق والإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك جائزة الشارقة في النقد الأدبي للعام 2009 عن كتابك "تحوُّلات المعنى في الشعر العربي"؟
يعني لي الكثير. في بلد مثل المغرب عليك أن تبذل مجهوداً لافتاً لتلقى الاهتمام ممّا يحبّون ويرغبون فيما تكتب، ويشجّعونه حقيقةً. هنا، حيث لا قيمة فيه للثقافي داخل الإعلام الرسمي وسواه، يصبح مجهودك ذا معنى، ويحفر في مجرى عكس السائد. لقد سرّتني الجائزتان، ولفتتا النّاس إلى شخصٍ يكتب خارج المؤسسة وسلطتها السالبة. ثمّ لا يخفى على أحد ما للجائزتين معاً من قيمة ثابتة، حتى لا تنعتها بسمات الجوائز الضالّة والمُجاملة والمُغرضة.
• ألهذا السبب نتعرّف على كتاباتك من خارج المغرب؟
ـ لولا ما سمعتُ يوماً عن أن الثقافة المغربية ذات بنية رصاصية لا يمكن اختراقها إلا من الخارج، لكنتُ قد انتهيْتُ، ولم يُسمع لي صوت. قرّائي اكتشفوني أوّلاً في جريدة "القدس العربي" التي تصدر من لندن، ثمّ قرأوا نتاجي الأدبي في أكثر من منبر غير مغربي، وتعرّفوا عليّ أكثر بعد نيلي الجائزتين من بغداد والشارقة كمركزين ثقافيّين بالمشرق.
• هل للأمر علاقة بما يسود الوسط الثقافي المغربي؟
ـ فتحْتُ أنا وأبناء جيلي، من الذين رأوا النور في زمن السبعينيّات، أعيننا على مؤسسة الأدب، واكتشفنا كيف كانت هذه الأخيرة يسودها مناخ غير سليم، وكان ينخرها واقع من الولاءات الحزبية والإيديولوجية والعشائرية التي كانت تُسيء للأدب، وتوقه إلى تجديد نفسه ورؤيته وعلاقاته بالعالم. ونتيجة لذلك، أذكر أنّ عدداً من أفراد هذا الجيل انقطع عن حلم الكتابة وانصرف إلى كفاف خبزه اليومي، بل منهم من قضى من الكمد أو انتهى إلى حافة الجنون.
وأعتقد أنّنا اليوم بتنا نلمس اتساع هامش الحرية والنشر، وتململ المؤسسة نحو الأحسن في إعادة تدبير علاقتها بفضاء الكتابة والإبداع، في ضوء الانقلابات التي يشهدها العالم من انهيار الأيديولوجيات إلى ثورة التكنولوجيا الرقمية.
• سبق لك أن صرّحت بأنّ النقد المغربي بدأ يتعافى من طغيان النقد الصحافي والإخواني بظهور مجموعة من النقاد ذوي حساسية جديدة في الرؤية والمنهج. في هذا الإطار، ما هو تقييمك لتجربة النقد الأدبي، ونقد الشعر تحديداً؟
ـ دائماً ما نسمع من المشارقة قولهم إنّ النقد يوجد في المغرب، لكنّنا بتنا نشكو من غياب النقد، ونقد الشعر تحديداً. لم يخض النقد بعد في قراءة واكتشاف التجربة الشعرية الجديدة بالمغرب. فإذا كانت تجارب شعرنا السابقة قد أُثيرت حولها نقاشات، واحْتُفي بها من قبل الدارسين بنسبٍ معقولة، مثلما كانت أصواتها مكرَّسة وذات رمزيّة بحكم ارتباطها بمشاريع ومؤسسات كانت تعتبر الموضوع الشعري، الرِّسالي تحديداً، امتداداً لخطابها، فإنّ تجربتنا الشعرية الراهنة تتكلَّم اليُتْم، وتُواجه العماء، مثلما أن كثيراً من أصواتها لم تُسمع، أو لا تُسمع إلا بالكاد. من هنا، يُجهل، حتى الآن، ممّا فيه اعتبار داخل الراهن الشعري.
وليس هناك من مسوِّغ، ألبتّة، أن يظلّ نقد الشعر المغربي كما هو، وأن يثبت خطابه على ميدان هيمنة السلط والكليشيهات، فلا يُراوح مكانه. يجترّ النصوص نفسها، والأسماء نفسها، والمصطلحات نفسها، وهواء الحياة نفسه. وإذا لم يعد هناك ما يقوله، فإنّ عليه أن يتغيَّر، لأن الخطاب حول الشعر يتغيَّر لما يتغيَّر الشعر نفسه. لكنّه لا يتغيَّر، انتقائيّ وشكلاني وحاجب. لا ينظر إلى الأراضي الجديدة التي يحترثها الشعر المغربي، بقدر ما ينظر إلى نفسه وانسجامه الخاص. ولهذا يظلّ هذا الشعر مجهولاً في كلّ مكان.
باتت هناك حاجةٌ ملحّة ومستعجلة لنقد حقيقيٍّ وصارم له هاجس الانتماء إلى هذا الراهن الشعري، يدرس خصوصيّاته، ويُقايس إضافاته النوعية ضمن تيار الحداثة الشعرية، ويكشف ما يتحكّم به من قوانين وأسئلة متنوّعة ومركّبة.
إنّ راهن الشعر المغربي ينتظر من كافة المعنيّين، ولا سيما من هؤلاء النقاد المتنبهين ممن يمتلكون حساسية جديدة في الرؤية والمنهج، أن يشرعوا في صياغة أجوبة لأسئلة من بينها مثلاً: أيهما أولى، الكتابي أم الإنشادي في مجتمع ذي أغلبية أمية؟ أيّ زخم يمكن أن تضفيه المعرفة الفلسفية على الممارستين الشعرية والنقدية بالمغرب؟ وأي موقع محتمل، في خارطتنا الشعرية، لشعراء قادمين إلى الشعر من معارف وحساسيات وهوامش نصّية لافتة؟ أيّ متخيَّل يمكن أن يرخيه مصطلح الكتابة الشعرية النسائية؟ بل أيّ متخيل شعري وطني يجب أن نهندسه بصدد شعراء مغاربة يكتبون بلهجاتهم المحلّية [الأمازيغية، الحسانية والعامية]، أو بلُغات الدول التي تُضيّفهم في المهاجر بأوروبا وكندا وسواهما؟
• بصفتك ناقداً كيف تنظر إلى خارطة الشعر المغربي المعاصر، لا سيما وأنّك اعتكفت على مقاربة مجموعة من الدواوين التي صدرت حديثاً؟
ـ تلوح لنا الخارطة التي اختطّها الشعر المغربي من ما بعد الثمانينيات وإلى الآن، جديرة بالتأمُّل، لأنها شكّلت بتضاريسها المتنوعة آفاقاً جديدة، وقطعت مع ما سبقها، بقدر ما كرّست وعياً جديدة بالمسألة الشعرية برُمّتها، بعد أن رفعت عنها السياسي والإيديولوجي، ويمّمت بوجهها شطر المغامرة، حتّى أنّ ما كان مُتخفِّياً ومأمولاً يصبح أكثر حضوراً في تجربة الراهن.
في راهن الشعر المغربي نُصغي إلى هذه الحداثة، المتحوّلة باستمرار. تتبلور متخيّلاتٍ جديدة، وترتجف حياة الأيدي بالقول الذي يُمضي سؤاله الخاصّ في هذه اللحظة بالذّات، وهي جميعها لشعراء من أراضٍ وأوفاقٍ وحساسيّات مغايرةٍ ترتاد أفقاً شعريّاً، وتفتح في ردهاته وعياً جديداً بالمسألة الشعرية برُمّتها. ولقد صار بإمكاننا أن نتبيّن ملامح التجربة الجديدة التي تتفاعل في الراهن الشعري،
وقد تأثّرت بعوامل سياسية وسوسيوـ ثقافية متسارعة وضاغطة، محلّياً وعربيّاً وعالميّاً: (أحداث 84 و90 التي فجّرها واقع القمع والظلم، سقوط جدار برلين، حرب الخليج، انهيار الإيديولوجيات الجماعية، صعود التكنولوجيات الجديدة، إلخ). ولعلّ أهم هذه الملامح التي يمكن أن نشير إليها هي: صعود قصيدة النثر التي باتت لسان حال الشعراء الجدد الذين لا يُخفي قطاعٌ كبير منهم رغبته في الحرية، وإن كان ذلك لا يخفي تهافته على كتابتها، ثمّ الاهتمام بالذات في صوتها الخافت والحميم وهي تواجه بهشاشتها وتصدُّعها الأشياء والعالم والمجهول، إلى جانب العزوف عن المعضلات التاريخية والسياسية الكبرى، والعكوف، بدلاً من ذلك، على ما تعجّ به الحياة اليومية من اختلاطات ومشاهدات وتفصيلات وعلائق خفية.
وأيّاً كان، يحقُّ لنا، في العقد الأول من الألفية الثالثة، أن نتكلّم عن ألفيّةٍ شعرية مغربية جديدة بما للزمن من استحقاقاتٍ، تأتي عبر ما تراكم في مجال النّوع الشعري والإضافات التي شهدتها القصيدة العربية المعاصرة.
• إحتفى بيت الشعر في المغرب مؤخّراً بالتجربة الشعرية الجديدة، وكنت أنت واحداً من الثلاثة المحتفى بهم. ما رأيك في هذه التجربة؟ هل حقّقت إضافات، أم لا تزال تراوح مكانها؟
ـ كان احتفاء بيت الشعر بهذه التجربة رمزيّاً وذا دلالة بعيدة، فهو اعترافٌ من المؤسسة بوجود تجربة شعرية جديدة في المشهد الثقافي المغربي اليوم من جهة، وتأكيدٌ على قيمة التجربة وراهنيّتها وأهميّتها في النهوض بأوضاع الشعر ووظائفه الجديدة، لما تمثّله من حساسيّات ووعي وانفتاح على أفق مغاير في الكتابة. وكنْتُ أشرت في شهادتي التي قدّمتُها بمناسبة الاحتفاء إلى "التجربة الشعرية الجديدة" في المغرب قد فجّرت جماليّاتٍ كتابيّة جديدة، وعكست فهماً جديداً لآليّات تدبُّر الكيان الشعري، ممّا يمكن للمهتمّ أن يتتبّعه ويتقرّاه في دواوين شعرائها، التي شرعت في الظهور منذ أواخر التسعينيّات، ونُشرت على نفقتهم الخاصة بسبب غياب الدعم والعماء الذي ووجهوا به، أو في إطار سلسلة "الإصدار الأول" الذي أطلقته وزارة الثقافة، ثمّ بيت الشعر. من تلك الجماليّات نذكر الانهمام بالذات في صوتها الخافت والحميم، والنزوع المستمرّ، في إطار قصيدة النثر، إلى بساطة القول الشعري، الانفتاح على السرد وجماليّاته البانية، كما الاعتناء بالكتابة الشذرية وبهوامش الجسد وفضّ مسمياته المختلفة.
لكن يجب أن نعترف بأنّ نصوص التجربة في كثيرٍ من هوامشها لم تسلم من تشوُّهاتٍ في الخلقة والنموّ لا تزال تُعاني منها حتّى اليوم، طالما أنّها كانت معرضة للإهمال والنسيان والصمت بسببٍ من أنّ النقد انصرف عنها إلى شعر الروّاد بأسلوب اطمأنّ إليه من المجاملة والمحاباة، وإذا التفت إليها ظلمها ودفع في اتّجاه تأويلها تحت هذه اليافطة أو تلك، بنيّة النبذ والسخرية. لكنّ قليلاً من أفراده من عبر إيقاع التحوّلات وفكّر في ذاتيّته خارج الخطاطات المعروضة، فخرج ظافراً بقصيدته، وأكثريّتهم حاصرت نفسها في ضرب من التنميط عديم الموهبة والجهد الفني، فتشابهت تشابه الرمل.
• بمناسبة اليوم العالمي للكتاب، كيف تقيم المشهد الثقافي المغربي؟ وهل لجهة سوس ماسة درعة خصوصية معينة في هذا المشهد؟
ـ لا حاجة لنا للتذكير بيوم خطير مثل هذا اليوم في حياة الشعوب واستمرارها. وبالنسبة لنا، يؤسفنا أن نقول إنّ المغرب لا يزال حتى اليوم متخلّفاً عن الدخول إلى عصر الكتاب، حيث يصير للكتاب معنى الواجب والضرورة في المدرسة، والمقهى، والباص، وشاطئ البحر وسواه من أمكنة الحياة والعمل. فالمجتمع المغربي، كما تدلّ على ذلك الإحصائيات، ليس مجتمعاً قارئاً، لأنه ليست لدى أفراده تربية على عادة القراءة ومحبّتها، حتى بالنسبة لمن يفترض فيهم ذلك. هناك بلا شكّ، مشكلات حقيقية مرتبطة بجذور وعلاقات بنيوية، وتتطلّب أفقاً حقيقيّاً في التحليل والمعالجة؛ ومن الطبيعي أن يتأثّر المشهد الثقافي العام بهذا تأثُّراً سلبيّاً. لكن مثقّفي المغرب، برغم كلّ شيء، قد بذلوا من أجسادهم وزيت أرواحهم مجهوداً عظيماً في النهوض بثقافة بلدهم، والتعريف بقيمة منجزها وميراثها المادي والرمزي في بلدان عربية وأجنبية، حتى استحقّوا الاحترام والثناء.
وعلى مؤسسات الدولة وهيئات المجتمع المدني الثقافية والتربوية والإعلامية أن تعي مسؤولياتها وتتبنّى المشاريع الثقافية خارج الفلكلرة والأجندة الموسمية. وفيما يخصّ المشهد الثقافي بالجنوب المغربي، يمكن أن نعتبر الهوامش (تزنيت، زاكورة، كلميم، اشتوكة أيت بها..) أكثر حراكاً وحيوية من الحواضر، حيث تشعّ من خلف الكراسي المتقادمة والمداشر والفجاج أمكنة للثقافة بمختلف تجلياتها وتعبيراتها اللغوية والجمالية. ولا زلت أقول إنّ الجنوب قارّة لو بُعِثت من رقادها لتغيّر وجه المغرب الثقافي والجيو-سياسي.
• هل أنت من الذين يزاوجون بين الكتابة الورقية والكتابة الالكترونية؟ وكيف تدبّر المسافة بينهما؟
ـ نعم، أنا بين هذه وتلك، في مسافة تتكلّم صيرورة - ذاتي. إن النصّ الذي يولد أمامي إلكترونيّاً ليس كالذي يُكتب ورقيّاً، سواء في مضمونه أو بنائه أو شكله. الإلكتروني عندي متعجّل وفضفاض وموسوم بالهشاشة وقابليّة الاندثار، فيما الورقي متماسك ومتّزن ومكتوب برويّة ومشطوب عليه مرّات. لهذا السبب، دائماً ما هرعتُ إلى الورق لمّا يرد عليّ أوّل بيت في القصيدة، حتى أحميه وأوجد له فضاء تعبيريّته الخاص، لاسيّما في حالة القصيدة المركّبة التي تتطلّب جهداً إيقاعيّاً ومعماريّاً.
وإذا كان الأمر يتعلّق بالشذرات أو نصوص الومضة، فإنّي غالباً ما التزمْتُ الإلكترون وتعيّشتُ من عماء الشاشة وجهاً لوجه. وقد حدث أن كتبت النصّ الواحد على شاشتي الكومبيوتر والورق معاً، ولطالما كان لهذا النصّ طعم خاصّ. ومن المهمّ أن نحدّد اليوم الكتابة بالمادّة التي تكتب عليها والحامل الذي يحملها، حتى ندرك المفهوم الذي صار لها في العصر الرقمي، بقدر ما يجعلنا نفكّر كيف أنها تغيّرت تبعاً لموادّها وحواملها الجديدة، وباتت تجسّد تقاليد وخصائص وأساليب مختلفة بين زمن الكتابة الإنتاج وزمن التلقّي والتفاعل مع النصوص.
كلمة أخيرة
كان كارل ساغان يقول: لمجرّد أن تنظر في كتاب، سوف تسمع صوتاً لشخص آخر، ربّما مات منذ ألف سنة. أن تقرأ يعني أن تُبْحر في الزّمن.







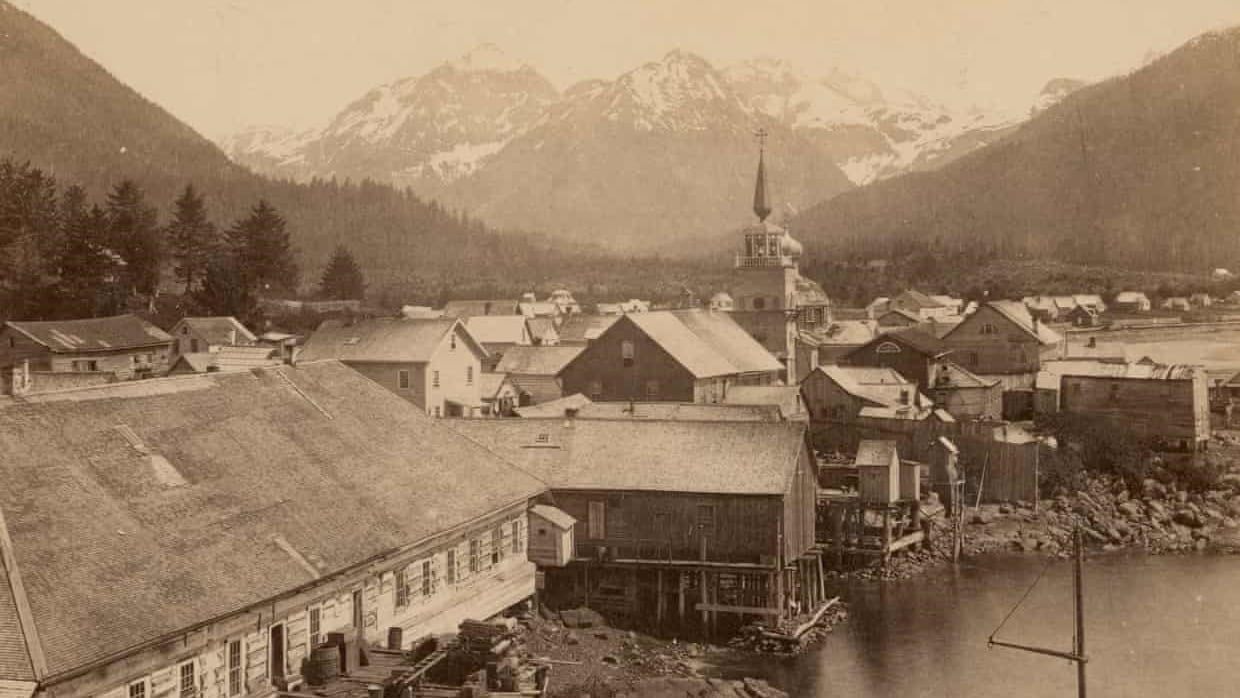


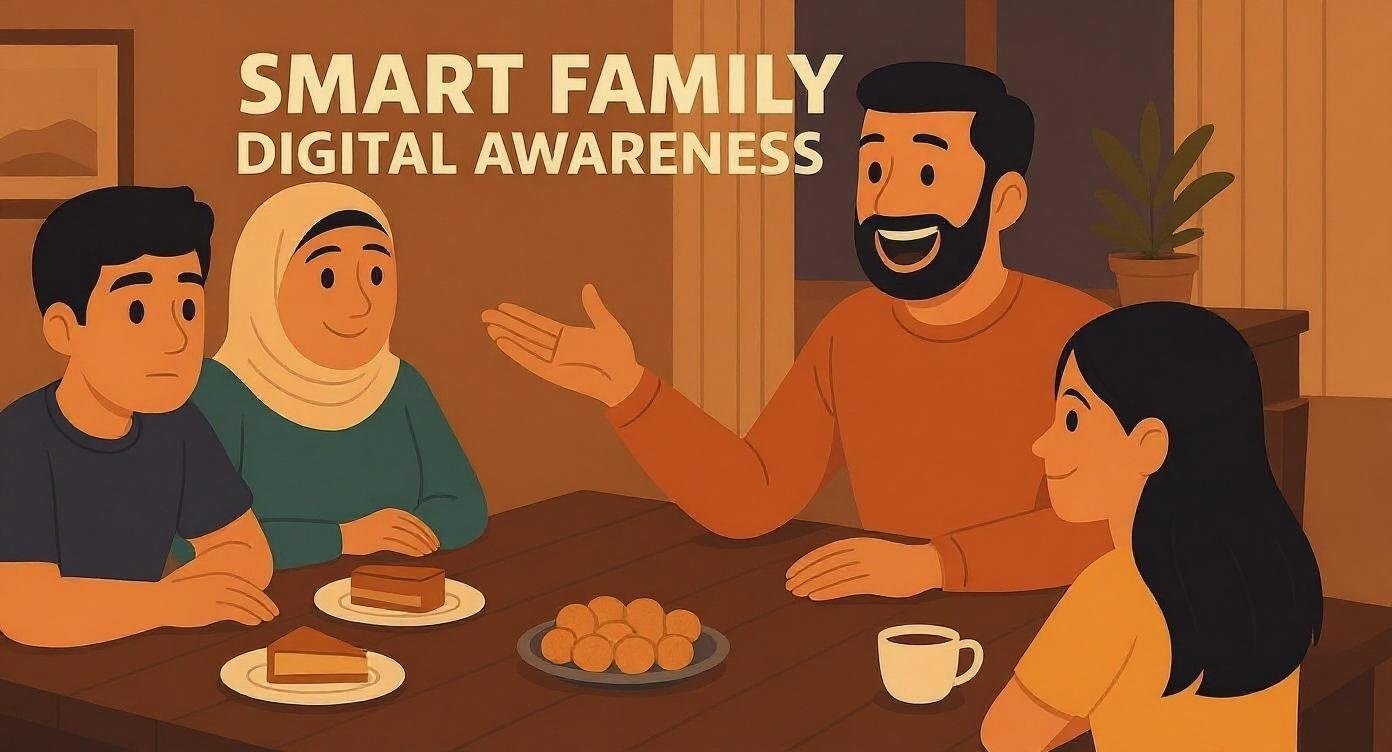







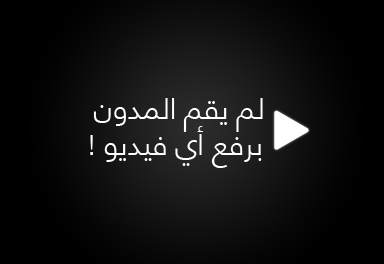

التعليقات (0)