الوجود بين حقائق الوحي وتخرصات الالحاد

تفسير الوجود بين حقائق الوحي وتخرصات الإلحاد
د. عبد الستار فتح الله سعيد
30 - 7 - 2009
هناك خطَّان أساسيان تقوم عليهما الحياة الإنسانية في مختلف جوانبها؛ الأول هو خط الوحي الإلهي، الذي يُحدِّدُ بالصدق حدود الوجود، وبداية الإنسان ومآله، ومنهاج حياته، ودين الحق الذي هُدي إليه، والثاني هو خط التخرُّصَات البشرية على كثرتها، الذي يطمس بالوهم أصل الوجود، وغاية الكون، ونهاية الإنسان، وقيم الحياة العليا، ويقود الإنسان دائمًا إلى الضلالة والمهانة.
هل يستويان مثلًا؟
وحقائق الوحي الإلهي هي التفسير الصحيح لكل ما ومن في الوجود، ومن المحال تفسير الكون والحياة تفسيرًا سليمًا متكاملًا دون الاعتماد على هذه الحقائق بشمولها، ومن ثَمَّ؛ فلا مجال للمقارنة ـ من حيث المبدأ ـ بينها وبين دعاوى الخرص والتخمين، التي قام عليها الشرك والإلحاد قديمًا وحديثًا؛ لأنه لا توجد حقيقة علمية واحدة تصادم الوحي الإلهي، أو تؤيد الأباطيل التي موَّه بها الملحدون على أنفسهم، ولكن المقارنة تأتي فقط كضرورة تقتضيها كثرة الفاتنين المفتونين بهذه الأباطيل.
وقد أوجز القرآن الكريم في كلمات المقارنة بين خطه الثابت، والأضاليل المتقلبة، فقال تعالى: {وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا} [الفرقان: 33]، وأمثال البشر الباطلة لا تنتهي في أمر الخلق والرزق والتشريع والعبودية والألوهية ...إلخ، لذلك ضرب الله تعالى لهم من كل مثل لكثرة جدالهم: {وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} [الكهف: 54]، فهذه أمثالٌ في مقابل أمثال، إلا أن الأمثال القرآنية تتميز بأنها حقٌ خالصٌ، على نقيض أمثال البشر، ولذلك كان الرد في آية الفرقان: {إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ} [الفرقان :33]،
أما أمثال البشر فقد حاوَلَتْ أن تُفسِّر ما لا علم للبشر به، فجاءت على غاية التخبط والسوء، وجاء تفسير الوحي الإلهي لأمر الكون والحياة على غاية الحسن بعد تمام الحق، لذلك كانت خصائص كل خط تحمل صفة واضعه ومصدره، وكان نهي القرآن الكريم جازمًا حازمًا، ومعطيًا السبب وراء هذه الخصائص: {فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلّهِ الأَمْثَالَ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [النحل: 74].
لله المثل الأعلى:
ومن ثَمَّ فقد انفصل الخطَّان إلى غير ما لقاء، وجاءت حقائق الوحي تحمل دلائل تفوقها، والتي نجملها فيما يأتي:
1-أنها جاءت من مصدرها المناسب لها، أي من لدن عالم الغيب، لأنها قضية غيب، ولم تأت عن طريق الحسِّ أو الحدس، كدعاوى البشر.
2-أن الذين جاءوا بها من رسل الله عليهم السلام قد اتفقوا عليها جملةً وتفصيلًا، رغم اختلاف الأزمنة والأمكنة واللغات والقوميَّات، وذلك في مقابل خطوط البشر المتكاثرة والمتناقضة.
3-اتفاقهم جميعًا على التبرُّؤ من ذاتية الوحي وبشريته، ودأبهم الدائم على نسبتها إلى مصدر حقيقي الذات، مُعيَّنٌ ومُسمَّى، وهو مَلَك الوحي وأمينه جبريل عليه السلام، وهو بدوره حَدَّدَ بيقين أنه مُرْسَلٌ من رب الكون ومليكه؛ ليبلغ رسالته إلى من اصطفاهم من عباده، وقد يوحي الله إلى رسله من البشر بلا واسطة، كما كلم موسى عليه السلام، قال تعالى: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ...} [النساء: 163]، وقال تعالى: {وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء: 164].
4-هؤلاء جميعًا كانوا على أعلى درجات الخلق والصدق في أممهم، فلا يستقيم لدى عاقل أن يفتروا الكذب على الناس، فضلًا عن الله رب العالمين، فضلًا عن أن يتواطئوا على ذلك من غير لقاءٍ ولا تعاصر.
5-ويضاف إلى هذا الاستدلال العقلي والتاريخي الجازم دلالة المعجزات والخوارق التي صدَّقتهم في دعواهم، ودلالة النصوص فيمن نزل عليه منهم كتاب، فيجتمع لدينا دلائل العقل والحس والمشاهدة والنقل، تصديقًا لهم عليهم السلام.
-لم يثبت في التاريخ كله أن إلهًا من الآلهة الزائفة، أو الصدفة المزعومة، أرسل رسولًا، أو أنزل كتابًا يخبرنا بحقيقته، ويدعونا لعبادته، وكل من ادعى الرسالة من البشر افتراء؛ ثبت كذبه بيقين، ولم يأت بشيء ذي بال، فبقيت دعوة الرسل متفردة تُثبت أحقيتهم، وأحقية ما أُرسِلوا به، وأحقية من أرسلهم سبحانه وتعالى.
7-كان الرسل في عامتهم من أوساط الناس، لا يملكون وسيلة يفرضون بها دعوتهم، وقد أُوذُوا وكُذِّبوا وطُرِدُوا، ومع ذلك فقد ذاعت دعوتهم واستمرت، وثبتت عبر القرون، بينما اندثرت دعوات هائلة كان وراءها المُلك والسلطان، وهذه دعوة نوح وإبراهيم ومحمد وَمَنْ بينهم عليهم السلام، ظلت قائمة على وحدتها وتطبيقها في أصولها، فأين هذا من دعوات ومذاهب كانت تملأ الأرض قوةً وضجيجًا، وقامت عليها أممٌ ودول؟ أين أساطير اليونان والرومان، والمجوس والفراعنة؟ وأين فكر الفلاسفة وملك الإسكندر، وشرائع جنكيز خان؟
8-لم يأت الإلحاد الحديث ـ المتذرِّع بوسائل العلم ـ بشيء جديد يدحض حرفًا واحدًا من دعوة الرسل، بل يقدم لنا العلم نفسه كل يوم مزيدًا من الحقائق التي توثقها وتؤكدها.
والملحدون الآن ـ علميًّا ـ بين خيارين: الإيمان بالله، أو التخلي عن دعوى العلم المادي، ليظلوا أصحاب أساطير؛
لأن العلم عجز عجزًا كاملًا عن الإجابة عن السؤال: من أين؟ والوحي قد أجاب، ولا يجرؤ عالم جاد أن يقول في ذلك رأيًا علميًّا غير قول الوحي، وإنما غايته أن يقول: "لا أدري"، وهذا ليس عِلمًا ولا حكمًا، وإنما هو نفي لهما، وعلى الذين لا يعلمون أن يلتمسوا العلم الذي يجهلونه ممن يملكه، وقامت تؤازره أدلة النفس والعقل، والآفاق والمعجزات.
وحسبنا نحن المسلمين شرفًا أن الله تعالى استحفظنا على هذا العلم، واستخلفنا على مواريث النبوات، وجعل لنا كتابًا منيرًا ومنهاجًا مبينًا، وأعظم بها من تبِعة وأمانة، يتوازن فيها التكليف مع التشريف، وتتعادل فيها المسئولية مع التكريم: {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ} [الزخرف: 44].
نقلا عن موقع لواء الشريعة



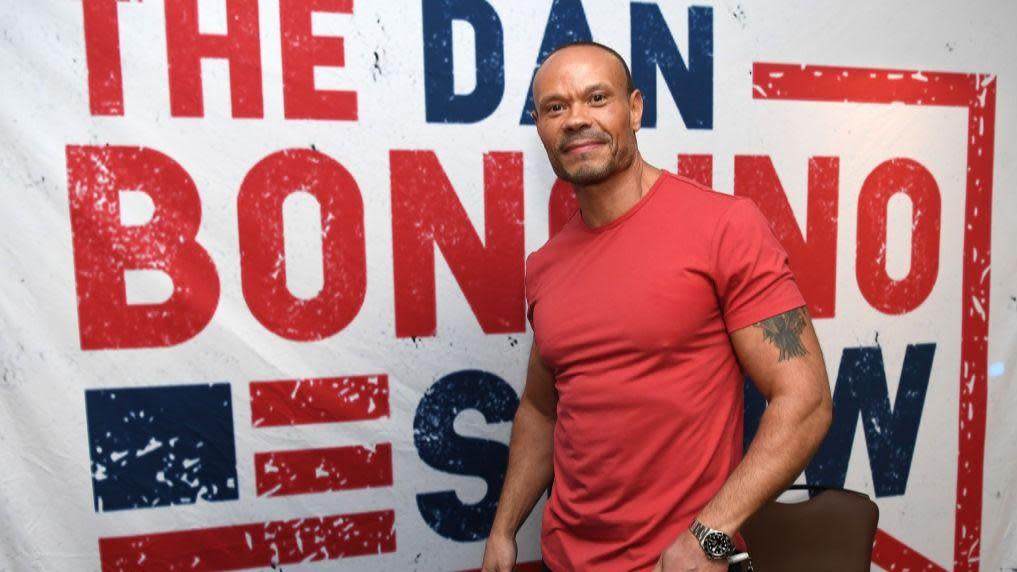
















التعليقات (0)