القومية العربية والإنسانية

القومية العربية والإنسانية
دكتور عبد الله عبد الدائم
تنحرف النزعة القومية عن مجراها وتنقلب إلى عصبية ذميمة عندما تنسى جوهرها الإنساني، وحين تعتبر القومية غاية في ذاتها، بدلاً من أن تظل وسيلة لإذكاء إنسانية الفرد. فتفّتح الحياة القومية لا يمكن أن يضطلع به إلاّ أناس أفسحوا المجال لطاقاتهم الفردية وحرياتهم، فذكَت قدرتهم على الإبداع والعطاء. وتفتُّح الإنسان والطاقات الحرّة لا يمكن أن يضطلع به، في مقابل ذلك، إلا أناس عرفوا أن حقيقة هذه الطاقات مرتبطة الجذور بالجانب القومي لدى الإنسان، بالجانب المتصل بحضارة أمته.
ولئن كان تاريخ النزعة القومية في البلدان الأجنبية ينبئ عن شيء من التلكؤ في إدراك هذه الرابطة بين القومية والإنسانية، فتاريخ هذه النزعة لدى العرب يفصح منذ البداية عن عمق الصلة بين هذه القومية والإنسانية.
وقبل أن نذكر الشواهد العديدة على عمق هذه الصلة لدى العرب، يحسن أن نستدرك فنبيّن أن من الخطأ الاعتقاد، كما يزعم أكثر الكتّاب، أن تاريخ الفكرة القومية عند العرب تاريخ مولّد مجلوب أتى إليهم بتأثير الأفكار الأجنبية. صحيح أن هذه الأفكار الأجنبية زادت في توضيح الفكرة القومية لدى العرب، لا سيما في عصور البعث الأخيرة، وعملت على إعطائها طابعاً فكرياً وفلسفياً حديثاً. غير أن جذور هذه الفكرة نجدها عند العرب منذ أقدم العصور، بل نجدها عندهم منذ البداية على وجهها الصحيح الذي تلتئم فيه القومية بالإنسانية.
فلدى أعراب الجاهلية، نجد الفكرة الوطنية نفسها، تلك الفكرة التي كانت قبلية ضيقة، تربط بين الإخلاص للقبيلة وبين الإخلاص للمثل العليا الخلقية، العربية والإنسانية في آن واحد. فالارتباط بالقبيلة عند عرب الجاهلية، كان جسراً لارتباط أعمق وأوسع يقود العربي إلى الارتباط أولاً بالمثل العليا العربية ومن ورائها بالمثل العليا الإنسانية. أو بتعبير أوضح، كان الارتباط بالقبيلة هو الشكل – البدائي الذي يبرره العصر، للارتباط بتقاليد الأمة وتراثها المعنوي من جهة، وبالتقاليد الخلقية الإنسانية من جهة ثانية. فالجاهلي كان يمجد من خلال قبيلته طائفة من القيم الخلقية تشترك فيها سائر القبائل، بل تتبارى عليها وتختصم. وهذه القيم الخلقية قيم عربية متوارثة ومتناقلة من جيل إلى جيل. ولكنها في الوقت نفسه قيم تريد أن تفرض وجودها المطلق، وجودها الإنساني الشامل. إذ ما كان العربي في الجاهلية يؤمن بنسبية هذه القيم، بل كان على العكس يريد أن ينصبها على شكل قيم عالمية مطلقة. بل نذهب إلى أبعد من هذا: فاللغة العربية، كانت بحد ذاتها لغة تحمل فلسفة عربية إنسانية. والنظرة التي تستخلص من هذه اللغة، نظرة حاملة للخُلق والمثل العليا الإنسانية. والأدب الجاهلي بدوره أدب إنساني، ومثله الحكم والأمثال، على قلة ما وصل إلينا منها. ولا غرابة بعد هذا أن نقرأ لمثل ماسينيون.
»إن البعث الدولي للغة العربية عامل أساسي في إشاعة السلام بين الأمم في المستقبل. وقد كانت هذه اللغة في نظر كثير من الفرنسيين المسيحيين – وأنا منهم – وما تزال، لغة الحرية العليا ووحي الحب والرغبة التي تطلب إلى الله – من خلال الدموع – أن يكشف عن وجهه الكريم«.
هذا إذا لم نذهب إلى ما وراء ذلك كله فنذكّر بالحضارات العربية الإنسانية التي قامت في جزيرة العرب منذ أقدم عصور التاريخ، أو التي انتشرت من جزيرة العرب إلى الأقطار المجاورة، فأشاعت منذ ذلك الحين الارتباط الوثيق بين العمل القومي والعطاء الإنساني. ثم إن الامتزاج السياسي الفعلي بين الحضارة العربية والحضارات الأخرى، وعلى رأسها الحضارات الثلاث الكبرى آنذاك، اليونانية والفارسية والهندية، قد ظهر لدى العرب كما نعلم منذ أيام جاهليتهم. والعرب منذ الجاهلية كانوا الورثة الحقيقيين لتلك الحضارات التي أخذت في الأفوال، وعرفوا أن يمزجوا بين هذه الحضارات وبين حضارتهم العربية، ليُخرجوا من ذلك كله تراثاً قومياُ وإنسانياً.
على أن هذا الارتباط بين القيم القومية والقيم الإنسانية، ما كان ارتباطاً ناضجاً مكتملاً في ذلك المجتمع الجاهلي. ولم يكمل نضجه إلا بعد الحركة الإسلامية. ففي تلك الحركة حاول العرب أن يجعلوا من قيمهم وأخلاقهم قيماً إنسانية، وأن ينقلوها إلى سائر أفراد البشر، وينعشوا عن طريقها سائر الناس. لقد بعث الرسول العربي ليتمم مكارم الأخلاق وليجعل من هذه الأخلاق أداة حضارة شاملة للناس. وهكذا كان الإسلام في أعماقه خير تعبير عن رغبة العرب في مجاوزة ذاتهم وكيانهم الضيق، للخروج به إلى الوجود الإنساني الشامل. والقيم العربية التي كانت قلقة في الجاهلية، مضطرمة ولكن ضمن أتون لا تبرحه، تواقة إلى التحقيق، استطاعت في الحركة الإسلامية العربية أن تطمئن إلى مستقرها الإنساني، وأن تحفر أقنية انتشارها.
وهذه الرغبة في الفتح الإنساني، في فتح قومي يحمل إلى الناس حضارة إنسانية ومثلاً إنسانية، تجلّت في روح الدعوة الإسلامية وفلسفتها الدينية، كما تجلّت في روح الفتوح الإسلامية. فهذه الفتوح كما نعلم لم تكن غزواً واستيلاء بمقدار ما كانت انتشاراً روحياً، وغزواً خلقياً. فلقد حكم العرب أيام الفتح الإسلامي بأخلاقهم قبل أن يحكموا بسيفهم، وكانت دعوتهم إلى الناس كافة، دعوة عدل وإخاء ومحبة.
وقد تجلىّ هذا الارتباط بين القومية والإنسانية لدى العرب، في سائر فترات التاريخ العربي بعد الفتح. تجلّى في الدولة الأموية التي كانت دولة عربية، تحرص على القومية العربية كما نعلم، والتي استطاعت أن تجعل من هذا الحرص شيئاً إنسانياً لا يتنافى مع العمل لحضارة إنسانية مشتركة. فلقد حوّل الخلفاء الأمويون، كما يقول فانتاجو الجمهورية الدينية العربية إلى إمبراطورية حقيقية شبيهة بتلك التي كانت تحلم بها زنوبيا من قبل، وذلك بفضل تحررهم الفكري وضعف عصبيتهم الدينية. فضربوا الدنانير الذهبية على نسق الدراهم واستعملوا عمالاً كثيرين من اليونان والسوريين وأسندوا إلى المسيحيين مركز الوزير الأول. وكلنا يعلم كيف تبنّى هؤلاء الخلفاء الأمويون بعد غزواتهم وفتوحاتهم سياسة التعريب القريبة من سياسة الهيلينيين، ولم يقيموا أي انقطاع، في مجال الفكر والعلم، بين التراث الجديد والحضارات القديمة، وعلى رأسها اليونانية، بل أقبلوا على الإفادة من الأطباء اليونان ومعارفهم، ولجأ أعيان بني أمية إلى استشارة هؤلاء الأطباء وتكليفهم بتربية الشباب بغضّ النظر عن دينهم المسيحي واليهودي. وفي عهدهم استمرت المدارس اليونانية الصغيرة في دمشق وأنطاكية، ورأس العين، في نقل المخطوطات اليونانية إلى السريانية. وكان الأساقفة يضيفون إلى وظائفهم الدينية وظائف الأطباء وأساتذة المنطق والمهندسين.
تضاف إلى هذه الصلات بالعالم اليوناني. والحضارة اليونانية صلات العرب أيام الحكم الأموي بالهند وتراثه، ولا سيما في ما يتصل بعلم الحساب والفلك. إذ دخل النظام العشري الهندي حوالي عام 773م، حين حملت السلاسل الفلكية إلى الخليفة مرفقة بالرموز العددية، وبالإضافة إلى الصفر. كما اطلع العرب آنذاك، في ما يبدو، على مؤلفات اريا غوبتا وبراهما غوبتا في الجبر.
وفي الوقت نفسه، كانت مؤلفات أرسطو تنقل إلى العربية في مدرسة رأس العين اليونانية، التي أصبحت في ما بعد مدرسة العين العربية.
وهكذا استطاع العرب كما يقول فانتاجو أيضاً، إن يُتّموا المهمة التي عجز عن إتمامها الفرس الساسانيون وهي المزج بين العلوم اليونانية والهندية. وكان لنجاحهم هذا كما نعلم نتائج بعيدة المدى في حضارة الإنسانية.
ولا حاجة بعد ذلك إلى الحديث عن امتزاج الثقافة العربية بالثقافات اليونانية والفارسية والهندية في عهد الدولة العباسية والى الإشادة بالروح الإنسانية التي كانت تسير في تلك الدولة جنباً إلى جنب مع الروح القومية العربية. وحسبنا أن نذكر، بين أمور عديدة تشهد جميعها بعمق الصلة بين العمل القومي عند العرب وبين العمل الإنساني، كيف ساعدت حكومة الأسرة البرمكية على تحقيق التعاون العربي – الفارسي ضمن نطاق واسع، وكيف انتشر المسيحيون النسطوريون في الوقت نفسه في البلاد الساسانية وفي وادي دجلة خاصة، حيث أسسوا ديارات وحافظوا على حريتهم كاملة. وكيف كان الخلفاء يستقدمون هؤلاء المسيحيين الحاملين للتراث اليوناني ويكلون إليهم تربية أولادهم في كثير من الأحيان. وحسبنا أن نذكر كذلك تقدير أمثال هارون الرشيد، ذي النسب العربي الخالص وذي الروح العربية القومية، للثقافة اليونانية، وما أمر به من نقل مؤلفات أبقراط وأرسطو وجالينوس إلى العربية. أما المأمون فقد أشرف على تربيته منذ صباه طبيب مسيحي هو حنا الماسوني، وعندما وصل إلى الحكم أرسل إلى اليونان والهند بعثات أمرها بشراء كل المخطوطات التي يمكن الحصول عليها ونسخ ما لا يمكن الحصول عليه منها. بل إنه بعد انتصاره على الإمبراطور اليوناني ميشيل الثالث طلب إليه في المعاهدة التي فرضها أن يتنازل له عن بعض المؤلفات اليونانية النادرة الثمينة.
وكتب التاريخ حافلة بالشواهد والبينات على روح التسامح الإنساني التي سادت المجتمع العربي. وليس المجال مجال التحدث عن روح التسامح التي شاعت خاصة بين المسلمين وأهل الذمة، فكلنا يعرف عنها الشيء الكثير. وهذه الروح، إن لم تكن في يومنا هذا موطناً لأي عجب أو إعجاب، فهي في تلك العهود الخوالي التي عرفنا فيها مآسي النزاعات الدينية في العالم ما عرفنا، صفحة واسعة في تاريخ العرب تنبئ عن عمق منازعهم الإنسانية. إنها هي التي دعت سائر المؤرخين إلى الإشادة بإنسانية المجتمع العربي، وهي التي دعت مؤرخاً كبيراً كـ متز إلى أن يقول في صراحة وجزم:
«لقد كان وجود النصارى بين المسلمين سبباً في ظهور مبادئ التسامح التي ينادي بها المصلحون المحدثون. وكانت الحاجة إلى الحياة المشتركة وما ينبغي أن يكون فيها من وفاق مما أوجد من أول الأمر نوعاً من التسامح لم يكن معروفاً في أوربا في العصور الوسطى. ومظهر هذا التسامح نشوء علم مقارنة الأديان، أي دراسة الملل والنحل على اختلافها، ولإقبال على هذا العلم بشغف عظيم«.
أفنذكر عابرين إذن جانباً من ذلك التسامح الذي يتجاوز معنى التسامح الديني، ويحمل منازع إنسانية أعم وأشمل؟ أنذكّر أن بعض الخلفاء كانوا يحضرون المواكب الدينية لأهل الذّمة وأعيادهم ويأمرون بصيانتها، وأن الحكومة كانت تأمر في حال انقطاع المطر، بعمل مواكب يسير فيها النصارى وعلى رأسهم الأسقف، واليهود ومنهم النافخون في الأبواق؟ أم نذكر ما يثير عجب شخص مثل متز أيضاً حين يكتب:
«من الأمور التي نعجب لها كثرة عدد العمال والمتصرفين غير المسلمين في الدولة الإسلامية. إذا كان النصارى هم الذين يحكمون المسلمون في بلاد الإسلام. والشكوى من تحكيم أهل الذمة في أشياء المسلمين وأموالهم شكوى قديمة«(1).
أم نذكر فوق هذا مكانة الجاثليق النسطوري والبطريق اليعقوبي وأحبار اليهود في مصر والشام؟ أم نذكر ما جرى للصابئين في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري يوم كتب لهم أمير المؤمنين منشوراً يأمر فيه بصيانتهم وحراستهم والذب على حريمهم ورفع الظلم عنهم والتخلية بينهم وبين مواريثهم وترك مداخلتهم ومشاركتهم فيها؟ بل لقد اعترف القرن الرابع الهجري للمجوس بأنهم أهل ذمة إلى جانب اليهود والنصارى، فكان لهم كاليهود رئيس يمثلهم في قصر الخلافة عند الحكومة.
والأمثلة أكثر من أن تحصى على هذا الضرب من التسامح، ونحن لا نورده هنا لأنه تسامح ديني وإنما نورده لأنه وجه من وجوه نزعة العرب الإنسانية التي تركب بفطرتها مركب التسامح أنَّى حل، وتعترف للإنسان بقيمته وكرامته ما دام إنساناً، وللمواطن بشأنه ما دام مواطناً.
والحق أن هذا التسامح الديني، كما رأينا، لم يكن موقفاً سلبياً فقط، وإنما كان له وجهه الإنسان الإيجابي، إذا كان يتجاوز رعاية أهل الذمة إلى الإفادة من علومهم ومن التراث الأجنبي الذي كانوا حملته غالباً، لا سيما في أوائل عهد الفتح العرب.
ويطول بنا الحديث أكثر من هذا إن نحن أردنا أن نعدّد الأعمال الكثيرة التي قام بها العرب في سبيل نشر حضارتهم العربية، وفي سبيل جعل هذه الحضارة حاملة التراث الإنساني،
ولا سيما اليوناني والفارسي والهندي. ويطول هذا الحديث خاصة إن حاولنا بعد هذا أن نبيّن ما قدّمه العرب، بعد هضم تراث الآخرين هذا، وبعد هذه الصياغة العربية لعلوم الأولين من خدمات للحضارة الإنسانية، حين انتقل تراثهم إلى أوروبا، عن طريق الأندلس. وحسبنا أن نذكر أن إحياء الخلفاء العباسيين الآثار اليونانية قد أظهر قيمة هذه الآثار لليونان أنفسهم، فأحدث ذلك في بيزنطة نوعاً من اليقظة الهيلينية تأسست خلالها في هذا البلد مدرسة الـ «ماجور» تقليداً لدار الحكمة التي أسسها المأمون قبل ثلاثين سنة. وحسبنا أن نذكر أن الثقافة العربية في الأندلس أصبحت مبذولة لكل إنسان. وأن الغربي والقشتالي إذا أصيبا بمرض لا يترددان في الاستشفاء عند العرب، ويحُجمان عن تسليم نفسيهما إلى طبيب لاتيني. وهل ننسى أن الملك ألفونس التاسع قد أنشأ في بلنسية عام 1280، أول جامعة مسيحية في إسبانيا على طراز الجامعات العربية، وأن أحد خلفائه، وهو ألفونس العاشر قد بنى أول مرقب في الغرب واستخدام لذلك هيئة من فلكيي العرب واليهود نظّموا قوائم فلكية سميت بالقوائم الألفونسية عام 1256م؟ بل هل ننسى أن بطل القرن الثالث عشر في بريطانيا، روجر باكون، قد استند في تكونيه الثقافي إلى المؤلفين العرب، ولا سيما مؤلفات ابن الهيثم؟ والأمثلة أكثر من أن تحصى على ما قدّمه العرب إلى الغرب من تراث حضاري في سائر ميادين العلم والمعرفة، وعلى الصلات المتبادلة التي قامت بين حضارة العرب وبين حضارة العالم بوجه عام. ولا يعنينا من هذه الأمثلة كلها إلا أنها شواهد بينات على أن الفكرة العربية التي حملها العرب وأرادوا إذاعتها بعد الإسلام ووطّدوا لها في خلافاتهم لم تكن عربية ضيقة، فيها التعصب وفيها التنكّر للأمم الأخرى والحضارات الأخرى، وإنما كانت فكرة قومية غنية خصبة لا تعرف الضيق ولا تركن إلى الغلبة، بل تحمل تراثها وتراث غيرها، وتغني تراثها وتراث غيرها عن طريق نضالها وغنائمها. وبهذا حقّقت لأبنائها تفتحاً ونمواً ذاتياّ ثرّاً. وحققت الإنسانية خدمات جلى، إذ منحت هذه الإنسانية الدفقة الحية التي انطلقت بها شطر الحضارة الحديثة كلها.
وحسبنا تلخيصاً لذلك كله أن نورد ما قاله المفكر الأمريكي راندال في كتابه عن تكوين العقل الحديث (الترجمة العربية، ص 313 – 314):
«إن عظمة العرب، كانت كامنة في مقدرتهم على تمثُّل أفضل ما في التراث الفكري للشعوب التي احتكوا بها... فقد أخذوا من العلم اليوناني المعرفة الرياضية والطبية التي احتقرها الرومانيون ونبذها المسيحيون جانباً. وراحوا يعملون بصبر وجهد في ذلك الطريق الذي ازدراه الإغريق في أوج عظمتهم، تابعين طريق التطور البطيء والتكيّف العملي. وقد اكتسبوا من الهند الأرقام »العربية« التي لا يمكن الاستغناء عنها، وشكل التفكير الجبري الذي لولاه لما استطاع المحدثون قط أن يبنوا على الأسس التي وضعها الإغريق. وبنوا في القرن العاشر في إسبانيا حضارة لم يكن العلم فيها مجرد براعة فحسب بل كان علماً طبِّق على الفنون والصناعات الضرورية للحياة العملية، وفي الجملة كان العرب يمثلون في القرون الوسطى التفكير العلمي والحياة الصناعية العلمية اللذين تمّثلهما في أذهاننا اليوم ألمانيا الحديثة.
وخلافاً للإغريق، لم يحتقروا المختبرات العلمية والتجارب الصبورة. أما في الطب وعلم الآليات، بل في جميع علوم، فقد استخدموا العلم في خدمة الحياة الإنسانية مباشرة ولم يحتفظوا به كغاية في حد ذاتها. وقد ورثت أوربا بسهولة عنهم ما ترغب أن تسميه بروح باكون التي تطمح في »توسيع نطاق حكم الإنسان على الطبيعة«.
غير أن حوادث الأيام لم تهمل هذه الحضارة العربية طويلاً، فما لبثت أن ذبلت بعد أن قدمت عطاءها إلى الإنسانية وبعد أن دفعت ركبها إلى أمام. وأعقبت تلك العصور الزاهيات في تاريخ العرب عصور انحطاط، كانت هي أيضاً من جني الفكرة القومية. غير أنها لم تكن هذه المرة من جني الفكرة القومية الإنسانية على نحو ما حملها العرب، وإنما كانت من جني فكرة قومية منحرفة حملها الأعاجم الذين لم يدركوا رسالة العرب الإنسانية، فاستفادوا مما حققه العرب لهم من رعاية ومزايا، ليقلبوها ضد العرب وليجعلوا منها أداة لعصبية ذميمة، ظهرت فيها الأفكار الشعوبية في أسوأ مظهر. وهكذا انقلبت هذه الشعوب الدخيلة على الحضارة العربية التي نشأتهم وأحسنت وفادتهم، ولم يدركوا الهدف الإنساني البعيد لاشتراك أمثالهم في الحضارة العربية، وساءهم أن ينتصر العرب حضارياً، فكادوا لهم عسكرياً، وكانت لهم الغلبة الحربية، وإن كانوا لم يصيبوا الغلبة الروحية.
ـــــــــــــــــــــــــ
المصدر : مجلة » الآداب « الصادرة عن دار الآداب – بيروت
تموز/ يوليو 1957






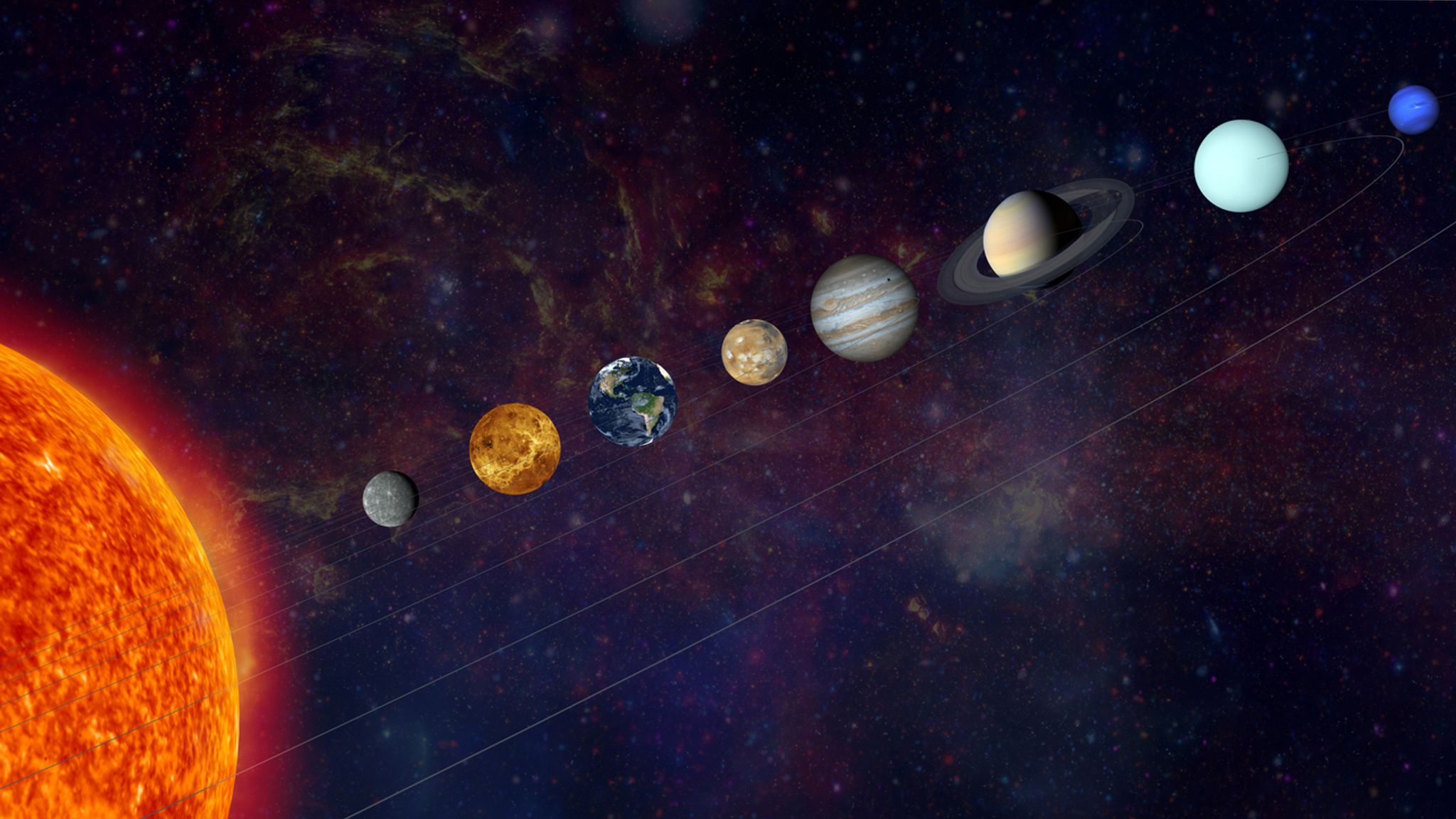





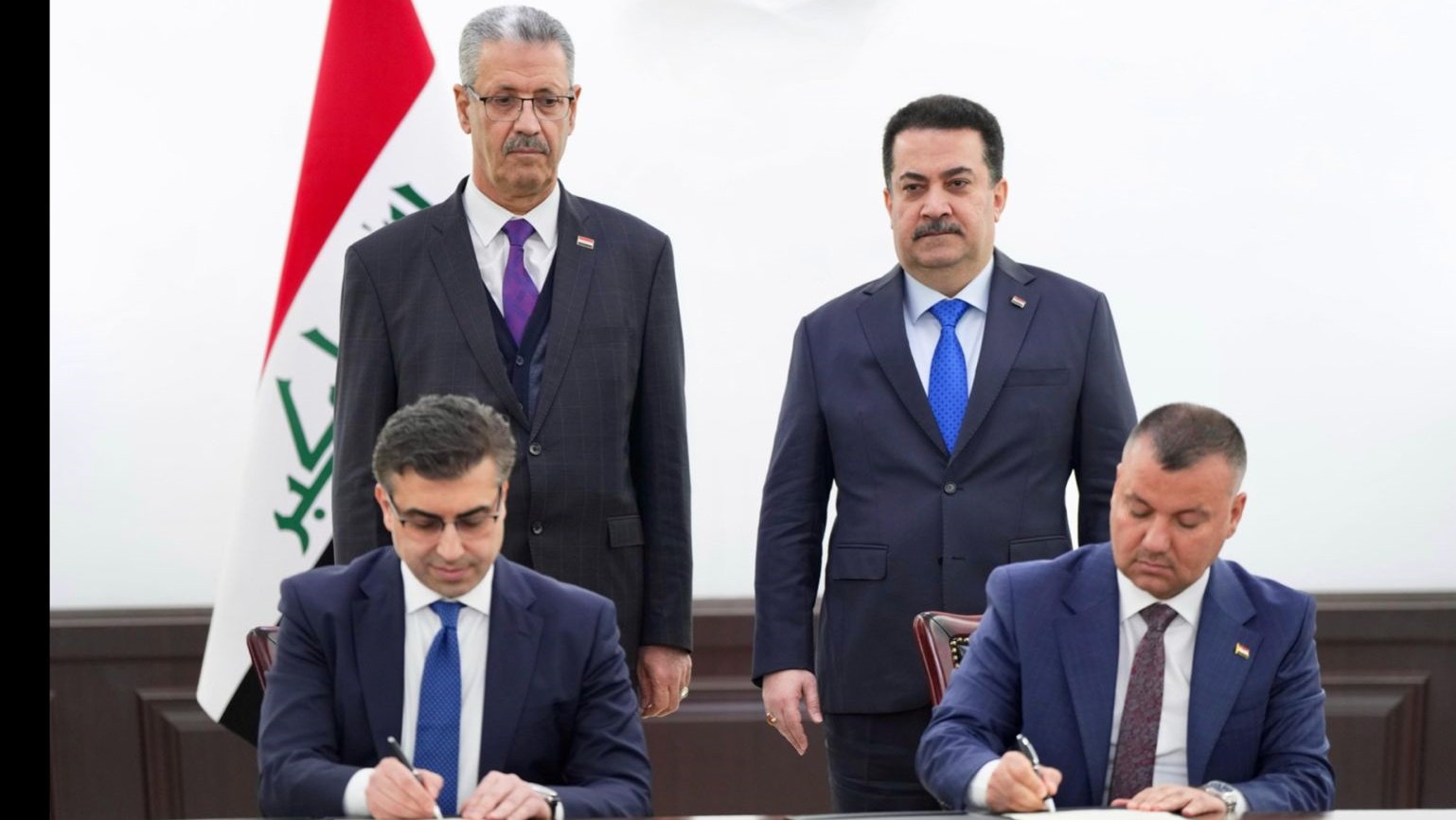







التعليقات (0)