القرآن .. والنزعة الإنسانية

كان السؤال الذي انتهينا إليه في المقال السابق هو لماذا لم يعرف الفكر الإسلامي أو ايتعرف على النزعة الإنسانية ، وكنا قد شددنا كثيرا على تلك المنهجية التي أدخلت هذا النمط في فوضى التصور العام لطبيعة الفكر، الذي راح يقصي كل أشكال وأنماط التركيبات الذهنية ، والمنهجية العامة في الفكر الإسلامي ذاته ، وأقصد هنا ذلك الأنزياح الأسطوري الخرافي الذي أعلى من شأن الحدث العام ووضعه في نسق تصعب مساءلته تاريخيا ، وهنا نود أن نتلمس الأسباب التي أدت الى غياب الذات ، الشخص ، غيابا مركب في القرآن والحديث والفقه.
نستخدم هنا الحدث القرآني وأعيد الكتابة حوله عن قصد ، ذلك أن كلمة القرآن مثقلة بالشحنات والمضاميين اللاهوتية ، وبالتالي فلا يمكن استخدامها كمصطلح فعال من اجل القيام بمراجعات نقدية جذرية للتراث الاسلامي ، واعادة تحديده وفهمه بطريقة استكشافية،، نهدف الى وضع التركيبات العقائدية الاسلامية وكل التحديدات اللاهوتية والتشريعية والأدبية والتفسيرية .. الخ، على مسافة نقدية ، ومن المعلوم أنها عقائد تفرض نفسها بشكل متعالي لا يناقش او يمس، وكانت قد فرضت نفسها كذلك منذ أن كانت قد تمت عملية الانتقال من مرحلة النص القرآني المفتوح الى مرحلة النص المغلق ـ المصحف. ويصعب علينا تحديد التاريخ الزمني لهذا الانتقال بدقة، ( بمعنى أن القرآن كان مفتوحا وحرا قبل أن يجمع ويسجن بين دفتي الكتاب الحالي المتداول، ففي الفترة الأولى كانت هناك عدة نسخ وعدة قراءات، على ما بين هذه القراءات من اختلافات منهجية، تطال التركيبات الأسلوبية والدلالية ، ثم تم منع ذلك كله وتجاوزه والتخلص منه نهائيا، بعد عملية الجمع الرسمي والأبقاء على الروايات الرسمية أو القراءة الواحدة والوحيدة، وهكذا تشكلت النسخة الناجزة والرسمية للقرآن ) . على أية حال يمكننا أن نشير الى بعض المعالم الكرنولوجية ـ أي الزمنية المتسلسلة ـ التي كان لها تأثير حاسم على تشكيل التراث الإسلامي، نذكر من بينها تاريخ الطبري، ورسالة الشافعي، ثم كتب الحديث مع البخاري ومسلم ،في المنحنى السني، والطوسي والكليني والمفيد وابن بابوية في المنحنى الشيعي، كل هؤلاء المؤلفين وغيرهم الكثيرين، تركوا وراءهم كتبا لعبت تأثيرا حاسما على العملية التاريخية البطيئة لتشكيل المسار الإسلامي بكل أطيافة المتنافسة سياسيا ولاهوتيا ، ثم تحولت هذه الكتب وخاصة كتب الحديث بسرعة فائقة الى مدونات رسمية مغلقة، واحتلت المكانة الثانية بعد القرآن بصفتها ثانية الأصول ، وقد حددها الشافعي من أجل بلورة القانون الديني الذي سيوصف عندئذ بالإلهي أي الشريعة، وقد بلورها عن طريق التفسير ذي المصداقية، في الواقع إن الأحاديث النبوية والأمامية هي في الأصل نتاج جماعي لا فردي ( بمعنى أن الأجيال المتتالية من المسلمين هي التي صنعتها وليس شخصا بعينه أو عدة أشخاص ، والأحاديث تعطينا فكرة واضحة عن البيئة التي دونت فيها، وتعكس هموم تلك الفترة كما تعكس تطلعاتها السياسية وطبيعة الصراع المحتدم بين القوى المتنافسة للقبض على السلطة ....) . وهي تعكس كذلك بعض المجريات البطيئة من لغوية وثقافية ونفسية واجتماعية . وهذه المجريات جميعها أدت الى تشكيل الروح الإسلامية العامة أو العقلية الإسلامية ، إنها تعطينا معلومات عن التفاعلات المتبادلة الكائنة بين تعاليم النص القرآني الذي كان في طور الأنغلاق وبين الأحداث أو المعطيات الثقافية السائدة في مختلف الأواسط التي انتشرت فيها ظاهرة القرآن ، ولكن الروح الإسلامية أو العقلية الإسلامية، التي كانت في طور التشكل، لم تمارس تأثير متساويا على جميع الأقوام المتواجدين في الفضاء الإسلامي الشاسع الواسع ، كإيران القديمة وأسبانيا القديمة والبربر وأندونيسيا في الوقت الراهن ، والنطاق التركي ... بل وحتى بعد تشكيل النصوص الرسمية المغلقة ونشرها بالصيغة المكتوبة والشفهية ، فإن تغلغل الروح الاسلامية لن يكون أبدا عاما يشمل الكل بنفس الاتساع والعمق ، ولن يكون نهائيا لامرجوع عنه من حيث الزمن ، ولن يكون متطابقا كليا مع التحديد المدرسي الكلاسيكي المثالي المؤبد في الأدبيات الأخلاقية والقصصية أو السردية الوعظية. إن التحديد المدرسي الكلاسيكي المثالي للذات الإنسانية في الإسلام لا يأخذ بعين الأعتبار المقاربة التاريخية التي نطرحها هنا ، ولا يهتم بتلك الأشكلة التي عرضناها للتو، وإذا ما دققنا في الأمر مليا لا حظنا أن القرآن المقروء من قبل أجيال المؤمنين المتعاقبة بصفته نصا رسميا مغلقا وناجزا، لم يمارس دوره لغويا وثقافيا ودلاليا كما كان يمارسه في مرحلته الشفهية المنفتحة حتى موت النبي، وهي المرحلة الأولى الطازجة التي صدر فيها لأول مرة من فم النبي. كما أنه لا يمارس دوره أو قل لا يفهم كما مارسه أو فهم في المرحلة الثانية من تدوينه بشكل مكتوب في مصحف أعلن أنه ناجز أو مغلق ونهائي ، هكذا نجد أنفسنا أمام مراحل مختلفة ومتعاقبة من تشكيل العقلية الإسلامية ، وإذا ما أخذنا بعين الأعتبار كل هذه القواعد المنهجية فإن كل محاولات تحديد مفهوم الذات الفردية طبقا للقرآن، لا يمكن أن تؤدي إلا الى تشكيلة معجمية أو لفظية أو عمومية متماسكة قليلا أو كثيرا ـ أقصد تشكيلة لا تراعي قواعد القرءة التزامنية، ولا قواعد القراءة التطورية اللغوية كما أوضحهاـ سوسيرـ وهذا ما تفعله بالضبط القراءة الإيمانية ولا تزال مستمرة في فعله الى اليوم ، وهي القراءة التي تخضع فقط لقواعد التصورات الإيمانية المدرسية، أي لضرورات دمج الذات في اطار الهوية المحددة من قبل هذا الإيمان بالذات. ولكن إذا كانت القراءة الإيمانية تحظى بالأولوية هنا ، فإنه لا ينبغي علينا أن ننسى الثمن الباهظ الذي تكلفنا إياه على الصعيدين الفكري والاجتماعي ، إنها تكلفنا ذلك ضمن شروط توسع الثقافة المدرسية الإجترارية التكرارية المولدة للجهل المؤسس أو المعمم مؤسساتيا، وهذا ما حصل بالضبط في الكثير من البيئات الإسلامية بدءا من القرنين الخامس عشر والسادس عشر ، إنني ألح فيما يخص هذه النقطة على إمكانية إرتدادية أو نكوص شروط ترقية الذات البشرية في السياقات أو البيئات الإسلامية، فقد كان الشخص أو الذات محترما طيلة الفترة الإنسية أو الإنسانية ثم إنقلبت الأمور بعدئذ ـ لقد كان الأديب والفيلسوف والصوفي يحظى باحترام ثم تدهور هذا الاحترام أثناء عصور الأنحطاط التي رافقت التدهور الكبير والممنهج للحضارة الاسلامية، بدء من نهاية القرن الرابع الهجري وبداية القرن الخامس .
سوف نتعرض بشكل سريع الى الاسباب والأدوات العقلية التي أدخلها الخطاب القرآني من أجل تأسيس إنسان جديد مضاد بكل وضوح للإنسان القديم ـ أي إنسان الجاهلية ـ وهذا المصطلح الأخير مصطلح جدالي ، والواقع أن المزدوجة المفهومية ، جاهلية/ علم ـ اسلام تشبه المفهوم الأنتربيولوجي للفكر المتوحش/ المضاد للفكر المدجن، إن الخطاب القرآني يستخدم مصطلحات كالنفس والروح والإنس والإنسان، كما يستخدم معجما غنيا من الإدراك الحسي والفاعلية الفكرية من أجل أن يشكل ما يدعوه بالإنسان، وذلك طبقا لمنظوراته الخاصة، سوف نرى من بعد بأن الرسالة الروحية للإنسان ، وكذلك التحديد الأخلاقي السياسي، هما واردان في القرآن ، يدلان على مضامين مشابهة ، إن لم تكن مماثلة لتلك الواردة في التوراة والإنجيل، لهذا السبب أدخلت مصطلح الخطاب النبوي الذي يستخدم نفس الآليات اللغوية والتمفصلية للمعنىعلى الصعيد الشفهي الأولي . وهذه بعض الأمثلة ذات الدلالة الغنية التي يستخدمها أصحاب القراءة التبجيلية والتي تعرض هيبة كلام الله :
( إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا).
( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لاتعلمون )
( ولولا دفع الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض )
( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل الى إبراهيم وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون )
فإذا أنسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركون حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقامو الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم )
( قتل الإنسان ما أكفره )
( ياأيها الإنسان إنك كادح الى ربك كدح فملاقيه )
( خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين )
( فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين )
يمكننا أن نذكر من الآيات الكثير، حيث نجد أن الحوار بين الله والإنسان ، أو الإنسان والله يتجسد على كل أصعدة الخطاب ومستوياته وأنواعه ، وحيث يشمل كل موضوعات المعرفة النظرية والممارسة العملية، فالقرآن يستعيد في كل مكان ، وبدون كلل أو ملل ، الوصايا العشر ويفصلها لكي يخلص الإنسان من العنف والعمى والضلال وحياة الجاهلية وقيود الجماعة بما فيهما الأبوان الذان يرفضان الميثاق ،
( ذلك مما أوحى ربك من الحكمة ) .
إن هذه الآيات التي استشهدنا بها كعينات لا يمكن أن نفهم معناها الحقيقي إلا إذا موضعنها في سياقها الأولي الذي صدرت فيه لأول مرة في مكة والمدينة، وهذه القاعدة يتجاهلها المؤمنون بكل سهولة لأنهم فقط يهتمون بالوصايا التي يمكن استخراجها منها مباشرة لتطبيقها على سلوكهم وحياتهم المعاشة ، وبنفس القناعة والحماسة ، بالآية الخامسة من سورة التوبة لتبرير اللجوء الى الجهاد :
( فإذا إنسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ، فإن تابوا وأقاموا الصلوة وءاتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ) .
ولكن إذا اختلفت الظروف استشهدوا بآيات أخرى أكثر سلمية وأكثر تركيزا على الأبعاد الإيجابية لترقية الإنسان وإعلاء شأنه، في الواقع إن القرآن المعاش كانت له دائما الأولوية على القرآن المحلل المدروس والمفهوم ، ولكن هذا الأخير ينبغي أن تكون له الأسبقية على الأول ، لكي يحد من أنحرافات المخيال الاجتماعي والديني ، ولكي يخفف من حدة التلاعبات ذات الأهداف الإيديولوجية إن هذا الصراع المر يخترق تاريخ كل النصوص التأسيسية الكبرى ويقع في الصميم منها ، وبالتالي فهو يتدخل في انتاج المعنى وآثار المعنى، التي تتحكم دائما بتشكيل الذات وعملها أو طريقة فاعليتها وانفعالها في هذا الوجود ، ينبغي أن نذكر هنا أن هناك عدة قراءات للقرآن ، فهناك أولا قراءة الفقهاء التي هدفت الى استخراج القوانين أو الأحكام القضائية التي أصبحت فيما بعد القانون الإسلامي أي الشريعة ، والشريعة ملزمة للجميع بشكل قطعي ، ولكن باستثناء هذه القراءة فإن التفاسير الأخرى لم تؤثر على عامة المسلمين ، ولا على عقائدهم المشتركة، ولا على طريقة التلقي الفردية للقرآن فتفاسير الأشخاص عالية المستوى لم تؤثر على كل ذلك، ولم تقرءها إلا النخبة المثقفة القادرة على فهمها.وذلك لأن جماهير المؤمنين مرتبطة عادة بالعواطف الانفعالية والذاتية وإكراهات التعبير عن الهوية والذات من خلال الجماعة، أكثر مما هي مشدودة الى شروحات العلماء وتفاسيرهم، فالآيات المحفوظة عن ظهر قلب هي في متناول الجميع وكلهم يستشهدون بها عفويا ومباشرة دون أن يلقوا بالا لسياقها الذي لفظت فيه لأول مرة، فهذا لا يعنيهم في قليل أو كثير ، كل ما يهمهم هو التعبير عن حالتهم الراهنة من خلال الآية المناسبة، ذات التعبير المقتضب والجميل والصحيح أبدا، لأنه هابط من عند الله ، إنهم يتلون الآية بشكل عفوي من أجل الصلاة أو من أجل التأمل في حالتهم الراهنة، أو من أجل فعل خير ما، أو من أجل تعزية النفس، والصبر على المكروه والنوائب والمآسي.. الخ.
إن الشخص بصفته ذاتا فردية مصطدمة حتما بتقلبات الحياة وهمومها يتشكل ويتفتح ، أو على العكس يغرق في الإستلاب طبقا لدرجة اقترابه من الخطاب القرآني بشكل عام، وطبقا لطريقة استعماله لنصوص أخرى متفرقة وتطبيقها على وجوده اليومي هنا والآن . قلت الأقتراب من الخطاب القرآني، وأقصد به، أن ملايين المسلمين لا يعرفون العربية ، والكثيرين من الناطقين بالعربية لا يسطيعون أن يفهموا لغة القرآن، وهي تشكل صعوبة بالغة لهم لذلك يكتفون بتلاوة القرآن موهمين أنفسهم بفهمه .
ولذلك يظل إنسان الميثاق المتعاقد مع الحي القيوم ... المتكلم الفاعل في التاريخ الأرضي ، من أجل توسيع وإغناء العلاقة المتبادلة بين الله والإنسان أو بين الإنسان والله ــ إنه يغنيها عن طريق منهجية تربوية ملئية بحب الخير ، وبفضل الغنى الكاشف للخطاب النبوي فإن الإنسان يترقى الى مرتبة الشخص عن طريق استبطان الله كمقابل حميمي ، ويحصل هذا الاستبطان عن طريق الصلاة وعمل الخير والتأمل في آيات الله وفك رموز كل هذه الأشياء يولد في قلب المؤمن شعورا بالذات ، وهذا الشعور مرتبط مع مطلق الله ، بصفته المعيار الأعظم والمرجعية العظمى .
والسؤال الذي أطرحه هنا: ماهي المتغيرات التي أدخلتها الحداثة بالقياس الى هذا النمط من الاستيقاظ وتحقيق الشعور بالذات، أين هو الشخص؟ ها ما سنحاول الإجابة عليه في المقال اللاحق.














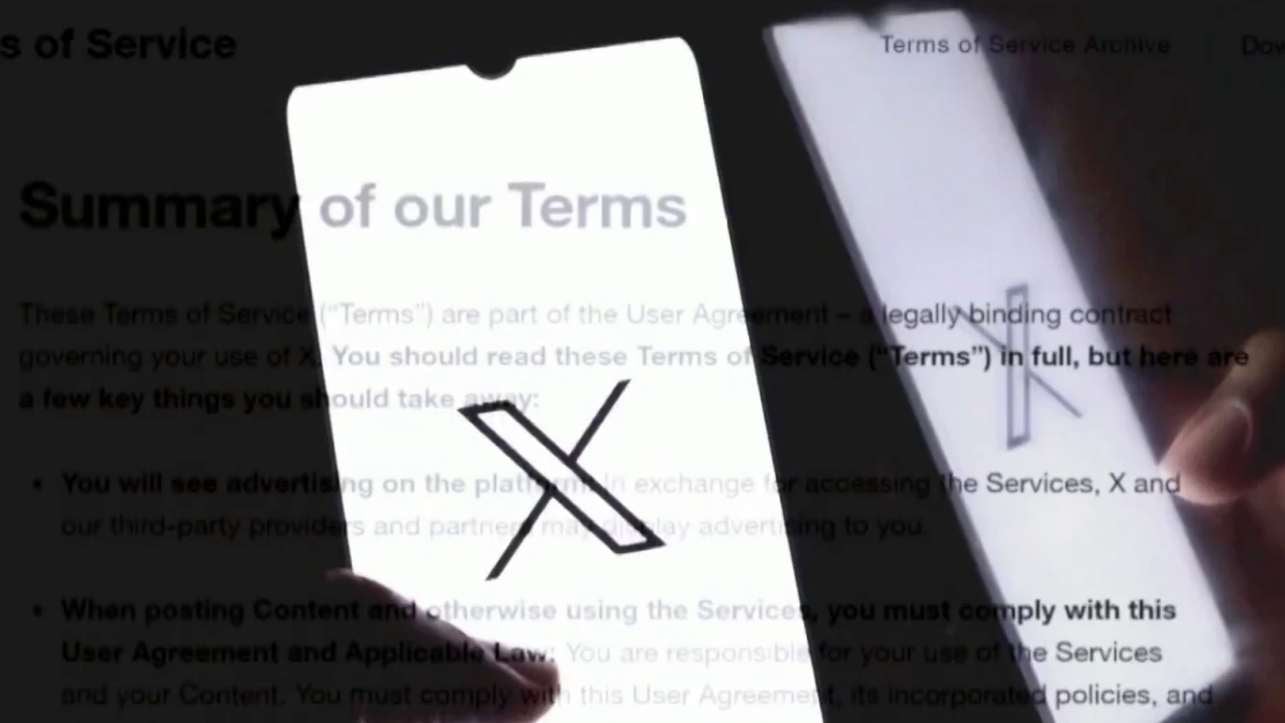





التعليقات (0)