الطائفية هي حزب أرضي يدّعي المُقدّس

الطائفية هي حزب أرضي يدّعي المُقدّس
حوار مع عمّار ديّوب
نادر المتروك
١٢ تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٩،
من الطّبيعي أن يخضع الوضع الخاص لمثقفٍ مختلف مثل عمّار ديوب لأكثر من معادلةٍ ضاغطة. في البيئة الخاصة، يصحّ الاستنتاج أنّ هناك أكثر من مولِّد تحفيزي لإنتاج أنماط تحوّليّة داخل الفكر السّوري المعاصر، كما يعبّر عنه ديوب، ولكن ذلك يُواجَه بعلاماتٍ عكسيّة من جانب البيئة العامة، وهو ما يُفسِّر اللّجوء الاضطراري إلى التكتم عن تفاصيل الذّات أو البوح بها علناً، وذلك خشية الإكراهات غير المحتملة التي يفرضها الحقل العام وسلطاته القاهرة. سوف يكون ذلك أفضل المبرّرات لعدم اقتران هذا الحوار بصورةٍ تُفصح/تفضح الضّيف الكريم. في كلّ الأحوال، فإنّ المرمى دائماً هو خوْض مغامرات الجدل الفكري والاقتراب من الصيرورات غير الهادئة لأفكار المثقفين العرب المعاصرين. في الجزء الأول من الحوار، نتبادل مع ديوب أسئلة الدين والطائفية والحداثة وما بعدها في سياقنا العربي الإسلامي. يختصر ديوب جملة من الأفكار المركّبة بتأكيده على ضرورة التمييز «بين الدين وبين الطائفية السياسية، مضافاً إليها الأحزاب الدينية التي لا تعترف بالآخر أو تفرض اشتراطات دينية سلفاً، فالدين لا يفسر ذاته، وحين يفسره الرجال/الأحزاب، يفسرونه ابتغاءَ مصلحة سياسية محدّدة وغالباً ما تكون ضد مصلحة المجتمع، المتدينين قبل العلمانيين، والمؤمنين قبل الوضعيين». تتنوّع الكتابات التي تناولت موضوع الطّائفية في العالم العربي، فبعضها يقرؤها من منظورٍ شعبوي، فيتمّ الحديث عن الوحدة بين المسلمين ومخاطر التمزّق ومؤامرة أعداء الخارج في ذلك. كتاباتٌ أخرى تُبرِز الطائفيّة باعتبارها حركة «واعية» لمواجهة الاتجاهات العقلانيّة، فالطائفيّة في هذا المجال هي مشروعٌ يُدْرِك أصحابه أنّهم معنيّون بتفجير الخصوصيّة المذهبيّة لأجل محاصرة أيّ مشروع للدّولة الحديثة وقيامة المجتمع المدني. كتّاب حداثيون أرادوا معالجة المسألة الطّائفيّة بالحديث عن العلمنة، وكان ثمّة سعي جاد لإرهاق العَضَلة التي تنهض بها القوى الطائفيّة مقدمةً للتأكيد على استحالة بناء مجتمع معاصر من دون قيم علمانيّة. في هذا السّياق، تبدو كتاباتكم في هذا الشّأن مهجوسة بالمنظار العلماني، أولاً وأخيراً. ما تعليقكم على كلّ ذلك؟
لنفرق بداية بين الدين والطائفة والمذهب، باعتبارها تشكيلات فكرية واجتماعية متوراثة وقديمة، يؤمن بها الناس بصورة مستمرة ومنذ أن وجدت الأديان على وجه البسيطة. وهو، في اللحظة الراهنة، لا يتضمن سعياً إلى الوصول إلى السلطة السياسية، بل هو شأن خاص و«إيمان» محصور في الأفراد أو الطوائف الدينية، المتمايزة في اعتقاداتها. ولكن الطائفيّة المطروحة مشروعاً سياسيّاً، أو على أرضية حزب سياسي، أو تلك التي تقدِّم نفسها مشروعاً عاماً للمجتمع، فهي طائفية سياسيّة، وهي إمّا أيديولوجيا، أو علاقات اجتماعية أو حزب سياسي، وتسعى لأن تكون النظام السياسي للبلد، أي تسعى إلى فرْض رؤيتها على الدولة، وهي بكلمةٍ محدّدة: حزب أرضي يدّعي المقدّس، ويُصادر على المجتمع إيمانه الشعبي الموروث، ويُسيّس الوعي الديني العام، بل ويبتزّه كي يقف إلى جانبه. هذه الرؤى الطائفيّة مآلها جزء من النظام السياسي أو النظام السياسي برمّته، وهذه لا تمتلك أي مشروع حقيقي للمجتمع، اقتصادياً أو سياسياً واجتماعياً، وربما تحاول احتجاز المجتمع وتكبيل البشر في إطار معتقدات دينية سياسية، مستفيدة منها للوصول إلى السلطة، وهذا يتناقض مع الدين نفسه، لأنه لا يُحْصَر بحزبٍ ما، ويتناقض مع إيمان الناس الطبيعي، فهذا الأخير، إيمان يفصل بين الدين والسياسة أو الدين والعلم أو الدين والاقتصاد، وغير ذلك. وبالتالي بتكريس الرؤية الطائفيّة يتشظى المجتمع إلى مجموعاتٍ وكانتوناتٍ طائفية. ويمكن اعتبار الطائفية أفضل طريق «يُدْرِك أصحابه» نحو الحرب الأهلية، فلنتأمل لبنان أو العراق أو أفغانستان أو الصومال، كلها دول فاشلة ودولة ترتد إلى التخلف لا التقدم، إذاً هي رؤية تبتغي تخريب الحداثة العربية على علاتها. العلمانية حيادية تجاه الأديان وكيف تشرح موقف العلمانيّة من هذه التشكيلات؟ وكيف يمكن الجمع بين حقّ الهويّات الفرعيّة في الظهور والإفصاح عن ذاتها، واعتبار ذلك مكسباً تمنحه علمنة المجتمع، وبين المخاوف المتناميّة، وأحياناً الإفصاح الصّدامي، تجاه التمظهرات الطائفيّة بوصفها إعلاءً وإعلاناً لهويّة خصوصيّة؟
العلمانيّة بالمقابل، تتحدّد بالحياد العام للدولة تجاه الأديان، وتجاه رجال الدين، وتنزعُ عنهم إمكانية تشكيل سلطة دينيّة، وتتيح السّماح لجميع البشر بممارسة شعائرها الدينيّة وعدم التدخل بذلك، وبعيداً عن الخلط بين الدين والسياسة، فهما حقلان منفصلان تماماً. وتعدّ العلمانيّة النظام الوحيد الذي يسمح للجماعات الدينية بممارسة شعائرها بشكل حر، وهو ما يحوّل الدين إلى منظومةٍ أخلاقيّة لصالح البشر كافة، وبالتالي لا مفرّ أمام العرب، إذا أرادوا التقدّم، من أنْ يحزموا أمرهم، ويتخلّصوا من تشويه العلمانية، ويعملوا نحو تبني قيمها، وبذلك يحافظ الشعب على هويّاته الفرعية/الدينية، وفي الوقت ذاته ينتمون إلى كليةٍ وطنية جامعية تنصف جميع الأفراد، بعيداً عن صرخات ودعاوى التمزق بين البلاد العربيّة. مشروع الحداثة العربية أثبت فشله السّجالات التي تفجّرت عربيّاً قبل عقدين بشأن الحداثة، وانتهت للحديث عن النّهايات والمابعديّات، توحي بأنّ المثقف العربي والمسلم (في العالم العربي خصوصاً) كان غالباً بصدد إعادة إنتاج الآخر، بما في ذلك مشروعات النقود المعنيّة بالعقل العربي والإسلامي، وهو أمرٌ حفّز بعض المتابعين إلى اعتبار أنّ مشروع الحداثة، ومتتالياتها، كان حالاً من اثنين: ردّ فعل ضد انتماء سابق، أو صدمة أمام الاكتشاف الجديد. اليوم، بأي أفق يمكن الحديث عن الحداثة في واقعنا العربي والإسلامي؟
لاشكّ أن مشروع الحداثة العربية أثبت فشله في أكثر من ميدان، وأتى النقد العقلاني العربي، ليُكمل ذلك الفشل؛ لأن النقد الحداثي، إنْ لم يتزامن مع صعود حركة الحداثة، فقد يُساهم في الإمعان في فشلها. في المقابل، تصاعد مع ذلك الفشل، المشروعُ السياسي الديني - وهو أحد أوجه ما بعد الحداثة في عالمنا العربي! - ولكن الأخير لم يملك رؤية كليّة للمجتمع، بل رؤيّة دينيّة سياسيّة عصبويّة بهدف الوصول إلى السلطة، وقد استفاد من عطاءات السلطة بشكل متواصل، وصولاً إلى لحظة القطع والخلاف، وسنّ الرماح، فتبدأ الحرب مع النظام الحاكم. لاحظ هنا أن النظام اليمني هو منْ صنع الحوثي، وخاضَ بعدها ستة حروب. والأمر نفسه عن علاقة السعودية بالقاعدة. أريد القول: إنّ منْ تبنّى مشروع الحداثة العربيّة، لم يقطع مع المشروعات السياسيّة الدينيّة، وهذه الأخيّرة أيضاً، لم تقطع معه، وكانت التحالفات هي الأساس وليست القطيعة. أيضاً، الحداثة العربيّة لم تكن انبهاراً بالحداثة الغربيّة، فالأخيرة نزوعٌ عالمي شَمَل مغرب الأرض ومشرقها، وبالتالي الحداثة نمط عالمي لا يمكن لشعب الخروج عنه إلا بالوهم، بل إنّ وهم الخروج عنه، يعدّ بمثابة شكل من أشكال الوعي الحداثي، أي أن الحداثة تؤدي في وجه منها إلى وهم الخروج عنها، خصوصاً إذا ارتبط الوهم بمشروع سياسي متخلّف، يتصوّر نفسه بأنّه يمثل الخصوصية والجوهرة للتاريخ المتوارث المستمر من دون قطيعة. هل تأتي ما بعد الحداثة في هذا السياق أيضاً؟
فلسفة ما بعد الحداثة، هي جزء من مشروع الحداثة ذاته، وإن كان عبر نقده. فهكذا حداثة تتطلب ما بعد الحداثة، أي هكذا إمعاناً في الإفقار والاستغلال والقمع وتدمير البيئة؛ تتطلب رداً كاسحاً ضد العقل، والصناعة، والسياسة الأحادية، وغير ذلك، وهذه فلسفة تنظّر إلى ما هو أكثر من ذلك، وصولاً إلى موت الإنسان، أي موت كلّ فعل تغييري يقوم به البشر، والدعوة إلى العودة إلى الدين، كي يكون ممكناً التخلص من مشروع الحداثة. ولكن المفارقة، أن البشرية لا يمكنها ترك منجزات الحداثة، ولكنها أيضاً، لا يمكنها الصمت عن سلبيات الحداثة، ولكن هذا لا يدفعنا إلى الأخذ بالدين حلاً لتلك المشكلات، لأنّ الدين قيم أخلاقية عظيمة، أما مشكلات المجتمع فتتطلّب حلولاً وفق العلوم الحديثة في الاقتصاد والسياسة والثقافة والعلم والصناعة والملكية وغير ذلك. المشروع الرأسمالي والردة الدينية المحافظة ما هي إذاً الآثار التي جلبتها الحداثة العربية؟
لنقل إن الحداثة العربية لم تجلب التقدّم، بالمعنى الأوروبي؛ لأن الحداثة الأوروبية جلبت التقدم العام، وأحدثت قطيعة كاملة مع بُنى العصر الوسيط الدينية. ولكن هل هذا يعني أن العرب أنتجوا الآخر في بلادنا؟ لا أعتقد ذلك أبداً، ولنأخذ العلمانية أو النظام الديمقراطي أو الثورة الصناعية، فهل حدث منها شيء؟! إذاً لم تُنقل الحداثة الغربيّة، ولم تكن حداثتنا لا ضد الماضي ولا انبهاراً بالحداثة الأوروبيّة، بل تصالحت مع الاثنين وشوهتهما معاً! تجربة الحداثة أوروبيّاً وعربيّاً، وُجهت لها انتقادات كثيرة، ولو حدّدنا الحداثة أكثر، لقلنا إن المشروع الرأسمالي الحامل لمشروع الحداثة، أصبح في مأزق عالمي كبير، وليست الأزمة الاقتصاديّة إلا وجهاً منه، وهو يبشر برّدة دينيّة محافظة عن قيم التنوير والنهضة الأوروبيّة، ولم تعط الحداثة الاشتراكيّة مثالاً أفضل، أما تسيّيس الدين فهو الآخر، أظهر عقم انقطاعه عن روح العصر؛ أقصد تجافيه عن روح التقدم العام. حداثة الدولة المواطنية هل ثمّة تموضعات (مشروعات) جدّية لتقديم القيم والمبادئ الحداثيّة في هذا الواقع.. أمّ أنّنا ملزمون بالتخلّي عن وهم «الخصوصيّة» نهائيّاً، والاعتراف بعالمية المشروع الحداثي؟
حدوثُ تقدّم في بلادنا العربيّة، أمرٌ متعذر، من دون مرتكزات مشروع الحداثة الأوروبيّة. يسميها بعض المثقفين، مشروع الاستغراب في الحداثة الأوروبيّة والعمل على مفْهَمة ثوراتها المتتالية، وتفهّم أزماتنا العربيّة وصوغ مشروع ثقافي سياسي قادر على إنجاز التقدم العربي. إذاً، لا يمكن إحداث حداثة عربيّة بعيداً عن قيم التنوير، كما النهضة الأوروبيّة، كما الثورة الصناعيّة، وبالتأكيد الانتقال إلى النظام الديمقراطي المواطني، مع الاستفادة من قيم المساواة وإلغاء الاستغلال والظلم المأخوذة من الفكر الماركسي. وبالتالي حداثة عربيّة ممكنة هي حداثة الدولة المواطنيّة، الدولة التي لا تميّز بين أفرادها على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو الملكية. حصيلة التحليل، لا توجد خصوصية تعيد الماضي حاضراً، فالحاضر يتحكّم بكلّ شيء، بما فيه استعادة الماضي بصورةٍ ما، وبالتالي لا مشروع عربيّاً خارج المشروع الحداثي العالمي، وموقع العرب منه هو التميّز فيه على قاعدة الحداثة حصراً. وهذا مختلف كليّة عن فكرة الخصوصية، التي لا تستفيد منها سوى الأنظمة أو الطائفيّة السياسية الساعية إلى إلغاء المجتمع وإعلاء المشروع الحزبي، وبتحقق ذلك تتحقق مصالح الفئات التجارية.
الإصلاحُ الدّيني لا يكون على أرضيّة الدّين
من الطّبيعي أن يخضع الوضع الخاص لمثقفٍ مختلف مثل عمّار ديوب لأكثر من معادلةٍ ضاغطة. في البيئة الخاصة، يصحّ الاستنتاج أنّ هناك أكثر من مولِّد تحفيزي لإنتاج أنماط تحوّليّة داخل الفكر السّوري المعاصر، كما يعبّر عنه ديوب، ولكن ذلك يُواجَه بعلاماتٍ عسكيّة من جانب البيئة العامة، وهو الأمر الذي يُفسِّر اللّجوء الاضطراري إلى التكتم عن تفاصيل الذّات أو البوح بها علناً وذلك خشية الإكراهات غير المحتملة التي يفرضها الحقل العام وسلطاته القاهرة. سوف يكون ذلك أفضل المبرّرات لعدم اقتران هذا الحوار بصورةٍ تُفصح/ تفضح الضّيف الكريم. في كلّ الأحوال، فإن المرمى دائماً هو خوْض مغامرات الجدل الفكري والاقتراب من الصيرورات غير الهادئة لأفكار المثقفين العرب المعاصرين. نفتح في الجزء الأخير من الحوار مع ديوب ملف ’’التعليم الدّيني’’ الذي مرّ بأكثر من جدال، ويكاد يكون من المؤكّد أنّ هذا الملف هو الموضوع المشترك في كلّ مناقشةٍ تتناول طبقة رجال الدين المسلمين، حيث تُمثّل مؤسّسات التعليم الدّيني المكوّن الأساس لهذه الطبقة، ومن خلالها يتمّ إسباغ المواصفات والتراتبيّات أو نزْعها. وبخلاف ذلك، فإن المجموعات الدّينيّة الجديدة، بما فيها ذات النّزعة الإصلاحيّة، تعتبر أنّ أيّ تقدّم إصلاحي من الدّاخل لابد أن يمرّ على التعليم الدّيني؛ نقداً وتقييماً.
من خلال رؤيتكم الخاصة، كيف تقيّم مجمل التعليم الدّيني في العالم العربي والإسلامي؟ وهل يمكن الحديث عن إصلاح لهذا التّعليم، أم أنّ المسألة باتت مستحيلة وغير مجدية؟ ما تعليقكم على المنهجيّات الحديثة (الإصلاحيّة) التي تُطرح في بعض البلدان، ومن قِبل بعض الإصلاحيين، على مشروع التعليم الدّيني؟ هل بالإمكان الحديث عن علمنة للتعليم الدّيني؟
لا يمكن الفصل بين جزئية وجزئية في أيّة دولة، فالسياسات العامة للدول العربيّة، تشمل كلّ مستويات الدولة، فإذا كانت الدولة هامشية ومتخلفة، فإن التعليم، ليس الديني فقط بل كل التعليم العربي، متخلف وزائد عن الحاجة، وربما وظيفته الوحيدة تتمثل في منع تشكّل عقل عربي ناقد ومنفتح وعلمي ومطابق للعصر، أي للتقدّم المستمر، لذلك يُشكل التعليم الديني واحدة من الأدوات الأيديولوجية للنظام السياسي العربي، بقصد مواجهة الوعي التقدمي على اختلاف أشكاله، بما فيه الوعي الدّيني الشعبي، أو الوعي الدّيني العلماني، أي الذي يفصل بين الدين والسياسة، ويقدم رؤية مختلفة باختلاف مواقع العمل أو الحياة. التعليم الديني ورغم أنّه جزء من سياسات الدولة العربيّة، يعبّر أيضاً عن هامشية مشروع الحداثة العربيّة، مقارنة بمشروع الحداثة التركية مثلاً، ويدلّل بوضوحٍ شديد، على الدور التدميري للنظام العربي لمشروع الحداثة ذاته.
التعليم الدّيني يُكرّس الطائفيّة
منْ الذي يتمصلح أو يستفيد من هذا الوضع السّيئ للتعليم الدّيني؟ وكيف يمكن إصلاح هذا الوضع؟
الذي يستفيد من التعليم الديني في ظلّ تراجع الدّولة العربيّة هي المجموعات الدّينية التي سريعاً ما تتحوّل إلى حزبٍ سياسي محافظ، يمارس العنف ضد المجتمع والدولة ذاتها. إصلاح التعليم الديني، لا يكون بتعليم ديني جديد، لأنّ أي تعليم ديني جديد سيكرّس السياسة الطائفيّة، وبالتالي - ربما لديّ رأي حاد قليلاً - إذا أردنا أن ندخل الدين في التعليم يجب تحويله إلى منهاج ثقافي ديني، يقدّم رؤية وأفكاراً وتحليلات عن الديانات السماوية بأكملها، وبالمقابل يتكفل الأهل ودور العبادة بالتعليم الديني الخاص.
هل يمكن أن يتم ذلك بلا ممانعة أو اعتراض؟
هامشية الدولة العربية ستمنع بالتأكيد هكذا تفكير، وستستمر بالتعليم الديني على حاله، وربما تخضع للشروط الدوليّة ’’الأميركيّة’’ المنادية بإصلاح التعليم الديني بشيء من ذلك، ولكنّه لن يكونَ إصلاحا للتعليم يصل إلى تعليم ديني علماني كما أشرت إليه. وأود القول إنّ الشروط الأميركيّة، لا تتكلّم أبداً عن وضع التعليم العام، وكأنّه بخيرٍ، بينما فقط، التعليم الديني هو الذي يعاني من المشكلات، وهو ما يظهر زيف تلك الدعاوى ومدلولاتها السياسية. ونفس الشيء يمكن قوله عن من يطالب بالحفاظ على التعليم الديني في حالته الراهنة’’ بعجره وبجره’’، ويُكفّر كلّ منْ يُنادي بإصلاحه، رغم أن إصلاحه كما إصلاح التعليم بكليته، أحد المداخل للإصلاح العربي الشامل.
الإصلاح الدّيني والإسلامات المتعدّدة
لديكم قراءة مركّبة لمسألة الإسلام الواحد، والإسلامات المتعدّدة. هل يمكنكم تقديم توضيح لهذه القراءة من حيث كونها واقعاً تاريخيّاً، وفي نفس الوقت لا تدخل في نطاق الخروج التحريفي عن الدّين؟ هل توافقون على الرّأي الذي يذهب إلى أن البوابة الأساسيّة - أو إحداها - للإصلاح الدّيني هو الاعتراف بالإسلامات المتعدّدة؛ واقعاً وفكراً؟
لا يوجد شيء اسمه إسلام واحد، سوى في أذهان منتجي الرؤية الدّينية السّياسية حصراً، حيث تنزع نحو الواحدية والانغلاق وتأثيم الكل، وتكفير كلّ منْ لا يوالي ذلك الحزب السّياسي. هنا لا أفرّق بين حزب ديني متشدّد وحزب ديني أقلّ تشدداً، وربما يكون السبب حجم التخلف المريع الذي تعيشه الشعوب العربية، فكلما انحطت المجتمعات انحطتّ الأفكار والمشروعات السياسية. وفي هذا تأتي النزعة الدّينية السّياسية، التي لا تمثل إطلاقاً الدين، ولا الدين الشعبي، بل تمارس تشويه الكلّ الديني’’المقدس والشعبي’’ لصالح الحزب الدّيني السياسي.
ما هو الرّابط التاريخي لهذا التحليل؟ هل هناك امتدادات سابقة؟
تاريخياً، أي بعد أن جاء الدين الإسلامي، تشكّلت فرق دينية متعددة، وهي الأحزاب السياسية في العصر الوسيط، ولاحقاً تشكّل فسيفساء متعدّد جداً من الحركات والمجموعات التي تنسب نفسها للإسلام، بل إن بعض الطوائف الدينية الإسلامية تعتبر نفسها خارج الإسلام. وبالتالي كلّ ما يُنسب نفسه إلى الدين الإسلامي من حركات هي حركات الإسلامية، وبالتالي الإسلام إسلامات متعددة، ولا يمكن حصره في إسلام واحد، إلا إذا أردنا التنظير لحروبٍ أهلية دينية في كلّ منطقة يوجد بها مسلمون. وهذا ما يحدث على كلّ حال في كلٍّ من باكستان، واليمن، وأفغانستان ولبنان. إذن كلّ كلام عن إسلام واحد كلامٌ سياسي ورؤية قاصرة واستبدادية وإقصائية وخارج عن روح العصر، وهي رؤية عصبويّة خاصة بجماعاتٍ بشرية محدّدة، محتواة في حزبٍ ديني ما، أو مجموعات ذات روابط طائفية.
الإصلاح الدّيني هو ما يُقدّمه المثقفون الأحرار
أين مسارات الإصلاح الدّيني في ظل ذلك؟
الإصلاح الديني، على أرضية الدين غير ممكن، فالدين لا ينطق بذاته، بل مصالح البشرية هي من ينطّق الدين، وهذه المصالح، يقول البعض عنها أنّها مصلحة المسلمين، أو مصلحة الوطن، أو مصلحة الطائفة، إلى غير ذلك. ولكن كل ذلك لا يعدو عن كونه تأويلاً بشريّاً محدّداً بأفراد محدّدين، أي هو تفسير قد يخطأ وقد يصيب، وأغلب الظن أنه يخطأ، لأن ذلك الإصلاح، مثاله الأعلى في الماضي، وليس في الحاضر أو المستقبل، ورؤيته لذلك الماضي رؤية مشوّهة، تنسف كلّ الحضارة العربية الإسلامية لصالح تفسير يتعلق بأسطورة العصر الذهبي، التي تفصلنا عنها قرون وقرون وتطورات لا متناهية حدثت في العالم العربي قبل حدوثها في كل أنحاء العالم. وبالتالي الإصلاح الديني الممكن هو ما يقدمه المثقفون الأحرار المستقلون عن التفكير السّياسي الديني، أمثال نصر حامد أبو زيد، محمد أركون، عبدالمجيد الشرفي، محمد عابد الجابري، وغيرهم، وهؤلاء لا رابط بينهم وبين أية رؤية دينية سياسية لحزب سياسي طائفي ما، والطائفي هنا، ليس ضد طائفي آخر، بل ضد أغلبية المجتمع، أي أنّ كل حزب ديني هو حزب طائفي بالضرورة حتى لو كان كل الشعب من دين واحد. على كلٍ، أبسط الإيمان، أن يتم الاعتراف بالطوائف الإسلامية الأخرى، والاعتراف بكل التيارات الفكرية سواء أكانت دينية أم علمانية، فهذا ربما يشكل المدماك الأول نحو مجتمع عربي متقدم، وإلا فإن الصوملة على يميننا والبلقنة على شمالنا، وربما تكون اليمننة أمامنا!
ــــــــــــــــــــــ
المصدر : جريدة الوقت، البحرين
منشورات الطليعة العربية في تونس

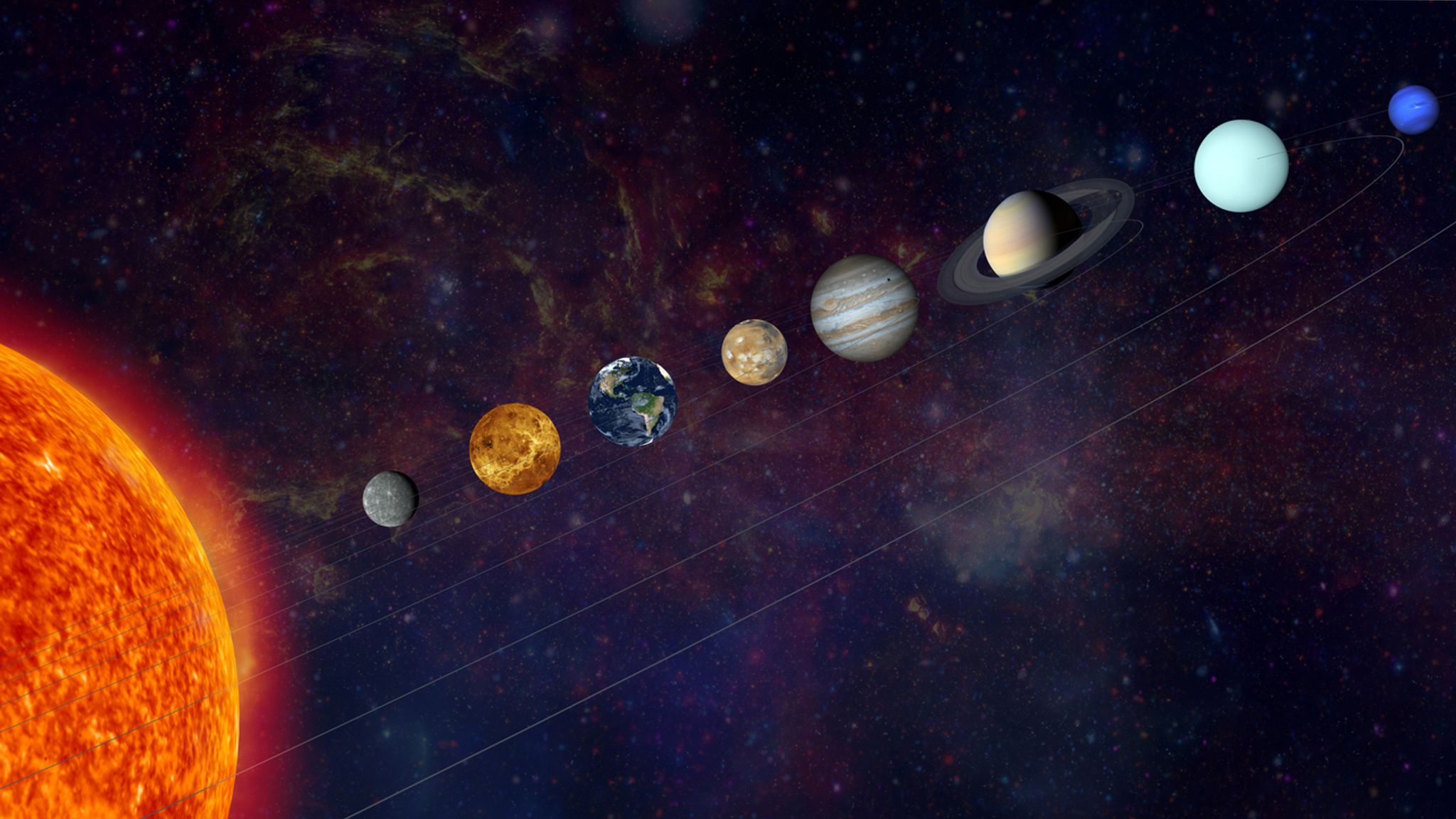





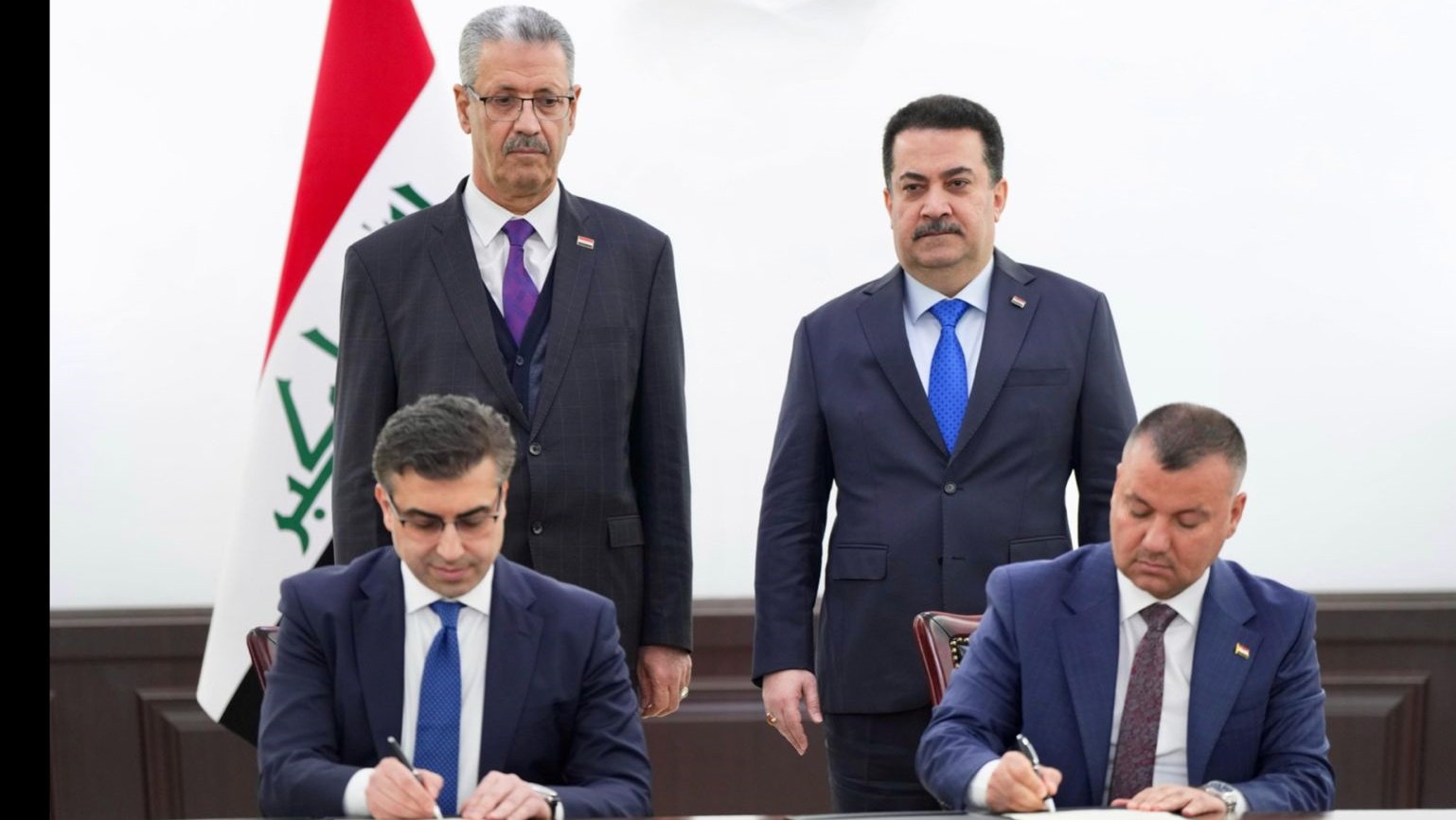

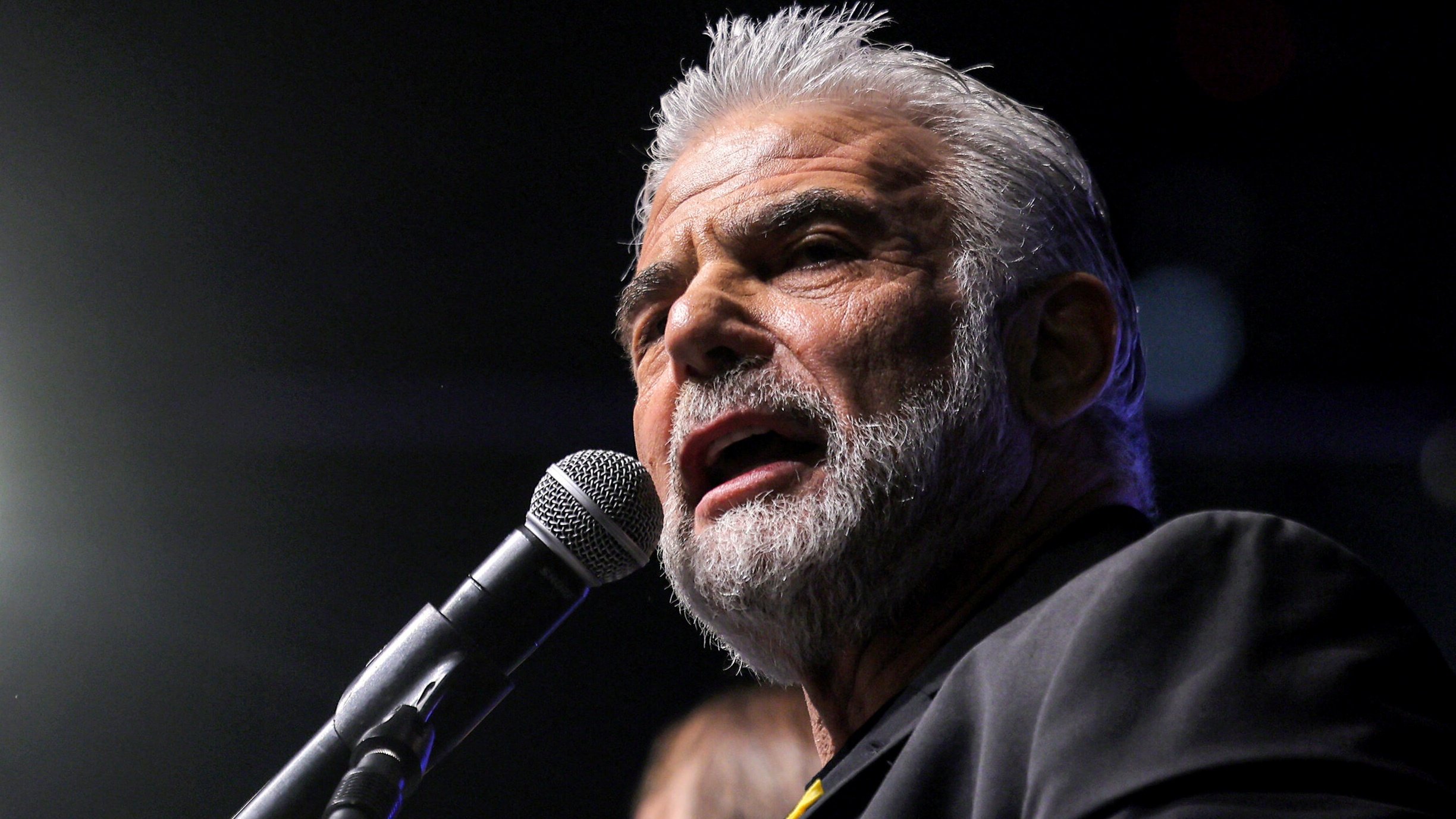










التعليقات (0)