الأمن والخطر بين النفسي والسياسي

بقلم/ مـمدوح الشيخ
mmshikh@hotmail.com
في حياة الأفراد ينبع الإحساس بالأمن والخطر غالبا من مصادر نفسية، والأمم كالأفراد تستشعر الأمن والخطر، ولكل أمة معايير لاستشعار الخطر والإحساس بالأمن، وهي معايير تعكس حقيقة ثقافتها وتكشف مكامن القوة والضعف في هذه الثقافة، وهي كذلك ثمرة مفهومها للقوة والضعف ومؤهلات بناء المستقبل الأفضل. والمقارنة بين عالمي الشمال والجنوب تؤكد هذه الحقيقة، ومشهد استشعار أمة ما للخطر يستحق التوقف والتأمل.
ومن الأدبيات الأمريكية الشهيرة في هذا السياق قول فريدريك تيلور أبو الإدارة العلمية الحديثة تعبيرا عن تقديره لقيمة النظام: "خذوا منا كل شيء واتركوا لنا النظام". ومن القيم التي تؤكد تجربة الغرب أنها ركيزة أساسية لمستقبل أفضل "استقلال القضاء"، فعندما كانت لندن تحت القصف الألماني، ورفعت وزارة الدفاع البريطانية دعوى لهدم بعض البيوت المجاورة لمطار حربي فرفض القضاء البريطاني دعوى الهدم، لجأت الوزارة إلى تشرشل لاتخاذ إجراء استثنائي بسبب ظروف الحرب، وقد قال السياسي البريطاني المخضرم جملته المشهورة: "أن تخسر انجلترا الحرب أهون عندي من أن أمتنع عن تنفيذ حكم قضائي".
وقد تراجع الوزن النسبي لمؤشرات قوة الدولة في علاقتها بمواطنيها لتصبح الأولوية للقدرة التنافسية للدولة، وهي مرهونة، أولا، بإتاحة مناخ ملائم للأفراد والجماعات، وبالتالي تحل الكفاءة محل التمترس خلف الهوية وتحل "ثقافة الإنجاز" محل "ثقافة الاعتزاز" ويصبح بناء الحاضر أكثر حضورا من التغني بأمجاد الماضي. ولبناء الحاضر لم تعد القوة مفهوما تبسيطيا مخلا يضع ما هو مادي في أولا. فالأفكار والمعايير والأشكال التنظيمية هي في عالم اليوم ثروات مهمة. وقد بدأ العالم يتجه بقوة لإحلال الثروة البشرية والاستثمار فيها محل فكرتين سيطرتا طويلا على العقل السياسي هما: التركيز على الثروات الطبيعية والنزوع المبالغ فيه نحو تعظيم القدرات العسكرية. وبالتدريج حلت المدارس والجامعات ومعامل الابتكار محل الثكنات العسكرية وقلاع الصناعات التقليدية. وفي مرحلة تالية بدأ سباق لترقية "المعايير" في الساحة التربوية في سياق العولمة. وما يشهده العالم من تغيرات هائلة متسارعة في المجالات كافة يدعونا لبلورة معايير صارمة للتعليم لملاحقة هذا التقدم فائق النوعية. وقد انتقل مصطلح المعيار لمجالات العلوم الاقتصادية والاجتماعية وبعدها للعلوم النفسية والتربوية.. ..كما يستخدم المعيار في تقدير متوسط الدخل ونسبة النمو الاقتصادي ومدى توازن ميزانيات المؤسسات والدول. وقد بدأت دول الشمال في وضع توصيف دقيق لضبط ما يجب أن يكون عليه الحال، ويعد هذا التوصيف تعريفا جامعا مانعا للمستويات التي ينبغي الوصول إليها، بوصفها محكات يقاس في ضوئها مستوى تقدم أية أمة في التعليم.
ومن الحقائق الجديرة بالتوقف أمامها أن فكرة المعايير نشأت في لحظة استشعرت فيها القوة الكبرى في العالم شيئا من الخطر، فقد شهدت أمريكا عام 1957 ولادة "حركة تحديث بنية العلوم" بعد نجاح الاتحاد السوفيتي في إطلاق أول صاروخ في الفضاء، ودعت هذه الحركة لإعادة النظر في بنية العلوم كلها، وشاع وصف "جديد" لمناهج المواد المختلفة. كما كان التقرير حول واقع التعليم الذي قدم لريجان " أمة في خطر" 1981 من المبادرات التي رسخت اتجاه اعتماد المعايير في تطوير التعليم. وكان هذا التقرير وثيقة ذات أهمية استثنائية، وفي عهد جورج بوش (الأب)، عقدت في سبتمبر 1989 "قمة تربوية" حضرها الرئيس وتمت فيها الدعوة لإعداد أهداف تعليمية من شأنها أن تحقق لأمريكا موقع الصدارة عالميا. وصدر بيان رسمي يذكر الأهداف التي يجب أن يتوخاها نظام التعليم الأمريكي.
وفي روسيا شهد هذا العام – بحفاوة كبيرة – ميلاد كتاب مدرسي جديد للتواكب مع المستوى الذهني للقرن الجديد، والكتاب عنوانه "الابتكار الحي: التفكير في القرن الحادي والعشرين". وهو لا يساعد على دراسة الموضوعات الطبيعية وحسب، بل الإنسانية أيضا. والكتاب يؤسس لمفهوم جديد للابتكار. فمثلا، بعد أن ظل اسم مثل "ماكدونالدز" رمزا للأمركة أصبح نموذجا للابتكار في عالم البزنس، ويصفه مؤلف الكتاب بأنه "أعطى تأثيرا مذهلا". والكتاب يضع الإدارة الناجحة في ترتيب الأهمية في مكانة لا تقل عن الابتكار. وهكذا، بعد سبعين عاما من التطبيق الاشتراكي وعشرين عاما من التأرجح بين بقايا رأسمالية الدولة واقتصاد مختلط تقليدي البنية، تعود موسكو للاعتراف بصحة ما قرره أبو الإدارة العلمية الحديثة من أن "النظام" بحد ذاته ثروة وأن الابتكار طريق للمستقبل.
ويبقى السؤال: كيف تستشعر أمتنا الخطر....وكيف تستجيب له؟

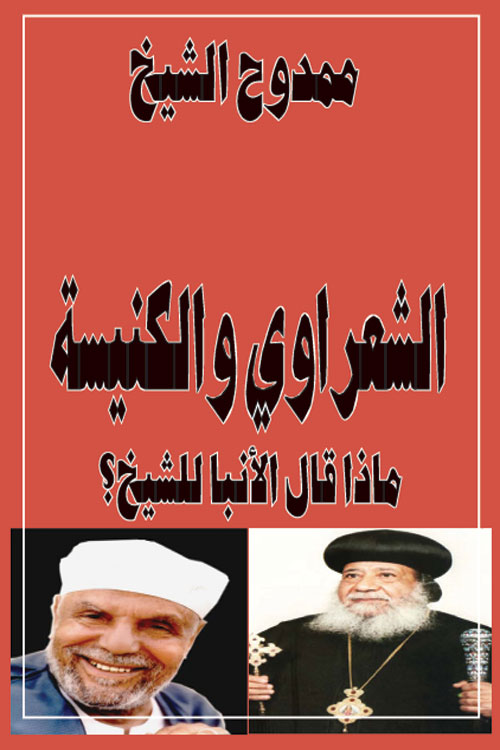


التعليقات (0)