الأساطير الدينية وخيال الشعوب

الأساطير الدينية وخيال الشعوب
بدايتا لا بد من التنبيه إلى إن مراجع ومصادر هذا المقال كانت طويلة وكثيرة ومتشعبة مما يصعب علينا ذكرها جميعآ.....ونقدم أعتذارنا لكل من أقتبسنا منه ولم نذكر أسمة أو اسم كتابة أو مقالة.
وثانيا ما دعاني لعمل هذا البحث هو الرؤية التالية التي قراتها في كتاب الدكتور «أحمد كمال زكي» صاحب باسم «الأساطير» حيث أكد بان معاجمنا اللغوية تقف عاجزة ـ عن إعطاء المدلولات الحقيقية لكلمة الأسطورة.. فالأساطير في هذه المعاجم هي «الأحاديث التي لا نظام لها» وهى «الأباطيل والأحاديث العجيبة» و«سطر تسطيرا ألف وأتى بالأساطير»، والأسطورة هي «الحديث الذي لا أصل له».وقد استعمل القرآن الكريم لفظة الأساطير فيما لا أصل له من الأحاديث.. قال تعالى: «وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلا أَسَاطِيْرُ الأَولِيْن» (سورة الأنفال: 30).
وقال جل شأنه: «وَقَالُوْا أَسَاطِيْرُ الأَولِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَة وَأَصِيْلا» (سورة الفرقان: 5).
فكيف نفسر تشابه الأساطير في أقصى الأرض الى أقصدها، خاصة وأن التشابه يتجاوز حدود الوحدة الثقافية الموجودة في الاديان السماوية ؟ ليطال العالم كله هذه المرة ؟ وهل ان هذا التشابة يجد تفسيره في بنية الوعي البشري والتي هي بنية أسطورية منطقية تفعل فعلها على صعيد الفكر الأسطوري والفكر العلمي على السواء. وليس على صعيد الأسطورة المرجعية التي يحلو للانسان الركض وراءها ووراء سرابها الأيديولوجي.
مثلا فلنبدأ في الانجيل المسيحي لايوجد شئ يذكر عن زوجات قابيل وهابيل ولا شرح ديني، الا ان الاساطير الباقية تحتوي الكثير عن الزواج بين الاخوة والاخوات. واغلبها تنطلق من انه في البدء لم يكن هناك إمكانية ولا مجال للاختيار وبالتالي اضطرت الاديان الى التسليم بتحليل الحرام الذي كان امر مقضيا واستثنائياً، ولكن اغلب الاساطير تعود لتحرم زواج الاخوة والاخوات، عدا بعض الاساطير التي استثنت الاشخاص الذين لهم مستويات الالهة (الفراعنة ومثال كليوبترا. على الاغلب معظم الالهة كانت ذكور ولكن هناك بعض الاناث وخصوصا ان عملية الخلق الاول تحتاج الى توالد من اجل اسكان الارض الفارغة وايجاد العناصر التي تحمل روح الآلهة او صفاتها (راجع اسطورة خلق يسوع والعذراء الانسانة التي حملت نطفة الآلهة) ونعود الى الالهة الاناث التي لم تكن خجولة وضعيفة وخاضعة، لقد كان هناك الكثير من الالهات التي بحثوا عن الجنس وقاموا بالاغتصاب والاغواء بتصرفات لم تختلف عن تصرفات الذكور(اساطير الاغريق.
الاساطير كلها تمتلئ بالحيوانات الناطقة ولم يكن الخلاف كبيرا بين ادوار ومستويات الحيوانات واختلافها عن البشر. فأتت الديانة المسيحية والاسلامية لتحل القضية باعطاء التفويض من الرب المقدس للانسان ليسيطر على الحيوان وسخر له موارد الارض والبيئة لمتطلباته.
الحية الافعى موجودة في الكثير من الاساطير، حيث تكون في قسم منها ممثلة للشر كما في اساطير شعوب الشمال او اساطير المسيحيين والاسلام (حيث الحية حملت ابليس الى الجنة ليغوي حواء وآدم) او تكون ممثلة للبطولة كما لدى شعوب استراليا الاصليين.
الأهم الان.. برأيي هو جذور دور الماء في الأساطير الدينية والتي كانت مدخلا لاقتناعي بان الاديان هي مجرد تطور فكري ومنهجي للشعوب تأثرا بالبيئة المحيطة بها وبحاجاتها الاجتماعية... الماء الذي جعل الله في الاسلام منه كل شيء حي.. كان هو مصدر الوجود او مسكن الآلهة عند معظم الاساطير.. نذكر منها على سبيل المثال الفرعونية والسومرية (معظم حضارات ما بين النهرين) السومريين خاصة اسسوا لنظرية الاسطورة القائلة بان الماء هو سبب الحياة والوجود والخلق ومنهم ابتدأت الاساطير اليهودية التي طورتها المسيحية بنفحات حكماوية وزيادات ملائمة للعصر الروماني القائم على الحكمة والفلسفة والتطور الاجتماعي الروماني فقدم الانجيل كمجموعة مواعظ ومن ثم اتى الاسلام في بيئة جاهلية قائمة على الشعر والسيف ليقدم القرآن كحصيلة لموروثات فكرية عن الديانات السابقة، مع اسلوب شاعري ومنقح بما يلائم النقص الحضاري عند العرب ومشددا على مفاهيم الجهاد والقتال وغيرها من ما يجذب العقل العربي ويستهويه... والدارس للديانات السومرية والفرعونية ومن يحاول اسقاط بعض الثوابت والنظريات لا بل والتقاليد او الموجبات على الفرد في المجتمع الاسلامي او المسيحي او اليهودي.. لا بد سيصل لقناعة بأن العلاقة بين كل هذه الاساطير هي علاقة وراثة فكرية و تطوير لاحق لكل منهج ديني لانتاج دين آخر
البعض يعتقد ان الخلق تم بشكل لصيق وحرفي كما جاء في اساطيرهم الدينية وما تناقله علمائهم وكهنتهم والبعض الاخر يعتقد ان الاساطير الدينية ليست إلا رواية رمزية ادبية لماقد جرى فعلاً. والبعض الآخر يرفضها كونها مجرد تفاهات اسطورية ويصر على موقف العلم والفيزياء التي اسس لها البيج بانج والقائمة على معادلة الزمن والمادة... والتي ينتفي أي وجود مادي قبلهما.
اساطير الخلق لاتحتاج الى ان تكون معقدة او شديدة الدقة او مليئة بالتفاصيل والشروحات الصحيحة، يكفي ان يتوافق احد مفاصلها مع حقيقة ما، للبدء ببناء التلفيقات الضرورية لاستكمال كامل البناء الاسطوري، لتصبح رمزا للاعجاز العلمي يعني تصل بنا الاساطير الى حدود نسميها اللا معقول او الماورائي الذي لا قدرة لعقل الانسان المحدود على تفسيره.. وهنا يتدخل العلم ليفرض وجهة النظر الاقرب الى المنطق الانساني: لحظة تشكل الكون هي لحطة بداية المقاييس المعاصرة أي الزمن والمادة وقبيل التكوين لا مجال لاختلاف الابعاد وواقعها اللا وجودي... أي لا معنى لطرح فكرة قبل الوجود بثانية.. لان اصلا ليس هناك شيء نسميه ثانية !
لقد كان الله على علم، منذ البداية، بأن الحرية التي مُنِحت للإنسان سوف تُستخدَم في المعصية التي تزرع بذرة الفساد في صميم الخلق. من هنا فقد أضمر الله، منذ البداية أيضاً، خطة لتصحيح ذلك كلِّه من شأنها تقديم الخلاص للإنسان وللعالم. فالتاريخ يبدأ بآدم، ثم يبدأ بداية أخرى جديدة بآدم ؛ وليس الزمن الفاصل بين هاتين البدايتين إلا شكلاً من أشكال "الجاهلية" الإنسانية،
ترتبط الأسطورة بنظام ديني معين ، وتعمل على توضيح معتقداته ، وتدخل في صلب طقوسه . فالطقوس الدورية الكبرى في أي دين إنما ترتبط عضوياً بأساطير أساسية كبرى . وتعتبر بمثابة تكرار على المستوى الطبيعي ، للحدث الأسطوري الذي يجري على المستوى الغيبي . فطقوس رأس السنة في بابل ، هي عرض درامي لأسطورة التكوين البابلية ، وكذلك أعياد الربيع في جميع أنحاء الشرق القديم ، التي تعيد تمثيل أسطورة موت وبعث إله الخصب . كما تدور الأعياد المسيحية حول المفاصل الرئيسية في حياة السيد المسيح ، ولدى المسلمين يتخذ الحج إلى بيت الله في مكة شكل تكرار دوري سنوي لحادثة بناء ابراهيم لأول بيت عبادة أقيم في مكة ، ولأول مكان مبارك أراد الله إقامته ليكون نقطة تواصل بين السماء والأرض .
فالأسطورة هي حكاية مقدسة يؤمن أهل الثقافة التي أنتجتها بصدق روايتها إيماناً لا يتزعزع ، ويرون في مضمونها رسالة أزلية موجهة إلى بني البشر ، فهي تبين عن حقائق خالدة وتؤسس لصلة دائمة بين العالم الدنيوي والعوالم القدسية . أما الخرافة فإن راويها ومستمعها ، على حد سواء ، يعرفان منذ البداية أنها تقص أحداثاً لا يقوم أحداً بتصديقها أو الإيمان برسالتها .
إن صلة القربى التي تربط الأسطورة والخرافة تخلق بينهما حالة تبادل ، فقد يلتقط الكهنة ، في فترات ضعف المؤسسة الدينية وانهيار المعتقدات الراسخة ، حكاية خرافية شائعة ويحملونها مضامين دينية ويضفون عليها طابع القداسة . وبالمقابل فقد تؤدي تغييرات عميقة في بنية المعتقدات الدينية إلى زوال القداسة عن أسطورة ما وهبوطها إلى مستوى الخرافة ، حيث تستمر فاعلة في الأدب التقليدي بعد زوال الرابطة التي كانت تشدها إلى نظام ديني معين .
وما يدور بين الآلهة وبعضها وبين الآلهة والطبيعة وهى تشير إلى حوادث حدثت فى الماضى البعيد مزجت بين حقائق وأحداث حدثت بالفعل وبين الخيال لدى الناقل والمدون أو الكاتب وتبدل فيها وأمتزج بين أحداث تاريخية قديمة وخرافات شطح فيها العقل ومن أهم هذه الأساطير : ـ أسطورة إيزيس وأوزوريس ـ أسطورة نجاة البشر ـ أسطورة حيلة إيزيس … الخ .
في هذا السياق جاء كتاب فراس سواح والمسمي بـ "مغامرة العقل الأولى: دراسة في الأسطورة سورية وبلاد الرافدين " معلنا عن نفسه بأنه أول كتاب يعالج الأسطورة بهذه الإحاطة وليس هذا فحسب بل عبر منهج جديد يعتقد سواح أنه الأول من نوعه أيضا ويقوم هنا المنهج على جمع الأساطير في مجموعات وفق موضوعاتها لا وفق تسلسل زمني أو توزع جغرافي وذلك بغية تفسيرها. يقول سواح "هو منهج جديد في دراسة أساطير المنطقة على ما وصل اليه علمنا" في القرن ةالواحد والعشرين.
و العلم الموجود حاليا والمختص بدراسة الأساطير هو علم الميثولوجيا Mythologia ، وكلمة ميثولوجيا ـ تستخدم للتعبير عن ثمرة إنتاج معين لخيال شعب من الشعوب في شكل حكايات وروايات يتناقلونها جيلا بعد جيل.. وكان الإغريق يسمون هذه الروايات والحكايات «ميثوي Mythoi» ومعناها «ألفاظ وكلمات»..
وبالرغم من أن كلمة ميثولوجيا لا تعني أصلا من ناحية الاشتقاق أكثر من «قص الحكايات»، إلا أنها تستعمل الآن لتدل على الدراسة المنظمة للروايات التقليدية لأي شعب من الشعوب أو لكل الشعوب بقصد معرفة الطريقة التي تمت بها حتى أصبحت رواية تُروى، وإلى أي مدى كان الاعتقاد بها، وكذلك بقصد حل المشاكل الأخرى المتعلقة بها مثل علاقتها بالدين، وأصولها، وعلاقتها بروايات أخرى لشعوب أخرى، وغير ذلك.
وعند محاولة العلماء تفسير نشأة الأساطير؛ بدايتها، وأسبابها، نجدهم لا يتفقون على أسباب محددة.. فجيمس فريزر وإدوارد تيلور مثلا يَريان أن كلمة الأسطورة ترتبط ببداية الإنسانية، حيث كان البشر يمارسون السحر ويؤدون طقوسهم الدينية التي كانت سعيا فكريا لتفسير ظواهر الطبيعة.. ولكن هربرت ريد يؤكد أن فريزر وتلاميذه يخطئون في زعمهم أن أساطير الأولين كانت محاولة لتفسير الكون.. ويؤيده ليفي برول قائلا:
«لم تنشأ الأساطير والطقوس الجنائزية وعمليات السحر ـ فيما يبدو ـ عن حاجة الرجل البدائي إلى تفسير الظواهر الطبيعية تفسيرا قائما على العقل، لكن نشأت استجابة لعواطف الجماعة القاهرة».. ويرى لويس هورتيك أن الأسطورة التي هي الفترة الدينية للجيولوجيا وعلم الحيوان نشأت على أطلال كانت يوما قصورا أو مدنا عامرة.. في حين ترى جين هاريسون أن الأسطورة «هي التفكير الحالم لشعب من الشعوب تماما مثلما يعتبر الحلم أسطورة الفرد».
وفي محاولة للوصول إلى أرضية علمية مشتركة في تفسير أصل الأسطورة يقرر توماس بوليفينشي في كتابه «ميثولوجية اليونان وروما» وجود أربع نظريات في أصل الأسطورة.. وهذه النظريات هي:
النظرية الدينية: التي ترى أن حكايات الأساطير مأخوذة كلها من الكتاب المقدس مع الاعتراف بأنها غُيِرت أو حُرِفت، ومن ثَم كان هرقل اسما آخر لشمشون، والمارد ديوكاليون ابن بروميثيوم الذي أنقذه زيوس مع زوجته من الغرق فوق أحد الجبال هو نوح، وهكذا..
النظرية التاريخية: التي تذهب إلى أن أعلام الأساطير عاشوا فعلا وحققوا سلسلة من الأعمال العظيمة، ومع مرور الزمن أضاف إليهم خيال الشعراء ما وضعهم في ذلك الإطار الغرائبي الذي يتحركون خلاله في جو الأسطورة.
النظرية الرمزية: وهي تقوم على أن كل الأساطير بكل أنواعها ليست سوى مجازات فُهمت على غير وجهها الصحيح أو فُهمت حرفيا، من ذلك ما يقال عن أن «ساتورن» يلتهم أولاده أي الزمن يأكل كل ما يوجد فيه.
النظرية الطبيعية: وبمقتضاها يتم تخيل عناصر الكون من ماء وهواء ونار في هيئة أشخاص أو كائنات حية، أو أنها تختفي وراء مخلوقات خاصة.. وعلى هذا النحو وجد لكل ظاهرة طبيعية ـ ابتداء من الشمس والقمر والبحر وحتى أصغر مجرى مائي ـ كائن روحي يتمثل فيه وتنبني عليه أسطورة أو أساطير.وعلى هذا الأساس قام العلماء بتقسيم الأساطير إلى ثلاثة أنواع هي:
الخرافة البحتةMyth proper وهي محاولة خيالية سابقة على العلم لتفسير بعض الظواهر الطبيعية الحقيقية أو المزعومة والتي تثير فضول مبتكر الخرافة، أو بمعنى أدق هي محاولة الوصول إلى شعور بالرضا والاقتناع في أمر مقلق محير يتعلق بتلك الظواهر، وخرافات هذا النوع غالبا ما تخاطب العواطف لا العقل..
فالخرافة البحتة هي ثمار إنتاج التخيل الساذج في البحث عن الحقائق التي تعرف بالخبرة، والتي يكشف لنا عنها فيما بعد كل من الفن والعلم.. وقد أطلق على هذا النوع من الروايات اسم Aetiological أي ما يهتم بالبحث عن علة وجود الأشياء من حركة ظاهرة للأجرام السماوية، إلى شكل تل، أو أصل عادة محلية، وفى هذه الحالة الأخيرة غالبا ما تخبرنا الروايات بما يوحي بأنه تاريخ أو ما يشبه التاريخ.
والنوع الثاني من الروايات هو ما يسمى Sega وهى كلمة إسكندناوية الأصل وتعني «قصة أو رواية» وعادة ما تذكر الآن للتعبير عن تلك الروايات التي تعالج أحداثا تاريخية أو شبه تاريخية.. وغالبا ما تتناول في خطوطها العريضة أمورا تتعلق بالبشر ومعاركهم ومغامراتهم.. لكنها تغفل الكثير من التفاصيل التاريخية وتركز على الأبطال وقدراتهم الخاصة وتدخل الآلهة في الأحداث معهم أو ضدهم.
أما النوع الثالث فهو القصص الشعبية Merchen وهذا النوع يهدف أولا وأخيرا إلى التسلية والإمتاع، ولا يعمل حسابا لأي شيء آخر، فلا تسجيل لأحداث تاريخية أو شبه تاريخية، ولا محاولة لتعليل ظاهرة طبيعية، ولا ملاحظة لأفكار المستمعين وعقولهم فيما يتعلق بأمر الضرورة والاحتمال، بل هو في مجموعه عبارة عن قصص شعبية بسيطة أنتجها الخيال في دور الطفولة المبكرة للشعوب وتناقلتها الأجيال، وأبرز ما يميز هذه القصص هو تشابه كثير من أحداثها عند الشعوب المختلفة.
هذا التنوع في النظر إلى الأساطير من حيث أصلها أو نوعها أو الوطن المنتمية إليه أو غرضها أو بنائها أو غير ذلك؛ لا يبرره إلا الغموض الذي يحيط بهذا الموضوع، والذي يبدو من المستحيل أن يصل فيه أحد إلى الكلمة النهائية، أو الجامعة المانعة كما يقول المناطقة.
الأساطير العربية حكايات نقلها العرب جيلاً بعد جيل بوساطة الرواية تدور حول موضوعات شتى منها الآلهة والأحداث الخارقة، وتختلف عن الخرافات والملاحم التي تسجل أفعال العرب الإنسانية أو التي ابتكرت لأغراض التعليم والتسلية. وقد ورد مصطلح أساطير في القرآن الكريم، مرتبطًا بالتصورات الدينية والاعتقادية، الطقوسية والمعرفية، الروحية والفكرية وذلك في تسعة مواضع في ثماني سور مكية وواحدة مدنية بصيغة الجمع "أساطير الأولين" حيث تحرج المفسرون من تعريفها كمعتقد ديني، واكتفوا بنعتها "بالأباطيل والأكاذيب من زخرف القول". وليس محض مصادفة أن يكون معظم الحديث عن "أساطير الأولين" في السور المكية؛ أي في سياق بث الدعوة الإسلامية في سنواتها الأولى، من أجل نشر المعتقد (الإسلامي) الجديد على أنقاض المعتقدات الأسطورية (الوثنية) التي كانت ذائعة في الجزيرة العربية عند ظهور الإسلام.
أسباب اندثار الأسطورة. الأساطير بالمعنى الاصطلاحي الذي أكده القرآن الكريم تؤكد أن العرب، شأنهم شأن سائر الشعوب، قد مروا بالمرحلة الأسطورية، وأن لهم تراثًا أسطوريًا يعكس رؤيتهم وموقفهم من الكون والعالم والوجود منذ جاهليتهم الأولى، على عكس ما أنكر المنكرون من المستشرقين وهو إنكار ينطوي على اتهام للعقل العربي وللمخيلة العربية بالعجز والقصور. غير أن هذه الأساطير ـ على كثرتها ـ ما لبثت بعد انتصار الدين الجديد ـ أن أخذت في التبدد والتلاشي باعتبارها تراثًا وثنيًا. ولم يكن ذلك في صدر الإسلام إبان عهد النبوة والخلافة الراشدة فحسب، بل استمر ذلك في العصور اللاحقة، حيث وقف فقهاء المسلمين من هذه الأساطير (الجاهلية) موقفًا حاسمًا بلغ حد القطيعة المعرفية بين موروث العصور الجاهلية من ناحية، وتراث الإسلام من ناحية أخرى. ثم شايعهم في ذلك الرواة والعلماء المسلمون ـ إبان عصر التدوين ـ فقد أصابهم جميعًا حرج ديني بالغ في رواية هذه الأساطير، بل تدوينها. وكان طبيعيًا في ضوء هذه القطيعة، واتساع المسافة الزمنية ـ بين العصر الجاهلي وازدهار عصر التدوين ـ أن تندثر معظم الأساطير العربية بعد أن فقدت وظائفها الدينية والمعرفية، وأن تندثر معها تفاصيلها الطقوسية الدقيقة وأخيلتها من الذاكرة التاريخية، علي نحو ما حدث عندما كتب محمد بن إسحاق (ت 152هـ، 769م) السيرة النبوية، وكان قد ضمنها بعضًا من أخبار الجاهلية الأولى التي لم تكن إلا مادة أسطورية. جاء من بعده ابن هشام (ت 213هـ، 828م) فعمد إلى إسقاط هذه المادة الأسطورية على نحو شبه كامل ـ برغم ضخامتها ـ حتى نسبت إليه السيرة دون ابن إسحاق.
وعلى الرغم من أن هذه القطيعة الدينية والثقافية والتدوينية قد فعلت فعلها الهائل في اندثار الأساطير العربية، بعد أن فقدت وظائفها، وانفرط عقدها، فإن مادتها التي علقت بالذاكرة الجمعية أو العقلية الأسطورية للعامة، لم تتبدد، وإنما تحللت أو تحولت إلى "عناصر" أسطورية استطاعت أن تتسرب ـ في كثير منها ـ إلى الثقافة العربية الإسلامية، بشقيها الشفاهي والكتابي، وأن تتبدى تجلياتها على شكل ممارسات أو عادات سحرية، أو على شكل عادات وطقوس لا معقولة، أو على شكل سلوك وثني موروث، أو على شكل معتقد شعبي لا إسلامي، أو غير ذلك مما هو سائد في العادات والتقاليد والمعتقدات الشعبية العربية ذات الجذور الأسطورية التي لاتزال فاعلة في الذات العربية العامة ـ ربما إلى اليوم ـ التي استطاعت أيضًا أن تعرف طريقها إلى التسجيل والتدوين في المصادر العربية القديمة، بشكل مباشر أو غير مباشر، على نحو ما جاء في المصادر الدينية ومصادر التفسير وقصص الأنبياء، وكذلك كتب الملل والنحل وما كتب عن الأصنام، وكتب الأدب ومعاجم اللغة، ومصادر الشعر الجاهلي وكتب الأمثال، وكتب المغازي والفتوح ومعاجم البلدان، وكتب الأخبار والأنساب والتراجم والسير التاريخية والشعبية، وكتب الحيوان، وعجائب المخلوقات وغرائب الموجودات وغيرها.
نماذج من الأساطير العربية. على الرغم من أن المادة الأسطورية جاءت ـ في معظمها ـ مقتطعة من سياقها السوسيو ـ ديني أو الثقافي، إلا أنها تؤكد أن العرب قد عرفوا الأساطير بكل أنواعها : الأساطير الكونية (أساطير الخلق والتكوين) والأساطير الطقوسية (الدينية) والأساطير التعليمية، والأساطير الرمزية، والأساطير الحضارية، وأساطير البطل المؤلَّه ونظائره من الكائنات الخارقة في العصور الجاهلية السحيقة والمتأخرة.
ويستطيع الباحث في هذه المادة الأسطورية أن يفرق بين أمرين بشأن تدوينها في كتب التراث؛ فبعضها حفل بتدوين أساطير عربية متكاملة أو شبه متكاملة، وإن وردت مجملة أو شديدة الإيجاز، ومنتزعة من سياقها الطقسي أو الشعائري، وبعضها اكتفى بتدوين بعض أجزاء منها فيما يعرف باسم "العناصر" الأسطورية. وهذه العناصر هي التي أطلق عليها الجاحظ (ت 255هـ، 868م) مصطلح أوابد العرب ومنها ـ على سبيل المثال ـ إيمان العرب في جاهليتهم بالهامة والصدى، وإلقاء سن الثغر إلى الشمس، وجزّ ناصية الفارس الأسير (حيث الشعر مكمن القوة)، ومنها الإيمان بالسحر والكهانة والعيافة، والتطير وزجر الطير، وشق الرداء، وخدر الرِّجل واختلاج العين ... إلخ. ومنها معتقدات العرب المعروفة باسم نيران العرب بكل أنواعها ورموزها الاعتقادية والسحرية والعلاماتية (السيميائية) التي أفاض أيضًا في ذكرها النويري (ت 732هـ، 1331هـ). ومنها الإيمان بالرئيّ والعمار والهاتف، وكذلك الغيلان والسعالي، وقدرتها على التحول والتشكل في أية صورة تشاء، ولاسيما السعالي من سحرة الجن التي تتشكل على هيئة فتاة حسناء أو أم تنادي وليدها وتتراءى للمسافر في القفار أو للساري في الخلوات، فيتبعها، فتفترسه، وقد تتزوج به، وغير ذلك من "عناصر" ذات طابع أو أصل أسطوري، مما نهى عنه الإسلام صراحة "لا هامة ولا صفر ولا غول ...إلخ" وما أكثر ما وصلنا من هذه العناصر الأسطورية في كتب الأمثال والأخبار والحيوان وعجائب المخلوقات.
أما المادة الأسطورية التي وصلتنا فهي، على شدة إيجازها، شبه كاملة أو كاملة فهي كثيرة؛ فثمة أساطير كونية تتعلق بالخلق والتكوين، وقد عرفت طريقها إلى التدوين في كتب الأخبار والتواريخ الموسوعية، وبعض الإسرائيليات والأحاديث الموضوعة. وثمة أساطير تتعلق بالمعتقدات الدينية، فقد كان للعرب آلهتهم في الجاهلية الأولى والثانية، وعرفوا ـ مثل سائر شعوب المنطقة ـ عبادة الآلهة الشمسية والقمرية، وإلى ذلك يشير القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن﴾ فصلت: 37. وما أكثر آلهة العرب في الجاهلية، وما أكثر أصنامهم وأوثانهم وأنصابهم الرامزة إلى هذه الآلهة، في مراحل عقائدية متلاحقة ومتداخلة، مثال ذلك الآلهة الشمسية اللات (إلهة الخصب والحب والجمال) ومثلها العزّى، أو الآلهة القمرية مناة باعتبارها إلهة الموت أو المنية التي ورد ذكرها في سورة النجم (53 : 20). وكان لهذه الآلهة جميعها طقوسها وشعائرها، كما يروي ابن الكلبي (ت 146هـ، 763م) ومنها أن قريشًا حينما كانت تطوف بالكعبة قبيل الإسلام، تنشد (وهذا هو المنطوق القولي للأسطورة) وتقول: واللات والعزّى ومناة الثالثة الأخرى، فإنهن الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى. وكانت العرب تزعم أن هذه الآلهة هي المدبرة للعالم بخيره وشره. كما عبدوا الكواكب والنجوم السيارة، ومن أشهرها "الزهرة" آلهة الجمال والحب والإغراء في الميثولوجيا العربية، وهذه الآلهة هي التي كانوا يعتقدون أنها أوقعت أعظم ملكيْن ـ علمًا ودينًا ـ في شراك إغرائها، وهما هاروت وماروت. وتروي الأسطورة أنها طلبت منهما أن يعلماها الكلام الذي يصعدان به إلى السماء، فعلّماها، وعرجت إلى السماء، وهناك نسيت ما تنزل به إلى الأرض، فبقيت هناك، وأصبحت ذلك الكوكب الجميل، كوكب الحب والحسن والغناء والسرور عند العرب.
ومثلها أسطورة إساف ونائلة وما يرتبط بعبادتهما من التلابي (وهي الأدعية الدينية المصاحبة لطقوس الحج في الجاهلية). وثمة بقايا أسطورية أخرى تشير إلى أن العرب أيضًا ـ في جاهليتهم الأولى ـ قد عرفوا تقديس الحيوان (ومن ثم تحريم ذبحه) فضلاً عن عبادته إبان المرحلة الطوطمية، وكذلك تقديس بعض الشجر مثل شجرة الخلصة، وشجرة ذات أنواط كما عرف العرب أيضًا عبادة الجن والملائكة، كما قدسوا بعض الظواهر الطبيعية كالمطر والاستسقاء بالأنواء، وقوس قزح، وكان "قزح" هو إله الرعد والبرق والمطر عند العرب، ثم في مرحلة متأخرة صار إله الحرب، كما كان "هبل" إله الخصب والرزق. كذلك قدس العرب النار (نار المزدلفة) كما كانت لهم تصوراتهم الميثولوجية عن الملائكة ومآثرهم، والشياطين وفعالهم منها أسطورة شياطين الشعراء ـ مثلاً ـ في وادي عبقر، وهي أسطورة تعليلية شارحة في تفسير الإلهام الشعري، ولها نظائرها في أساطير الشعوب.
وللعرب كثير من الأساطير التعليلية التي تتعلق بعالم النجوم (أسطورة الثريا والدبران) أو بعالم الطبيعة، وعالم النبات، وعالم الحيوان الذي كان الجاحظ أول من أفاض في ذكر أساطيره، وكذلك في الأساطير التي تتعلق بعالم الجن والسعالي والغيلان، والعلاقة بينها وبين عالم الإنسان من عشق وزواج كان من نتاجه المشترك ـ مثلاً ـ بلقيس ملكة سبأ، أو ما وقع بينهما من معارك وحروب ضارية. وما يرتبط بذلك كله من أعمال السحر والكهانة والعرافة والقيافة وتسخير الجن.
وثمة أساطير تاريخية تتعلق بذكر قصص العرب البائدة الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم والشعر الجاهلي. وقد وقفت عندها المصادر التاريخية المبكرة وكتب الأخبار والتفاسير، مثل إرم ذات العماد، وثمود وعاد، وطسم وجديس وجرهم والعماليق وغيرهم وما يتعلق بتاريخهم من حروب، أو بمعتقداتهم من آلهة، مثل الإله الشمسي "سمو إيل" بمعنى الإله صاحب السمو في مدينة جو باليمامة (السموءل قبل أن تختلط الأسطورة بالمرويات التاريخية والشعبية الإسلامية المتأخرة). فضلاً عن بعض الأساطير التي تتعلق بظهور المدن وإنشاء السدود مثل؛ سد مأرب، وبناء بعض القصور والحصون والمعابد وبيوت الآلهة مثل؛ قصر غمدان أو الخورنق والسدير ومثل حصن الأبلق وحصن مارد في منطقة الجوف في عصر العماليق.
كما عرف العرب أيضًا الأساطير الحضارية، فضلاً عن أساطير بعض المخلوقات أو الكائنات الخارقة، وبعضها موغل في القدم، مثل أسطورة عوج بن عنق أو عناق، وأسطورة زرقاء اليمامة، الكاهنة التي كانت تبصر الشيء من مسيرة ثلاثة أيام. وبعضها حديث نسبيا، مثل أسطورة الكاهن شق؛ وقد سمي بذلك لأنه ولد بشق واحد، وبيد ورجل وعين واحدة وأسطورة الكاهن سطيح الذي كان يدرج كما يدرج الثوب، ولا عظم فيه إلا الجمجمة. وتروى عن كليهما قصص عجيبة وأحاديث غريبة ذات طابع أسطوري بحت.
الملامح العالمية للأسطورة العربية. الملامح العامة للأساطير العربية (من حيث هي قصة، تحكمها مبادئ السرد القصصي) هي الملامح ذاتها في الميثولوجيا العالمية. فهي تتضمن حدثًا خارقًا لفاعل خارق (إله أو شبه إله أو كائن فوق طبيعي) وهي بهذا الحدث المقدس تختلف اختلافًا جذريًا عن سائر أنماط التعبير القصصي الشعبي والملحمي والدرامي. وقد يكون هذا الحدث الأسطوري الخارق بسيطًا يتكون من عنصر قصصي واحد (وحدة حكائية)، وقد يكون مركبًا من عدد من الوحدات الحكائية. ويقع هذا الحدث الميثولوجي دائمًا في الزمن الأسطوري القديم، زمن البدايات المقدسة، وفي الحيِّز الأسطوري، حيث الأمكنة الأسطورية لا تملك واقعًا جغرافيًا محددًا أو يتسم بأية خاصية جغرافية حقيقية.
إن مثل هذا التراث الميثولوجي للعرب، الذي يبدو في نظر البعض تراثًا خرافيًا أو لا معقولاً، هو تراث جدير بالدرس والتحليل باعتباره من أهم أعمدة التراث العربي.
إذا عدنا إلى ليفي بريل في كتابه الميثولوجيا البدائية نجده يعتبر ظاهرة الأسطورة سابقة على الظاهرة الدينية لأنها منتمية إلى مرحلة ما قبل الدين، فهي لا تمثل جزءا من الديانات القديمة بل تعتبر سابقة على الديانات الموجودة لاحقا لأن عملية الانتقال من الأسطورة إلى الظاهرة الدينية قد تمّت من خلال تغيير جذري في مستوى العناصر الأساسية المكوّنة للأساطير باختفاء بعض العناصر التي تكون مرحلة الأسطورة وبروز عناصر جديدة تكون العقلية الدينية, إذ ينتقل من مشاهدة تأثير الحوادث في الكائن البشري إلى الإقرار بوجود قوى خفية لهذه الحوادث ويختلف تأويله لهذه القوى والأحداث تبعا لأهميتها بالنسبة لحياة الأفراد.
لقد ارتبطت الاسطورة في اذهان الكثيرين بالخرافة او الحديث الباطل, واعتبر كلاهما شيئا واحدا, ذلك انه بينما يعتمد الخرافة علي الخيال المحض – في الغالب- فإن الاسطورة تفقد مصداقيتها اذا لم تتكئ علي واقع..لقد كانت الاسطورةهي الوسيلة المبكرة التي عكست توق الانسان الي المعرفة وتفسير العلم من حوله .
لم تظهر الدراسة الدقيقة المتخصصة لجمع وتفسير الاساطير إلا في العالم الغربي في القرن الثامن عشر, وإن كان بعض الفلاسفة القدامي قد تناولوها بالتفسير حسب معطيات ومنجزات عصرهم...ولقد كان الفيلسوف" طاليس " اول اغريقي يعبر عن موقف نقدي تجاه الاساطير الاغريقية, كما وجه " ارسطو" هجوما عنيفا للاساطير باعتبارها " قصصا وهمية لا تقدم أي حقيقة لا عن الانسان ولا عن العالم" , اما افلاطون فقد حاول استخدامها كعوامل مساعدة علي كشف الحقائق الفلسفية العميقة واستخدمها ايضا بشكل مجازي في حواراته.
وعبر القر التاسع عشر والعشرون, تقدمت الدراسات التي تهتم بالاساطير وظهرت المدارس المختلفة في تفسيرها. ويذهب " روبرتسن سميث" في مؤلفه " محاضرات في ديانةالساميين " الي " ان الاسطورة ماهي الا تفسير للعرف الديني , وما كان هذا التفسير لينشأ الا حين يوشك المعني الاصلي للعرف في دائرة النسيان . ومن المسلم به ان الاسطورة ليست تفسير لاصل الشعيرة الدينية بالنسبة لمن يؤمن بانها رواية لبعض الاحداث الحقيقية, وهو مالا يؤمن به أي عالم من علماء الاساطير مهما بلغت جراءته, ولكن رغم ان الاسطورة غير حقيقية , الا انها تحتاج الي تفسير , وكل مبدأ فلسفي وكل مسلمة من المسلمات تتطلب الحث عن تفسير لها , وهو مالا يتم الا بنظريات تشبيهية متعسفة , بل بالحقائق الواقعية للشعيرة او العرف الديني الذي تلتصق به الاسطورة , بل الشعيرة الدينية والعرف الموروث "
وقد عرف " كارل كيريني" الاسطورة بالنظر الي اصلها بقوله" ان الاسطورة في المجتمع البدائي – أي في شكلها المعاش – ليست حكاية تحكي ولكنها حقيقة معاشة . انها ليست اختراعا , ولكنها حقيقة حية يعتقد انها حدثت في ازمنة اولية , وانها لازالت تمارس تاثيرها علي العالم وعلي مصائر البشر" (2)
وعلي نفس المنهاج يسير " برونيسلاف مالينوفيسكي" اذا يضيف : " ان الاسطورة اذا درست وهي حية فعالة , فانها لاتكون تفسيرا يتطلبه اشباع الولع بالعلم , وانما هي بعث روائي لحقيقة ازلية , يروي لاشياع رغبات دينية عميقة وحاجات اخلاقية ومتطلبات اجتماعية واحتياجات عملية...والاسطورة في حقيقتها ليست تدفقا عشوائيا لخيالات عقيمةولكنها قوي ثقافية هامة تشكلت بصورة محكمة"
ويري" يوهيمروس " " ان الاسطورة هي التاريخ في صورة متنكرة " اما "ماكس موللر" فيري انها " مرض من امراض اللغة وانها القوي التي تمارسها اللغة علي الفكر علي الفكر في كل مجال ممكن من النشاط الذهني"
اما الاسطورة في نظر " تيليارد" فهي : " موهبة أي جماعة بشرية كبيرة كانت ام صغيرة – وقدرتها علي ان تحكي قصصا معينة عن احداث او اماكن او اشخاص معينين خياليين كانوا ام حقيقيين , وتكون حكاية هذه القصص بشكل واع غالبا , ويكون لها مغزي رائع" (3)
ويذهب الاستاذ / رشدي السيسي في مقدمة ترجمته لترجمة كتاب " بلفتش " " عصر الاساطير " الي ان : الاسطورة هي سجل لايمان الشعوب البدائية للسحر واسترضاء آلهتهم بالطقوس وبهذه الاسباب يمكن ان نصف الاسطورة بوجه عام بانها مظهر لمحاولات الانسان الاولي كي ينظم تجربة حياته في وجود غامض خفي , الي نوع من النظام المعترف به"
اما " بلفتش " نفسه فيعدد لنا مذاهب تفسير الاسطورة في كتابه " عصر الاساطير"(6) ونوجزها في :
1- نظرية الكتب المقدسة: وهي تذهب الي ان جميع القصص الاسطورية انما هي مشتقة من روايات الكتب المقدسة ولكن الوقائع الصحيحة استترت وتغيرت.
2- النظرية التاريخية: وتذهب الي ان جميع الاشخاص الذين ورد ذكرهم في الاساطير كانوا يوما كائنات بشرية وان االروايات الخرافية المنسوبة اليها ليست سوي زيادات وزخارف اقحمت في عهد متاخر
3- النظرية المجازية: : وهي تفترض ان كل اساطير الاقدمين مجازية ورمزية احتوت علي عض الحقيقة الادبية او الدينية او الفلسفية او الواقع التاريخي في شكل مجاز ولكن بمرور الزمن استوعبها الناس علي اساس ظاهرها الحرفي
4- النظرية الطبيعية: وبمقتضاها كانت عناصر الهواء والنار والماء محط العبادة الدينية وكانت الالهة مشخصات من قوي الصبيعة
وكل هذه النظريات صحيحة الي حد ما , ولذلك فمن الاصح ان يقال ان اساطير امة ما قد انبثقت من كل هذه المصادر مجتمعة, بينما ينتقد بلفتش المدرسةالطبيعية في تفسير الاسطورة باعتبارها اكثر الآراء تطرفا في تفسير الاساطير ....
اما د/ سيد القمني فيضيف منهجين آخرين في تفسير الاسطورة في مؤلفه " الاسطورةوالتراث" هما :
" المنهج العقلي : والذي يذهب الي نشوء الاسطورة نتيجة سوء فهم او خطأ ارتكبه مجموعة افراد في تفسيرهم او قراءتهماو سردهم لحادثة اقدم.
ومنهج التحليل النفسي الذي يحتسب الاسطورة رموز لرغبات غريزية وانفعالات نفسية"(7)
هذا بالاضافة الي المنهج الماركسي في تفسير الاساطير وقد سبق عرضة .
ولكن خلاصة ما سبق انه لا يوجد قول حاسم في تفسير الاسطورة وماهيتها وهو ما يلخصه لنا " مالينوفيسكي " بانه : " يصعب كثيرا وضع مقياس عام للظواهر الثقافية ومن بينها الاساطير" ... وربما اعادنا هذا الي قول " بلفتش" : " ان كل هذه النظريات صحيحة" لنكمل معه : او تكون جميعها خاطئة..... فأبواب التنظير والتاويل لازالت مفتوحة وكل الاحتمالات قائمة ووارد فيها الصحة والخطا
إذا عدنا إلى ليفي بريل في كتابه الميثولوجيا البدائية نجده يعتبر ظاهرة الأسطورة سابقة على الظاهرة الدينية لأنها منتمية إلى مرحلة ما قبل الدين، فهي لا تمثل جزءا من الديانات القديمة بل تعتبر سابقة على الديانات الموجودة لاحقا لأن عملية الانتقال من الأسطورة إلى الظاهرة الدينية قد تمّت من خلال تغيير جذري في مستوى العناصر الأساسية المكوّنة للأساطير باختفاء بعض العناصر التي تكون مرحلة الأسطورة وبروز عناصر جديدة تكون العقلية الدينية, إذ ينتقل من مشاهدة تأثير الحوادث في الكائن البشري إلى الإقرار بوجود قوى خفية لهذه الحوادث ويختلف تأويله لهذه القوى والأحداث تبعا لأهميتها بالنسبة لحياة الأفراد.
اسطورة الخلق
ومن تشابه الأساطير عند مختلف الشعوب والعصور اسطورة الخلق (عند المصريين القدماء والسومريين والهنود الحمر والبابليين والاشوريين والكنعانيين الهندوس شعوب الشمال الاسكندينافي شعب دوجون الافريقي أساطير آلهة اليونان والرومان وايضا في عند الديانات التي تدعى ’’السماوية‘‘: الاسلام والمسيحية واليهودية.. الخ وهنا.. سنحاول عرض بعض اساطير الخلق عند الشعوب البشرية والواردة في معتقداتها
إن كل ما يتلو خروج آدم وحواء من الجنة والدخول في زمن الأرض ليس إلا اساطير اكتتبها التاريخ والتاريخ يكرر نفسه. فمن قابيل وهابيل، إلى تكاثر الناس وتجمُّعهم في بابل ثم تشتيتهم في بقاع الأرض، إلى الطوفان العظيم، إلى اختيار الإله لشعبه الخاص، ومسيرة هذا الشعب عبر كل المصائب والمحن التي أحاقت به بسبب خطاياه، وصولاً إلى دمار الهيكل الأول، وما تلاه من سبي، فعودة، فدمار ثانٍ، جميعها فصول في ميثولوجيا توراتية تفصح عن مقاصد الإله في حياة الناس، ويتخذ كل حدث فيها معناه ومغزاه من هذه الصلة التي لا تنفصم مع الإرادة الإلهية. من هنا فإن ميثولوجيا الأصول هنا ليست وقفاً على الإصحاحات الأولى من سفر التكوين، بل تنسحب على جميع فصول الكتاب الذي يمكن اعتباره بحق كتاباً في ميثولوجيا الأصول ومثالاً على التاريخ المقدس بامتياز. إن قارئ التوراة المطلع على تاريخ منطقة الشرق القديم يلاحظ بسهولة تامة كيف تجاهل محرِّرو الأسفار التوراتية تاريخ هذه المنطقة برمَّته، ولم يركزوا إلا على تلك السلسلة من الأحداث التي قادت إلى تشكيل مملكة داود وسليمان (التي نعرف الآن بشكل مؤكد أنها لم توجد في يوم من الأيام ، ثم إلى انهيارها، فإلى قيام مملكتي إسرائيل ويهوذا، فالسبي الآشوري والبابلي، فالعودة من أجل انتظار المسيح، ملك اليهود الأرضي الذي سيمهِّد الطريق لحلول مملكة الربِّ التي يديرها الإله بشكل مباشر. هذه السلسلة من الأحداث لا تتخذ معناها من خلال السياقات الحقيقية لتاريخ المنطقة، ولا من خلال علاقة النتائج بأسبابها الفعلية، بل من خلال سلسلة من السياقات الميثولوجية القائمة على تداخل المشيئة العُلوية في التاريخ. إن ما يُدعى بـ"التاريخ التوراتي" ليس، في حقيقة الأمر، إلا مجموعة فصول في ميثولوجيا توراتية، تبدأ بالتكوين وخطيئة الإنسان الأولى، وتنتهي بقيام ملكوت الربِّ على الأرض.
بعد ذلك تستمر خطة الخلق انطلاقاً من الماء، وهو أول ظهور مادي غير متمايز. فمن الماء صنع الله السماء والأرض وبقية مظاهر الكون والطبيعة في ستة أيام انتهت بخلق الإنسان. أخذ الخالق حفنة من تراب الأرض وصنع منها آدم على صورته، ثم نفخ في أنفه نسمة الحياة، فجاء نموذجاً للإنسان الكامل الذي أراده خالقه. وقد وهبه الله حرية الإرادة، والتي لم يهبها للملائكة والجان من قبله، وجعله سيداً على الأرض وعلى جميع مخلوقاته فكان مخلوقا (وسطا)ا. وجاء إليه بكل ما يدبُّ على الأرض أو يطير في السماء أو يسبح في الماء، فعرضهم أمامه صنفاً صنفاً، فأعطى آدم لكل صنف اسمه. وبما أن آدم كان خليفة الله على الأرض، فقد غرس من أجله في الأرض جنة تُناظِر الجنة السماوية، وفجَّر فيها نهراً ينقسم إلى أربعة فروع، وأنبت في وسطها شجرة الحياة وشجرة معرفة الخير والشر. ثم خلق الله المرأة من ضلع آدم لتكون له رفيقاً، وأمرهما أن يأكلا من جميع شجر الجنة، ولا يقربا شجرة المعرفة، لأنهما إن أكلا منها سيلحقهما الموت عاجلاً أم آجلاً. ولكن الإنسان يستعمل حريته في معصية خالقه، ويأكل من الشجرة المحرمة بتحريض من إبليس الذي تسلل إلى الجنة في هيئة حية. فكان عقابه الطرد من الجنة إلى الأرض القاحلة ليعمل فيها ويكدُّ من أجل لقمته. ومنذ ذلك الوقت ظهر الألم والمرض ودخل الموت في نسيج الحياة بسبب خطيئة الإنسان الأصلية.
اسطورة الرقم سبعة
والرقم سبعة ليس من اختراع اليهود في توراتهم، بل هو رقم مقدس موجود قبل كتاب موسى التوراتي، وقبل يوم السبت Shabat في التراث اليهودي. وما علينا سوى الرجوع إلى الأساطير القديمة لنعاين فيها المزهريات السبعة في معبد الشمس بمصر العليا، النيران السبعة المشتعلة منذ الأبدية على مذبح الإله ميترا، المعابد السبعة المقدسة عند العرب، الجزر السبعة والبحار السبعة والأنهار السبعة في الهند، الآلهة السبعة القوطيين، العوالم السبعة والأرواح السبعة عند الكلدانيين، الأجرام السبعة التي ذكرها هوميروس. والرمز السباعي كان موجوداً دائماً في كتابات الصوفية المسلمين. فالصوفي الكبير العطار الذي كان يقول عنه الرومي إنه اجتاز الوديان السبعة، أو مدن العشق السبعة، كما ذُكِر في كتاب منطق الطير، يروي أن الطيور في ترحالها للبحث عن طائر السيمرغ، رمز الإله، قد مرت بالمراحل السبعة وهي: وادي الطلب، وادي العشق، وادي المعرفة، وادي الاستغناء، وادي التوحيد، وادي الحيرة، وأخيراً الوصول إلى الهدف النهائي، ألا وهو وادي الفقر والفناء، أو الذوبان في الإله. والحكمة القديمة تقول: "تجرَّدْ مما لديك، تنلْ شيئاً أرحب وأجمل وأعمق." وفي البوذية يُرمَز للإله أيضاً بالطائر كالاهامسا Kalahamsa. ولذلك تجيء بعض الكتابات السَّرانية للسيدة بلافاتسكي على ذكر الصلة الخفية الموجودة قديماً بين الحكماء الدروز والبوذيين، وتُورِد ملاحظة هامة، وهي أن اسم "حمزة"، المنتظر مجيئه قبل نهاية العالم، مشتق من هذا الطائر Hamsa.
وكل هذه الرموز تعني أيضاً الأجناس البشرية السبعة التي ذكرتها كتب الهندوس المقدسة، وعلى الأخص كتاب Rig-vida، حيث كانت قد ظهرت للوجود أربعة أجناس بشرية؛ وقد اندثرت كلها. ونحن الآن في الجنس البشري الخامس؛ وقد بقي للبشرية الجنسان البشريان السادس والسابع قبل حدوث الانهيار الكوني للنظام الشمسي برمَّته
كما انني وجدت مؤخرا ومن خلال بحثي وقرائتي لعديد من الكتب الغير عربية بان كثير من القصص والاساطير الذي تحكيها الكتب المقدسة مثل قصص الاسراء والمعراج وقصة اهل الكهف وقصة ياجوج وماجوج وغيرها من القصص موجودة ايضا في كتب يقال انها كتبت منذ 4000 سنة ... ارجو ان يفهمني الجميع انا لا اتعرض للكتب المقدسة أو انتقدها حاشا الله ولكنني اتسائل كيف حدث ذلك
تحياتي للجميع




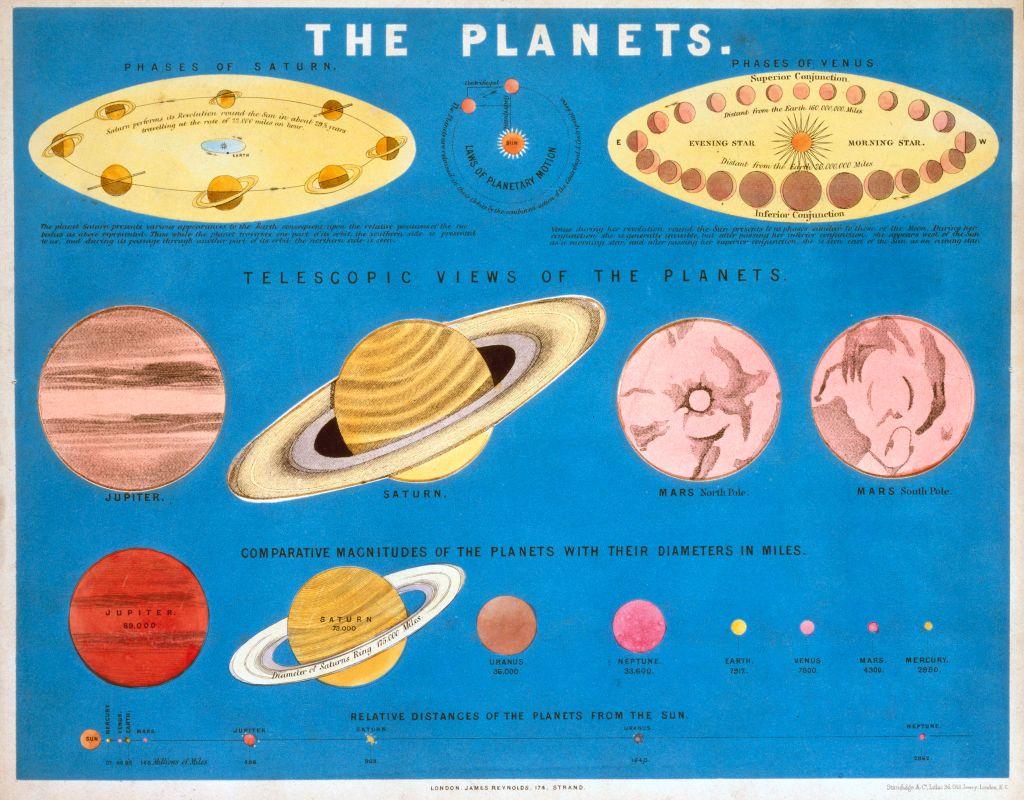














التعليقات (0)