إمتلاك المصطلحات وإنزياح المفاهيم

إن هذا العنوان يربط بين شيئين منفصلين ، بين الاعتقاد من جهة وبين تشكيل الذات لإنسانية من جهة أخرى ، فالاعتقاد هو الصيغة الزمنية لفعل اعتقد، وككل مصدر فإنه يحيل بطريقة لا معينة الى العمل المستهدف في صيغة الفعل، والى الحالة الناتجة عنه، لا بد من لفت الانتباه الى مجريات العملية الدينامكية المنخرطة في كل فعل أو عملية للاعتقاد، فالذات المتوسل اليها عن طريق ظاهرة ما أو حدث ما أو مقترح ما، تعطي موافقتها أو لا تعطيها، ثم تشرط بعدئذ الإبقاء على موافقتها بآثار الحقيقة أو الخطأ ، أو النجاح أو أو الفشل، المولدة عن هذا الاعتقاد، وإذن فان الاعتقاد ينغرس في المؤسسات والعلاقات الاجتماعية والتجارب اليومية للذات الانسانية ، وبهذا المعنى فإنه لا يمكن فصله عن المحيط البيئوي، وذاكرة الجماعة التي ينتمي إليها الفرد، والأطر المعرفية والبنى الاجتماعية التي تولد فيها الذات البشرية وتتحقق وتزدهر، إن الاعتقاد المحدد على هذا النحو له ميزة احتواء كل انماط ومستويات الاعتقاد، وخاصة نمط الإيمان، فهذا النمط من الاعتقاد مرتبط بشكل وثيق وأكثرمن غيره بالتصديق أو القبول الذي تتطلبه بشكل ملح وقطعي ، تلك الخطابات التي تعتبر ذاتها مرجعية لذاتها، والتي أصبحت نصوصا تأسيسية، أو قوانين للكتابات المقدسة للأديان وبما أن مفهوم الإيمان كان قد بلور من قبل النصوص التأسيسية فإن العلاقات الناشئة أو التي ستتمحور على نمط معين في بنية العلاقة الاجتماعية والانتربيولوجية ستتخذ لذاتها مرجعية مختلفة ، وبما أن القيم في مستوى العلاقة سوف يتغير بتغير العلاقات الاعتقادية ذاتها ، فإن ذلك سيحدد طبيعة وشكل المفاهيم ويحدد الاطار العام الذي سيتخذ شكل التأبيد التاريخي ومن تظهر على الشكل الذي يعتاش عليه ويتغذى منه الوعي المبلورللمؤمن ، إن نموذج الإيمان داخل الدائرة الواسعة التي تحتوي كل أنماط ومستويات الاعتقاد، وهو الذي يؤسس المعنى الذي يقولب دائرة العامة الذي يتحرك في مجالها الواسع نسق المتخيل ، وهذا ما فعله الفكر الإسلامي وذلك بواسطة التمييز بين مفهومي الاعتقاد/ والإيمان وقيم المتخيل في كلا الدائرتين أو الفضائين .
من الضروري هنا أن نتفحص بداية إمكانيات استملاك المصطلحات العربية المتأثرة جدا بشحنة التحديدات الإسلامية الأرثوذكسية ، ولا يكفي هنا أن نقوم بتحر فللوجي ـ لغوي تاريخي ـ عن الكلمات ذاتها وأصولها القديمة ، وإنما ينبغي أن نحدد بروتوكولات قراءة النصوص التأسيسية من جهة ، ثم قراءة الأدبيات العقائدية المستقيمة من جهة أخرى .
بما أن الاعتقاد الديني يجد تمفصله الأول أو تجسده الأول في العبارات الشفهية النبوية التي أصبحت فيما بعد الكتابات المقدسة ، فإنه لابد من تحديد المكانة المعرفية لهذه المرجعية الإجبارية التي تتمثل في القراءة الإيمانية الضاغطة على الوعي الإسلامي العام والقراءة النقدية، ونحن نعلم كم الصراع الذي يدور الآن بين القراءتين، فإذا ما اعترفنا بحقوق القراءتين هاتين فإننا نكون قد تجاوزنا الانقسامات ذات الجوهر الايديولوجي والتي تفصل بين البشر . وهي انقسامات غطي عليها طيلة قرون عديدة من قبل رهانات الحقيقة الإلهية المطلقة أو النجاة الابدية في الدار الآخرة ، أو المقدس او التعالي ، أو القانون الموحى به، أو القيم الخالدة التي لا تناقش ولا تمس، أو الاستقامة الفكرية الضرورية من أجل الاستقامة السلوكية، كانت القراءة الإيمانية قد ولدت نصوصا اعتقادية عديدة متنوعة ، ذات مضامين تاريخية غنية ، فإذا ما أردنا التأريخ لموقعها اللاهوتي في خياراته ومجرياته ، وآفاقه المحددة في السياق التاريخي والثقافي والحضاري ، وعندما نؤرخ لهذا النسق لغويا وسسيولوجيا فإن حقوق القراءة النقدية تفرض نفسها، إن ما تدعوه القراءة الايمانية بالله والوظيفة النبوية والكلام الموحى به والكاشف والمقدس والثواب والصلاة وتسليم النفس الى الله الخ ... كل ذلك ينبغي أن يتخذ كمادة للتفحص التاريخي النقدي. على المؤمنين أن يقبلوا بذلك لا ريب أن المؤرخين كانوا قد استخدموا كل المفردات الدينية أو المعجم الديني ، ولكنهم استخدموها من خلال ثقافة علمية قائمة أو مؤسسة على الحكم المسبق للعقلانية ، أو على العقلانية كحكم مسبق ، فعلى هذا الأساس قامت التحديدات والمقولات الأرسطوطاليسية لفترة طويلة، ثم تلتها على نفس الخط عقلانية التنوير . نقول ذلك ونحن نعلم أن استراتيجية عقل التنوير ومحاجاته وموضوعاته كانت تهدف الى احلال سيادتها الخاصة محل سيادة العقل الديني بحسب ما تجلى في صيغته المؤسساتية، على هيئة السلطة العقائدية لرجال الدين ، على أية حال لا يزال هذان النمطان من القراءة ـ القراءة الإيمانية والقراءة النقدية يستمران في الهيمنة و بشكل متنافس على الساحة الدينية أو الفكر الديني ، هذا مع أنه يوجد قراءة ثالثة تم استبعادها تماما مع أنها تستوعب المكتسبات أو المقتضيات الأكثر خصوبة للقراءة التاريخية والأنتربيولوجية والألسنية الحديثة، كما وتستوعب في ذات الوقت القراءة الإيمانية ومنتجاتها، ولكن بعد اتخاذها كمادة للدراسة من قبل علم التاريخ الثقافي والأجتماعي، وكل هذا يتضافر ليؤسس ممارسة تفاعلية أو تداخلية جديدة لفلسفة الظاهرة الدينية ولتشكيل لاهوت مقارن ضمن الإطار التوحيدي المنفتح على التوسعات اللاحقة لعلم الاجتماع الديني، إنها القراءة التي تجمع بين القراءتين.
اصبح علماء الاجتماع والسياسة الذين يهتمون بالتجليات الحالية للأديان يتحدثون عن اعادة تركيب الاعتقاد، أو الإيمان، تحت ضغط عوامل عديدة. إن اختيار إعادة التركيب يدل إما على قرار باتخاذ موقف الحياد تجاه كل تقييم معياري لأشكال الاعتقاد الجديدة ومستوياته ووظائفه العابرة قليلا أو كثيرا ، وإما على تصور مكانيكي صرف لعمليات تشكل كل اعتقاد، وفي هذه الحالة الأخيرة نلاحظ أن الإيمان، قد تقلص الى مجرد اعتقاد مبتذل تتحكم به لعبة لايمكن ضبطها من اللآليات المختلفة ، إن التفكك يفترض أنه قد وجدت سابقا حالة مندمجة ومؤسسة للاعتقاد، إن ما يميز العقل الاستطلاعي عن العقل الإيماني والعقل السيد هو أنه يحاول أن يكشف الانحرافات الموضوعية حتى درجة التشيؤ والتطرف ، وعن الانحرافات الاختزالية، لكي يبلور بشكل أفضل الأماكن الجديدة للصحة المعرفية ، ولكن هل المشروع الهادف للتوصل الى المعرفة الصحيحة للممارسة الاجتماعية ولآليات الانتاج الخاصة بكل مجتمع يتوافق مع المطالبة بذات مستقلة نقدية قادرة على معرفة ذاتها؟ ان العلوم الاجتماعية تجيش دائما اسبقيات انتربولوجية وتحاول بعدئذ تغطيتها بحجاب المعرفة العلمية الموضوعية. واما الخطابات الدينية التي سادت قبلها والتي ازيحت عن عرشها من قبلها وسفهت، فقد فعلت الشيء ذاته، لقد خلعت ستار القداسة على المعايير المستبطنة من قبل المؤمن، والمهضومة وكأنها متولدة عن الوصايا الإلهية ، في الواقع إن المسلمات الضمنية للعلوم الاجتماعية تمارس تاثيرها على الفرد بصفتها أولويات تستبق على ما سيصبح عليه الانسان بالضرورة كذات ، وسوف يصبح الأمر كذلك في كل مكان ينتصر فيه النظام المعرفي المشكل على هذا النحو في كل المؤسسات المدنية للمجتمع، وكل المسلمات الميتافيزيقية يصعب في حقيقة الأمر الغوص فيها الى نهاية المطاف، ومن ثم يستحل بلورة فكرة صادقة عنها، ولذا ينبغي اجراء عملية إزاحة مبرمجة لها بعيد عن الخط التاريخي الذي يجبرنا العقل الأدواتي والبرغماتي أي النفعي على اتباعه.
إن الأمر هنا يتعلق بتحجيم مزاعم الحركات الدينية المحافظة والمغلقة التي ترفض المكتسبات الفكرية للحداثة ، كما وينبغي تحجيم المطالب التي تركز على عصبية الأنتماء للهوية القومية أو الطائفية، أو شتى أنواع التعصب وكره الآخر ، لمجرد أنه لا يشاركنا نفس الأنتماء القومي،ن واللغوي، أو الديني ، وفي الوقت ذاته ينبغي أن نواصل مكتسبات الحداثة بصفتها مشروعا لم يكتمل بعد ، أي مشروعا يهدف أساسا الى تحرير الشرط البشري ، وإذا كان ينبغي أن يعود العامل الديني الى التاريخ بعد أن فرغ منه أو استبعد لسنوات طويلة ، فإنه لا يمكن أن يعود إليه كما كان سابقا، وإنما ينبغي عليه أن ينقد ذاته ويتجاوز عراقيله وانغلاقاته تماما كما يحصل للحداثة الآن ، بمعنى آخر ينبغي أن يتجاوز في إعادة تحديده وبلورته الجديدة كل ما برر نقده وتسفيهه وازاحته وحشره في الحياة الشخصية للفرد في المجتمعات المعلمنة، التي تشكلت مع الحداثة وهكذا لا يعود من حق الدين أن يحتكر السيطرة على الذرى العليا التي يتقرر فيها تشكيل الذات البشرية وحسم مصيرها بكل حرية وسيادة ، ينبغي أن نعلم أن كل ذات بشرية وكل مجتمع بشري يشكلان من خلال جدلية معقدة وتفاعلية ومكثفة قليلا أو كثيرا، مرئية أو غير مرئية ، وينبغي أن ينتج عن هذا المعنى الأساسي موقف جديد للباحث الذي سيكون في ذات الوقت مفكرا نقديا لكل ما يتحمل مسؤلية الكلام عنه ، إن القوالب المفهومية والنظرية التي تشكلت في سياق القطيعات السياسية والاجتماعية الكبرى، التي حصلت أثناء الحداثة الكلاسيكية ، ينبغي أن تترك نفسها تكمل وتصحح فيما يخص النقاط الثلاث التي تظل صالحة وسارية المفعول . وأقصد بالنقاط الثلاث هنا : الممارسة العملية ، والفاعل المنخرط في الممارسة ، وتصميم الروابط التي تربط بين الفاعل الفردي والنظام الاجتماعي السائد ، والواقع أن القوالب المفهومية والفلسفية المذكورة آنفا هي عبارة عن التركيبة التي تصل بين هذه الاشياء الثلاثة ، كما تصل التركيبة النحوية بين أطراف الجملة . فالممارسة الفعلية هي نتاج المعايير والقيم المستبطنة من قبل الجماعة ثم بدرجات متفاوته من قبل كل عضو من أعضاء الجماعة، وذلك طبقا للفلسفة السياسية المهيمنة، وعندما تتجسد هذه القيم في مؤسسات معينة، أو تصبح مؤسساتية فإنها تتحول الى أدوار أو الى نماذج تحتذى أو أمثلة عليا من أجل الادراك والممارسة والحكم على الاشياء، ينبغي أن نعلم أن النظام الاجتماعي لا يتولد بشكل كلي لا عن الارادة الإلهية، ولا عن العقد الاجتماعي ، وإنما هو ينتج عن مستويات استبطان التصورات التي تحدد أو تكون جماعات الفاعلين اي البشر . وهكذا نجد أن علم الاجتماع الكلاسيكي من دوركهايم الى بارسونس، يشكل في الواقع فلسفة اجتماعية، وهذه الفلسفة الاجتماعية تفرض تصورا معينا عن الفاعل أي الانسان، وعن الاخلاق الحديثة، وبحسب هذا التصور فإن الفرد سوف يصبح مستقلا استقلالا ذاتيا كلما سيطر على المعايير والنواميس وأفلت من قبضة الجماعة، أو من هيمنتها ومراقبتها، بمعنى أن استقلاليته الذاتية تزيد كلما زادت سيطرته على المعايير والنواميس الجماعية، والواقع أنه يحاول عندئذ أن يحول الجماعة ذاتها عن نواميسها لكي تعتنق أفكاره الخاصة ، فاذا كان الفاعل يحدد نفسه كفرد مواطن فإنه ستحصل جدلية بين الفرد والمجتمع داخل الفضاء المحكوم بالقوانين السارية، وإذا كان يحدد نفسه كشخص ذي رساله روحية فإنه ستحصل جدلية بين الشخص والطائفة الروحية أو الدينية داخل إطار مجتمعات الكتاب المقدس ، وهذا الفاعل أو الانسان موجود ضمن مقياس أن المجتمع موجود بصفته مجتمعا حديث ـ أي كنظام من التفاوت الاجتماعي أو اللامساواة المضبوطة من قبل روح العدالة والحفاظ على كرامة المواطن ، إنه نظام تكون فيه العقائد الإيمانية وعادات السلوك ، والمواقع الطبقية ، محددة عن طريق فاعليتها ـ براغماتية ـ وظائفية شغالة، هكذا نرى كيف أن علم الاجتماع الكلاسيكي وامتدادته الحالية قد عريا الآليات الاجتماعية وأنظمة المعايير والتصورات التي تشكل الذات الداخلة في حالة تفاعل مع الفئة الاجتماعية . وفي ذات الوقت راح علم الاجتماع هذا يحل محل الفكرة القديمة عن القدر والمصير أو فكرة الضرورة والصدفة اللتين تتحكمان في نهاية المطاف بكل الوجود البشري ، وهكذا أصبح الانسان عبارة عن ذات تاريخية مفردنه لا يمكن أن تتحرك أو تفكر إلا داخل حدود الإكراهات تدرس موضوعيا أو علميا من قبل علم الألسنيات وعلم الاجتماع وعلم التاريخ .
كاتب أردني مقيم في نيزلاندا














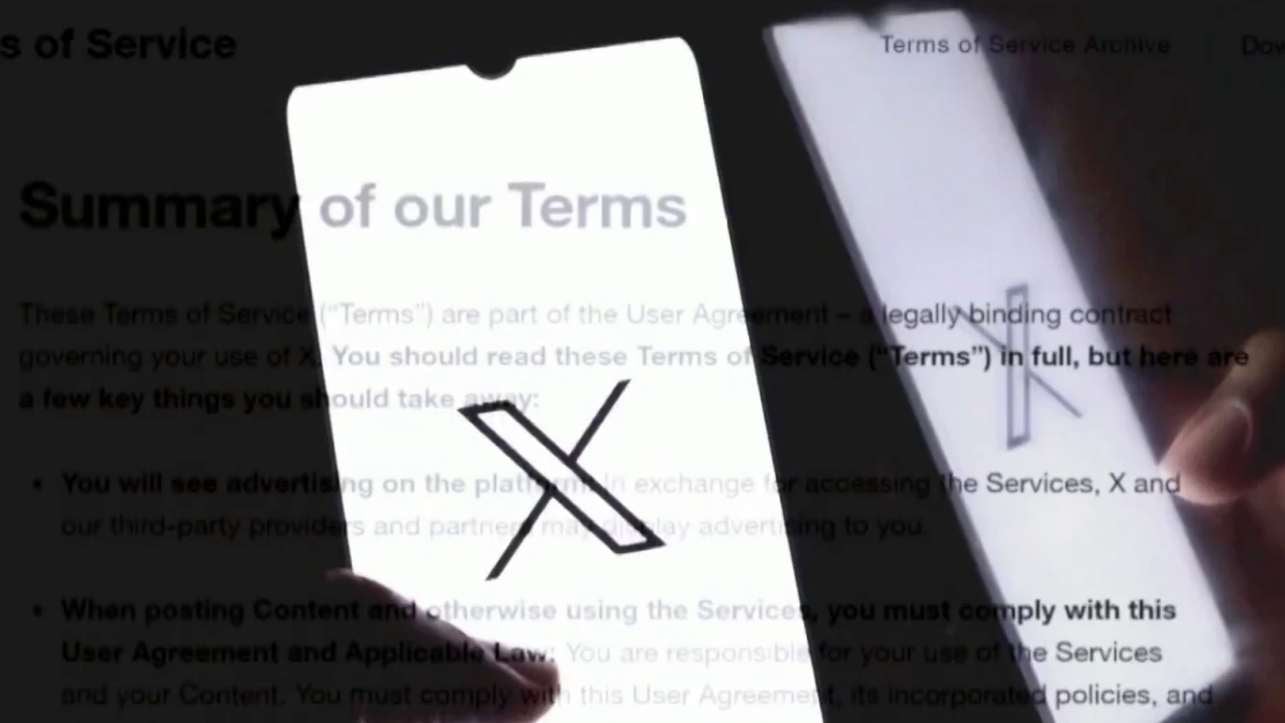





التعليقات (0)