أوروبا تتصالح مع نفسها

بقلم/ ممدوح الشيخ
في تحول تاريخي بدأ بحر المانش يتحول للمرة الأولى إلى جسر بين بريطانيا و"القارة الأم"، بعد أن بقي لقرون ساحة حرب فرنسية بريطانية وسمت التاريخ الأوروبي بميسمها، صحيح أن نفقا ربط الجزيرة المتمردة ذات الإرادة الفولاذية باليابس الأوروبي الذي طالما تبادل مع جزيرته العصية محاولات السيطرة المتبادلة. لكن هذا النفق الذي اختصر مسافة نقل السلع والبشر لم ينجح في فتح البوابات المغلقة أمام الأفكار، أي أنه كان تعبيرا عن ضرورات المصالح لا عن تقارب الرؤى.
لكن ختام قمة بروكسيل المنعقدة مؤخرا شهدت تحولا هو بكل المعايير "تاريخي"، فبريطانيا التي فضلت التقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية وبينهما المحيط الأطلنطي، قررت لأول مرة التوجه صوب اليابس الأوروبي الذي لم يفلح قرب المسافة في ربطها به، وبعد قرون من "فرنسة" اليابس الأوروبي تجد أوروبا: اليابس والجزيرة معا طريقا وسطا بين الرؤية الفرنسية الألمانية (الاتحاد الأوروبي)، والرؤية الأمريكية البريطانية (حلف شمال الأطلنطي)، وهو تحول ربما لم يكن ليحدث لولا وصول نيكولا ساركوزي لرئاسة فرنسا، وربما بدرجة أقل وصول أنجيلا ميركل لمنصب مستشار ألمانيا.
قبل الوصول إلى لحظة التوافق التاريخية المشار إليها كانت القارة والجزيرة ومعهما الولايات المتحدة قد خاضت العديد من الاختبارات التي أكدت جميعا حاجة الأطراف الثلاثة للعمل معا، فخلال النصف الأول من القرن العشرين انعزلت أمريكا عن الشأن الدولي واتجهت بريطانيا صوب اليابس الأوروبي فاشتعلت حربان عالميتان ضاريتان (الأولى 1914 – 1918 والثانية 1939 - 1945)، وفي الحالين كانت العسكرية الأمريكية قارب النجاة للقارة مرة من ألمانيا القيصرية وحلفائها والثانية من النازية والفاشية، ومن نهاية الحرب العالمية الثانية لنهاية الحرب الباردة (1989) كانت أوروبا تحتمي بالمظلة النووية الأمريكية في مواجهة الخطر النووي السوفيتي. بل إن أوروبا من الناحية الاقتصادية لم تكن لتتعافى لولا مشروع مارشال.
لكن فرنسا بعد قليل من تحريرها كانت على موعد مع الديجولية التي حاولت جاهدة دفع أوروبا بعيدا عن الولايات المتحدة على خلفية تباينات ثقافية عميقة.
وبعد نهاية الحقبة الديجولية بخروج الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك من قصر الإيليزيه انتهت الديجولية، كما لو كانت جملة اعتراضية!! فمؤسسها شارل ديجول أعلن انسحاب بلاده من حلف شمال الأطلنطي (الناتو) ودشن بذلك عهدا من التباعد وصل في نهايته إلى التنافس العلني الأمريكي الفرنسي حتى انتهى زمن المشاكسة الفرنسي بكارثة رواندا (1994)، وبدأ زمن المسايرة مع ساركوزي وصولا إلى الحديث الجدي عن العودة (الكاملة) للجناح العسكري للحلف حيث انسحبت منه في الستينات وعادت إليه (جزئيا) في التسعينات.
والتحول الذي يقوم به ساركوزي في طبيعة علاقة بلاده بثالوث: بريطانيا – أوروبا – أمريكا، هو من أهم التصورات التي حملته إلى الإيليزيه، وقد طرحها بقوة في القمة الأوروبية الأخيرة في بروكسيل. ساركوزي أكد أن أوروبا ""لا يمكن لأوروبا أن تكون قزما على الصعيد العسكري وعملاقا في الموضوع الاقتصادي، هذا غير ممكن"، واصفا الخلاصات التي توصلت إليها قمة الاتحاد الأوروبي التي ترأسها على صعيد السياسة الأوروبية الدفاعية بأنها "بالغة الأهمية". وعليها – أي أوروبا – أن "تحافظ" في هذا المجال على "حرية تحركها" مع التعاون مع حلف شمال الأطلسي والحفاظ على صداقتها مع الولايات المتحدة.
والجدير بالتوقف عنده هنا أولا أن المواءمة ممكنة بين الأجندات المتعارضة، وكذلك بين الهويات المتباينة، وهو ما لم يحدث حتى الآن في العالم العربي رغم المشتركات الكثيرة والتحديات الخطيرة والآمال العريضة وأدبيات الوحدة التي لا تحصى، فهل المشكلة في العرب أم في العروبة أم في حلم الوحدة؟
من جانب آخر فإن هذا يحدث في ظل أزمة مالية عالمية شديدة الضخامة ومن المؤكد أن من يقرر في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة تدشين عمل جماعي عسكري بهذا الحجم لا بد أنه يستشعر مخاطر كبيرة – ولو على سبيل الترجيح – فما طبيعة هذا المخاطر؟ وما مصادرها المحتملة؟ وما حجمها؟ هذه أسئلة من المهم جدا أن نفكر بها بل أن ننشغل بها، فنحن نشكل على مدى التاريخ الجوار الأهم للقارة الأوروبية، وما يدفع قادتها – في هذا المأزق الاقتصادي العالمي – إلى تدشين مظلة أمن جماعية بهذا الحجم ينبغي أن يشغل مثقفينا ومؤسساتنا البحثية.
فالانشغال بالصراع العربي الصهيوني – وحده – عما يحدث في كل مكان في العالم من تغيرات خطأ لا يجوز أن نقع فيه، وبعض هذه التحولات قد تغير – ولو جزئيا – نظرتنا للصراع العربي الصهيوني نفسه، وهي على وجه القطع ستغير نظرتنا للقارة التي قررت أن تتصالح مع نفسها.

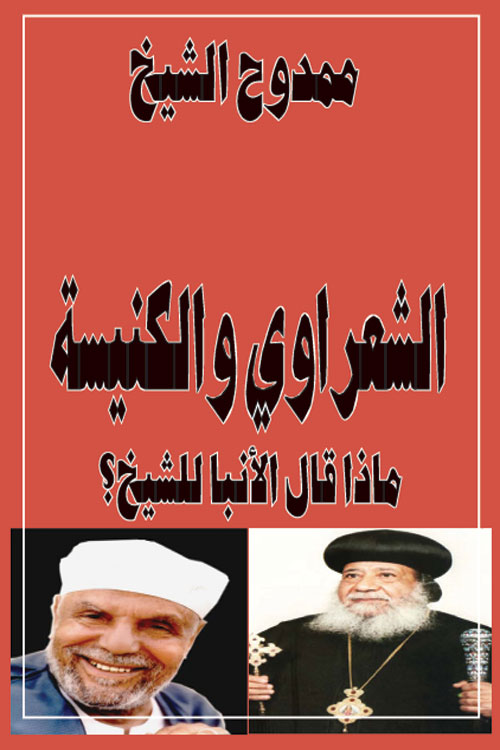


التعليقات (0)