أذناب البقر(6)

عندما تفجرت ينابيع البترول تحت أقدامهم، وباتوا يسيرون فوق أكبر مخزن طبيعي للثروة في هذا الكوكب، وعندما جمع الله سبحانه وتعالى بين أيديهم جميع المقاليد الاقتصادية للجنس البشري بطريقة لم يحدث مثلها على مدار حقبات التاريخ الإنساني منذ بداياته الأولى، وعندما باتت جميع أسس الاقتصاد الكوني تستند على ما يختبئ تحت أقدامهم من سائل أسود تحولت مدن صحرائهم وقراها إلى مشافط عالمية تدفقت عليها سيول اللاهثين وراء الثروة من كل حدب وصوب، وتطاحن على أبواب سفاراتها جيوش الطامعين في أوصال هذه الكعكة التي بلغ من ضخامة حجمها أن امتدت أطرافها أبعد من مدى البصر؛ فلم يظهر لحدودها نهاية حتى الآن. باع الشاوية شياههم وهجر أهل المدر قراهم وانحدروا من جبالهم كالسيول الجارفة لا يلوون على شيء وسيول اللعاب تنهمر من أفواههم كعصارة الذباب الجائع كي يحجزوا لأنفسهم مقاعد حول فتات تلك الكعكة الشهية، وتتكدس نساؤهم وذراريهم على عتبات تلك المدن النفطية يتحاشرون جنباً إلى جنب مع بقية أكوام اللاهثين العالميين؛ الداخليين منهم والخارجيين.
ولكن أين أبناء الصحراء أنفسهم؟ أين من نبع النفط في صحرائهم وتبرك بتراب أقدامهم قبل أن يخرج إلى العالم وتتراكم خيراته في تلك المدن؟ لماذا لم نجدهم يقفون على أبواب المدينة ضمن طوابير المصطفين بملفاتهم يتسولون مرتباً شهرياً، يقبلون يد هذا ويلعقون حذاء ذاك كيما يقبلهم ضمن قطيع صبيانه ويوظفهم في خدمته كما توظف حيوانات الركوب؟ لماذا لم نجدهم يعرضون أنفسهم في أسواق نخاسة السخرة أسوة بقطعان اللاهثين العالميين؟ لماذا لم يبيعوا جمالهم ويعقروا نوقهم ويحرقوا خيامهم ويهجروا صحراءهم ويهرعوا نحو المدن كما فعل أبناء الشاوية ورعاة التيوس؟
لماذا لم نجدهم يشاركون أبناء يعقوب في سرقة مجاري جدة وتهريب نفط ينبع واختلاس ميزانية أرامكو ونفطها الخام والمكرر والتحايل على عقودها ومشاريعها والتآمر على تحطيم وتخريب طائرات الخطوط السعودية عمداً أثناء صيانتها وتزوير شهادات صلاحية أجهزتها ومستندات صيانتها وذلك لإرهاق ميزانيتها للحيلولة دون خصخصتها حتى لا تفقد عصابة الأدارسة العلويين سيطرتها المطلقة على الأجواء النفطية؟ لماذا لم يحاول أبناء الصحراء –على الأقل- مشاطرة تلك العصابة جزءً من مدخول صحرائهم؟ لماذا تركوهم يزرعون بقية فروع عصابات الفساد –وبطريقة مكشوفة- في الأمانات والجمارك والغرف التجارية والاتصالات والمواصلات والمدن الصناعية والاقتصادية والهيئات الملكية والوزارات والمؤسسات الاقتصادية والمالية والعسكرية والاستخباراتية إلى آخره؟
لماذا يتعفف أبناء الصحراء حتى عن المطالبة بإعانة للبطالة أو بدل لغلاء المعيشة بالرغم من أن الحكومة السعودية هي ابنتهم البارة، هي منهم وفيهم، ينتمون إليها وتنتمي إليهم، دماؤهم تجري في عروقها ودماؤها في عروقهم، وبالرغم من أنه لم يبق أحد من أهل المدر والحجر ومن جماعة اللاهثين العالميين إلا تعالت أصواتهم حتى صمت الآذان مطالبين بكل ما يمكن سلبه من جيوب آل سعود بحق أو بغير حق؟!
ترى هل بلغت الكرامة بابن الصحراء إلى هذا الحد من الجنون؟ أم بلغت الخسة والنذالة بغيرهم إلى الحد الذي جعلهم يعتبرون الكرامة والعفة وعزة النفس جنوناً؟
ولكن السؤال القنبلة؛ السؤال الثورة؛ السؤال المعجزة هو: لماذا اختار الله سبحانه وتعالى هذه الصحراء على وجه التحديد؛ ودوناً عن كافة بقاع الدنيا وأصقاعها؛ لماذا اصطفى الله هذا المكان اصطفاءً انتقائياً حصرياً ليكدس تحت رماله جميع تلك الثروات النفطية الهائلة ويخبئها عن أعين العالم بأسره طيلة تلك الحقبات من الزمن وبطريقة لا يمكن لأحد أن يتوقعها؟! لماذا أعرض الله سبحانه وتعالى ونئى بثروته عن جميع تلك الأمم والشعوب المتحضرة والمتمدنة والزراعية والصناعية والتجارية ليضع كنوزه بين أيدي الأمة الوحيدة الفريدة التي لا علاقة لها بالمدنية والحضارة من قريب أو بعيد؟!!
مع مطلع القرن التاسع عشر؛ انطلقت الثورة الصناعية الكبرى التي حوّلت العالم بأسره إلى مجرد منتج من منتجات البترول بعد أن أصبحت حياة كل من يسكن في هذا الكوكب تعتمد بشكل أساسي على النفط سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وخصوصاً بعد أن أصبحت قوة الشعوب والدول لا تقاس إلا من خلال قدراتها الصناعية؛ بات لا يلزم لإسقاط أعظم دولة عظمى على وجه الأرض سوى شيء واحد فقط: أن تمنع عنها إمدادات النفط.
والآن؛ وبعد انقضاء قرنين كاملين على انطلاقة الثورة الصناعية لم يعد بمقدور أحد أن يتخيل إمكانية استغناء بقعة واحدة أو شعب واحد من شعوب هذا الكوكب عن النفط بأي حال من الأحوال، ولكن المعجزة هي أن الشعب الوحيد الذي لا يحتاج في معيشته إلى النفط إلا من باب الكماليات الثانوية جداً والتي يمكن الاستغناء عنها في أي لحظة دون أن يشكل ذلك أي أثر حقيقي على انسيابية حياته واستقرارها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي بوجه عام هو الشعب الوحيد الذي يتحكم في منابع النفط ويسيطر سيطرة مطلقة على عملية تدفقه إلى بقية شعوب العالم، إنهم أبناء هذه الصحراء على وجه التحديد، الصحراء العدنانية، صحراء إدوم، صحراء عيسو، صحراء أبناء إبراهيم الحقيقيين.
ولكن ما هذه المفارقة القدرية العجيبة؟ ما هو تفسيرها؟ وما الذي ترمي إليه الإرادة الإلهية من وراء هذه القصة؟!
أين أولئك الذين يدعون بأنه قد انتهى عصر المعجزات؟ وإذا لم يكن ظهور البترول بهذه الكميات المهولة وفي هذا الزمان والمكان وتحت أقدام هذا الشعب على وجه التحديد هو المعجزة بعينها وسنها وكامل حذافيرها؛ فما هي المعجزة إذاً؟
وإذا لم تكن هذه المعجزة كفيلة بإقناع البشرية بأن لله شعباً مختاراً؛ شعباً واحداً فقط اختاره الله دون بقية أمم الأرض وشعوبها ليكون إماماً وشاهداً وقائداً أعلى لهذا الكون وخليفة لله في أرضه يقوم مقامه في حكمها وإدارتها وقيادة شعوبها نحو طريق الحق والخلاص، شعباً مقدساً مختاراً اصطفاه الله اصطفاءً أبدياً كي يكون ممثلاً له في أرضه، شعباً ربانياً مقدساً جسد الله فيهم روح عدالته وفضيلته ليجعل منهم قدوة لبقية الأمم والشعوب وليجعل من ثقافتهم نموذجاً معيارياً عالمياً للإنسانية الحقة، نقول إذا لم تكن معجزة البترول كافية لإثبات هذه الحقيقة فإن البشرية تعاني من مشكلة حقيقية في الفهم والإدراك والرؤية من خلال ثقوب الغربال.
إن ثقافة الصحراء هي ثقافة الخلاص والنجاة من متاعب الدنيا والآخرة، هي ثقافة الإنقاذ من التخبطات الفكرية والأمراض النفسية والمتاهات العقائدية، هي ثقافة التحرير من العبودية والذل والظلم والفجور والقهر والغباء والخسة والنذالة والخيانة والغدر والكذب والنفاق والرياء وبقية عناصر الاستعباد التي فرضتها ثقافة المدينة على سكان هذا الكوكب، هي ثقافة التحرر من قيود الجسد وأغلال السوءة الحيوانية إلى رحاب الروح وفضاء النفخة الإلهية.
إن عناصر ثقافة الصحراء يمكن تلخيصها جميعاً في عبارة واحدة: "الكرامة"، فما هي هذه الكرامة؟ هل يمكننا بما نملكه من تعابير أدبية أن نقدم تعريفاً دقيقاً ومحدداً لهذه العبارة بحيث لا ندع شاردة أو واردة من عناصر هذه الكرامة لا يشملها تعريفنا؟ أم إن الكرامة مفهوم وجودي لا يمكن اصطياده بأجهزة اللغة المنطوقة أو محاصرته داخل قالب تعبيري مادي؟
إذا قلنا إن الكرامة هي تلك السلوكيات التي يحاول الإنسان من خلالها التعبير عن رفضه لجسده، أي رفضه لامتداده الحيواني. أو إنها السلوكيات التي تعبر عن عمق القطيعة الوجودية بين أقنومي الشخصية الإنسانية: الروح والجسد. السلوكيات التي تعبر عن عدم رغبة الأقنوم الروحاني في التعايش مع الأقنوم الحيواني داخل بوتقة الكينونة الشخصية للإنسان. أو السلوكيات التي تظهر مدى استمامة الإنسان في إثبات انتمائه الكامل لعالم السماء الروحاني، وتبروئه من انتمائه الأرضي الحيواني، وتنكره لوجود أي صلة تربطه بعالم الحيوان، واشمئزازه من مجرد النظر إلى جسده الحيواني (سوءته). فإننا نكون بهذا التعريف قد بذلنا قصارى جهدنا الأدبي لتقريب مفهوم الكرامة إلى الأذهان، ولكن ألا يبقى هذا التعريف شمولياً جداً ويحتاج إلى الكثير من الدقة والتحديد؟
لو تناولنا –على سبيل المثال- صفة الكرم كإحدى التجليات السلوكية لمفهوم الكرامة، لوجدنا أن التعابير الأدبية والتعريفات اللغوية المنطوقة التي نشير بها إلى هذا المصطلح "الكرم" هي مطاطية وفضفاضة بل وهلامية للحد الذي يستحيل معه تكوين أي صورة ذهنية دقيقة ومحددة لهذا الشيء الذي اسمه "كرم". فعندما نقول: "هذا الرجل كريم" فهل نعني أنه سخي معطاء مضياف؟ أم نعني أنه ينحدر من أسرة شريفة الحسب والنسب؟ أم أنه طيب القلب دمث الأخلاق حسن المعشر؟ أم أنه قوي جبار عظيم متعال ذو سلطة وسطوة؟
كيف استخدم القرآن الكريم هذا المصطلح "الكرم"؟ وماذا نعني أصلاً بقولنا أن القرآن كريم؟ هل كرم القرآن له علاقة بالبذل والعطاء وحسن الضيافة؟ كيف يمكننا أن نستخلص معنى دلالياً دقيقاً ومحدداً للكرم في قوله تعالى: (وقل لهما قولاً كريماً) أو قوله: (واعتدنا لها رزقاً كريماً) أو قوله: (وندخلكم مدخلاً كريماً) أو قوله: (رب العرش الكريم)؟ وهل كرم العرش هو من نفس نوع كرم القرآن؟
إن اللغة هي أداة مادية صرفة تستخدم لاصطياد المعاني وتجسيدها داخل قوالب تعبيرية مادية محسوسة وملموسة، لذلك فإن التعبير اللغوي المنطوق من شأنه تحقيق نجاح كبير في توصيف المحسوسات وتعريف الماديات، ولكن هذا النجاح يبدأ في التضائل كلما جنحت تلك المعاني نحو التجرد، بمعنى أن المعاني المجردة التي لا ترتبط كثيراً بعالم المحسوس والملموس تظل عصية على اللغة أن تصطادها داخل قوالب تعبيرية محددة، وما "الكرم" إلا مثالاً على ذلك.
ولكن الكرم من شأنه أن يتحول إلى مفهوم مادي محسوس وملموس عند استخدامه داخل أسوار المدينة، وهذا من الأمور التي من شأنها توضيح ذلك الفرق الشاسع بين الثقافتين: ثقافة المدينة وثقافة الصحراء، فالحضري باعتباره كائناً مادياً جسدياً صرفاً؛ استطاع أن يجسد مفهوم الكرم ويحجمه ويحصره داخل إطار الجسد الحيواني، استطاع أن يقولب هذا المفهوم في صيغة لا تخدم إلا غريزة الجوع.
عندما تتحدث مع المدني عن الكرم فإن ذهنه لا ينصرف إلا نحو المدلول الاقتصادي البحت لهذه العبارة: البذل والعطاء، إطعام الطعام، التبرع ببعض الملابس والحاجيات وخلافه. إن جميع هذه الأمور يمكن التعبير عنها بمصطلح "السخاء" وليس "الكرم"، فالسخاء هو الشق الاقتصادي المادي من مفهوم الكرم، وهو تعبير دقيق استطاعت اللغة أن تصطاده وتجسده داخل قالب تعبيري محدد ودقيق، وذلك على عكس مفهوم الكرم. إلا أن الحضري لا يستخدم مصطلح الكرم إلا للدلالة على السخاء، وهو بذلك يقوم بإلغاء هذا المصطلح وشطبه من قاموس المدينة، بمعنى أن الكرم بدلالته الأنطولوجية ليس له وجود داخل أسوار المدينة، فهو مفهوم روحاني لا علاقة له بالمادة، في الوقت الذي لا يوجد داخل أسوار المدينة مكان لغير المادة، لذلك فإن المدني لا يفهم من الكرم إلا ما يدل على المادة: "السخاء".
هنا نجد كيف استطاعت الثقافة المدنية أن تحول المفاهيم الأخلاقية المجردة إلى مفاهيم مادية مبتذلة، وأصبح الكرم الذي كانت تتناوله ثقافة الصحراء كمفهوم روحاني مطلق يرمي إلى التسامي فوق متطلبات الجسد والانفكاك من قيوده البيولوجية؛ أصبح في المدينة لا يتجاوز إطاره البيولوجي، ولا يتمحور إلا حول خدمة الجسد وغرائزه الحيوانية.
ولكن هنا أيضا لا بد لنا من وقفة مع مصطلح السخاء نفسه، فقد عرفنا السخاء سابقاً بأنه الشق الاقتصادي فقط من مفهوم الكرم بصفته الشمولية، وبذلك يكون السخاء هو إحدى التجليات السلوكية لمفهوم الكرم، بمعنى أنه يمكننا تشبيه الكرم بجسد يحوى عددا من الأعضاء، وأن السخاء هو مجرد عضو من هذه الأعضاء. ولكن ماذا لو قمنا بفصل هذا العضو عن جسده؟ ماذا لو قمنا بقطع الاتصال تماماً بين مفهوم السخاء ومفهوم الكرم، هل يبقى هذا العضو يحمل أي إشارة دلالية نحو الجسد؟
عندما قام المدني باختزال مفهوم الكرم برمته في مصطلح "السخاء" لم يعد هذا المصطلح يحمل أي دلالة أخلاقية، بمعنى أن البذل والعطاء في ثقافة المدينة لم يعد عملاً أخلاقياً مجرداً من النفعية والتمصلح، بل بات ضرباً من ضروب الصفقات التجارية القائمة على مبدأ تبادل المنافع. فالكرم المدني من الممكن التعبير عنه كالتالي: هو بذل بعض الفائض من المال في سبيل التظاهر بمساعدة الآخرين، أو هو تنازل الإنسان عن شيء من طعامه الزائد عن حاجته كنوع من إظهار التعاطف مع بعض الفقراء والمحتاجين، أو كنوع من التودد لبعض الأقارب والأصدقاء، أو كنوع من إظهار الشعور ببعض المسئولية الاجتماعية تجاه الغير. وهو في جميع هذه الأحوال يدور حول خدمة الجسد، وذلك باستجلاب قدر من القبول الاجتماعي الذي من شأنه توفير المزيد من السعادة والمتعة والراحة البدنية والنفسية لهذا الجسد داخل إطار محيطه الاجتماعي، فالمدني مهما تظاهر بالكرم والبذل إلا أن بذله هذا لا يمكن أن يتعدى حدود الفائض عن حاجته، وهو ما يدل على أنه لا يقدس العطاء والبذل لذاته بل لما يحمله له من فائدة ومنفعة، فهو لم يقم –أساساً- بفعل من أفعال الكرم إلا بغرض خدمة جسده، خدمة وجوده المادي وراحته وسعادته الجسدية داخل بيئته الاجتماعية، لذلك فإنه لا يمكن أن يسمح لهذا الكرم أن ينال من راحة جسده وسعادته، أو ينتقص شيئاً من حاجات معيشته الأساسية، أو حتى شبه الأساسية.
وباختصار؛ فالكرم –برغم كونه مفهوماً أخلاقياً- إلا أنه لا يخضع في الحاضرة لغير قانون المنطق الرياضي البحت، قانون المادة والحركة، الفعل وردة الفعل، هو نوع من الشغل الذي يسبقه حافز وتتبعه نتيجة، هو حركة تسير في اتجاه هدف محدد ومعلوم. فمفهوم الكرم في ثقافة المدينة –حاله كحال أي مفهوم أخلاقي آخر- يدور في النهاية حول الجسد، حول خدمة هذا الجسد المادي وحماية وجوده البيولوجي داخل الجماعة، لذلك كان بإمكاننا تقديم توصيف لغوي محدد لهذا المفهوم الأخلاقي في ثقافة المدينة عندما حصرناه في مصطلح "السخاء"، وذلك باعتبار اللغة أداة مادية صرفة؛ تتجسد من خلالها المعاني داخل قوالب محسوسة ملموسة، والسخاء مادة محسوسة ملموسة من خلال تجلياتها البيولوجية، ولكن ترى هل ينطبق نفس الكلام على ثقافة الصحراء؟ أم المسألة على النقيض تماماً.
هل يمكننا لغوياً توصيف مفهوم الكرم بنفس القدر من الدقة والتحديد خارج أسوار المدينة؟ هل يمكننا أن نتوصل إلى تعريف قاموسي لمصطلح الكرم لدى أبناء الصحراء؟
دعونا نحاول أن نستأصل الجانب الاقتصادي لمفهوم الكرم في ثقافة الصحراء من سياقه العام، لنحاول –مثلاً- اعتبار مصطلح "السخاء" رديفاً للكرم البدوي، ولنر إلى أي مدى يمكن لمحاولتنا هذه أن تنجح.
فلنأخذ –على سبيل المثال- تلك التجليات السلوكية التي يعبر من خلالها البدوي الأصيل عن مفهومه للكرم: كأن تقدم لقريبك أو جارك أو ضيفك أو حتى عابر السبيل آخر وجبة لديك، تلك التي لا تملك غيرها، حتى لو كنت جائعاً وفي أمس الحاجة لها. وأن لا تسأل ضيفك عن اسمه، أو من أين أتى، أو إلى أين ينوي الرحيل، لا تسأله إذا ما كان غنياً أم فقيراً، شريفاً أم حقيراً، من علية القوم أو من سفلتهم، ولا يعنيك إذا ما كان سيرد لك جميلك أم ينكره، إذا ما كان سيذكرك بخير أم بسوء، كل ما يعنيك هو أن لا يمر بك عابر سبيل يحتاج إلى طعام إلا أطعمته، أو شراب إلا سقيته، أو مأوى إلا آويته، أو جوار وحماية إلا أجرته وحميته حتى تبلغه مأمنه، وبغض النظر عن أي مردود مادي.
هنا نحن نتحدث عن جانب اقتصادي أيضاً يتعلق بالبذل والعطاء والسخاء المادي، ولكن إلى أي حد هو اقتصادي ومادي؟ هل يمكننا اعتباره مادياً بحتاً لا تحكمه سوى دوافع التمصلح وتبادل المنافع؟ هل يمكننا توصيفه بأنه سخاء وحسب؛ سخاء كذلك الذي نجده داخل أسوار المدينة؟ هل يمكننا فصله بالفعل عن سياقه الأخلاقي المجرد؛ عن المفهوم الأنطولوجي للكرم؟
ترى أي نوع من المادية النفعية يمكننا العثور عليه لدى شخص يقدم –مجاناً- آخر وجبة طعام يملكها؛ تلك التي لا يملك غيرها، ولا يعلم على وجه التحديد متى سيملك غيرها؟ ترى هل يقبل مفهوم الكرم البدوي القسمة على مربع الجسد؟





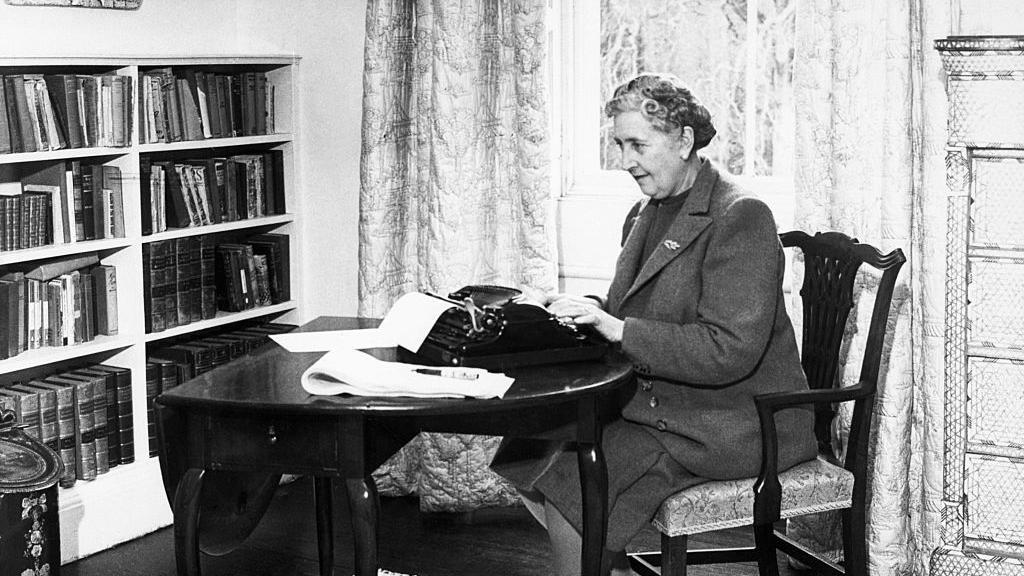











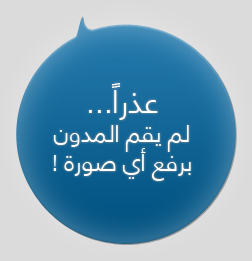

التعليقات (0)