آيات القتل والقتال في القرآن الكريم - الجزء الرابع

آيات القتل والقتال في القرآن الكريم / الجزء الرابع
من كتاب/ قضايا تهم كل مسلم
تأليف: إبراهيم أبو عواد .
......................
} فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِن اللهَ قَتَلَهُمْ {
[ الأنفال :17]
الآيةُ تتحدث عن يوم بَدْر . وفيها رَد الفضلِ إلى اللهِ صاحبِ الفضل _ سبحانه وتعالى _ . وقد أُضيف القتل إليهم على جهة الكسب ، أمّا التأثيرُ فلله تعالى وَحْدَه . فهو _ سبحانه _ الذي قَتَلَهم بما يَسّره من الأسباب التي أدّت إلى هزيمة الأعداء وانتصارِ المسلمين . وهو _ سبحانه _ الذي أعانَ على الأعداء ، وبث في قلوبهم الرعب ، وثبّث قلوبَ المؤمنين .
قال القرطبي في تفسيره ( 7/ 337 ) : (( أي يوم بدر . رُوِيَ أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لَمّا صَدروا عن بدر ذَكَرَ كل واحد منهم ما فعل ، قتلتُ كذا، فعلتُ كذا، فجاء من ذلك تفاخر ونحو ذلك ، فنزلت الآية إعلاماً بأن الله تعالى هو المميت والمقدّر لجميع الأشياء ، وأن العبد إنما يشارك بتكسّبه وقصده )) اهـ .
والسياق التاريخي للآية الشريفة يتضح في غزوة بدر ، لذلك فهذه الآية تتحدث عن معركة حقيقية ضد أعداء مُسلّحين لا أبرياء أو عُزّل ، وهم يستهدفون قتلَ المسلمين، والله تعالى قام بقتلهم ، أي إنه سهّل على المسلمين قتلَهم ، ومكّنهم من الكافرين ، وقادهم إلى مصارعهم . وهذا لا يتعارض مع كَوْن الله تعالى الرحمن الرحيم ، فالله تعالى هو الإله المتصرف وَحْدَه في الكون يَرحم مَن يَشاء ، ويُعذّب مَن يَشاء. ومن عادى اللهَ تعالى فعليه أن يتحمل المسؤولية ، وينتظر انتقام الله وعذابه . واللهُ تعالى لا يُكرم أعداءه ، بل يُهينهم ويَسحقهم . وهو _ سبحانه _ قتلَ أعداءه جزاء محاربتهم له، وقرّب أولياءه، فمن عمل خيراً وجد خيراً، ومن عمل غيرَ ذلك وجد غيرَ ذلك .
} يَا أَيهَا النبي حَرض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ {
[ الأنفال : 65]
التحريضُ هو الحث على الشيء . والآيةُ تَأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحث المؤمنين على القتال .
وقد يظن بعضُ المغرِضين أو العوام في الشرق أو الغرب بأن الآية الشريفة تدل على أن الله تعالى يأمر النبي بالكراهية والعنصرية تجاه الآخرين، وبث الحقد والقتال في النفوس دون وجه حق . وهذا الوهم ليس له أدنى نصيب من الحقيقة . وهو استنتاج مغلوط لأنه مبني على فرضية مغلوطة تغفل السياقَ التاريخي للنص . واعلم أن الأعداء كانوا يحيطون بالدولة الإسلامية من كل الجهات ، فقد قضى المسلمون جزءاً كبيراً جداً من أعمارهم ، وهم في حالة حرب . فلا يجوز إخراج الآيات التي تتحدث عن حالات الحرب ، ومحاولة إسقاطها على أوضاع السّلم ، والأوضاع الطبيعية . فالحرب حالة طوارئ خاصة تستدعي شحذاً للهمم ، وتحريضاً على القتال بكل الوسائل المعنوية والمادية . فلا يمكن أن أستقبل عدوي الذي يريد قتلي بالورود وعباراتِ الترحيب والاستقبال. إذن ، هي حالة حرب ، ولا بد من التعبئة المعنوية والعسكرية لقتال أعداء الحق من أجل إرساء دعائم الحق والعدل والأمان حتى تستقيم الحياة للناس ، فلا يعقل أن نترك كل مجرمٍ يعيث في الأرض فساداً ، ثم نمنحه وسام الشجاعة والأخوة الإنسانية . يجب قتل الأعداء المحارِبين الذين هم أعداء البراءة والأخوة الإنسانية والاحترام المتبادل .
قال أبو السعود في تفسيره ( 4/ 34) : (( بَالِغْ في حثهم عليه _ أي القتال _ ، وترغيبهم فيه بكل ما أمكن من الأمور المرغّبة التي أَعْظمها تذكير وَعْده تعالى بالنصر ، وحُكمه بكفايته تعالى أو بكفايتهم . وأصل التحريض الحرض ، وهو أن ينهكه المرض حتى يشفى على الموت )) اهـ .
} فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتموهُمْ {
[ التوبة : 5]
هذا أمرٌ إلهي للنبي صلى الله عليه وسلم إذا انقضى الأجل ، أن يَقتل المشركين حيثما وُجدوا ، سواءٌ كانوا في الحِل أو الْحَرَم . وذلك صيانةً للأشهر الْحُرُم من القتل والقتال .
إذن ، مع رفع الأمان عن المشركين الذين لم يرتدعوا عن أفعالهم المعادية توجّب قتلهم لكي تأخذ الحياةُ دورتها الطبيعية ، والقتال حتى اعتناقهم الإسلام . لكن أحدهم قد يقول إن الله تعالى يقول : } لا إِكْرَاهَ فِي الدينِ { [ البقرة: 256] ، فكيف يُقاتَلون حتى اعتناقهم للإسلام ؟! .
فنقول يجب التمييز بين الكتابيين والمشركين ، فالإسلام خصّص مكانة معتبَرة لأهل الكتاب باعتبارهم شركاء مع المسلمين في بعض الأصول بعكس المشركين، فالمشرك لا يستند إلى أي كتاب سماوي ولا وَضعي ، بل هو يعبد أحجاراً من صنع يديه ، وبالتالي تم تصنيفهم كخونة خيانة عظمى عليهم السيف حتى يرتدعوا ويعتنقوا الإسلامَ ، ورُفِع عنهم شرعية الغطاء الإنساني لأنهم شواذ عَقَدياً ضد الإنسانية . وليس في ذلك إجبار أو إكراه ، أَرأيتَ المجرمين والقتلة وتجار المخدرات الذين يبيدون شعوباً بأسرها ، لا خيار أمامهم إلا أن يصبحوا مواطنين صالحين ، أو يلاقوا مصيرهم المحتوم وعقوبتهم الرادعة ، فمن غير المعقول أن نترك تاجرَ المخدرات حراً في تصرفاته بحجّة أن أفعاله حرية شخصية وقناعة ذاتية . والمشرك يريد فرضَ عبادة الأوثان في أرض الله ، فلا يعقل أن يجزيه الله خيراً على هذا الفعل . فكان لا بد من وضع حد لهم ، وإيقافهم عن طريق قتلهم واستئصالهم، لأن كل وسائل الحوار لم تنفع معهم، وفوق كل هذا فهم يحملون السلاحَ في وجوه المسلمين ، فكان لزاماً على نظام الدولة الإسلامية أن يضع حداً لهذه المهزلة ، لئلا يحدث تسيّب أو انفلات يقضي على كل المجتمع، ويعيد الناس إلى الوثنية التي هي ضد الله في أرض الله. أَرأيتَ لو أن شخصاً يشتم الحاكمَ في قصره ويرفع في وجهه السلاح ، أو يشتم الحكومةَ في المقرات الحكومية، ويقتل موظفي الدولة.ماذا ستكون رد فعل الأجهزة الأمنية ؟! . ولله المثل الأعلى ، فالأرض أرضه، ولا يقبل لأحد أن يشاركه فيها من أوثان المشركين وآلهتهم الوهمية ، فكان القتل الحل الوحيد والأكثر نجاعةً للتعامل مع هؤلاء الذين لا يُرسِلون ولا يَستقبلون، ولا يفهمون إلا لغة السيف .
قال ابن الجوزي في زاد المسير ( 3/ 398 ) : (( قولُه تعالى: } فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ { فيها قَوْلان : أحدهما _ أنها رجب وذو القعدة وذو الحِجّة والْمُحرّم ، قاله الأكثرون . والثاني : أنها الأربعة الأشهر التي جُعلت لهم فيها السياحة ... فعلى هذا سُمّيت حَرَماً ، لأن دماء المشركين حُرّمت فيها )) اهـ .
} وَإِن نكَثُوا أَيْمَانَهُم مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ {
[ التوبة : 12]
فإن نقضَ المشركون أيمانهم وعهودهم ، وطعنوا في الإسلام ، أي عابوه وانتقصوه . فعندئذ لا عِصمة لدمائهم ، ويجب قتالُ أئمة الكفر ، وهُم رؤساء الضلال ( صناديد قُرَيْش ) الذين يَتْبعهم الناسُ ، ويَعتبرونهم القُدوة ، والمَثل الأعلى .
ويظهر من سياق الآية الشريفة أن هؤلاء القوم ليس أبرياء أو مُسالِمين ، بل إنهم خانوا الأمانةَ بنكثهم أيمانهم من بعد عهودهم ، وأضف إلى هذا طعنهم في الإسلام بغير وجه حق ، وهذا نقلهم إلى دائرة الكافرِ المحارِب الذي يُقتَل أينما وُجِد في العالَم في كل زمان ومكان . فهذه الآية تتعامل مع أعداء فاعلين في عداوتهم لا مدنيين أبرياء . والبعض يظن واهماً أن الكافر المحارِب هو الذي يُوَجّه نحو المسلمين السلاح فَحَسْب، وهذا جزء من الحقيقة ، وليس كل الحقيقة ، فكل من حارب الإسلامَ ( الدين السماوي الوحيد ) بأي شكل من الأشكال يجب قتله ، سواءٌ كانت حربه بالكلمة أو بالسيف أو بأي شكل آخر .
وفي زاد المسير ( 3/ 404 ) : (( قال ابن عباس : نَزلت في أبي سفيان بن حرب ، والحارث بن هشام ، وسهيل بن عمرو ، وعكرمة بن أبي جهل ، وسائر رؤساء قريش الذين نَقضوا العهدَ حين أعانوا بني بكر على خُزاعة حُلفاءِ رسول الله )) اهـ .
} أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْماً نكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَموا بِإِخْرَاجِ الرسُولِ وَهُم بَدؤوكم أَولَ مَرةٍ {
[ التوبة : 13]
هذا التوبيخُ يَحمل معنى الحض على قتالهم . وسببُ نزول الآية هو نقض قُرَيْش عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاهدهم بالحديبية ، حيث أعانوا بني بكر على خُزاعة ( حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ) . وقد هموا بإخراج الرسول من مكة ، حين اجتمعوا في دار الندوة ، وتشاوروا في أمره صلى الله عليه وسلم . وهؤلاء المشركون هم الذين بدأوا القتالَ يَوم بَدْر ، والبادئُ أظلم .
وقال الطبري في تفسيره ( 6/ 331 ) : (( يقول تعالى ذِكره للمؤمنين بالله ورسوله حاضاً لهم على جهاد أعدائهم من المشركين : } أَلا تُقَاتِلُونَ { أيها المؤمنون هؤلاء المشركين الذين نَقضوا العهدَ الذي بينكم وبينهم ، وطَعنوا في دِينكم، وظاهروا عليكم أعداءكم ، } وَهَموا بِإِخْرَاجِ الرسُولِ { مِن بَين أظهرهم فأخرَجوه ، } وَهُم بَدؤوكم أَولَ مَرةٍ { بالقتال ، يعني فِعلهم ذلك يوم بدر ، وقيل : قتالهم حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مِن خُزاعة )) اهـ .
والآيةُ الشريفة توضّح _ بلا أدنى لَبْس _ عِلّةَ القتال ضد هؤلاء الشاذين عن المسار الإنساني الحضاري ، فهم قومٌ نكثوا أيمانهم وعهودهم والشروطَ التي أعلنوا التزامهم بتطبيقها، وعملوا جاهدين لإخراج النبي صلى الله عليه وسلم عبر التضييق عليه ، ومحاصرته بكل السبل، فكانوا سببَ خروجه ، وهُم الذين اعتدوا على المؤمنين أول مرة ، فكان بدء القتال منهم ، وكل هذه الأفعال العدائية يجب أن يتم التصدي لها بشكل حازم ، لذا جاء تحريض المؤمنين على القتال ( ردة الفعل ) لكف عدوان المشركين (الفِعل) وتحجيمهم ، وتثبيت دعائم الوجود الإسلامي الذي ينشر الرحمة والعدل والتسامح بعد أن يتم استئصال العناصر المسعورة التي لا تُرسِل ولا تَستقبِل . فلا بد للعقيدة من قوة تحميها ، ولا بد للقوة من عقيدة تُوجّهها . والإسلامُ مُصْحَفٌ وَسَيْف ، لا يُقبَل أحدهما بدون الآخر . ولكل مقامٍ مقال ، ففي بعض الأحيان يكون الكلامُ هو وسيلة الحوار ، وفي أحيان أخرى يكون السيف وسيلة الحوار مع بشر صاروا حيواناتٍ همجية، وأضل من الحيوانات . فهؤلاء لا يفهمون إلا لغة السيف ، مثلما تتعامل أية دولة في العالَم مع أعدائها، ومع الخونةِ من شعبها، ومع تجار المخدرات ، والقتلة ، الذين يريدون الدمارَ للعالَم .
} قَاتِلُوهُمْ يُعَذبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ {
[ التوبة : 14]
إنه أمرٌ إلهي بقتال الأعداء . وقد تكفّل اللهُ بقتلهم بأيدي المؤمنين ، وإذلالهم بالأسرِ والقهر.
قال السيوطي في الدر المنثور ( 4/ 138 ) عن نزول الآية : (( وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وابن المنذر وأبو الشيخ عن عكرمة _ رضي الله عنه _ قال : نَزلت في خُزاعة )) اهـ .
وقال الطبري في تفسيره ( 6/ 332 ): (( يقول تعالى ذِكره: قاتِلوا أيها المؤمنون بالله ورسوله هؤلاء المشركين الذين نكثوا أيمانهم ، ونقضوا عهودهم بينكم وبينهم ، وأخرجوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مِن بَين أظهرهم ، } يُعَذبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ { يقول : يقتلهم الله بأيديكم ، } وَيُخْزِهِمْ { يقول : ويذلهم بالأسر والقهر ، } وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ { فيعطيكم الظفر عليهم والغَلبة )) اهـ .
نلاحظ من خلال السياق التاريخي للآية الشريفة أنها تتحدث عن المشركين الذين نقضوا عهودهم ، وتلبّسوا بالخيانة العظمى ، وأَعملوا سيوفَهم في رقاب الأبرياء ، وبالتأكيد فإن جزاءَ القتلِ القتلُ . لذا جاء الأمر الإلهي بوجوب قتال هؤلاء المجرمين وقتلهم لكي يُلاقوا جزاء أفعالهم .
وكما قلنا في أكثر من موطن، فهذا الأمر الإلهي بالقتل ليس مُوَجّهاً ضد أبرياء أو مدنيين ، وإنما مُوَجّه ضد قتلة محترفين مُسلّحين لم يضعوا أَسلحتهم . ولا أظن أن هناك عاقلاً يتعاطف مع إرهاب المشركين بحق المؤمنين إلا أن يكون صاحب هوى، أو غرض مُبَيّت في رأسه للطعن بغير حق في القرآن الكريم، وهذا دَيْدن المستشرقين أصحاب المستوى الضحل عِلمياً، وصبيانهم من أبناء جِلْدتنا الذين يَحفظون كلمتين بالإنجليزية أو الفرنسية ، ويظنون أنفسهم شيوخاً للشافعي أو البخاري .
} قَاتِلُوا الذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ {
[ التوبة : 29]
نسخَ اللهُ جَل جلاله عفوَه عن المشركين والصفحَ عنهم ، بفرض قتالهم حتى يُصبحوا مؤمنين لا مكان في قلوبهم للكفر .
قال الإمام الشافعي في الأُم ( 1/ 426) : (( فمن لم يزل على الشرك مقيماً لم يحول عنه إلى الإسلام ، فالقتل على الرجال دون النساء منهم )) اهـ .
لقد سبق القول إن علينا التمييز بين المشركين الذين رُفِع الأمان عنهم لأنهم وصلوا إلى الدرك الأسفل من الحيوانية فلم يعد هناك فائدة منهم ، وبين الكتابيين الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ، وبالتالي فالآية لا تشملهم . إذن ، الآية مختصة بالمشركين ، وقد سبق الحديث عن سبب رفع الأمان عنهم ، ووجوب قتلهم في تلك المرحلة ، أو أن يُعطوا الجِزيةَ وهم أذلة لقاء حمايتهم في ظل الدولة الإسلامية ، وخضوعاً لقوانين الشريعة الإسلامية ، وهذا ما تفعله كل الدول التي تضع قوانين وضرائب، وتجبر الشعبَ على التقيد بها للصالح العام من وجهة نظرها، وكَوْنهم أَذِلّة بسبب إقامتهم على الكفر ، فالكفر ذُل في الدارين ، ومن اعتنقه سيظل ذليلاً في كل حالاته وإنساناً درجةً عاشرة عَقَدياً، والعقائد لا مجاملة فيها ، ولا حياد فيها ، فالمؤمن مؤمن ، والكافر كافر ، وكل واحد منهما يتحمل المسؤولية أمام الله تعالى عن اختياره . لكن الفرق بين النظام الإسلامي السماوي، والأنظمة الوضعية، هو أن النظام الإسلامي لم يأتِ لاستغلال الناس وسرقتهم، وإجبار الناسِ على عبادة الحكام، بل جاء لينشر الخيرَ في المجتمع ، ويحافظ على الأمن والأمان في شتى المناحي .
والجِزيةُ هي الخراج المقدّر على رؤوسهم ، وذلك مقابل تكفل الدولة بحماية نَفْس الذمي وماله وعِرضه ودِينه ، ولا يُكلّف حرباً ولا يدفع للدولة زكاة . فدافع الجِزية يُمنَح الأمان على نَفْسه وأسرته وممتلكاته ، وينطلق في أرجاء الدولة الإسلامية بكل أريحية ليقوم بالمشاريع التي يراها .
والجِزيةُ ليست إجراءً استكبارياً أو استغلالياً ، لأن المسلم يدفع الزكاة بإرادته ورغم أنفه ، والذّمي مَعفي من دفع الزكاة ، فمسألة الدفع المادي ليست مُوَجّهة للذميين خاصة ، بل هي عامة للجميع ، لأننا نتحدث عن دولة ذات أركان ، وبحاجة إلى أموال لكي تقوم بواجباتها تجاه المنضوين تحت لوائها ، ولكي تستمر ، ولا تَسقط .
} قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنى يُؤْفَكُون {
[ التوبة : 30]
أخزاهم اللهُ تعالى، كَيفَ يُصرَفون عن الهدى إلى الضلال. قال القرطبي في تفسيره ( 8/107): (( أي لعنهم الله ، يعني اليهود والنصارى ، لأن الملعون كالمقتول )) اهـ .
وهذا اللعن والطرد من رحمة الله تعالى عادلٌ ومنطقي ، لأن الكافر يجب أن يَعلم أنه اختار الكفر ، أي محاربة الله تعالى ، ولكنّ رحمةَ اللهِ الواسعةَ سمحت له بالعيش بكرامة في هذه الدنيا ، لكي تُقام عليه الحُجّة يوم القيامة ، ويلقى مصيره العادل. وهذا لا يناقض التسامح الديني، فالمسلم يجب أن يعلم أنه مسلم، والكافر يجب أن يعلم أنه كافر، والمومس يجب أن تعلم أنها مومس ، واللص يجب أن يعلم أنه لص ، وهكذا . فالتسامح لا يقتضي إبطال عقائدنا من أجل سواد عيون الآخرين ، وكما أن شتم الله تعالى موجود في الإنجيل عبر استخدام عبارات التثليث ، وأن لله تعالى ولداً ، وأن المسيح الذي هو عبد الله ورسوله إلهٌ بُصِق عليه وصُلِبَ ، وأن زنا المحارم المنسوب للأنبياء ، ووصف أثداء الزانيات كما في سِفْر حزقيال[ الأصحاح الثالث والعشرون] في التوراة التي يقدسها اليهود والنصارى تُعتبَر من عقائد أهل الكتاب، ولهم كامل الحرية في اعتناقها ، ولا أحد يمنعهم من ذلك ، فيجب أن يحترموا عقائدَنا ، وألا يتدخلوا في مسارها، لأننا تركنا لهم حريةَ عباداتهم الباطلة رغم كل ما في الإنجيل والتوراة من أشياء لا تليق . فالمسلم يعتقد أن غير المسلم كافرٌ خالدٌ في النار ، واليهودي يعتبر كل ما سوى اليهودي كافراً، والنصراني يعتبر كل ما سوى النصراني كافراً لا يدخل الجنّة، وهذه عقائد. واللهُ تعالى يَحكمُ بين الناس فيما كانوا فيه يَختلفون . ولكن علينا التنبه إلى أن الأستاذ لا يمنح الترقيةَ لطالب مشاغب،والحكومة ترفض المعارِضين، ومدير العمل يطرد الموظف الكسول. وللهِ تعالى الْمَثَلُ الأعلى، فمن المحال أن يمنح اللهُ الجنةَ لأعدائه الذين يسبونه ليلَ نهار ، بل إنه تعالى طردهم ووعدهم جهنم جزاءَ أفعالهم ، ومع هذا أعطاهم فرصة العيش بسلام في الدنيا لئلا يكون لهم حَظ في الآخرة .
} وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافة كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافةً {
[ التوبة : 36]
هذه الآية الشريفة تهدف إلى الأمر برد العدوان الذي يتعرض له المسلمون ، فالأمر بقتال المشركين كافة إنما جاء لأنهم يقاتلون المسلمين كافة كما يتضح من السياق اللغوي للآية . وبالتالي كان هذا القتال في خانة رد الفعل المنطقي على الجرائم التي يرتكبها المشركون كافة مستخدمين عقلهم الجمعي، وإمكانياتهم الكلية ، وكل طاقتهم مجتمعةً ، ومن أجل رد هذا العدوان الجماعي كان لا بد من القتال الجماعي حتى تنكسر شوكة المشركين .
وقال ابن كثير في تفسيره ( 2/ 465 ) : (( فيحتمل أنه منقطع عما قبله، وأنه مُستأنَف، ويكون من باب التهييج والتحضيض ، أي كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم فاجتمعوا أنتم أيضاً لهم إذا حاربتموهم وقاتلتموهم بنظير ما يفعلون )) اهـ .
} يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ {
[ التوبة : 111]
إن هذه الآية _ التي مَدحت الذين يُقاتِلون في سبيل الله فَيَقْتُلون أو يُقْتَلُون _ ليست دافعاً للإرهاب والحقد والكراهية ، وإنما هي تأصيل شرعي تحدثنا عنه كثيراً عند شروحاتنا للآيات السابقة. فاللهُ تعالى حدّد القتالَ بأن يكون في سبيله ، أي وفق ضوابط شرعية ، وليس من أجل الاستعلاء في الأرض بغير الحق ، أو ابتزاز الآخرين ، ووأد إنسانيتهم . ولا مفر من التعامل مع بعض البشر الذين لا يَفهمون إلا لغة السيف ، وإذا لم يتم تطهير المجتمع العالمي منهم ، فسيصبح العالَم مكاناً موبوءاً فاسداً لا يصلح للحياة . وهكذا ، فلا بد من بتر العضو الفاسد من أجل الحفاظ على استمرارية الحياة في الجسد كاملاً .
قال ابن كثير في تفسيره ( 2/ 515 ): (( أي سواء قَتَلُوا أو قُتِلوا أو اجتمع لهم هذا وهذا ، فقد وَجبت لهم الجنّة )) اهـ .
والجنة مكافأة لهم على عملهم الدؤوب في نشر السلام على الأرض عبر تصفية المحارِبين جسدياً الذين يريدون لكوكب الأرض الفساد والدمار . ومما لا شك فيه أن التخلص من العناصر السامة في أي مجتمع أمرٌ محمود ، يُقابَل بالترحاب من الآخرين لأن فيه استمرارية الحياة بصورة معتادة لأولئك الذين يريدون الحياةَ ويحترمون الحياةَ ، أما أولئك الذين يريدون سلب الحياةَ من الإنسان ، فيجب سلبُ الحياة منهم .
} يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الذِينَ يَلُونَكُم مِنَ الْكُفارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً {
[ التوبة : 123]
أمرَ اللهُ تعالى بقتال الأقرب فالأقرب ، وإظهار الشدة والصبر على القتال . وقد أُمر النبي صلى الله عليه وسلم أولاً بإنذار عشيرته الأقربين . فالأقربُ هو الأحق بالرحمة والرعاية والنصيحة .
وقال البغوي في تفسيره ( 1/ 113) : (( أُمروا بقتال الأقرب فالأقرب إليهم في الدار والنسب . قال ابن عباس _ رضي الله عنهما _ : مثل بني قريظة والنضير وخيبر ونحوها . وقيل : أراد بهم الروم لأنهم كانوا سكان الشام وكان الشام أقرب إلى المدينة من العراق )) اهـ .
مما لا شك فيه أن المقصود في الآية هم الكفار المحارِبون الذين ينبغي قتلهم فوراً لتطهير المجتمع منهم ، والآيةُ ذات سياق تاريخي محدّد ، وهي أيضاً عامة لمواجهة الأعداء المحارِبين في كل زمان ومكان، وهذا هو العدل المطْلَق . ففي هذه الآية لا يوجد دعوة للقتل العبثي ، أو إبادة الآخرين ، أو ممارسة العنف الهمجي، بل هي مُوَجّهةٌ ضد مَن تُسوّل له نَفْسُه أن يحارِب الإسلامَ والمسلمين، وكل الدول في العالَم تقوم بحماية شعبها من الأعداء، وقتلهم للحفاظ على حياة شعبها . والدولة الإسلامية هي التي تُطَبّق تعاليمَ الله تعالى لا التعاليمَ الوضعية ، وهي تقوم بواجبها لحماية الناس من أولئك الذين رموا القيمة الإنسانية للحياة وراء لمعان سيوفهم المرفوعة في وجوه الأبرياء، وبالتالي كان لزاماً التدخل لوأد هذا الفساد في الأرض .

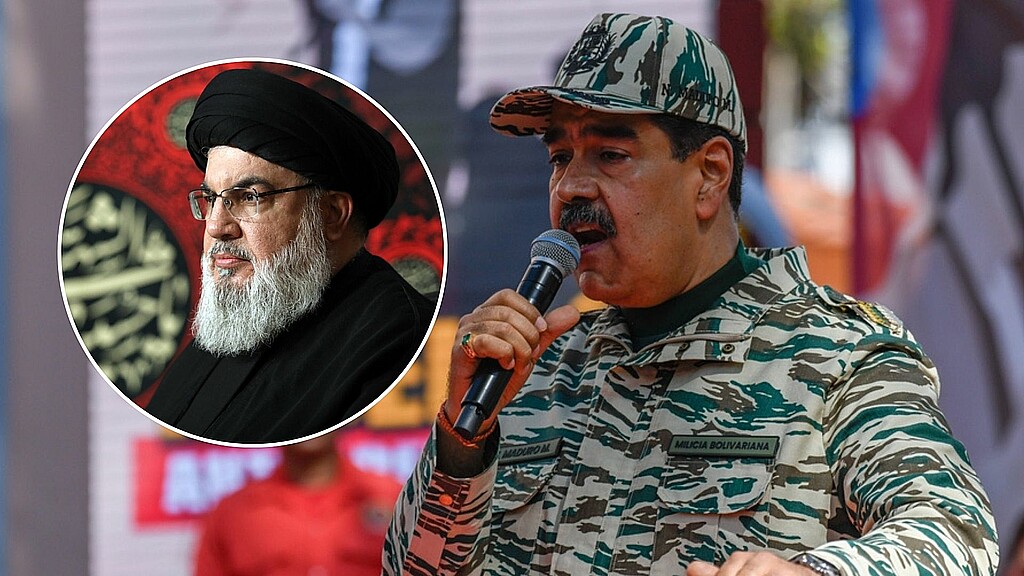


















التعليقات (0)