" محمد بن عبد الكريم الخطابي في الشعر العربي المعاصر بالمغرب " بقلم: د. فاطمة عبد الحق

محمد بن عبد الكريم الخطابي في الشعر العربي المعاصر بالمغرب
بقلم الدكتورة: فاطمة عبد الحق
يشكل التاريخ إحدى المرجعيات الأكثر ترسبا في ذاكرة الشعر العربي المعاصر بشكل عام، المغربي بخاصة. يتحقق هذا الحضور والترسب بكثافة على شكل أعلام وأحداث، أي على شكل رموز تاريخية. كما قد يتم –ولو بشكل أقل- على شكل نصوص.
إن علاقة الإفادة المتبادلة بين التجربة الشعرية الجديدة والرمز التراثي تتحقق بشكل واضح حين يتعلق الأمر بالرمز التاريخي، خصوصا وأن هذا النوع من الرموز يرتبط في جوهره بالزمن. لذلك يرجع الشاعر المعاصر إليه لينشىء صلات وروابط بين الماضي والحاضر والمستقبل، ويعيد كتابة التاريخ العربي والإنساني بوجه عام ممتزجا بواقع العصر. ينقل الرمز المرتبط في سانكرونيته/ سكونيته بفترة زمنية محددة إلى إطار آخر أكثر اتساعا وامتدادا، معيدا بذلك تشكيل المنظومة التاريخية الأصلية لتتلاءم مع سياق التجربة الجديدة، بتحويل التاريخ من حدث مرتبط بمرحلة وظروف معينة مشدود إليها، إلى استمرارية تلتقي على خطوطها التجارب التاريخية والتوجهات الحضارية القديمة والجديدة. أو لنقل: إن الشاعر المعاصر -بتوظيفه للمرجع التاريخي- ينفض عنه غبار الزمن، ويعيد رسم ملامحه وإظهار خطوطه لتبدو أكثر وضوحا وجدة، ويحمل إلى جانب بعده التاريخي أبعادا أخرى يكتسبها من سياق التجربة الجديدة في واقعها المعاصر. وهو – في الوقت نفسه- يخلق لإبداعه جذورا تمتد في تجربة الماضي، تتغذى منها لتمكنه من الاستمرار في الحياة.
هذه العلاقة بين الإبداع والتاريخ تتجاوز حدود الاستفادة الجزئية المتبادلة لتجعل من كل منهما مصدرا للآخر، فالتاريخ مصدر للإبداع، والإبداع مصدر للتاريخ. أو لنقل: إن للتاريخ ذاكرة إبداعية وللإبداع ذاكرة تاريخية.
وبما أننا بصدد الحديث عن حضور شخصية الخطابي في الشعر العربي المعاصر بالمغرب سندخل عوالم النماذج الشعرية التي استدعت هذا الرمز من بوابة الحديث عن التاريخ باعتباره مصدرا للشعر.
التاريخ مصدرا للشعر
لا يعد اللجوء إلى التاريخ سمة مميزة للإبداع الشعري المعاصر وحده، ولكنها نقطة تلتقي عندها المتون الشعرية العربية والأجنبية في مختلف عصورها بأشكال الفنون الإنسانية من تشكيل وعمارة ونحت ... ذلك أن التاريخ/ الماضي " إنما يسري في الحاضر، ويتحرك نحو المستقبل " (1)، ويفرض وجوده على مختلف مجالات الإبداع الإنساني، مع شيء من التفاوت والتمايز، فكل فن من الفنون أو عصر من العصور يختار من التاريخ الزوايا والوجوه الملائمة له.
وقد تحدث صاحب مقال "الشعر والتاريخ" عن مسألة استغلال الشعر للتاريخ حيث قال: " ... فإن الشعر كثيرا ما يكون نتاجا للأحداث التاريخية، بمعنى أن الشاعر قد يجد في حادثة تاريخية ما أو ظاهرة تاريخية بعينها ما يلهمه ويوقظ شيطان الشعر فيه، فينظم قصيدته أو ينسج خيوط مسرحيته الشعرية، مستلهما تلك الحادثة أو الظاهرة التاريخية " (2)، ثم يقرر: " وهو في كل الأحوال [ أي سواء جاء النتاج الشعري في شكل ملحمة أو قصة شعرية أو مسرحية أو قصيدة ... ] إنما يقوم بما يشبه التسجيل الفني للحدث التاريخي " (3).
غير أن صاحب المقال لم يشر في حديثه عن علاقة الشعر بالتاريخ أو عن استلهام الشعر للتاريخ إلا إلى جانب واحد من هذه العلاقة، ولم ينظر إليها إلا من زاوية واحدة، حيث يعمد الشاعر إلى الحدث أو الشخصية التاريخية اللذين يجد فيهما مادة لإبداعه، فينطلق في وصفهما بالإشادة أو الذم ... أي – ببساطة- إلى صياغة هذه المادة شعرا. فتكون قصيدته بذلك أشبه بالوثيقة التاريخية وأقرب إليها. ويمكننا أن نطلق على هذا النوع – تجاوزا- اسم "القصيدة التسجيلية" أو "الوثائقية" (4)، في حين أن حضور التاريخ في الإبداع الأدبي عامة والشعري بخاصة يتخذ وجوها شتى، ذلك أن المبدع –كما اشرنا- :
قد يصف حادثة أو شخصية تاريخية ما ويؤرخ لهما، فيكون إبداعه بذلك وثائقيا، مع لمسات فنية وصور خيالية لا يخلو منها الإبداع أيا كان جنسه. ومن نماذج هذا التعامل مع الموروث التاريخي: السير الروائية والقصائد التي تكتب بهدف التأريخ لحدث أو شخصية ما (الملاحم،بعض القصائد والمسرحيات الشعرية) (5).
قد يستلهم الإطار التاريخي ليملأه بمضامين تعبر عن عصره. ويحدث ذلك – في الغالب- في الروايات ذات الطابع التاريخي أو التي توهمنا بتاريخيتها، وبعض المسرحيات والقصائد التي ترسم جوا تاريخيا متكاملا بلغتها وصورها وتناصاتها واستغلالها لشخصيات تاريخية عامة (الخليفة، الجلاد، الحاجب، الجارية ...) للتعبير عن تجربة جديدة.
قد يستدعي الشخصية أو الحدث ويحيل عليهما للتعبير عن واقع جديد، بالتطابق والترادف أو بالنفي والحوار. فيكون استحضار التاريخ بذلك على سبيل التقنيع أو التعبير بالواسطة والرمز. وهذا ما يحدث غالبا في الإبداع الشعري المعاصر. وهو شكل الاستحضار الذي يهمنا أكثر، لأنه بالإبداع الأدبي ألصق وبسياق موضوعنا ألوط.
بقيت مسألة واحدة لابد من الإشارة إليها قبل الخوض في غمار المتن الشعري المغربي المعاصر وهي كون الشاعر في استغلاله للتاريخ لا يملك حرية التصرف كاملة، بمعنى أنه ينبغي عليه " ألا يلوي عنق الحقيقة التاريخية في سبيل الإبداع الفني، فإن ذلك يعد تزييفا للتاريخ وينأى بالعمل الفني عن خاصية أولية من أهم خواصه وهي الصدق. والصدق الذي نقصده في هذا المقام هو "الصدق التاريخي" الذي لا نراه متعارضا مع "الصدق الفني" (6). فليس على الشاعر حرج إن هو استحضر رمزا ما ونظر إليه من أية زاوية شاء. أو إن هو اعتمده نواة واقعية يكسوها من خياله، شرط أن لا ينافي الواقع التاريخي أو يزيف الحقيقة، " فالقارئ يرفض تحريف التاريخ ولا يرفض تزويقه "(7).
لقد برهن الشاعر العربي المعاصر، المغربي على وجه الخصوص، من خلال استحضاره للتاريخ وقراءته ": قراءة سياسية تقدمية، تبتعد عن أسلوب المؤرخين الرسميين ومناخ الثقافة السائدة التي تفرز الكتابة التاريخية انطلاقا من [توجهها السياسي والأيديولوجي] ورؤيتها الطبقية لهذا التاريخ، هادفة من وراء ذلك إلى طمس الحقيقة " (8):
على وعيه بالعلاقة الحتمية التي تربطه كحاضر ومستقبل بتراث أمته بوجه خاص وبالتراث الإنساني عموما، أي أنه صار يمتلك بحق "حسا تاريخيا" Historical Sense بالمفهوم الإليوتي، يعي معنى التلازم الصميم والعضوي بين الماضي الأب الشرعي للحاضر والحاضر الاستمرار والامتداد للماضي.
على أن نظرته للتاريخ كانت محكومة دائما باعتبارات الحاضر. بمعنى أنه ينظر إلى التاريخ انطلاقا من المشكلات التي يعيشها في واقعه.
من هنا يمكن القول: إن الظروف التاريخية التي عرفها المغرب الحديث، بل والأمة العربية بوجه عام، كان لها أكبر الأـثر في توجيه أنظار شعرائنا نحو رموز تاريخية بعينها، مما أدى إلى طغيان أصناف من الشخصيات والأحداث، تشكل في مجملها "أنماطا بدئية" أو "نماذج أصلية" Archetypes، يلتقي عندها أغلب الشعراء على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم.
لذلك حفل الشعر المغربي المعاصر باستدعاءات لشخصيات تاريخية كان لها الدور الهام والفاعل في التاريخ، وهي الشخصيات المناضلة والمجاهدة من الفاتحين وقادة الثورات والحروب التحريرية التي تحمل كل معاني الرفض والتمرد على الاحتلال الغاشم والفساد المستشري وكذا الامبريالية العالمية ( محمد بن عبد الكريم الخطابي، صلاح الدين الأيوبي، ارنستو تشي غيفارا، طارق بن زياد ... ).
وقد غلب توظيف هذه الرموز خاصة في بدايات الفترة المعاصرة، أي في سنوات السبعين، نظرا للظروف وطبيعة المرحلة التي عرفها المغرب والوطن العربي عموما. بحيث شكلت بالنسبة للشاعر المعاصر المخلص والمنقذ من الوضع المتردي ومن رداءة اللحظة التاريخية المعاصرة.
محمد بن عبد الكريم الخطابي
حظيت شخصية بطل الريف محمد بن عبد الكريم الخطابي باهتمام بالغ من لدن المؤرخين والمبدعين العرب والأجانب على حد سواء، حيث أفردت كتب ودراسات أرخت لحياته ومقاومته الباسلة للقوى الفرنكوإسبانية. يقول صاحب كتاب "عبد الكريم أمير الريف": لقد كان اسم عبد الكريم " يتردد على كل شفة ولسان في العالم أجمع، فهو صورة المقاومة المحلية ضد الحكم الاستعماري، وهو أول إفريقي شمالي ينادي بتطبيق مبدأ تقرير المصير على ضحايا الامبريالية. إن رجل القانون البسيط الذي انقلب جنديا، وقاضي البلدة الصغيرة الذي مضى إلى الحرب يركب حمارا قد اجتاح مخيلة ملايين الناس في أوروبا وأمريكا. إن صحفيين مشاهير قد أفلتوا من يقظة أعدائه وتغلغلوا متنكرين في الريف كي يقابلوه. كما أن الصحف قد نشرت مآثره بعناوين كبيرة في صفحاتها الأولى وهو يسحق بصورة لا تصدق جيوش إسبانيا وفرنسا معا" (9).
من الطبيعي بعد كل هذه الضجة التي أحدثها اسم الخطابي أن يكون حقل الإبداع المغربي، الشعري منه على وجه الخصوص، أكثر الحقول أو المجالات احتفالا بشخصيته، إحياء/ توثيقا أو استلهاما.
ولو أطلقنا لأنفسنا العنان في إيراد كل النماذج التي استحضرت شخصيته أو أحد العناصر التي تدور في فلكها لما أمكننا ذلك في هذا الحيز. لذلك سنعمد إلى إيراد بعضها فقط، حتى نتبين أشكال الحضور التي مارسها هذا الرمز والحمولة التي وظف لأجلها.
الرمز محورا للقصيدة:
النموذج الأول: قصيدة "عبد الكريم" لعبد الكريم الطبال
يستدعي الشاعر في هذا النص رمز عبد الكريم الخطابي بطل حرب الريف، مصرحا باسمه مرة في المقطع الأول وأخرى في الثاني، ويحيل باسم عبد الكريم (عنوان القصيدة) على شخصيتين، أو لنقل بتعبير آخر: إن اسم عبد الكريم في عنوان القصيدة هو عملة ذات وجهين متناقضين. لنقرأ المقطع الأول:
عبد الكريم الفارس في الموت والحياة
يا أجمل الأسماء
يا عاشق الجبال والصلاة في الجبال
يا أخير الأحباب
أنا هنا أحمل اسمك العظيم
لكنني لا أشبهك
لست بالفارس، ولا تعرفني الجبال
يهرب مني اسمك العظيم
تنكرني الجبال والصيحات في الجبال
تهرب من ناصيتي العمامة الولية
تنكرني الحمالة والسيف (10)
فالشاعر يخاطب عبد الكريم الخطابي مبرزا حجم المفارقة الهائلة بين عبد الكريم الفارس بطل حرب الريف وعبد الكريم الشاعر الذي تنكره كل مظاهر الفروسية، بل أكثر من ذلك يرفضه الاسم نفسه، فهو النتاج المشوه للواقع المريض والصورة الصادقة عن حياة الرخاء والكسل والفراغ والتفاهة.
ويغلب أسلوب الموازنة بين عبد الكريم الخطابي وعبد الكريم الطبال خصوصا في المقطع الثاني من القصيدة:
عبد الكريم الفارس في الموت والحياة
يا أجمل الأسماء
يا عاشق الجبال والصلاة في الجبال
يا أخير الأحباب
حيث أنا هنا أحمل اسمك العظيم
لكنني لا أشبهك
كنت تحب أن تستقبل الصباح في الجبال
وإنني أحب أن أستقبل الصباح في جنان حلم ساحر
كنت تحب أغنيات الخيل والمكاحل والريح
وإنني أحب أغنيات كوكب الشرق العجوز
كنت تحب أن تحمل السبحة إذا ما جاء الفجر
وإنني أحب أن تحملني الكأس إذا ما جاء الليل (11)
يصور الشاعر حياة أمير الريف بما فيها من امتلاء، ويقارن كل صورة من صورها بمشاهد حياته هو باعتباره رمزا للإنسان الذي أنجبه الواقع الرديء؛ فإذا كان الخطابي عاشقا للجبال والصلاة فيها، يحب أغنيات الخيل والمكاحل والريح، ويحمل السبحة إذا ما جاء الفجر بما يرمز إليه من معاني النور والوضوح والبراءة والإيمان. فإن عبد الكريم المعاصر ربيب المدينة وجنان الحلم الساحر. يعشق أغنيات كوكب الشرق العجوز. ولا يجد بين أسوار عجزه وإحباطه غير كأس بالليل البهيم؛ ليل الواقع وليل النفس المحبطة. يغرق فيها همومه وإحساسه الخانق بالضياع والتفاهة.
فاستحضار رمز الخطابي في قصيدة الطبال هو استحضار لحياة كاملة، لصور فيها من العمق والصدق والإنسانية ما يمنحها –على بساطتها- قيمتها ومعناها. ويمنح الإنسان إحساسا عميقا بإنسانيته وفاعليته. في حين جعل الشاعر من شخصه هو رمزا للحياة المعاصرة بكل ما فيها من بذخ .. للإنسان الذي يمتلك كل شيء إلا إنسانيته.
النموذج الثاني: قصيدة "مليلية" لعبد الكريم الطبال.
يصر الطبال في هذا النموذج أيضا على أسلوب الموازنة؛ فإذا كان في النص السابق يقارن بين شخصيتين: شخصية الخطابي الفارس وشخصية الطبال الإنسان المعاصر المهزوم، فإنه في هذا النص يقيم نوعا من الموازنة –وإن لم تكن واضحة وضوحها في النص السابق- بين عهد أنجب الخطابي، يتميز –رغم قساوة ظروفه- بالحيوية والحركة. يمنح الأشياء معناها. يستحضره في ذاكرتنا باستدعائه الرمز. وعهد تطوى فيه عمامة الفارس الجليلة في دولاب. صورة حملها الشاعر أقسى معاني السكون والموت وأعمقها. تعرض حقيقة ما آل إليه الوضع في بلد الخطابي، بل وفي أمة العرب كلها. لنقرأ:
أيتها العمامة الجليلة
أيتها السحابة الحزينة
ها أنت الآن في الدولاب
مطوية كالسر
أو أنت غيمة على بقايا نافذة
تحجب الفجر
أو راية منكوسة
تبكي على موت السماء
أو كفن لطائر .. سقط في شباك الثلج (12)
فالغيمة تحجب الفجر، والعمامة راية منكسة باكية أو كفن لطائر سقط في شباك الثلج. كل شيء بارد وساكن وفاقد لقيمته.
فأين –يا عبد الكريم- رأس الشمس
وجبهة الصلاة
وأين أنت
يا سيد المدينة
يا سيد البحر الجميل (13)
يهز الشاعر هذه الصورة الصامتة الراكدة ركود ماء آسن بالسؤال الذي يفجر السكون، عن رأس الشمس الشامخة التي ترسل أشعة النور والدفء إلى الأشياء لتهتز وتستعيد الحياة، عن جبهة الصلاة/ الإيمان التي تمنح الأشياء بعدها العميق. لكن سؤال الشاعر يتحول إلى مجرد صدى يرتد إليه، فعبد الكريم سيد المدينة وسيد البحر الجميل
مر كملاك خافض الجناح
يشبهه في لطفه
وفي بهاء وجهه
وفي التماعة الجبين
ثم اختفى في عطفة السماء
سألت عنك مقعدا في مقهى
مشحون بالرجال الجوف
والأطفال الزرق
فقال لي:
عهدته يجلس فوق الصهوة
ويشرب الزلال من سحابة
والعسل المصفى من قفيرة
فقلت الله الله
في أرض بلا شجر
وفي رياح لا تهب
وفي عصفورة بلا صداح (14)
فالأشياء لا تزال فاقدة قيمتها، عاجزة عن القيام بدورها؛ فالأرض بلا شجر، والرياح لا تهب، والعصفورة لا تصدح، والفارس لا يزال يمارس غيابه عن وطن لا يملأه غير الفراغ.
أيتها العمامة الجليلة
أيتها اليتيمة
ها أنت الآن لا بياض فيك
ولست نجمة على الأفق
ولست آخر قميص
نمسح به الوجه
فنبصر الحقيقة (15)
فعمامة الخطابي الذابلة التي فقدت بياضها لم تعد نجمة تتلألأ في الأفق رمزا للنور والصحو، وليست آخر قميص يكشف الحقيقة أمام أعيننا لنرتد بصراء، فقمصان يوسف أكثر من أن تعد، وواقعنا المعاصر زاخر بأشياء ومواقف ومشاهد تلقى على عيني الإنسان المعاصر، فتتضح أمامه الرؤية.
لقد ظلت الصورة التي رسمها الشاعر سوداوية راكدة لم يضئها الرمز المشرق الذي يواصل غيابه عن هذا العالم، فلا يملك الشاعر إزاء هذا الغياب غير تنهيدة يرسلها لما تبقى من أشيائه : العمامة.
أيتها الأميرة
أيتها الأسيرة
تنهيدة إليك
من غريب الرأس واللسان (16)
النموذج الثالث: قصيدة "رسائل منسية في دائرة القهر للثائر الخطابي" لأحمد مفدي:
يخلق عنوان النص في البداية نوعا من الإبهام، فالشاعر يشير إلى رسائل منسية في دائرة القهر للثائر اتلخطابي، "واللام للملك" كما يقول ابن مالك في ألفيته، فهي تفيد ملكية الخطابي لهذه الرسائل، في حين ينطبع في ذاكرتنا من القراءة الأولى للنص أن هذه الرسائل إنما هي مبعوثة إلى الخطابي وليس العكس.
ومهما يكن من أمر، فإن هذا لن يغير من المعنى الذي يوحي به العنوان شيئا، فإذا كان هذا الاستنتاج صحيحا تكون رسائل الخطابي مختزنة ومنسية في "دائرة القهر" حتى لا يحدث بذلك التواصل بين الواقعين: واقع الشاعر الباعث وواقع الخطابي المبعوث إليه. وإذا كان العكس هو الصحيح، تكون رسائل الخطابي إلى واقعنا المعاصر منسية في "دائرة القهر". فــــ "دئرة القهر"/ السلطة القمعية تظل حاجزا بين العالمين: عالم الخطابي بما فيه من تحرر وقدرة على الفعل وعالم الشاعر بما يحيط به، ويعشش في زواياه من مظاهر الإحباط والعجز.
كان الخطابي رشفة قهوة
تحلو في الأذواق
تمضي يده الهادئة المنبت في الأعماق
لتداوي ما ترك الماضي من جرح لا يندمل!
"لم يمنع من خبز الريف فما"
"لم يهدم بيتا"
الغاوي لم يقدر أن يحرق في مدخله العلما
الثائر في أنوال يرفع "شارة"
تنصب على هامته
يزحف في طرق الحارة ..!
ها قد صار يزف وصاياه إلى
جيل يعصف كالريح إذا هاجت (17)
يمضي الشاعر في رسم صورة نبوية –إن صح التعبير- للخطابي، فهو مسيح يمر بيده الهادئة على جرح الماضي الساكن في الأعماق فيندمل، وهو نبي الرحمة الذي "لم يمنع من خبز الريف فما" و"لم يهدم بيتا".
تتكرر ملامح النبوة الرحيمة هذه في أكثر من نموذج من نماذج المتن الشعري المعاصر بالمغرب: فهذا الحسين القمري مثلا يرسم في قصيدته "عبد الكريم" صورة مماثلة لصورة مفدي:
عبد الكريم
قلب يمارس في الجبال
عشق الوطن
شلال إيمان يحف به الرجال
ويد تمد الخبز للفقراء والمستضعفين
قنديل ضوء للحيارى
ورفيق عافية .. وأمن .. واحتساب (18)
لقد استغرق وصف الخطابي مع إضفاء ملامح النبوة على شخصه قصيدة مفدي بأكملها، وكان بإمكان هذا الاستغراق أن يسجن الشخصية في إطارها التاريخي المعروف، بدل أن يستحضرها في سياق جديد يمنحها امتدادا واستمرارية. فتسقط قصيدته بذلك في الوثائقية والتسجيلية. غير أن إحالته في عنوان النص وكذا في المقطع الأخير منه:
يا صاحبي الخطابي ..!
نظرتك العاشقة الظمأى تلتهم الأطواق
تختزن الماضي والآتي
تكتب في أحراش الريف وصاياك السبع (19)
وضعت أمام أعيننا عالمين: عالم الخطابي الماضي والعالم الآتي الذي ترسمه وصايا الخطابي السبعة المكتوبة في أحراش الريف. فالشاعر إذن لم يعمد إلى التوثيق، وإنما لجأ إلى التلميح لكي "يولد إحساسا أليما بالمقارنة" (20)، فالشاعر قد صرح بطرف المقارنة الأول الذي يمثله موقف الخطابي القوي، واكتفى بالإيحاء بالموقف الضعيف المعاصر من خلال سياق النص، وكذا من خلال عنوانه.
لكن الشاعر المنتظر لموسم الرياح لم يقف في رؤيته لهذا الواقع ورؤياه تجاهه عند هذا الحد، بل أعلن عن وجود جيل "يعصف كالريح إذا هاجت"، يزف إليه الخطابي وصاياه، جيل يتجاوب مع ثورته وينفض عنه غبار الواقع. فوصايا الخطابي إذن هي رسائله المنسية في "دائرة القهر". وبالقضاء على هذه الدائرة تصل الوصايا إلى الجيل الجديد العاصف كالريح إذا هاجت.
الرمز مكونا جزئيا
النموذج الأول : من قصيدة "مغربنا وطننا" لمحمد علي الرباوي
أيهـــــــا الطالـــــــع من جمر الخزامــــى قطرة حمــــــــراء تخضر بهــــــا كل
بساتين بلادي، بحت بالعشق، وليلى طفلة نم عليها نورها الوهاج ما
إن سلمت حتى بكت عيناك عشقــا والتهابـــا، بحت بالســـــــــــــر، وكـــــــان
السكر يسري بين أدغالك ليلا. آه يا ليلى! مري أن أقتل اللحظة، أن
أدفن في صدرك هذا. أمرت بالقتل عيناها، حملت الجرح. لم تسقط
على الصدر ... (21)
في هذا المقطع من قصيدة "مغربنا وطننا" التي يتأسس عنوانها نفسه على تناص مع شعر الشاعر علال الفاسي، يستلهم الشاعر رمز أمير الريف عبد الكريم الخطابي مكتفيا ببعض المؤشرات التي تؤكد هذه الإحالة: الخزامى وهو الاسم القديم للحسيمة، "حملت الجرح لم تسقط على الصدر" وسقوط الخطابي لم يكن في مسقط رأسه، بل في أرض مصر. وفي المقطع الموالي إحالة على جبل التوباد تذكرنا بمصر في شخص أحد رموزها وهو أحمد شوقي.
والخطابي في مقطع الرباوي هو نقطة الدم الحمراء التي تنجب خضرة تشرق بها أرض الوطن، ثم لا تملك بها رقعة أرض تحضنها في مقامها الأخير. وهو معادل موضوعي للشاعر، بل لجيل غريب عن أرض هو جزء منها، غير أنه لا يملك فيها حتى قبرا يثويه.
وإذا كان الرباوي قد اكتفى في هذا المقطع بالإحالة على رمز الخطابي ببعض لوازمه، فإنه في المقطع السابق له من القصيدة نفسها سار على الخط النقيض، إذ عمد إلى شحنه بعدد من الأسماء التاريخية وبعض أسماء الاماكن والأحداث المرتبطة بها:
إيــــــــــــــه أمـــــــــــــــي .. من يذكــــــر أبنـــــــاء كحمـــــــــــــــــو والهيبــــــــــة والخطابـــــــــــــــي؟ مــــــن
يذكــــــر أبنـــــــــاءك عسو والحجــــامي؟ من يذكــــــــــــــــــر رحــــــــو والنكــــــادي؟ قذفتهـــــــــــم
يا أم موائد إكس ليبان بعيدا عن ذاكـــــــــرة الأطيـــــــار، فمن يذكـــــــر هــــــــذا اليـــــــوم
شقائق نعمـــــــان كانت بغلائلهــــــا تلقي زينتها البيضــــــاء على الأطلــــــس والريـــــف
الشامخ .. ما زالت تلك الأزهار تفوح بعطر الجنة حول اخنيفرة والدار البيضاء (22)
فأسماء مثل حمو والهيبة والخطابي وعسو والحجامي وغيرها... عبارة عن أقنعة تاريخية، ارتبطت في الذاكرة الجمعية المغربية خصوصا بوقائع وثورات، يحاول الشاعر من خلالها أن يستعيد الوجه المشرق للمناضل المغربي المؤمن بهدفه وقضيته، أو يرثي زمنا لم تعد الأوطان تذكر فيه من أبنائها غير الأسماء.
النموذج الثاني: من قصيدة "توقيعات" لحسن الأمراني
(الخزامى) ترفع السيف جهارا وتكبر
صولة الأصنام تهوي .. تتكسر
فأعد يا جبل الريف العظيم
صوت (أنوال)
أعد صولة هذا الفارس الرائع
في أشواقه الأولى
وفي أسفاره ..
عبد الكريم (23)
يستحضر الشاعر في هذا النص شخصية الخطابي، إلا أنه لم يصرح باسمه إلا في آخر المقطع، حيث بدأ بتقديم مؤشرات تشير إلى شخصه: (الخزامى، جبل الريف، أنوال). والشاعر –من خلال استدعائه لرمز الخطابي- يبحث عن المثل الأعلى، عن الوجه المشرق للواقع العربي والإسلامي، حيث تهوي صولة الأصنام، ويرتفع صوت الحق، وتستعيد الأمة الإسلامية نموذج المجاهد البطل والفارس الرائع.
يفرض التوجه الإسلامي نفسه على هذا الاستدعاء، فالخطابي لم يعد رمزا للمناضل ضد القوى الاستعمارية فحسب، بل تجاوز هذه الصورة المعهودة، ليتحول إلى مجاهد يحطم الأصنام بما تحيل عليه هذه الكلمة من مضمون تاريخي وعقدي.
استنتاجات
بعد قراءتنا لهذه النماذج من المتن المدروس –وكذا لنماذج أخرى لم نتمكن من إيرادها نظرا لضيق المجال- من خلال أشكال الحضور التي يمارسها رمز الخطابي داخلها، توصلنا إلى بعض الملاحظات، نوردها باختصار:
• تعامل شاعرنا المعاصر مع هذا الرمز التاريخي من خلال بعث الماضي واستدعائه في إطار تجربة جديدة، يحاول من خلالها خلق نوع من التواصل والتفاعل بين المرحلتين التاريخيتين: القديمة والمعاصرة. وقد خضعت هذه العلاقة لقانون الحوار والنفي. وهو القانون الذي يتعامل به شاعرنا المعاصر مع الرموز التاريخية الإيجابية، حيث يستدعيها في إطار التجربة الشعرية الجديدة المعبرة عن الواقع الراهن، ثم يحاورها وينفيها، ليثبت أن هذا الماضي التاريخي المشرق والمشرف والواقعالراهن الرديء قطبان لا يلتقيان.
• تكشف نصوص المتن المدروس عن مدى الإحباط والضياع اللذين تعانيهما الذات الجمعية المغربية في الفترة المعاصرة، وكذا عن رغبتها العارمة في الخروج من القمقم الذي صار يعتصرها في أعماقه، بفضح الواقع وإزاحة أقنعة الزيف عن وجوهه، حتى تضحي الحقيقة عارية واضحة للعيان.
الهوامش
1- "التراث التاريخي عند العرب" د. عفت الشرقاوي. مجلة "فصول" المصرية (مشكلات التراث). م:1 ع:1 أكتوبر 1980م. ص: 142.
2- "الشعر والتاريخ" قاسم عبده قاسم. مجلة "فصول: (شوقي وحافظ). م:3. ع:2 1983م. ص:238.
3- م. ن. ص:239.
4- مصطلح أطلقه "جوزيف ترنر" على الرواية التي تتقاطع مع التاريخي والوثائقي. انظر مقال "الرواية والتاريخ" لفريال جبوري غزول. مجلة "فصول (الرواية وفن القص). م:2. ع:2. يناير- فبراير- مارس 1982م. ص: 295.
5- مثال ذلك قصيدة "فتح عمورية" لأبي تمام، فهي قصيدة تتوفر على الأبعاد الجمالية المطلوبة في الإبداع الشعري، لكنها تظل مع ذلك قصيدة تسجيلية، إذ لم تتعامل مع الحدث التاريخي باعتباره رمزا، بل باعتباره واقعة يصوغها الشاعر وفقا للمنهج الاستردادي الذي يتبعه المؤرخ حين يسير في الخط المناقض لخط التاريخ ليصف الحدث.
6- "الشعر والتاريخ" قاسم عبده قاسم. ص: 236.
7- الرواية والتاريخ" لفريال جبوري غزول. ص: 295.
8- "ظاهرة الشعر العربي المعاصر في المغرب. مقاربة بنيوية تكوينية" محمد بنيس. دار التنوير للطباعة والنشر. بيروت. المركز الثقافي العربي. الدار البيضاء. ط:2. 1985م. ص: 269- 270.
9- "عبد الكريم أمير الريف" روبرت فورنو. ترجمة: د. فؤاد أيوب. دار دمشق للطباعة والنشر. (بدون تاريخ). ص"4.
10- "الأشياء المنكسرة" عبد الكريم الطبال. دار النشر المغربية. الدار البيضاء. ط:1. 1974م. ص: 109.
11- م. ن. ص: 110.
12- "القبض على الماء" عبد الكريم الطبال. منشورات البوكيلي للطباعة والنشر والتوزيع القنيطرة ط:1. 1996. ص:28.
13- م. ن. ص: 28- 29.
14- م. ن. ص: 29- 30- 31.
15- م. ن. ص: 31.
16- م. ن. ص: 32.
17- "في انتظار موسم الرياح" أحمد مفدي. مطبعة النهضة فاس 1972 ص: 14- 15.
18- "ألف باء" الحسين القمري. منشورات رواد القلم. مطبعة المحيط. الدار البيضاء. ط:1. 1975. ص: 81- 82.
19- "في انتظار موسم الرياح" أحمد مفدي. ص: 15- 16.
20- "استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر" د. علي عشري زايد. منشورات الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان. طرابلس. الجماهيرية الليبية. ط:1. 1978م. ص: 256.
21- "أول الغيث" محمد علي الرباوي. منشورات المشكاة. المطبعة المركزية. وجدة. ط:1. 1995م. ص: 11.
22- م. ن.
23- "الزمان الجديد" حسن الأمراني. منشورات المشكاة. وجدة. دار الأمان للنشر والتوزيع. الرباط. ط:1. 1408هـ 1988م. ص: 80.














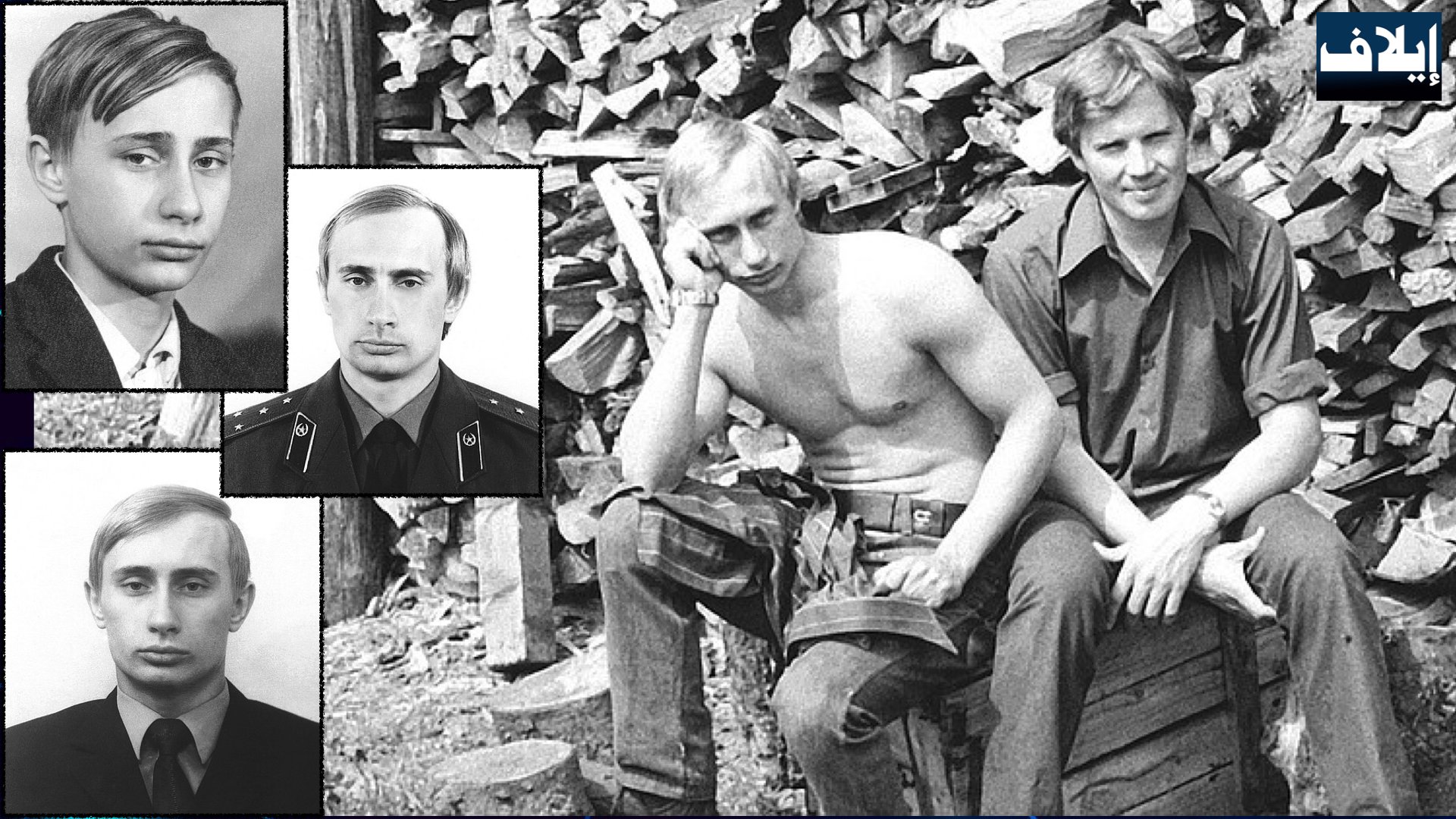




التعليقات (0)